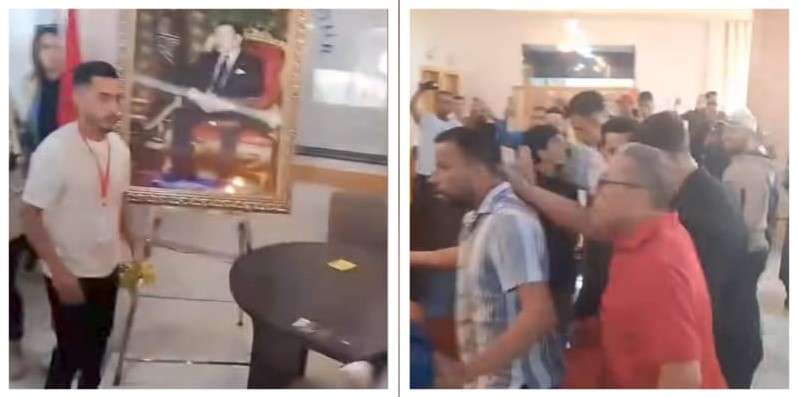داخل كل حجرة من حجرات الدرس التي بناها المستعمر، أو تلك التي شيدت في بداية استرجاع الاستقلال، كانت هناك خزانة. وكان المسؤول عن الخزانة هو الأستاذ(ة). وباستثناء بعض الحالات النادرة فقد كانت خزانة الفصل تضم كُتُباً ملائمة لمستوى التلاميذ، وكان عليهم قراءتُها بالتناوب، والقيام بأنشطة كتابية حولها أو انطلاقاً منها. وقد كان الأمر يسري على اللغتين العربية والفرنسية معاً.
أما اليوم فقد أصبحنا في حاجة إلى مسابقة لكي يقرأ التلاميذ. وأم الفضائح أننا صرنا في حاجة إلى مسابقة حتى يقرأ الأساتذة أيضا. وهي المسابقة التي أُطلقَ عليها اسم "الأستاذ المثقف"، والتي ترعاها دولةٌ خليجية، وينخرط فيها كثير من الأساتذة لا حُباًّ في القراءة وإنما طمعاً في الجائزة. ولا أحد انتبه ـ على ما يبدو ـ إلى أن وصف "الأستاذ المثقف" يعني، بالمُخَالَفة، أن هناك أستاذا آخر، "غير مثقف". وتقسيم الأساتذة، ضمنياً، على هذا النحو معناه القبول ب"الأستاذ غير المثقف" كواقع قائم لا يرتفع، والتصالُح معه، ومع وجوده داخل المنظومة التربوية. والحال أن الأستاذ لا ينبغي أن يكون مثقفا فقط وإنما يجب أن يكون منتجا للفعل الثقافي الواعي، والهادف، والمسؤول. ولا مكان، مبدئياً، في المدرسة ولا في الجامعة لأستاذ "غير مثقف".
التصالح مع "الأستاذ غير المثقف"، والإقرار به كواقع قائم في المدرسة والجامعة، هو عينُه التصالحُ مع "الأستاذ التاجر" الذي يبيع الدروس الخصوصية للتلاميذ. وهو ذاتُه التصالح مع الأستاذ الجامعي الفاسد المُفسد الذي يبتز الطالبات جنسياً.
وهو نفسُه التصالح مع الأستاذ الذي تمر عليه الأيام، والأسابيع، والشهور، والسنوات، دون أن يقرأ حرفاً واحداً. إنه ذلك "الأستاذ" الذي ليس أستاذا إلا بالوظيفة الرسمية، وكلُّ هَمِّه هو الركض وراء المال والتهافت المسعور وراء المظاهر والموضة وكأنه عارضة أزياء. فبعد أن كان الأستاذ يعتدُّ بما في جعبته من معارف، ويأتي إلى الفصل لينقل المعارف إياها لتلاميذه أو طلبته، صرنا اليوم أمام "أساتذة" يتبارون في ارتداء آخر صيحات الملابس التي لا تليق بالفصل الدراسي في أغلبها، بل ولا تليق بصورة الأستاذ داخل المجتمع على العموم، ولا يرتديها إلا "المُشَرْمَلُون".
وإلى جانب "الأستاذ المُشَرْمَل" يوجد "الأستَاذُ المُخَوْنَج" الذي يأتي ـ ذكراً كان أو أنثى ـ إلى الفصل الدراسي بلباس الدواعش وطالبان، أشعَثَ أغْبَر، تفوح منه رائحة "الحلبة"، لينشر الجهل عوض المعرفة ويُفشي الظلام بَدَلَ النور. وهذه الفئة الأخيرة أخطر، طبعاً، من الأولى لأنها تُسمِّمُ عقول النشء ووجدانه بالخرافات، والأوهام، والفكر الإرهابي المتطرف. وهنا، بالتأكيد، توجد مسؤولية جسيمة من مسؤوليات الدولة التي تتغافل عن الخطر الأكبر. فالدولة لكي توظف شرطياً، أو دركياً، أو جندياً، تتحرى عن أصله وفصله وقبيلته وفصيلته التي تأويه. ولا يمكن أن تقبل في صفوف الشرطة أو الدرك أو الجيش شخصا يحمل فكرا ظلامياً لأنه سيحمل السلاح الناري وسيكون مسؤولا عن الأمن. لكنها، بالمقابل، توظف الأساتذة دون أي بحث أو استقصاء رغم أن السلاح الذي يحمله الأستاذ داخل الفصل أخطرُ من أي سلاح ناري مهما كان فتاكاً.
وإلى جانب "الأستاذ المُشَرْمَل" يوجد "الأستَاذُ المُخَوْنَج" الذي يأتي ـ ذكراً كان أو أنثى ـ إلى الفصل الدراسي بلباس الدواعش وطالبان، أشعَثَ أغْبَر، تفوح منه رائحة "الحلبة"، لينشر الجهل عوض المعرفة ويُفشي الظلام بَدَلَ النور. وهذه الفئة الأخيرة أخطر، طبعاً، من الأولى لأنها تُسمِّمُ عقول النشء ووجدانه بالخرافات، والأوهام، والفكر الإرهابي المتطرف. وهنا، بالتأكيد، توجد مسؤولية جسيمة من مسؤوليات الدولة التي تتغافل عن الخطر الأكبر. فالدولة لكي توظف شرطياً، أو دركياً، أو جندياً، تتحرى عن أصله وفصله وقبيلته وفصيلته التي تأويه. ولا يمكن أن تقبل في صفوف الشرطة أو الدرك أو الجيش شخصا يحمل فكرا ظلامياً لأنه سيحمل السلاح الناري وسيكون مسؤولا عن الأمن. لكنها، بالمقابل، توظف الأساتذة دون أي بحث أو استقصاء رغم أن السلاح الذي يحمله الأستاذ داخل الفصل أخطرُ من أي سلاح ناري مهما كان فتاكاً.
وحين تسمح الدولة ل"المُشَرْمَلين" و"المُخَوْنَجين" باستلام زمام السلطة التربوية داخل الفصل الدراسي فلا حق لها في البحث بعد ذلك عن هذا "الأستاذ المثقف" المزعوم. فالمثقف ـ إن وُجِدَ فعلاً! ـ سيكون في هذه الحالة منبوذا، وغريباً، وربما يصير مضطهدا ويغدو عرضة للتشهير والمضايقات والدسائس من طرف هؤلاء وأولئك. وليست مسابقة سنوية، برعاية دولة خليجية يحكمها نظام قروسطوي متخلف، هي التي ستصنع "المثقفين". فالقاعدة الأولية الشهيرة تقول بأن فاقد الشيء لا يعطيه. والدولة التي تساهم في صنع المثقف لدى الغير يفترض أولاً أن يكون شعبُها مثقفاً. والشعب المثقف لا يمكن أن يقبل بحكم عشائري في القرن الحادي والعشرين.
نعم، إنه لهدفٌ في منتهى النبل أن نفكر في إنعاش القراءة داخل مدارسنا. لكني أتصور أن الأمر لا يتطلب أكثر من بناء "خِزَانات" داخل كل الفصول التي بُنيت ـ ويا للعار! ـ بدونها. وبعد هذا لن يتطلب الأمرُ أكثر من ملء تلك الخزانات بالكتب الملائمة لمستوى المتعلمين مع إلزام الأساتذة بقراءتها وقراءة كل ما يتطلبه تصريفُها ديداكتيكيا، واعتماد الإنتاج المعرفي السنوي للأستاذ(ة) في مجاله ضمن معايير الترقية. وما لم يحدث هذا فسنظل أمام تفاهات من قبيل ذلك النشاط الذي تم تنظيمه ذات يوم في إطار "نادي الإبداع الفني والأدبي" حول موضوع لا أعرف ما علاقتُه بالفن ولا بالأدب ولا بالإبداع: "الطهارة: شروطُها وأحكامُها". فكأن كل هواجسنا غسلُ المؤخرات وما يتدلى بجوارها!