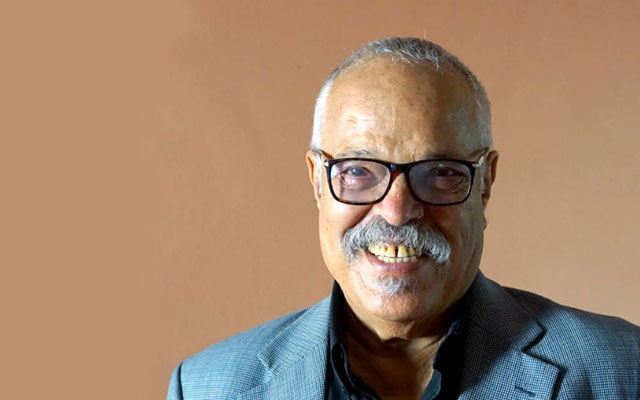تؤكد محاكمات الفاسدين ولصوص المال العام التي تجري أطوارها في بلادنا منذ أقل من سنة ونصف، أن الفساد تحول إلى مناخ سياسي ينبغي التعامل معه بالشدة اللازمة، خاصة أن الأمر يوحي بأنه يتمتع بـ "حماية رسمية". والدليل على ذلك المآل الذي عرفه مشروع القانون الجنائي، بسبب الفصل المتعلق بمحاربة الإثراء غير المشروع، الذي تم سحبه من البرلمان برسالة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش في 28 أكتوبر 2021، أي بعد 21 يوم من بداية الولاية الحكومية الحالية، مما أدى أنذاك إلى وقوع ضجة في الوسط السياسي والإعلامي، خاصة أن شبهة الفساد كانت تحدق بسياسيين قاموا ببناء إمبراطوريات مالية وتجارية مجهولة المصدر والمسار.
وينص ذلك المشروع الخاص بمراجعة القانون الجنائي في المجمل على جرائم جديدة، من بينها الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتجريم الإبادة، بالإضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. غير أن أبرز مُقتضى جديد تضمَّنه المشروع يبقى هو «تجريم» الإثراء غير المشروع بهدف تعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويتجلى هذا الإثراء في «الزيادة الكبيرة وغير المبررة للذمة المالية للشخص الملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح مقارنة مع مصادر دخله المشروعة دون استطاعته إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة».
إن إقدام رئيس الحكومة على سحب هذا المشروع، وخروج وزير العدل عبد اللطيف وهبي للدفاع عن هذا الإجراء المثير للانتباه دون أن يرف له جفن أو تتحرك في وجهه ذرة خجل، يؤكد أن الحكومة تدافع بكل الطرق الممكنة عن «أسواق النفوذ» التي أتت بهؤلاء الفاسدين وحوَّلت مراكزهم إلى «مؤسسات ربحية» «غير مراقبة» تفضي بطريقة ممنهجة إلى الإثراء غير المشروع، ذلك أن أي حكومة لما تكون صافية النية وصادقة لن يضيرها، ولن يزعجها قانون تم وضعه لمواجهة المرتشين والمختلسين وتجار المخدرات والمضاربين في الصفقات العمومية والمترامين على أراضي الغير وسارقي المال العام.
فبعد تلك الضجة التي أثارها هذا السحب، خرج وهبي ليبرر للرأي العام أن الحكومة لم تسحب هذا المشروع، وأنها فقط تتريث في إخراجه، لأنها «تريد مناقشة مشروع القانون في شموليته»، كما دفع بأن النص الذي تم تقديمه للبرلمان في يونيو 2016 يشوبه عدد من العيوب لأنه «تجزيئي» و«خلافي» و«غير دستوري» و«لا يحترم قرينة البراءة»، وأنها ستقوم بتجويده وإعادته إلى المسالك التشريعية ليخوض مساره الطبيعي والعادي. غير أننا الآن وقد تجاوزنا منتصف الولاية الحكومية، ما زلنا ننتظر تفعيل ما التزمت به الحكومة على لسان وزيرها في العدل، وما زلنا ننتظر أن يأخذ المسار التشريعي مجراه، خاصة أن محاربة الإثراء عبر المشروع، والفساد عموما، لا يمكنها أن تتحقق في ظل القانون «مقتول» «حكوميا» وغير قادر على إنزال العقاب بكل من نهب المال العام من دون ثبوت جريمة الاختلاس أو الغدر، أو استعمل موقعه لمراكمة الثروات بشكل غير مشروع، سواء عبر تضارب المصالح أو الرشوة أو غيرهما من الأشكال غير القانونية.
معنى ذلك أن الحكومة والمسؤولين في البرلمان ليست لهم أي رغبة في تمكين المغرب من نص يطارد الفاسدين واللصوص وناهبي المال العام. ومعنى ذلك أيضا أننا أمام حكومة اتخذت من تعطيل مسار توفير القوانين المناسبة لمحاربة الفساد ومحاصرة الإثراء غير المشروع، نهجا غريبا في التعامل مع «الفساد المالي»، خاصة أن الأمر يتعلق أساسا ببعض موظفي الدولة المشمولين بالتصريح بالممتلكات، رغم أن «المؤشرات الموضوعية لاكتشاف التطور المشبوه للثروة لا يمكن أن تَستنِد فقط إلى ما يقدمه المعنيون من تصريحات حول ثرواتهم، بل يتعين أن تساهم فيها أيضا المعطيات المتوفرة لدى عدة مؤسسات وطنية كالمحافظة العقارية ومكتب الصرف وإدارة الضرائب والجمارك ومؤسسات الائتمان وغيرها من الهيئات العامة والخاصة، وذلك باعتبارها هيئات قادرة، بالنظر لاختصاصاتها وصلاحياتها، على أن تشكل مصادر أساسية وروافد حقيقية لرصد تطور الثروات؛ بما من شأنه أن يُوفِّر بالتالي ضمانات مهمة للتفعيل الأمثل لهذه الآلية القانونية الجديدة»، بحسب ما يذهب إليه بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. وهذا يعني أن تجريم الإثراء غير المشروع، الذي من شأنه إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سيشكل لبنة أساسية في مكافحة الفساد والرشوة، بل من شأنه أن يتحول إلى ذرع واق من استمرار الاكتفاء بتصريح خطي لا يسمن ولا يغني من جوع، دون الانفتاح على السؤال الكبير «من أين لك هذا؟».
ويستمد مشروع «محاربة الإثراء غير المشروع» أهميته من لزوم ملاءمة التشريع الجنائي مع مقتضيات دستور 2011 وتوجهاته في السياسة الجنائية، وكذا ملاءمته مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والمرتبطة أساسا بمحاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع، إعمالا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بنيويورك سنة 2003، وإعمالاً للمادة 4 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها المملكة المغربية بتاريخ 2010. غير أن المفارقة الكبرى التي تؤشر على اللؤم المؤسستي أنه في الوقت الذي تم «تجميد المشروع» في ثلاجة الحكومة، ازداد منحنى الإثراء غير المشروع، وتواترت قضايا الفساد بكل أنواعه، والدليل على ذلك هو هذه المحاكمات المتواترة في ظرف سنة ونصف الأخيرة، والتي استهدفت سياسيين وقياديين بارزين في أحزاب وطنية ومنتخبين كبار ورؤساء جماعات.. إلخ، علما أن الفساد غير ديمقراطي وضار بالنمو الاقتصادي للدول. بل إن خطاب العرش (30 يوليوز 2016) نص صراحة على أن «محاربة الفساد لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات»، وأن مفهوم السلطة «يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله» في الانتخابات والإدارة والقضاء، وغيرها. وعدم القيام بالواجب، هو نوع من أنواع الفساد».
معنى ذلك أن المغرب يعيش مفارقة خطيرة؛ فهو الآن يترأس مجلس حقوق الإنسان الأممي (وهذا مكسب تاريخي مهم)، بيد أنه يعيش، في واقع الحال، نكوصا على مستوى حقوق حماية المال العام، وحماية ممتلكات المواطنين، وعلى مستوى الإرادة الحكومية التي لم تترجم، بسحبها لمشروع «محاربة الإثراء غير المشروع»، إرادة القرار السياسي المركزي إلى أفعال، خاصة أن ملك البلاد أمر بـ «تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين». فهل يعني التفعيل السحب والتجميد والإخلال بالالتزام؟
المفارقة الثانية هو أن المغرب يتوفر على معمار مؤسساتي مهم «المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الجهوية للحسابات، المفتشية العامة للمالية، المفتشية العامة للإدارة الترابية، المفتشيات العامة للوزارات، الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، مجلس المنافسة.. إلخ». ومع ذلك لم ينهض هذا المعمار المؤسساتي بضمان حماية المال العام، وحماية البلاد من الفاسدين والمفسدين. مما يؤكد أن بعض السياسيين تدرّبوا على الفساد المقنّع، واكتسبوا مهارات تقف حاجزا أمام تعرضهم للملاحقة القضائية. كما يؤكد أن الحكومة لا تعنيها قضية محاربة الفساد والرشوة، على الرغم من خطورة ذلك على البرامج أو السياسات العامة الموجهة للتنمية.
وتبعا لذلك، فإن استكمال وضع أنظمة رقابة داخلية قوية وفعالة لن يتم إلا باعتماد وتنزيل وأجرأة مشروع «محاربة الإثراء غير المشروع» ليكون حجر الزاوية في الإدارة المالية وغير المالية السليمة. ذلك أننا لسنا في حاجة فقط إلى مؤسسات لتقييم مخاطر الفساد، بل إلى قانون يحد من نشاط الفاسدين، وإلى رادع قوي يكون في الخط الأول لمواجهة تغول هؤلاء.
إن ترسيخ مكافحة الفساد كأولوية لم يستقيم إلا بالقول إن «إهمال مكافحة الفساد فسادٌ في حد ذاته»، وينبغي فضحه ومواجهته، وإرغام الحكومة على الإسراع بتنزيل صارم للدستور وتأسيس مسار إصلاحي حقيقي يتجاوز «السحب» و«التجميد» و«اللعب على المتناقضات» في مشروع بحجم محاربة الإثراء غير المشروع، كما يقتضي التعبئة الشاملة، أحزابا وجمعيات ونقابات ومؤسسات قانونية وحقوقية وتربوية، ومجالس الحكامة والرقابة، من أجل عدم الرضوخ لبعض المراكز والمواقع القوية المستفيدة من واقع الريع والفساد، والتي ما زالت تعرقل المسار التنموي لبلادنا وتحكم عليها بالبقاء رهينة في أيدي المافيات وتجار المخدرات.
تفاصيل أوفى تجدونها في العدد الجديد من أسبوعية" الوطن الآن"