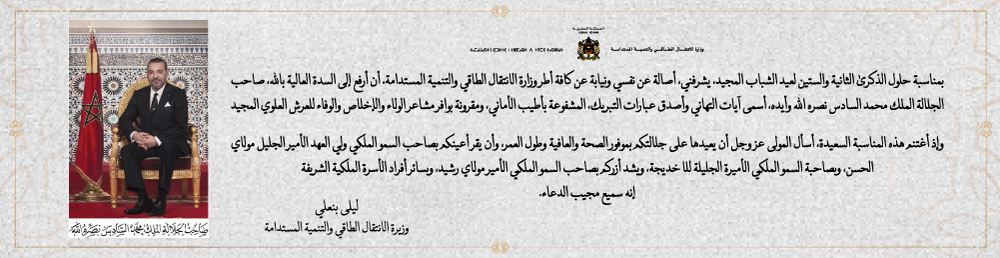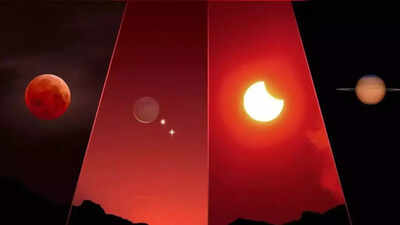في قراءته لكتاب "تمغربيت: محاولة لفهم اليقينيات المحلية" الذي أصدره صدر سعيد بنيس، أبرز مصطفى يحياوي، الأستاذ الباحث في الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية أن التمغربيت فكرة تتدحرج منذ على الأقل بداية العشرية الأخيرة في النقاش العمومي من دون أن ترسوَ بعدُ، وتستقرَ على أطروحة ثقافية "ناعمة" واضحة المغازي والأبعاد التأطيرية، وإن كانت بعض الخطابات السياسية في سياقات لحظية حماسية تحاول أن تجعل منها إطاراثقافيا مرجعيالمعنى أن تكون مغربيا في القرن 21.
جريدة "أنفاس بريس" تنشر كلمة مصطفى يحياوي حول الكاتب والكتاب.
جريدة "أنفاس بريس" تنشر كلمة مصطفى يحياوي حول الكاتب والكتاب.
المتدخل:مصطفى يحياوي، أستاذ باحث في الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية
المؤسسة: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، جامعة الحسن الثاني- الدار البيضاء
في البعد المعرفي للتحليل:
1. نلتقي في هذا المجمع حول كتاب "تمغربيت: محاولة لفهم اليقينيات المحلية" الذي صدر للأستاذ سعيد بنيسفي 2022؛ وهو يعتبر تتويجا لمسار بحثي لأستاذتابعت محاضراته ومقالاته منذ أكثر من عشر سنوات، ووجدته أستاذا يهوى السؤال الذي تتقاطع فيه المعارف الاجتماعية من دون أن يكون لذلك داع تخصصي يحسب على علم بعينه. في ذات الوقت، وجدته ببراءة أجوبته وثقلها الفكري باحثا سخيا في النقاش العمومي، ولا يعير أي اهتمام لمسوغات التي عادة ما استدعاها المثقف المؤدلج وهو يتأهب لخوض معركة التأطير الجماهيري. إنه السي سعيد ببشاشته الدائمة وبعشقه الأبدي للفضائل الاجتماعية الجامعة، الكاتب والباحث الأكاديمي الذي سأحاول أن أجادله فيما كتب عن قيم وعينا حول عددها قد يختلف، لكنه بالمؤكد يتوحد حول يقينية وجودها معنا وحولنا أينما كان لمغربيتنا محلا.
2. دعوني بعد هذه التوطئة الإنسانية السريعة، أن أنتقل إلى ما نحن بصدده، وسأخصص حديثي فيما ورد في الفصول السابع والثامن والتاسع من الكتاب، وستكون فرصة لي لأن أقدم تأويلا لما اعتبره السي سعيد " خصوصيات المغرب التي تمنحه طابع التميّز والفرادة (...) فتمغربيت هي تلك القيم التي تعبر وتتقاطع وترافق وتلتصق وتلازم وترتبط بطريقة عمودية وأفقية بجميع مناحي حياة المغاربة (...)".
منطلقي فيما سيأتي أن التمغربيت فكرة تتدحرج منذ على الأقل بداية العشرية الأخيرة في النقاش العمومي من دون أن ترسوَ بعدُ، وتستقرَ على أطروحة ثقافية "ناعمة" واضحة المغازي والأبعاد التأطيرية، وإن كانت بعض الخطابات السياسية في سياقات لحظية حماسية تحاول أن تجعل منها إطاراثقافيا مرجعيالمعنى أن تكون مغربيا في القرن 21.
وهنا لا بد أن أنبه على أن سياق العشرية التي نتحدث عنها قد اتسم ببروز أحداث جديدة مثيرة للانتباه، أذكر منها خاصة حدث 20 فبراير 2011، وحدث دستور يوليوز 2011 وترسيم اللغة الأمازيغية ودسترة الجهوية المتقدمة، وحدث مقاطعة بعض المنتوجات التجارية في 2016التي أكدت أهمية شبكات التواصل الاجتماعي في التعبئة الاحتجاجية، وأحداث 2018 "حراك الريف وحراك جرادة وحراك زاكورة"، حدث كوفيد في 2020 وآثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحدث كركرات وما استتبعه في 2021 من اعتراف للولايات المتحدة بمغربية الصحراء وتوقيع المغرب لاتفاقية أبرهام والتطبيع مع إسرائيل، وعودة التوتر الحاد على مستوى العلاقات المغربية الجزائرية والمغربية الفرنسية، وحدث 2022 تأهل الفريق الوطني لكرة القدم لنصف نهاية كأس العالم بقطر...
كلها أحداث اتسمت بكسر الجمود "المجتمعي" وخلق لحظات شعورية متمايزة جعلت من فكرة الانتماء إلى المغرب موضوع سؤال هوياتي قديم يستفيق من جديد ليواكب إيقاع التغييرات التي تطال علاقة المحلي بالمركزي من جهة، وعلاقة الفرد بالجماعة والتراب والأمة والمؤسسة من جهة ثانية.
بهذا التقدير، يكون لظهور فكرة "تمغربيت" في الفضاء العام علاقة سببية مباشرة مواكبة لوجود تغيرات مجتمعية تجعل من المغرب، على المستوى النظري، مثله مثل بقية الدول -راهنا- التي تعرف تغيرات قيمية متسارعة تجعل من سؤال الهوية الوطنية موضع اختلاف في الدلالة وفي الإجابة. إذن،من هذه الناحية، المغرب لا يمثل حالة شاذة. وفي اعتقادين ما يلاحظ من عناية واهتمام -حاليا- في الخطاب السياسي والإعلامي وحتى الدعوي، لا ينبغي النظر إليه أنه استثناء مغربي. ذلك إن انتماء المغرب لفضاءات قيمية متعددة الروافد التاريخية والعقدية والثقافية (الفضاء العربي، الإسلامي، المتوسطي، الإفريقي، الأمازيغي...) لا يمنعه من أن يخضع للتغيرات التي يعرفها عالم معولم في لحظة شيوع "الحداثة المائعة" على حد تعبير ZygmuntBauman، حيث سرعة الزوال والتحول ملمحان مميزان يجعلان من العيش المشترك فضاء للاستهلاك تستكان معه إغراءات الرغبة في الاجتماع، ومفاسد الإحساس بتلك الرغبة... فيقل الثبات ويرتفع إيقاع التحول والتفكك والمنحدرات اليقينية،حتى تبدو معه الوحدةُ متعةَ المحن للرخاء.
وظني أن التغييراتالعميقة التي يشهدها المغرب خلال هذه الفترة التاريخية من "العولمة المائعة" ذات آثار مهيكلة، إن على مستوى الزمن المتوسط، وإن على مستوى الزمن البعيد؛ وفي نفس الآن هي أيضا محفزة على ظهور تفاعلات آنية تبرز على شاكلة Effets écran أحجب تريد التستر على وجود تلك التغييرات العميقة.فتصبح، معها التمثلات والقيم إما مصاحبة لتلك التغييرات الموضوعية، وإما سابقة لها، وإما متأخرة عنها.
من هذا المنطلق، سأجادل العزيز السي سعيد حول دلالة ظهور فكرة التمغربيت في هذا السياق الثقافي والدولي المركب؛ بمعنى آخر، ما محل التمغربيت في مشهد التغييرات الموضوعية التي يشهدها المجتمع المغربي -راهنا، علما أن تمظهراتها اليومية قد تخون التحليل الأكاديمي المتعالي عن الانطباعات الحماسية اللحظية والتصورات السائدة العفوية؟
3. بدءً، يتميز هذا الكتاب بسلاسة سردية تتدفق فيها المعلومات والأفكار بتعاقبية تمتحي الرصد المبني على تأريخ وثائقي مبسط للقيم تسهل معه القراءة؛ وإن كان الاشتغال المعمق على المضامين يستدعي تمكنا معرفياأوسعا لكي يتمكن القارئ من ربط الصبيب القيمي في الحالة المغربية بالسياقات السياسية والثقافية والاجتماعية والتاريخية التي تحكمت في إيقاع هذا الصبيب.
وهكذا يجمع النص بين بساطة المؤلف في الحكي وتملكه للموضوع وبين دفع المتلقي المهتم بقضايا اليقينيات المحلية إلى تكسير حدود معرفته العامة باعتماد نباهة الفضول والنبش في الأبعاد والشروط التي حكمت تطور فكرة تمغربيت عند السي بنيس بوصفها سردية حول الممانعة الثقافية الجماعية للاحتباس القيمي والانهزامية الهوياتية.
بالجملة، نحن أمام كتاب يغري بإعمال النقد الإشكالي والنزعة الاشتباكية المتعددةالأبعاد في فهم التوازي بين أن تكون مغربا في القرن 21 وبين أن تعيش دينامياتالتغيير التي تتجاذبها قوى غير متساكنة حيث التعدد غير خاضع لتراتبيات محسوم في شرعياتها، وإن كان الاتفاق في الوثيقة الدستورية لـ 2011 قد حصل حول القيم المحورية الحاسمة في إعادة تركيب توازن ميزان القوة المجتمعي.
4. ما أثارني في الفصول الثلاثة (7، 8، 9) أن المؤلف يؤسس لفائدة التمغربيت باعتبارها مشروعا ثقافيا للتنشئة الاجتماعية يروم خلق وعي مجتمعي يحصن جدوى العيش المشترك داخل "أمة"تتغذى أواصلها بالتفاعل الإيجابي بين عناصر الثالوث التالي: القيم (الأطروحة الأخلاقية الجامعة بين نقائض الخصوصيات والحداثة العابرة للحدود الثقافية)، والتراب (الأطروحة المجالية الأنثروبولوجية للمجتمعات المحلية)، والسيادة الوطنية (الأطروحة السياسية ما بعد الاستعمار للدولة المركزية).
في الفصل السابع.
المؤسسة: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، جامعة الحسن الثاني- الدار البيضاء
في البعد المعرفي للتحليل:
1. نلتقي في هذا المجمع حول كتاب "تمغربيت: محاولة لفهم اليقينيات المحلية" الذي صدر للأستاذ سعيد بنيسفي 2022؛ وهو يعتبر تتويجا لمسار بحثي لأستاذتابعت محاضراته ومقالاته منذ أكثر من عشر سنوات، ووجدته أستاذا يهوى السؤال الذي تتقاطع فيه المعارف الاجتماعية من دون أن يكون لذلك داع تخصصي يحسب على علم بعينه. في ذات الوقت، وجدته ببراءة أجوبته وثقلها الفكري باحثا سخيا في النقاش العمومي، ولا يعير أي اهتمام لمسوغات التي عادة ما استدعاها المثقف المؤدلج وهو يتأهب لخوض معركة التأطير الجماهيري. إنه السي سعيد ببشاشته الدائمة وبعشقه الأبدي للفضائل الاجتماعية الجامعة، الكاتب والباحث الأكاديمي الذي سأحاول أن أجادله فيما كتب عن قيم وعينا حول عددها قد يختلف، لكنه بالمؤكد يتوحد حول يقينية وجودها معنا وحولنا أينما كان لمغربيتنا محلا.
2. دعوني بعد هذه التوطئة الإنسانية السريعة، أن أنتقل إلى ما نحن بصدده، وسأخصص حديثي فيما ورد في الفصول السابع والثامن والتاسع من الكتاب، وستكون فرصة لي لأن أقدم تأويلا لما اعتبره السي سعيد " خصوصيات المغرب التي تمنحه طابع التميّز والفرادة (...) فتمغربيت هي تلك القيم التي تعبر وتتقاطع وترافق وتلتصق وتلازم وترتبط بطريقة عمودية وأفقية بجميع مناحي حياة المغاربة (...)".
منطلقي فيما سيأتي أن التمغربيت فكرة تتدحرج منذ على الأقل بداية العشرية الأخيرة في النقاش العمومي من دون أن ترسوَ بعدُ، وتستقرَ على أطروحة ثقافية "ناعمة" واضحة المغازي والأبعاد التأطيرية، وإن كانت بعض الخطابات السياسية في سياقات لحظية حماسية تحاول أن تجعل منها إطاراثقافيا مرجعيالمعنى أن تكون مغربيا في القرن 21.
وهنا لا بد أن أنبه على أن سياق العشرية التي نتحدث عنها قد اتسم ببروز أحداث جديدة مثيرة للانتباه، أذكر منها خاصة حدث 20 فبراير 2011، وحدث دستور يوليوز 2011 وترسيم اللغة الأمازيغية ودسترة الجهوية المتقدمة، وحدث مقاطعة بعض المنتوجات التجارية في 2016التي أكدت أهمية شبكات التواصل الاجتماعي في التعبئة الاحتجاجية، وأحداث 2018 "حراك الريف وحراك جرادة وحراك زاكورة"، حدث كوفيد في 2020 وآثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحدث كركرات وما استتبعه في 2021 من اعتراف للولايات المتحدة بمغربية الصحراء وتوقيع المغرب لاتفاقية أبرهام والتطبيع مع إسرائيل، وعودة التوتر الحاد على مستوى العلاقات المغربية الجزائرية والمغربية الفرنسية، وحدث 2022 تأهل الفريق الوطني لكرة القدم لنصف نهاية كأس العالم بقطر...
كلها أحداث اتسمت بكسر الجمود "المجتمعي" وخلق لحظات شعورية متمايزة جعلت من فكرة الانتماء إلى المغرب موضوع سؤال هوياتي قديم يستفيق من جديد ليواكب إيقاع التغييرات التي تطال علاقة المحلي بالمركزي من جهة، وعلاقة الفرد بالجماعة والتراب والأمة والمؤسسة من جهة ثانية.
بهذا التقدير، يكون لظهور فكرة "تمغربيت" في الفضاء العام علاقة سببية مباشرة مواكبة لوجود تغيرات مجتمعية تجعل من المغرب، على المستوى النظري، مثله مثل بقية الدول -راهنا- التي تعرف تغيرات قيمية متسارعة تجعل من سؤال الهوية الوطنية موضع اختلاف في الدلالة وفي الإجابة. إذن،من هذه الناحية، المغرب لا يمثل حالة شاذة. وفي اعتقادين ما يلاحظ من عناية واهتمام -حاليا- في الخطاب السياسي والإعلامي وحتى الدعوي، لا ينبغي النظر إليه أنه استثناء مغربي. ذلك إن انتماء المغرب لفضاءات قيمية متعددة الروافد التاريخية والعقدية والثقافية (الفضاء العربي، الإسلامي، المتوسطي، الإفريقي، الأمازيغي...) لا يمنعه من أن يخضع للتغيرات التي يعرفها عالم معولم في لحظة شيوع "الحداثة المائعة" على حد تعبير ZygmuntBauman، حيث سرعة الزوال والتحول ملمحان مميزان يجعلان من العيش المشترك فضاء للاستهلاك تستكان معه إغراءات الرغبة في الاجتماع، ومفاسد الإحساس بتلك الرغبة... فيقل الثبات ويرتفع إيقاع التحول والتفكك والمنحدرات اليقينية،حتى تبدو معه الوحدةُ متعةَ المحن للرخاء.
وظني أن التغييراتالعميقة التي يشهدها المغرب خلال هذه الفترة التاريخية من "العولمة المائعة" ذات آثار مهيكلة، إن على مستوى الزمن المتوسط، وإن على مستوى الزمن البعيد؛ وفي نفس الآن هي أيضا محفزة على ظهور تفاعلات آنية تبرز على شاكلة Effets écran أحجب تريد التستر على وجود تلك التغييرات العميقة.فتصبح، معها التمثلات والقيم إما مصاحبة لتلك التغييرات الموضوعية، وإما سابقة لها، وإما متأخرة عنها.
من هذا المنطلق، سأجادل العزيز السي سعيد حول دلالة ظهور فكرة التمغربيت في هذا السياق الثقافي والدولي المركب؛ بمعنى آخر، ما محل التمغربيت في مشهد التغييرات الموضوعية التي يشهدها المجتمع المغربي -راهنا، علما أن تمظهراتها اليومية قد تخون التحليل الأكاديمي المتعالي عن الانطباعات الحماسية اللحظية والتصورات السائدة العفوية؟
3. بدءً، يتميز هذا الكتاب بسلاسة سردية تتدفق فيها المعلومات والأفكار بتعاقبية تمتحي الرصد المبني على تأريخ وثائقي مبسط للقيم تسهل معه القراءة؛ وإن كان الاشتغال المعمق على المضامين يستدعي تمكنا معرفياأوسعا لكي يتمكن القارئ من ربط الصبيب القيمي في الحالة المغربية بالسياقات السياسية والثقافية والاجتماعية والتاريخية التي تحكمت في إيقاع هذا الصبيب.
وهكذا يجمع النص بين بساطة المؤلف في الحكي وتملكه للموضوع وبين دفع المتلقي المهتم بقضايا اليقينيات المحلية إلى تكسير حدود معرفته العامة باعتماد نباهة الفضول والنبش في الأبعاد والشروط التي حكمت تطور فكرة تمغربيت عند السي بنيس بوصفها سردية حول الممانعة الثقافية الجماعية للاحتباس القيمي والانهزامية الهوياتية.
بالجملة، نحن أمام كتاب يغري بإعمال النقد الإشكالي والنزعة الاشتباكية المتعددةالأبعاد في فهم التوازي بين أن تكون مغربا في القرن 21 وبين أن تعيش دينامياتالتغيير التي تتجاذبها قوى غير متساكنة حيث التعدد غير خاضع لتراتبيات محسوم في شرعياتها، وإن كان الاتفاق في الوثيقة الدستورية لـ 2011 قد حصل حول القيم المحورية الحاسمة في إعادة تركيب توازن ميزان القوة المجتمعي.
4. ما أثارني في الفصول الثلاثة (7، 8، 9) أن المؤلف يؤسس لفائدة التمغربيت باعتبارها مشروعا ثقافيا للتنشئة الاجتماعية يروم خلق وعي مجتمعي يحصن جدوى العيش المشترك داخل "أمة"تتغذى أواصلها بالتفاعل الإيجابي بين عناصر الثالوث التالي: القيم (الأطروحة الأخلاقية الجامعة بين نقائض الخصوصيات والحداثة العابرة للحدود الثقافية)، والتراب (الأطروحة المجالية الأنثروبولوجية للمجتمعات المحلية)، والسيادة الوطنية (الأطروحة السياسية ما بعد الاستعمار للدولة المركزية).
في الفصل السابع.
5. إن منظومة القيم، في رأي السي سعيد، وعاء تصوري تتجمع فيها ترتيبات أخلاقية كبرى توجه سلوك الأفراد في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية. وهذه القيم بطبيعتها مستقلة عن بعضها البعض لكنها مجتمعة تؤلف نسقا واحدا يجعلها قواعد ضبط اجتماعي بالإمكان أن يؤدي عدم إعمالها أو احترامها إلى اختلال في آليات اشتغال العيش المشترك.
ولذلك، تراه يربط سردية تمغربيت تارة بالسوق اللغوية، والحسم في الجدل اللغوي حول قناة التواصل الفضلى باعتبار العربية في صيغتها المعيارية أو الوسطى أو الدارجة القيمة اللغوية الجامعة للمغاربة. وتراه، في نفس الحين، موافق للتطبيع مع خطاب الهويات الصغرى ذات الطبيعة الترابية على سبيل انتعاش التفاعلات والأدوار المجتمعية، وليس من زاوية التحريض على الكراهية.
وبعد هذا، ينتقد إلى قيمة الهوية المواطنة، ليعتبرها الحد المغني في التمييز بين تمغربيت تتغذى في نفس الآن من الممارسات الفضلى في المواطنة الواقعية والمواطنة الافتراضية. لينتهي بالقول:
ثمة، إذن، حاجة إلى التفاوض والتداول المجتمعي، لأن إشكالات التعدد والتنوع ترتبط أساس بقبول الآخر، وتلغي مواقف الإقصاء والكراهية. وهي محكومة بالقيم المشتركة لتمغربيت، وبدورها في إشاعة ثقافة التنوع وخطاب التسامح والتساكن. لهذا، يستلزم بناء الهوية المواطنة بإيلاء الأهمية لإشكالات الرابط الاجتماعي والعيش المشترك؛ وذلك (...) بترسيخ مبادئ ومحددات سياسة هوياتية، هدفها التصدي للإحباط الهوياتي.
(الصفحة، 123)
بهذا الاستنتاج، لم تعد تمغربيت مجردة فكرة عامة يُتغنى بها تمجيدا لهوية محمولة على تاريخ مشترك، وإنما قيمة تؤسس لمراجعة التصور اليقيني في فهم الاجتماع المغربي، يعاد عبرها إنتاج محتوى العيش المشترك بحسب ما تقتضيه الضرورة لتحصين اللحمة الاجتماعية وتحيين مضمون الاتفاق الاجتماعي حول الدولة الوطنية بناء على قيم حقوق الهوية المواطنة التي تأسست عليها الوثيقة الدستورية لـ2011؛ كل ذلك في رأي، السي سعيد، يتم لتجاوز أو استباق حالة الاحتباس القيمي الذي يعتبره التوصيف الأنسب لوضعية يشوبها القلق والاختلاف والغموض، إذ يقول:
ليس هناك أزمة قيم؛ فالقيم ما تزال موجودة، ولكنها أصبحت في جدلية تنذر بالانقراض والاندثار، كما هو الحال في عواقب ظاهرة الاحتباس الحراري.
(الصفحة، 125)
ويزيد بيانا في مرافعته على الحاجة إلى التمغربيت باعتباره مشروعا ثقافيا استراتيجيا لتحصين السلم الاجتماعي، بأن اعتبر اختلالات السياسة اللغوية بالمغرب وانعدام العدالة اللغوية بمثابة احتباس ينذر بانهزامية هوياتية، وفي رأيه تجاوز فخ ارتباك السياسة اللغوية:
يتطلب المعرفة العميقة بالوضعية اللغوية للبلاد في علاقتها بالرهانات المجتمعية. وهو ما يقتضي تدبير الثنائية اللغوية الرسمية في مجال التعليم، يبنى على مبدإ الشخصانية أو مبدإ الترابية، من خلال ترابطية الدستورانية بالمؤسساتية، لأن هذين المبدأين يأخذان بعين الاعتبار عناصر الهوية المغربية المعلنة في الدستور.
(الصفحة، 129)
في رأي المؤلف، لا أمان اجتماعي بدون مواجهة شيوع ظاهرتي الانفلات القيمي وظاهرة القساوة العاطفيةبين الشباب. وهو ما يجعل التمغربيت، من منظور السي بنيس، منظومة قيم تنتعش وسط المجتمع لتفادي ما اعتبرته سوسيولوجية الأخلاقية عند دوركايم تراجع وظائف الحاضنات المحصنة للمجتمع من شيوع حالة "الضياع" Anomie بين أفراده بسبب إما غياب القيم، وإما اضمحلال بعضها؛ وهو ما يؤدي إلى بروز حالة اللايقين واللااستقرار العلاقات الاجتماعية.
(في الفصل الثامن)
6. يطرح البعد الترابي في إنضاج فكرة البعد النفعي في التمغربيت عند المؤلف انطلاقا من الحاجة المبررة للاعتراف بالدولة لدى أفراد وجماعات تجمعهم الوحدة المجالية بفواصل ثقافية أنثروبولوجية تميزهم عن بقية الوحدات المجالية الأخرى المندمجة في إطار مبدإ الوحدوية الترابية للدولة المغربية. ويعتبر أن مصدر هذه الحاجة ينبني على التفاوض حول الحق في التنمية شرطا لتحقق الوئام الوطني، وعلى الثقة في جدوى الانصهار في المصير المشترك. ومنه، يعتبر نجاعة النموذج التنموية مرهونةً باستبطان الشعور بتمغربيت حقا وواجبا يوجدان من داخل منطق ترابي لتحقيق التنمية المحلية.
ولتحقيق هذا المبتغى، يظهر أن تثمين الانتماء الجغرافي للمملكة المغربية (المغرب الكبير وإفريقيا والمتوسط والأطلسي)، يمر أساسا بالاعتراف والتفاعل مع الديناميات السياسية والاقتصادية والثقافية، لإغناء روافد النموذج التنموية المغربي (...) أما على المستوى الداخلي، يبدو جليا ضرورة استبطان الانتقال من جهات ملحقة بالمركز إلى جهات ذات استقلالية، تشكل أقطابا اقتصادية، (..) عبر منظومة ديمقراطية يتكامل فيها المحلي بالوطني.
(الصفحة، 139)
كما يتبين من هذا المقتطف، نفعية العلاقة بين المحلي والوطني تجعل من التمغربيت مشروعا سياسيا يقوم على قرب المسافات الجغرافية والشعورية والثقافية، ليتجاوز بذلك مبدأ التدبير الحر إلى مبدإ الاستقلالية المعللة لتوازن ميزان القوى بين المحلي والمركزي؛ وحينئذ تصبح الدولة الوطنية كلا تندمج فيه الخصوصيات المحلية لا على سبيل الإلحاق المبني على التراتبية المشرعنة بالاستقلالية المشروطة بقواعد تدبيرية مغلقة، وإنما على سبيل الثقة المرهونة بالرخاء والتنمية.
ولتحقيق هذه الغاية الفضلى من تمغربيت مسنودة إلى اللامركزية داعمة لاستقلالية القرار المحلي، يراهن المؤلف على مواجهة تراجع الوساطة الثقافية ومخاطر انهيار منظومة القيم المزدوجة الروافد (الحداثة من جهة والتقليدانية من جهة ثانية) لتجاوز معضلة التسيب القيمي والنفاق الاجتماعي.
بهذا الحجاج، يعود بنا المؤلف لسؤال الهوية والاستلاب الثقافي والمثقف العضوي والالتزام الأخلاقي والجامعة "الترابية"، وكأن فكرة تمغربيت استدراك للجواب عن أسئلة اعتقدنا أن زمن العولمة المائعة قد تجاوزها بأسلوب حياة ما بعد الحداثة، حيث موت الإيديولوجيا يقتضي رسم آفاق جديدة في مساحة "البين بين" للعيش المشترك، حيث الغرائبية والافتراضية مظهران من مظاهر التمرد الرمزي على ثبات المنظومات الأخلاقية والتقليدانية المعيارية في أزمنة واقعية تسترشد الوجود الاجتماعي بالمحاصرات الضبطية للإقبال المتزايد على الحريات لدى الأفراد والمجموعات المنسلخة من الثنائيات المتوافق عليها في تاريخ التقسيم الوظيفي للهويات.
وبهذا الحمل التراتبي في وظائف المحلي في مقابل المركزي،يعتبر المؤلف "الجهة وعاء منطقي للتفاوض والمشاركة الجماعية..."(الصفحة145)
ويبدو هنا أيضا أن الغاية من فكرة تمغربيت مشروع بناء مجتمع الثقة المبين على احتواء الأزمة بعقلنة مسار التمكين الترابي عبر إرادة سياسية حقيقية لتجاوز إكراهات الأعطاب البنيوية للنسق السياسي المغربي، بما فيها أزمة الوساطة السياسية وضعف المردودية الاجتماعية للسياسات الترابية ومحدودية نتائج الأوراش الإصلاحية المتعاقبة للجامعة المغربية.
في الفصل التاسع
7. يختم المؤلف التنظير لسردية تمغربيت باعتبارها إرادة انتقال من الزمن الدستوري، حيث للأمة المغربية روافد حضارية وعمرانية وتاريخية وجغرافية ودينية وثقافية ولغوية تتساكن فيما بينها بالرغم من اختلافها وتنوعه الذي وصل في لحظات من تاريخ العمران إلى درجة صراعات وجودية، إلى الزمن المؤسساتي المؤطر للحياة العامة في مغرب القرن 21.
القاموس الذي يستعمله المؤلف في هذا الفصل ينطلق من الوثيقة الدستورية لـ 2011 لضبط التحديات الهوياتية في علاقتها مع التعاقد المجتمعي الجديد الذي جعل من المنظومة الكونية لحقوق الإنسان الأساس المرجعي للمصفوفات الإصلاحية التي تحين على ضوئها الأرضية الثقافية للعيش المشترك لمغرب يتطلع لأن يتأقلم ومتغيرات العولمة المائعة. إذ يعتبر المؤلف أن ما يتيح تفعيل سردية تمغربيت، باعتبارها مشروعا ثقافيا وطنيا، هو:
بناء عقد اجتماعي وهوياتي دون تراتبية ولا إقصاء يفضي إلى الانتقال من "جميعنا كعا" إلى "جميعا متساوون" (...) على هذا، يمكن لسرية تمغربيت بقيمها المرجعية أن تلعب دور (..) الركيزة المحورية لإبداع نموذج تنموي، يتأسس على سياسة تنموية ترمي إلى مزج المقومات الرمزية كقوى ناعمة، تحيل على العلامة والشخصية المغربية، ببرامج التنمية المحلية كقوى صلبة لاستتباب الشعور بالمواطنة والعيش الكريم (..) ما باب الترافع بالخصوصي ليرتقي للعالمي.
(الصفحة 156)
بهذا التقدير الحالم، يدافع السي سعيد على الحق في أن نثق في سردية تمغربيت على الصمود بمنطق "الفيض المؤدي للمدينة الفاضلة".
8. ولأن القراءات الاجتماعية بطبيعتها نقدية، دعوني أختم ما جدت علي به فكرة تمغربيت عند الصديق بنيس بأن أستدرك القول بأن تلك السردية التي أمتعنا بها السي سعيد مدخلا لحلم يراود أي مثقف ملتزم بقضايا هذا الوطن الحبيب. ومنه، فهي ليست بالضرورة مشروعا خطيا بإمكان تحقيق مقاصده الأخلاقية بدون ممانعات ومعاكسات يُحفز على وجودها سياق سياسي عام محكوم بتنافر حاد في المصالح بين الفاعليين، وبواقع قيمي موسوم بتحولات سريعة.
ولعل من أهم حسنات هذا الكتاب أنه يجعل من فكرة تمغربيتأرضية تقبل باعتبار التقابلية في التعاطي مع المعايير والمرجعيات تنازعا مصلحيا بين النزعة المحافظة| التقليدانية في تصور حدود تدبير مخاطر مسار الانتقال الديمقراطي وبين النزعة النقدية ذات الاشتباكية المتعددة المعارف والمقاصد التي تجعل من العدالة المجالية والحرية والمواطنة والمنظومة الكونية لحقوق الإنسان أطروحات حاسمة في استشراف عيش مشترك متسع للجميع يرقى فيه الخطاب الإصلاحي لاشتراطات سلامة التنزيل الديمقراطي للدستور.
ولذلك، تراه يربط سردية تمغربيت تارة بالسوق اللغوية، والحسم في الجدل اللغوي حول قناة التواصل الفضلى باعتبار العربية في صيغتها المعيارية أو الوسطى أو الدارجة القيمة اللغوية الجامعة للمغاربة. وتراه، في نفس الحين، موافق للتطبيع مع خطاب الهويات الصغرى ذات الطبيعة الترابية على سبيل انتعاش التفاعلات والأدوار المجتمعية، وليس من زاوية التحريض على الكراهية.
وبعد هذا، ينتقد إلى قيمة الهوية المواطنة، ليعتبرها الحد المغني في التمييز بين تمغربيت تتغذى في نفس الآن من الممارسات الفضلى في المواطنة الواقعية والمواطنة الافتراضية. لينتهي بالقول:
ثمة، إذن، حاجة إلى التفاوض والتداول المجتمعي، لأن إشكالات التعدد والتنوع ترتبط أساس بقبول الآخر، وتلغي مواقف الإقصاء والكراهية. وهي محكومة بالقيم المشتركة لتمغربيت، وبدورها في إشاعة ثقافة التنوع وخطاب التسامح والتساكن. لهذا، يستلزم بناء الهوية المواطنة بإيلاء الأهمية لإشكالات الرابط الاجتماعي والعيش المشترك؛ وذلك (...) بترسيخ مبادئ ومحددات سياسة هوياتية، هدفها التصدي للإحباط الهوياتي.
(الصفحة، 123)
بهذا الاستنتاج، لم تعد تمغربيت مجردة فكرة عامة يُتغنى بها تمجيدا لهوية محمولة على تاريخ مشترك، وإنما قيمة تؤسس لمراجعة التصور اليقيني في فهم الاجتماع المغربي، يعاد عبرها إنتاج محتوى العيش المشترك بحسب ما تقتضيه الضرورة لتحصين اللحمة الاجتماعية وتحيين مضمون الاتفاق الاجتماعي حول الدولة الوطنية بناء على قيم حقوق الهوية المواطنة التي تأسست عليها الوثيقة الدستورية لـ2011؛ كل ذلك في رأي، السي سعيد، يتم لتجاوز أو استباق حالة الاحتباس القيمي الذي يعتبره التوصيف الأنسب لوضعية يشوبها القلق والاختلاف والغموض، إذ يقول:
ليس هناك أزمة قيم؛ فالقيم ما تزال موجودة، ولكنها أصبحت في جدلية تنذر بالانقراض والاندثار، كما هو الحال في عواقب ظاهرة الاحتباس الحراري.
(الصفحة، 125)
ويزيد بيانا في مرافعته على الحاجة إلى التمغربيت باعتباره مشروعا ثقافيا استراتيجيا لتحصين السلم الاجتماعي، بأن اعتبر اختلالات السياسة اللغوية بالمغرب وانعدام العدالة اللغوية بمثابة احتباس ينذر بانهزامية هوياتية، وفي رأيه تجاوز فخ ارتباك السياسة اللغوية:
يتطلب المعرفة العميقة بالوضعية اللغوية للبلاد في علاقتها بالرهانات المجتمعية. وهو ما يقتضي تدبير الثنائية اللغوية الرسمية في مجال التعليم، يبنى على مبدإ الشخصانية أو مبدإ الترابية، من خلال ترابطية الدستورانية بالمؤسساتية، لأن هذين المبدأين يأخذان بعين الاعتبار عناصر الهوية المغربية المعلنة في الدستور.
(الصفحة، 129)
في رأي المؤلف، لا أمان اجتماعي بدون مواجهة شيوع ظاهرتي الانفلات القيمي وظاهرة القساوة العاطفيةبين الشباب. وهو ما يجعل التمغربيت، من منظور السي بنيس، منظومة قيم تنتعش وسط المجتمع لتفادي ما اعتبرته سوسيولوجية الأخلاقية عند دوركايم تراجع وظائف الحاضنات المحصنة للمجتمع من شيوع حالة "الضياع" Anomie بين أفراده بسبب إما غياب القيم، وإما اضمحلال بعضها؛ وهو ما يؤدي إلى بروز حالة اللايقين واللااستقرار العلاقات الاجتماعية.
(في الفصل الثامن)
6. يطرح البعد الترابي في إنضاج فكرة البعد النفعي في التمغربيت عند المؤلف انطلاقا من الحاجة المبررة للاعتراف بالدولة لدى أفراد وجماعات تجمعهم الوحدة المجالية بفواصل ثقافية أنثروبولوجية تميزهم عن بقية الوحدات المجالية الأخرى المندمجة في إطار مبدإ الوحدوية الترابية للدولة المغربية. ويعتبر أن مصدر هذه الحاجة ينبني على التفاوض حول الحق في التنمية شرطا لتحقق الوئام الوطني، وعلى الثقة في جدوى الانصهار في المصير المشترك. ومنه، يعتبر نجاعة النموذج التنموية مرهونةً باستبطان الشعور بتمغربيت حقا وواجبا يوجدان من داخل منطق ترابي لتحقيق التنمية المحلية.
ولتحقيق هذا المبتغى، يظهر أن تثمين الانتماء الجغرافي للمملكة المغربية (المغرب الكبير وإفريقيا والمتوسط والأطلسي)، يمر أساسا بالاعتراف والتفاعل مع الديناميات السياسية والاقتصادية والثقافية، لإغناء روافد النموذج التنموية المغربي (...) أما على المستوى الداخلي، يبدو جليا ضرورة استبطان الانتقال من جهات ملحقة بالمركز إلى جهات ذات استقلالية، تشكل أقطابا اقتصادية، (..) عبر منظومة ديمقراطية يتكامل فيها المحلي بالوطني.
(الصفحة، 139)
كما يتبين من هذا المقتطف، نفعية العلاقة بين المحلي والوطني تجعل من التمغربيت مشروعا سياسيا يقوم على قرب المسافات الجغرافية والشعورية والثقافية، ليتجاوز بذلك مبدأ التدبير الحر إلى مبدإ الاستقلالية المعللة لتوازن ميزان القوى بين المحلي والمركزي؛ وحينئذ تصبح الدولة الوطنية كلا تندمج فيه الخصوصيات المحلية لا على سبيل الإلحاق المبني على التراتبية المشرعنة بالاستقلالية المشروطة بقواعد تدبيرية مغلقة، وإنما على سبيل الثقة المرهونة بالرخاء والتنمية.
ولتحقيق هذه الغاية الفضلى من تمغربيت مسنودة إلى اللامركزية داعمة لاستقلالية القرار المحلي، يراهن المؤلف على مواجهة تراجع الوساطة الثقافية ومخاطر انهيار منظومة القيم المزدوجة الروافد (الحداثة من جهة والتقليدانية من جهة ثانية) لتجاوز معضلة التسيب القيمي والنفاق الاجتماعي.
بهذا الحجاج، يعود بنا المؤلف لسؤال الهوية والاستلاب الثقافي والمثقف العضوي والالتزام الأخلاقي والجامعة "الترابية"، وكأن فكرة تمغربيت استدراك للجواب عن أسئلة اعتقدنا أن زمن العولمة المائعة قد تجاوزها بأسلوب حياة ما بعد الحداثة، حيث موت الإيديولوجيا يقتضي رسم آفاق جديدة في مساحة "البين بين" للعيش المشترك، حيث الغرائبية والافتراضية مظهران من مظاهر التمرد الرمزي على ثبات المنظومات الأخلاقية والتقليدانية المعيارية في أزمنة واقعية تسترشد الوجود الاجتماعي بالمحاصرات الضبطية للإقبال المتزايد على الحريات لدى الأفراد والمجموعات المنسلخة من الثنائيات المتوافق عليها في تاريخ التقسيم الوظيفي للهويات.
وبهذا الحمل التراتبي في وظائف المحلي في مقابل المركزي،يعتبر المؤلف "الجهة وعاء منطقي للتفاوض والمشاركة الجماعية..."(الصفحة145)
ويبدو هنا أيضا أن الغاية من فكرة تمغربيت مشروع بناء مجتمع الثقة المبين على احتواء الأزمة بعقلنة مسار التمكين الترابي عبر إرادة سياسية حقيقية لتجاوز إكراهات الأعطاب البنيوية للنسق السياسي المغربي، بما فيها أزمة الوساطة السياسية وضعف المردودية الاجتماعية للسياسات الترابية ومحدودية نتائج الأوراش الإصلاحية المتعاقبة للجامعة المغربية.
في الفصل التاسع
7. يختم المؤلف التنظير لسردية تمغربيت باعتبارها إرادة انتقال من الزمن الدستوري، حيث للأمة المغربية روافد حضارية وعمرانية وتاريخية وجغرافية ودينية وثقافية ولغوية تتساكن فيما بينها بالرغم من اختلافها وتنوعه الذي وصل في لحظات من تاريخ العمران إلى درجة صراعات وجودية، إلى الزمن المؤسساتي المؤطر للحياة العامة في مغرب القرن 21.
القاموس الذي يستعمله المؤلف في هذا الفصل ينطلق من الوثيقة الدستورية لـ 2011 لضبط التحديات الهوياتية في علاقتها مع التعاقد المجتمعي الجديد الذي جعل من المنظومة الكونية لحقوق الإنسان الأساس المرجعي للمصفوفات الإصلاحية التي تحين على ضوئها الأرضية الثقافية للعيش المشترك لمغرب يتطلع لأن يتأقلم ومتغيرات العولمة المائعة. إذ يعتبر المؤلف أن ما يتيح تفعيل سردية تمغربيت، باعتبارها مشروعا ثقافيا وطنيا، هو:
بناء عقد اجتماعي وهوياتي دون تراتبية ولا إقصاء يفضي إلى الانتقال من "جميعنا كعا" إلى "جميعا متساوون" (...) على هذا، يمكن لسرية تمغربيت بقيمها المرجعية أن تلعب دور (..) الركيزة المحورية لإبداع نموذج تنموي، يتأسس على سياسة تنموية ترمي إلى مزج المقومات الرمزية كقوى ناعمة، تحيل على العلامة والشخصية المغربية، ببرامج التنمية المحلية كقوى صلبة لاستتباب الشعور بالمواطنة والعيش الكريم (..) ما باب الترافع بالخصوصي ليرتقي للعالمي.
(الصفحة 156)
بهذا التقدير الحالم، يدافع السي سعيد على الحق في أن نثق في سردية تمغربيت على الصمود بمنطق "الفيض المؤدي للمدينة الفاضلة".
8. ولأن القراءات الاجتماعية بطبيعتها نقدية، دعوني أختم ما جدت علي به فكرة تمغربيت عند الصديق بنيس بأن أستدرك القول بأن تلك السردية التي أمتعنا بها السي سعيد مدخلا لحلم يراود أي مثقف ملتزم بقضايا هذا الوطن الحبيب. ومنه، فهي ليست بالضرورة مشروعا خطيا بإمكان تحقيق مقاصده الأخلاقية بدون ممانعات ومعاكسات يُحفز على وجودها سياق سياسي عام محكوم بتنافر حاد في المصالح بين الفاعليين، وبواقع قيمي موسوم بتحولات سريعة.
ولعل من أهم حسنات هذا الكتاب أنه يجعل من فكرة تمغربيتأرضية تقبل باعتبار التقابلية في التعاطي مع المعايير والمرجعيات تنازعا مصلحيا بين النزعة المحافظة| التقليدانية في تصور حدود تدبير مخاطر مسار الانتقال الديمقراطي وبين النزعة النقدية ذات الاشتباكية المتعددة المعارف والمقاصد التي تجعل من العدالة المجالية والحرية والمواطنة والمنظومة الكونية لحقوق الإنسان أطروحات حاسمة في استشراف عيش مشترك متسع للجميع يرقى فيه الخطاب الإصلاحي لاشتراطات سلامة التنزيل الديمقراطي للدستور.