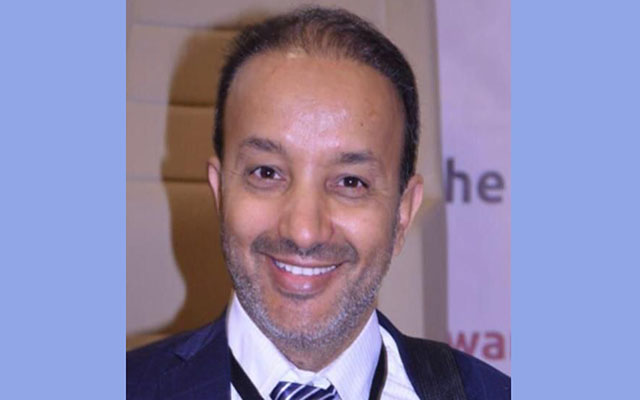إن الحديث عن موضوع الشبكات الاجتماعية هو حديث عن قضية ذات أولوية قصوى في حياتنا المعاصرة، بالنظر لما يمكن أن تضطلع به هذه الظاهرة المعلوماتية الجديدة من أدوار تنموية تتجاوز بكثير الطرح الاختزالي الذي يسعى إلى تحجيم دورها في ذلك البعد التواصلي الضيق، الذي يطبع مع الأسف واقع ممارستنا الرقمية، نتيجة لهيمنة تصورات خاطئة ساهمت بشكل كبير في تغييب تلك الأدوار الطلائعية التي يمكن أن تلعبها هذه الشبكات الاجتماعية، ولذلك فإنه من الأهمية بمكان أن يحظى هذا الموضوع بالعناية اللازمة بحثا وتدقيقا وتنظيرا، لبلورة رؤية متبصرة قادرة على إدراك أهمية هذه الوسائل في معادلة التنمية الشاملة، ومستوعبة في الوقت نفسه لكيفية تجاوز ما يمكن أن تطرحه من إشكاليات هوياتية وقيمية.
إرتباطا بهذا السياق يمكننا أن نطرح الأسئلة التالية: إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الشبكات الاجتماعية في تحقيق التنمية بشتى أبعادها؟ وما هي التحديات التي من شأنها أن تعيق هذا الدور؟ وكيف يمكن تجاوزها؟
قد يكون من نافلة القول التذكير بدور هذه الشبكات الاجتماعية في مد جسور التعارف والتواصل بين الناس في مختلف بقاع العالم، إذ أنها أصبحت اليوم عبارة عن فضاء مفتوح على العالم برمته، بحيث لم يعد لتلك الحواجز التقليدية لغوية كانت أو جغرافية أو إيديولوجية أي معنى، في ظل الإمكانيات التواصلية التي تتيحها، وبالتالي فقد أصبح بإمكان أي شخص يمتلك حدا أدنى من الثقافة الرقمية أن يتواصل مع مختلف الثقافات والجنسيات والأعراق، دون قيد أو شرط. لكن بغض النظر عن هذا الجانب الذي له سلبياته وإيجابياته فإن الذي نريد أن نلفت الانظار إليه، هو أن هذه الوسائل يمكن أن تكون أيضا أداة من أدوات تحريك الأوراش التنموية، والمساهمة في عملية البناء المجتمعي، وهذا ما سنعمل على إبرازه من خلال الفقرات اللاحقة.
إن الحديث عن هذا الموضوع الذي أبرزنا أهميته يقتضي معالجة ثنائية تتضمن جانبين أحدهما نظري والآخر إجرائي، على أن نبدأ بالجانب النظري لنعرج في النهاية على بعض النماذج التطبيقية التي تبرز أهمية هذه الشبكات الاجتماعية في السياق الحالي بكافة أبعاده.
إننا اليوم بحاجة إلى إعادة النظر في كثير من التصورات التي تحكم علاقتنا بهذه المستجدات التقنية، لأن محاولة التقهقر إلى الوراء والاستجداء بتلك الحصون التقليدية المهترئة التي هي بحاجة إلى إعادة ترميم، وأعني بها أساسا الخلفيات التي تؤطر رؤيتنا للعالم، والتي تقوم على أساس التمسك بالماضي بكل مقوماته الفكرية والثقافية، رغم أنها في معظمها نتاج تراكمات واجتهادات بشرية محكومة بشروط بيئتها الحاضنة لها، إذا استثنينا طبعا ذلك الجانب المتعلق بالدين ككليات متعالية عن عوارض الزمان والمكان؛ هذه الرغبة في التمسك بالماضي بكل مظاهره ليست منهجا سديدا ولا يمكن أن تخدم تلك التطلعات نحو بناء مجتمع المعلومات وتحقيق التنمية المنشودة، بل ستساهم بشكل كبير في تشكيل ملامح شخصية مضطربة ومترددة وغير قادرة على الاندماج واتخاذ القرارات المناسبة، وهو ما سيفوت حتما على مجتمعنا فرص التنمية والتعاطي لأسباب النهوض من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة، خصوصا ونحن نعلم أن الرهان اليوم هو رهان معلوماتي بامتياز، وأن كل الدول تتطلع إلى بناء مجتمع معلوماتي قائم على تكنولوجيا المعلومات، كما أن الحروب القادمة هي حروب معلوماتية، لذلك فالخطوة الأولى في مسار بناء مجتمع المعلومات تنبني على أساس تصحيح التصورات الخاطئة، المرتبطة بهذه الوسائل. ويؤسفنا أن نجد اليوم الكثير من الناس ما زالوا محكومين بمنطق الذهنية التقليدية الذي يتعامل مع كل جديد على أساس من الرفض المتعسف دون تمحيص أو نظر، ومما يبعث على الأسف أكثر أننا نجد بعض من يحسبون على النخبة المثقفة التي من المفترض أن تضطلع بدورها في التوعوية والعمل على نشر هذه الثقافة الرقمية باعتبارها ضرورة من ضرورات العصر، نجدهم على العكس من ذلك يعملون على إنتاج خطابات غاية في التطرف، من خلال إشاعة أنماط من التفكير الذي لا يرى في هذه الوسائل التكنولوجية إلا ذلك الوجه المتمثل في هدم الأخلاق وزعزعة منظومة القيم، معرضين عن المكتسبات التنموية والنتائج الإيجابية التي يمكن أن تتحقق في حالة ما إذا تم التعاطي معها وفقا للضوابط التشريعية والمعايير الأخلاقية.
إن هذه الذهنية النمطية الموغلة في التطرف والمنتمية إلى زمن ما قبل زمن التكنولوجيا، هي من أكبر العوائق التي تساهم في عرقلة عجلة التنمية، وتحول دون تحقيق تلك الأهداف التنموية المنشودة، وهي ليست حالة عرضية معزولة يمكن التعامل معها كاستثناء لا يقاس عليه، بل هي ظاهرة خطيرة تكاد تسري في النسق المجتمعي ككل، تغذيها وتمدها بعناصر النمو والاستمرار تلك الخطابات العدمية التي يمارسها البعض في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وعبر مجموعة من المنابر الإعلامية التي من المفترض أن تساهم في عقلنة وترشيد استعمال هذه الوسائل بالكيفية التي تبني ولا تهدم.
اليوم بحاجة إلى أن نكون واعين بمدى التأثير الكبير لنوع الخطاب الذي نمارسه سواء كان خطابا سياسيا أو دينيا أو ثقافيا، لأن كل ما يقال أو ينشر في مختلف وسائل الإعلام ما يلبث أن يظهر كسلوك متطرف وعنيف في الشوارع والفضاءات العامة، وفي مختلف الأوساط الاجتماعية، وبالتالي فإن كل من يتصدر لإنتاج خطاب معين يجب أن يستحضر في ذهنه بأنه يشرعن لممارسات معينة. صحيح أن مثل هذه الخطابات ليست لها سلطة مادية يمكن أن تمارس بها نوعا من أنواع القهر والاستبداد، لكنها في الوقت نفسه يمكن أن تترك أثرا عميقا في النفوس بسبب ما تتمتع به من سلطة رمزية وقوة تأثيرية وإقناعية يتجاوز تأثيرها ما تحدثه الدبابات والأسلحة المدمرة، لذلك فمن الواجب استحضار هذه الأبعاد عند ممارسة أي نوع من أنواع الخطاب، واستشعار تحمل مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن مثل هكذا ممارسات.
وإذا كانت هذه الوسائل التكنولوجية بما هي عليه من ازدواجية في الأدوار، إذ هي بقدر ما يمكن أن تكون فضاء مفتوحا لنشر قيم الخير والفضيلة وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش بين الناس، بقدر ما يمكن أن تكون أيضا مرتعا خصبا لتغذية ثقافة الصدام والتحريض ضد الآخر، والتطلع نحو زعزعة الأمن والاستقرار؛ إذا كان الأمر كذلك فإن مقتضى النظر فيها في كلتا الحالتين، أن ننظر إليها من زاوية ما يمكن أن تحققه من نتائج إيجابية فنعمل على تحصيلها بكل الطرق الممكنة والمشروعة، وننظر إليها أيضا من زاوية ما يمكن أن ينتج عنها من سلبيات فنعمل على تفاديها بما هو متاح من إمكانيات تربوية وتأطيرية وغيرها.
هذا التصور في نظرنا هو الذي ينبغي أن يؤطر سلوكنا ويحكم علاقتنا بهذه الوسائل والتقنيات الجديدة، وهو تصور بلا شك سينأى بنا عن طرفي الإفراط والتفريط، لأنه قائم على الاعتدال والوسطية، وعلى الاستخدام الممنهج الذي يراعي كافة الشروط والضوابط التشريعية والأخلاقية.
وقد لا يخرج ما ذكرناه بخصوص أهمية هذه الوسائل في حياتنا المعاصرة عن مجال الادعاء ما لم نعزز ذلك بنماذج تطبيقية مستوحاة من واقع التجربة الحسية والممارسة الميدانية، وهذا ما سنعمل على إبرازه من خلال مثالين يختلفان سياقا ومضمونا لكنهما يتقاطعان من حيث إبراز أهمية الوظائف والأدوار التي يمكن أن تضطلع بها هذه الوسائل التكنولوجية في مواجهة التحديات الراهنة بكافة أبعادها.
يتعلق المثال الأول الذي نريد عرضه هنا بواقع التجربة الوبائية وما طرحته من إشكاليات، حيث عرفت هذه الفترة الوبائية في بدايتها توقف جميع المصالح والمرافق العمومية عن العمل، مما استدعى ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات البديلة ضمانا لاستمرارية الخدمات العمومية، فكان من بينها الانتقال من العمل الميداني إلى العمل عن بعد، عن طريق استعمال هذه الوسائط التكنولوجية الحديثة، التي لولاها ما كان باستطاعتنا أن نتصور النتائج الكارثية التي يمكن أن تحصل، خصوصا في ظل الارتباك الذي حصل نتيجة للصدمة التي تعتبر بحق صدمة تاريخية، بالنظر لكون هذا الوباء لم يكن معروفا من قبل، لكن بالرغم من كل تلك التحديات، وبفضل هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، استطاعت الدولة أن تدبر المرحلة بكفاءة عالية، ومن ثم الخروج بأخف الأضرار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي وغير ذلك من المجالات.
أما المثال الثاني فيرتبط بسياق الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة وما شهدته هذه الاستحقاقات من ممارسات غير ديموقراطية من طرف بعض الفاعلين السياسيين أو من يتعاونون معهم، وقد رأينا كيف أسهمت هذه الوسائل بشكل أو بآخر في ترشيد العمل السياسي والممارسة الديمقراطية، الشيء الذي كنا نفتقده في سنوات خلت، حيث لم تكن تسلط الأضواء على كثير من الخروقات والأحداث التي تقع خلف الكواليس في الواقع السياسي المغربي.
باختصار أقول: إن كل ما ذكرناه بخصوص واقع الشبكات الاجتماعية وما يقتضيه ذلك من ضرورة إعادة النظر في منظومتنا الثقافية التي تؤطر سلوكنا وتوجه تفكيرنا، بالإضافة إلى تلك التجارب العملية المستوحاة من واقع الممارسة الحسية، كل ذلك من شأنه أن يساهم في تشكيل وعي جديد حول أهمية هذه الوسائل، والنظر إليها كرافعة للتنمية لا كمجرد وسائل لهدر الطاقات والموارد، التي نحن في أمس الحاجة إليها للخروج من وهدة التخلف والانحطاط إلى أفق ينعم فيه مجتمعنا بكل مظاهر التقدم والازدهار.