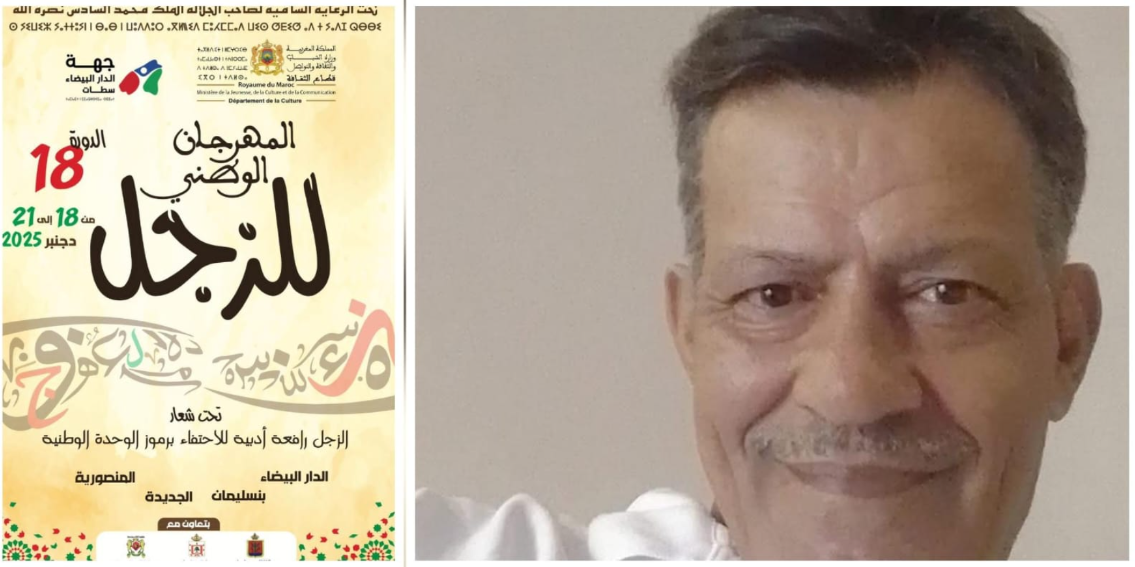الحب...
يفرض الشعور بالخطر البحث عن الأحباب والأصدقاء للاحتماء والنجاة، أي أن المرء لا يمكن له أن يقاوم وحيدا موج القدر، يضطر لأن يعيد النظر في مواقفه من الناس، أن يعيد تقييم آرائه، قناعاته التي تشكلت لديه في لحظات غضب أو كبرياء، هو ذا الإنسان الهارب دوما من ضعفه، من حدود استطاعته، يداري في أوقات القوة كل العراقيل، يسطو على حقوق الآخرين، يكون صارما، فظا في نسف علاقة حب آو زواج أو حتى صداقة بسيطة مع صديق قديم، لا يفكر أبدا في أنه قد يكون في حاجة ماسة لكل هؤلاء الذين يعاملهم بشدة وقسوة طالما أنه يشعر بالقدرة على الاستغناء عنهم والعيش دونهم... لكن الأمور سرعان ما تتغير بسرعة فائقة، ويصبح هذا المزهو بذاته، هرا مرعوبا، عصفورا مفزوعا، يبحث عن العش، عن الرفيقة والذرية لحماية نفسه من خطر الموت والانقراض... لهذا فالحب ليس لأزمنة الرخاء بل هو غذاء في لحظات الخطر والعزلة والموت الداهم....
الدين...
كثير من الناس لا يفهمون الدين إلا في حدود العادات والطقوس التي ورثوها عن الأجداد، حيث يظلون يعيدون تكرارها دون بحث أو تفكير، قد يكون بعض المفسرين محدودي الفهم سببا في الكثير من المغالطات التي أساءت إلى دور الدين في حياة الناس وضرورته الوجودية لحمايتهم من الكثير من الانهيارات النفسية والشكوك والمخاوف والوساوس التي سرعان ما تهاجم الإنسان عندما يتحلل من كل اعتقاد وينصرف لممارسة الشك في كل عقيدة أو دين.. الدين خطاب متعالي، صوت من السماء تحقق، يوما، في شخص الأنبياء والرسل وغيرهم من الحكماء والمصلحين ورجال التربية والصلاح، شكل لحظة لقاء ابدي بين المطلق الكامل، اللامتناهي الأبدي، والكائن النسبي الفاني المحكوم بالموت والانقراض... هو أثر لا يمحى، ودلالة لا تفنى، وشوق لا يقهر، إلى الكائن الأبدي، إلى عالم دون رغبات، دون ألم، دون موت، دون خوف، دون مرض.. هو الإنسان الناضج في حضرة الإله الحاضن...لهذا لابد أن يعود هذا النداء ليسكن القلوب والنفوس في لحظات الموت الهادر والفناء القادم الذي تشكله الأمراض و الأوبئة والكوارث وغيرها من الشرور الطبيعية التي تدخل في نطاق الأنظمة الكونية السابقة على وجود الإنسان...
لكن عودة الدين كحماية من انهيار الكينونة شيء، واستغلال الكوارث من لدن رجال الدين لتكريس نفس التصورات ونفس التمثلات شيء آخر، في الحالة الأولى سيعود الدين كأصل ضائع، وجذر وجودي لابد منه حتى تظل الشجرة على قيد الحياة، وفي الحالة الثانية يتعدى الأمر مجرد شعور إنساني بضرورة استحضار القوة الربانية للتغلب على القوة الطبيعية القاهرة، إلى استثمار سياسي لخدمة سلطة أرضية إيديولوجية لا علاقة لها بالحالة الأولى... غالبا سلطة رجال الدين الكارهين لكل تحرر للفرد من هيمنتهم وسطوهم على روحه ومصيره... لهذا وجب التمييز بين الحالتين، وبالتالي وجب تفادي انتقاد تشبث المرء بدينه في حالة الشعور بالخطر، وبين خطابات الدعاة التي لا مكان لها في هذا المقام، وبالتالي فهذا يدعو إلى انتقادهم وبيان تهافتهم، وركوبهم على الوضع النفسي للمؤمنين قصد استقطابهم واستعمالهم مستقبلا في معارك سياسية أرضية...
الموت...
ظاهرة طبيعية في صورتها المباشرة، مصير سابق على كل وجود إنساني، دورة وجود تستلزمها الحياة للاستمرار والتجديد والتطور... لكن دينيا الموت شيء آخر، هو حكم رباني، نهاية متوقعة، معبر نحو عالم آخر، عبور برزخي للقاء الله، فرصة النجاة من العدم.. حساب وتقييم للوجود على الأرض... الموت هنا جزء من منطق عام، يتعلق الأمر بأن الوجود ليس صدفة، والحياة ليست عبثا، والأفعال ليست اعتباطية، لكن كل ما يقع له منطق ودور ومسؤولية تفسرها رسالة التكليف، أي أن الإنسان مسؤول عن وجوده، مكلف بتدبير حياته على الأرض، سيحاسب على كل أفعاله... لهذا فالموت هنا ليس تراجيديا، بل عتبة نحو ما هو أفضل، ما هو باق وما هو ابدي..
العلم... في أزمنة الأوبئة...
هو خطاب العقل، منهجية البحث في الظواهر الطبيعية، مقاربة للكون من زاوية العقلانية والتجريب، هو النهج الذي يلاحظ، يفترض، يقيس، يجرب، يستنتج، ثم يبني القوانين ويؤسس النظريات... لهذا فالعلم هو العالم المنظم... الكون المعقلن،... ولقد قضى الإنسان زمنا كبيرا وهو يحاول فهم ما يحيط به من ظواهر طبيعية منها، ما يسائله ويستفز فضوله، ومنها ما يرعبه ويشكل خطرا على وجوده مثل الزلازل والفيضانات والأوبئة.. هكذا شكل العالم الخارجي دوما تحديا للعقل البشري، ودفعه بالتالي إلى تطوير قدراته العقلية من أجل الوصول إلى فهم كنه هذا العالم واكتشاف القوانين التي تؤطره وتنظمه..
من هنا جاءت العلوم التجريبية التي تسمى أيضا العلوم الطبيعية، وتبلور العقل الرياضي الذي سماه العالم الفيزيائي الشهير كاليليو "اللغة التي تتحدث بها الطبيعة" أي أن الطبيعة لا تتحدث إلا بلغة المربعات والمستطيلات والدوائر، ومن هنا كانت الرياضيات كلغة هي اللحظة التي بدأ فيها الإنسان يسال والطبيعة تجيب، لأنه اكتشف أبجديتها الحقيقية... ومن هنا شرع الإنسان في تأسيس مشروع تفسير كبير لكل الظواهر الطبيعية والفلكية وغيرها التي كانت تقض مضجعه وتفرض عليه الهروب والاختفاء في المغاور والكهوف وكأنها كائنات حية تريد الفتك به، في حين أنها مجرد ظواهر غير عقلانية تمارس أنشطتها التي هي جزء من طبيعتها... بهذا المعنى ساهم العلم في تحرير الإنسان من الكثير من الأوهام والخرافات والأساطير التي كانت تعرقل نموه وتطوره وتحكم عليه بالضعف وبالهوان ..
لهذا فالتفسير الذي يقدمه العلم للأوبئة اليوم يبدو بديهيا بالنظر للتطور والنمو العقلي والمعرفي، لكنه في الحقيقة هو ثورة فكرية، نقلة ابستمولوجية من منطق إلى آخر، من الجهل إلى العلم، من الخوف إلى الفهم، من الغموض إلى الوضوح... ولهذا وجب احترام العلم والإنصات إلى خطابه الذي لا تحكمه الغرائز ولا الانفعالات ولا حتى الإيديولوجيات على الرغم من كون العلماء قد يقعون في أسوأ الإيديولوجيات كما كان يقول لويس التوسير، لكن هذا نقاش آخر...
خلاصة:
للعلم مجاله، الذي لا يعني نفيا للدين، ولا قفزا على الحالات النفسية التي يعيشها الإنسان في لقائه بخطر الموت أو المصير المجهول، كما أن للعلوم النفسية دورها وريادتها في مساعدة الناس على فهم أنفسهم وهم يواجهون الموت والمرض في لحظات الكوارث الطبيعية، كما أن للدين دوره في تقوية مناعة الفرد الروحية والرفع من قدراته الباطنية التي تساعده على تحدي المرض والتسلح بعقيدته للتصدي للوباء كأي جندي الذي لا يحتاج فقط للسلاح والعتاد، بل هو في حاجة لدعم نفسي وديني حتى يشعر أن معركته أخلاقية ومصيره بعد الموت مقدس وضامنه هو الله.... لكن كل استثمار إيديولوجي لاهوتي أو غيره للوباء هو خطاب فاشل ومنبوذ ولا يمكنه أن يستقطب بقدر ما أن مصيره سيكون هو النبذ والسخرية...