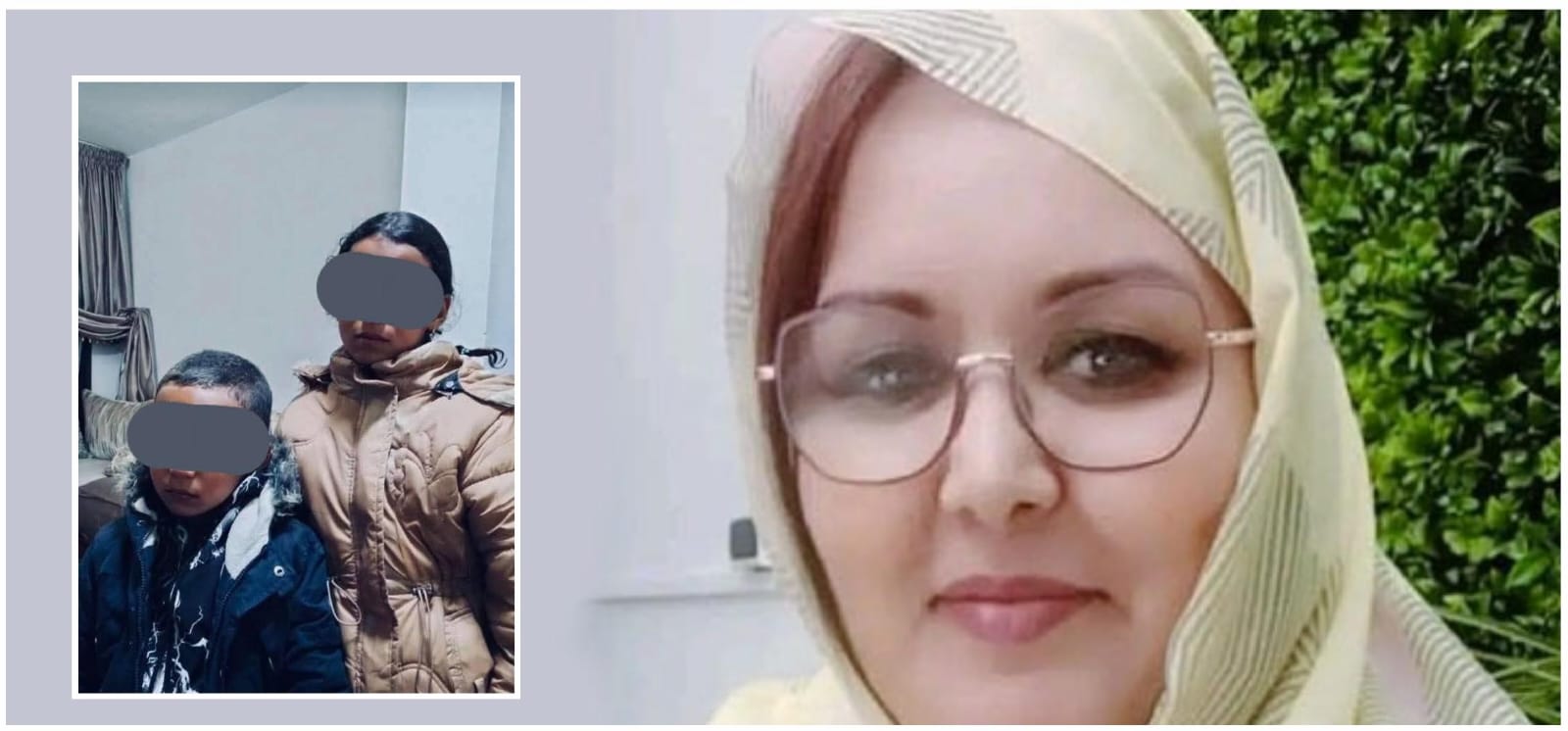ليست "كورونا" أو كوفيد19 هي الوباء الأول الذي تجاوز الحدود، و"عولم" العالم، وساوى بين الناس في المحنة، فيكفي الرجوع إلى الأدب العالمي سنجد كتابات خلدها تاريخ الإبداع، إما مستوحاة من كوارث وبائية مرت منها البشرية أو وظف فيها الوباء لخدمة البناء الروائي. ولعل المهتم بالمجال تستوقفه رواية الطاعون لمبدعها ألبير كامو Albert CAMUS الصادرة سنة 1947، التي تدور أحداثها في مدينة وهران، حيث صور الكاتب كيف يؤثر الوباء في السلوكات والعلاقات، ولكن أيضا على مستوى التمثلات.. وهو الأمر الذي اختار مواصلته عدد من المبدعين الروائيين، موظفين الوباء كتيمة أساسية أو فرعية في إبداعاتهم. فبعد ثلاثين سنة، سيبدع مواطنه مارسيل بانيولMarcel PAGNOL رواية لا تقل روعة، تحمل عنوان "المصابون بالطاعون" "Les Pestiférés" التي تدور أحداثها في مدينة مارسيليا الفرنسية، إبان فترة الطاعون سنة 1720، وتصور كيف سيقرر سكان حي، اللجوء إلى نظام العزل الصحي الصارم. ويبدو وكأن الرواية تريد أن تبرز أن الإنسان قد يقبل بالتخلي عن الكثير مقابل البقاء على قيد الحياة. ولن نستثني الأدب العربي من هذا المجال، فالراحل طه حسين في سيرته الذاتية التي تحمل عنوان "الأيام"، يصور وباء الكوليرا الذي ضرب مصر سنة 1902، وكيف قضى على أحد إخوته. ولا تقل رواية أمين معلوف "ليون الإفريقي" روعة في توظيف الوباء، حيث وظف كيفية عزل المصابين بوباء الجدري في مدينة فاس في تلبية رغبات النوازع البشرية، وصدمت فواجع الأوبئة الشعراء. ولعل من أبلغ من أبدعوا في ذلك، الشاعرة العراقية نازك الملائكة في قصيدتها "الكوليرا" مصورة هول هذه الفاجعة في مصر سنوات الأربعينيات، وأبدعت بشكل بليغ في وصف ارتفاع عدد الضحايا، ملامسة بذلك مشاعر الإنسان وخوفه الدائم من الموت:
"موتى، موتى، ضاع العدد/ موتى، موتى، لم يبق غد..."
وبعيدا عن الإبداع الأدبي، ماذا علمنا هذا الوباء الجديد؟
يبدو لي أنه أيقظنا من حلم كنا نعيشه، أو نتعايش معه، آمنا بمثل وهمية مجدت الفرد أكثر مما ينبغي، واختزلنا علاقاتنا مع ذوينا فيما يمكن أن نوفره لهم ماديا، فلم نعد نلعب مع الأطفال، ونصاحبهم إلى المدرسة القريبة من البيت، وتنافسنا في إدخالهم إلى المدارس التي تفنن أصحابها في اختيار التسميات، وتوهم الكثيرون أن التلميذ سيناله حظ من اسم المدرسة، سواء أكان فلسفة أو علما أو فنا. ولم نعد نعير لإبداع الطفل أي معنى فلا يهمنا، أن يصبح فنانا أو بطلا، سعيدا في اختياراته وبناء حياته، بقدر ما نمني النفس بأن يحقق حلمنا نحن الذي فشلنا في تحقيقه، في أن نكون أطباء ومهندسين، وبالأخص أغنياء، وسلبنا من أطفالنا فرصة اختيارهم الحياة التي يرغبون فيها، بل أحيانا سرقنا طفولتهم، فلم ندعهم يلعبون بالتراب، ويسقطون ليتعلموا كيف يقفون، فأغرقناهم بالتمارين وبالساعات الإضافية وفرضنا عليهم التفوق ولا شيء غيره. وهجر الفرح والصخب جلساتنا، التي تحولت إلى انزواء جماعي تحضر فيه الأبدان، وتبحر فيه العقول والأهواء خلف الشاشات في مواقع التواصل الاجتماعي، وسرقت منا متعة لحظات الالتئام حول "صينية" الشاي، أو حول مائدة الطعام. واعتقدنا أن الوضع المادي المريح يمكن أن يضمن الاستغناء عن الدولة، فلا حاجة لنا بتعليمها ولا بخدماتها الصحية، ولا ما تقدمه عبر قنواتها الإعلامية، بل ما عدنا نصدقها أصلا، حينما تخاطبنا وبتنا نشكك في كل شيء صادر عنها، معتقدين أن وراء كل مبادرة تصور مكيافللي للسياسة، وتندرنا في بعض جلساتنا بالمعلم، والممرض والمقدم والشيخ و القايد والشرطي... وأقنعنا أنفسنا أحيانا بخطاب بعض السياسيين، الذين أوهمونا بأن النفقة العمومية يجب أن تتخلص من عبء النفقات الاجتماعية عبر تقليصها، وأن التعليم والصحة... من الضروري أن تؤول إلى القطاع الخاص، فهو العارف والقادر على تحويلها إلى قطاعات منتجة. فإذا بالوباء يوقظنا فجأة من هذا النوم الثقيل، وإذا بنا نهجر القنوات الإعلامية الأجنبية ونتسمر أمام جهاز التلفزة لنعرف حالة تطور الوباء في بلادنا، ونعود إلى الإذاعات والمنابر الإعلامية الوطنية. وفجأة تعود الحرارة إلى هواتف الصحة العمومية، وتتنقل سيارات إسعافها إلى نقل المصابين بغض النظر عن مستوياتهم الاجتماعية والمادية إلى المستشفيات العمومية، وتهب قيمة التضامن الثاوية في كينونة هويتنا، ويختفي الكثير من السياسيين من حياتنا، ويختار أغلبهم البيات الشتوي، وفي الوقت الذي نلزم فيه البيوت ونترقب خائفين، يظهر أولئك الذين كنا نتفكه بهم في طليعة من يحمينا، فلا بلاد الخارج أصبحت عاصما، ولا الجواز الأجنبي بات منقذا، بل الدولة هي من ينقذ، وهي من يعيل، وهي من يحمي الناس من بعضهم البعض، كي لا تنتشر العدوى ويواصل الوباء حصد الأرواح.
قد تنجلي هذه الجائحة، وقد يكتب للكثيرين البقاء، والاستمتاع برواية ما نعيشه اليوم من حجر وما تخلله من أحداث للأحفاد بشكل أسطوري، ولكن كيف ستصبح علاقاتنا مع بعضنا البعض بعد الوباء؟ كيف سنتعاطى مع الدولة؟ لو كتب لي أن أكون من الناجين، سأخبر طلبة علم السياسة بأن أزمة كورونا خلقت مفهوم " الدولة المنقذة" وسأعيد وأكرر بثقة أكبر ما كنت أقوله حول السلطة السياسية.