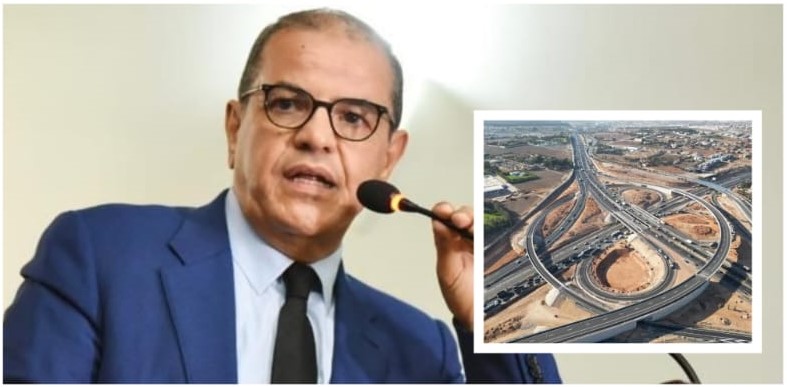سقْطة ديموقراطية هو فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب. نهضت مع هذا الفوز إشارات نقيضها، أي التسلّط والاستبداد وأين؟ في أكبر وأقوى ديموقراطية، توزّع النصائح وتعطي الدروس للعالم حول السُبل الأفضل للحكم الديموقراطي. فاز ترامب بأصوات المتحمّسين لهوية الذكور البيض، غير المتعلمين، ومعهم نساؤهم (53%): العنصريين، الإسلاموفوبين، الإنعزاليين. استوحى ترامب تصوراته من المخزون العنصري الأميركي، ولكن ايضاً من الحكام المتسلّطين. حبه لبوتين وإعجابه به، وعطفه على بشار الأسد، و"الكيمياء" الإيجابية بينه بين عبد الفتاح السيسي؛ ثم طموحاته الإمبراطورية القائمة على الهوية العنصرية. وربما كان أيضاً معجباً بالسرّ بـ "العدو" الإرهابي الذي سيحاربه، والذي مثله، يقوم على حلم إمبراطوري قديم، قوامه الهوية الدينية. فأعطى بذلك نفَسا عميقا للإرهاب، ولكافة مرتكبي جرائم حرب، المحاربين لهم. عبد الله المحيسني، القاضي الشرعي لـ "جيش الاسلام"، يعلّق على فوزه: "إنها مرحلة مهمة في طريق انتصار السنّة".
إعلاء ترامب لهوية الرجل الأبيض هي دغْدغة لمشاعر الجماهير العنصرية، الغاضبة من سقوطها الطبقي، المنْتفضة؛ إنه يضعها على السكّة نفسها لثورات اليمين الأوروبي المتطرّف، القومي، الذي لا يرى في العوْلمة سوى مؤامرة هويتية تقودها "المؤسسات". وربما هنا نقطة صحيحة، ولكن لماذا ثورة يمينية لا ثورة يسارية؟ لماذا أخفق بيرني ساندرز، نظير دونالد ترامب، على الضفة اليسارية من "الحزب الديموقراطي"؟ لماذا خسر ساندرز، "الثوري، الاشتراكي" أمام هيلاري كلينتون، فلم يخترق "الاستبلشمنت" ولا فرض نفسه بوجه ترامب؟ إنها ربما روح العصر: حنين إلى الماضي، ثورة من أجل استعادة هذا الماضي. ويتبادر السؤال هنا: إذا فاز ترامب بأصوات دعاة الهوية، والثورة من أجل الماضي، فلماذا الحرب ساعتئذ ضد "داعش"، صِنْوه الماضوي الإمبراطوري؟
ثورة رجعية شعبية من أجل العودة إلى الماضي: هي الوصفة الأخرى المناسبة لذاك الزَلَل الديموقراطي. من الآن فصاعداً سيكون من الصعب الدفاع عن التقدم، تلك الفكرة المحمولة على الديموقراطية، والقائلة، عكس ترامب، بأن المستقبل هو مصدر الإلهام. يسميه البعض، تلطيفاً، "حنينا"، ولكنه في الواقع عداء صميمي لكل ما هو أعمق بقليل من المنظور، من السطح؛ أي عداء للثقافة، والفن، والعلم (لا يعترف ترامب بنتائج توصل إليها علماء حول أزمة البيئة العالمية). والسطحية موجة عالمية على كل حال، وهي ترتكز على الاضمحلال التدريجي للثقافة والأخلاق السياسية، والاعتماد الأقل تدرّجا على القوة السافرة، وبمسالك شخصية تمزج الابتذال بالكذب وانعدام اللياقة والذوق: انظر إلى منزل ترامب البشع، المرصّع بالذهب والألماس، والذي يشبه، بحبه لكل ما هو متلألئ، بيوت الأثرياء الجدد. أما عداؤه للنساء وللنسوية، فلم يكن يحتاج إلى قذارة كلماته بحق النساء، أو إلى وصفه لنوعية علاقته بهن. زيجاته المتلاحقة بـ "الجميلات" الأصغر منه سناً، وصولاً إلى الأخيرة، ميلانيا، التي تصغره بعقدين ونصف، شبيهة نجمات الفيديو كليب المخضرمات، المتجمّدة ملامحهن، المختبئة خلف العمليات الجراحية "الناجحة"... كلها خير إشارة. والواضح أن سيرته معها لا تختلف عن سيرة أي بليونير، "اشترى" غرام الصبية الفقيرة التي "اختارها" من بين أولئك اللواتي ينظّم شؤون انتخابهن ملكات للجمال، على أدنى تقدير...
الانتخابات في أقوى ديموقراطيات العالم جاءت برئيس معادٍ لغالبية الركائز التي تقوم عليها الديموقراطية. منذ فترة تعاني الديموقراطية، حيث هي معتمدة في الأنظمة الأقل سوءاً، المسماة "ديموقراطية"، من أمراض عصرها: أولهم الثقافة "الجماهيرية"، التلفزيونية، القائمة على الصورة الاختزالية، الملموسة، والتي من طبيعتها نفسها معاداة كل تجريد، أو فكرة، أو عمق، أو بُعد. وصار العرض السريع، المقتضب، الديماغوجي، يحرِّك أقدم الغرائز وأقواها. أطلق ترامب شعاره "فلنجعل أميركا عظيمة مجدداً"، فحرّر خيال الجماهير المشْبعة بالمختصرات. أكثر من أية ديموقراطية أخرى، تعتمد أميركا تعتمد على المال لتسيير انتخاباتها الديموقراطية، مال الإستبلشْمنت، ومال الخارجين عنه: هيلاري كلينتون تعاطت هي أيضا بالمال، وأفرطت. فيما ترامب، لم يحتج إلى من يموّل حملته. هو غطاها بما جناه في مقاولاته الناجحة، يقول انه سوف يستفيد منها ليطبّق تجربتها على الحكم إذا فاز. وقد يكون العيب الأخير هو أكثر ما ساعد ترامب على الفوز: الوعود البراقة التي يعرف انه لن يحقّقها. والنتيجة، شعبوية ظافرة، منفّرة، استفزازية، ركيكة، ولكنها مقنعة جداً لـ "جماهير الطوائف" الأميركية. ومثل خياراتنا نحن، أبناء البلدان التعيسة بحكامها، كان على الأميركيين، في هذه الانتخابات بالذات، أن يختاروا بين ترامب، الكوليرا، وهيلاري كلينتون، الطاعون... كيف أخفقت النخبة الأميركية، فحصرت الخيار بين مرضَين خطيرين، ولا ثالث لهما؟
لو ربحت كلينتون الانتخابات، لكان استمر تعثّر البشرية في السير نحو المستقبل. ولكانت الإدارة الأميركية واظبت على النفاق الديموقراطي، وحقوق الانسان إلخ. الآن، مع ترامب، القضية واضحة جداً: هو معجب بالاستبداد وملحقاته. طبعاً هناك من سيقول بأن ترامب مرشحاً ليس كترامب رئيساً، وأن مصالح الإستبلشْمنت العسكري-الديبلوماسي، والمنافسين الجمهوريين الآخرين في الكونغرس... قد يغيرونه، ولو قليلاً. ربما، ولكن يبقى المهم، أن عهده سوف يتخلّله نوع من المقاومة الجديدة: المقاومة الديموقراطية.
(عن جريدة "المدن" الإلكترونية اللبنانية)