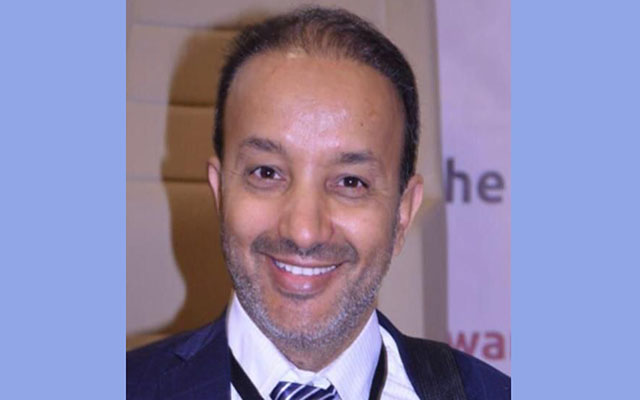صحيح أن الرئيس المُتْعَب صحيًا عبد العزيز بوتفليقة قد تمكّن مؤقتًا من حسم الصراع الدائر على السلطة بين القصر الرئاسي وبين المخابرات، ولكن مع ذلك لا بد من طرح السؤال عمن يمسك منذ ذلك الحين بزمام الحكم في الجزائر - هل هو الرئيس أم الجيش المنتشر في كلّ مكان؟ الصحفي غياني ديل بانتا، يجيب على هذا التساؤل في تحليله التالي.
تعتبر الجزائر في الواقع بلدًا معقدًا. ولكن مع ذلك هناك ثلاثة عوامل أساسية من أجل فهم حالة التدهور السياسي الراهنة في الجزائر. وهذه العوامل هي: المحسوبية وعائدات النفط وإرث الحرب الأهلية.
في البداية لا بدّ من إلقاء نظرة على الماضي: في الثمانينيات ومع انتخاب الرئيس الشاذلي بن جديد رئيسًا للجزائر، اتسمت عملية التحرُّر الاقتصادي بانسحاب الدولة، وكذلك باتِّساع المجال للمبادرات الحرّة وباستخدام عائدات النفط من أجل إنعاش الصناعات الخفيفة وتطوير البنية التحتية في البلاد.
والانخفاض المفاجئ والمؤلم لأسعار النفط في السوق العالمية في عام 1986، الذي رافقته حالة من التدهور الاجتماعي المتزايد، يُفسِّر إلى حدّ ما سبب الاضطرابات التي شهدتها الجزائر في شهر نوفمبر 1988، والتي تدخَّل فيها الجيش بعد ذلك بصورة دموية.
وتلت ذلك عملية كانت مدعومة من خلال التحوُّل الديمقراطي في البلاد، وأسفرت في نهاية المطاف عن فوز الإسلاميين في الانتخابات المحلية في عام 1990 وكذلك في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في عام 1991. ومن أجل تجنُّب حصول الإسلاميين على أغلبية برلمانية، ألغى الجيش العملية الانتخابية وقام بانقلاب. وكان هذا الانقلاب بمثابة الدافع الأساسي لحرب أهلية طويلة الأمد كانت حصيلتها نحو مائتي ألف قتيل.
وهذه التجربة أثَّرت تأثيرًا عميقًا في الجزائر اليوم - التي باتت تعاني من توتُّرات داخلية وتعتمد اعتمادًا كبيرًا على عائدات النفط، التي تأتي لصالح محسوبية أصحاب العلاقات الحقيقية مع سلطة الدولة. وهذه العلاقات مع سلطة الدولة تتم المحافظة عليها من قبل مختلف الزمر المتنافسة باستمرار. كما أنَّ هذه العلاقات تجعل هذا البلد الغني بالموارد الطبيعية سجينًا لرفض واستنكارات اجتماعية قوية.
رئيس المخابرات المعروف بلقب "إله الجزائر"
في بداية شهرسبتمبر من العام الماضي 2015 أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بشكل مفاجئ رئيس المخابرات الجزائرية القوي، الجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق. هذا الرجل الذي تم تدريبه في الستينيات من قبل الكي جي بي (الاستخبارات السوفييتية)، والذي بات يُعرف بلقب "إله الجزائر" - مثلما يحب أن يسميه الناس، نشأ في ظلِّ رئيس جهاز المخابرات الجزائرية في الثمانينيات، الجنرال محمد بتشين، قبل أن يصبح بنفسه ولأكثر من خمسة وعشرين عامًا رئيسًا لواحد من أقوى أجهزة الاستخبارات في العالم وأكثرها تأثيرًا.
وفترة رئاسته لجهاز المخابرات كانت غير مألوفة من حيث مدتها. وهذا ما يشير إليه أيضًا الباحث جيرمي كينان من مدرسة الدراسات الشرقية في جامعة لندن، ويذكر للمقارنة فترات رئاسة غيره من رؤساء أجهزة الاستخبارات الأخرى السيئة السمعة: حيث استمرَّت فترة طغيان لافرينتي بيريا كرئيس لجهاز الاستخبارات السوفيتية خمسة عشر عامًا. وفترة طغيان هاينريش هيملر بما في ذلك رئاسته للاستخبارات الداخلية وكمنِّظم لإرهاب النازيين انتهت بعد أحد عشر عامًا مع انتحاره إثر انتهاء الحرب.
وفي فترة رئاسته لجهاز المخابرات الجزائرية طيلة ربع قرن، كان الجنرال محمد مدين من أكثر الشخصيات تألُّقًا ولمعانًا في الجزائر، بينما كان في الوقت نفسه من أقل الوجوه المعروفة للجمهور: إذ لا توجد سوى صورة واحدة فقط وباهتة، يظهر فيها مثلما يُفترض الجنرال توفيق في نهاية التسعينيات.
غير أنَّ إقالته من عمله ليست - مثلما سارع الكثيرون إلى الادعاء - محاولة من قبل القوى المدنية الحاكمة للسيطرة على الجيش بشكل أفضل وأكثر فعالية، بل يجب أن ننظر إليها على أنَّها هجمة مُنَسَّقة وناجحة من قبل رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح وكذلك رئيس المخابرات الجزائرية الحالي الجنرال عثمان طرطاق.
كان الفريق أحمد قايد صالح من ألد أعداء الجنرال محمد مدين منذ عام 2004، وذلك بعدما تم إبعاد سلفه محمد العماري إثر اتِّفاق بين الجنرال توفيق (محمد مدين) وبين الرئيس بوتفليقة. وعثمان طرطاق، المعروف باسم الجنرال بشير، كان الرقم اثنين سابقًا في جهاز المخابرات الجزائرية، وقد وقع في خلاف مع الجنرال محمد مدين بعد الإدارة الكارثية للأزمة المعروفة باسم أزمة "إن أميناس"، التي وقعت في شهر يناير 2013، بعدما أقدمت مجموعة مسلحة لها علاقة بتنظيم القاعدة على احتجاز أكثر من ثمانمائة عامل كرهائن في حقل للغاز في منشأة تيقنتورين.
وفي هجوم مُتسرِّع تم تنفيذه من دون تخظيظ من قبل مجموعة من القوَّات الخاصة الجزائرية، تم قتل ما لا يقل عن سبعة وستين شخصًا، من بينهم سبعة وثلاثون أجنبيًا. وقد كانت لهذه الأزمة عواقب دولية، وأدَّت إلى أمور من بينها استدعاء السفير الجزائري من قبل الحكومة اليابانية، وذلك لأنَّ هذا الهجوم أسفر عن قتل عشرة عمَّال يابانيين.
تصفية حساب مع الجنرال توفيق
وعلى العكس مما كان يمكن للمرء أن يتوقَّعه، فإنَّ إقالة الجنرال محمد مدين لم تكن محض مفاجأة، بل كانت نتيجة لعملية إضعاف ناجحة لهذا الجنرال، الذي كان في السابق من أقوى رجال الجزائر. لقد تم التخطيط لهذه الصفقة لعدة أشهر، وقد مرَّت في ثلاث مراحل: في البدء تم وضع مختلف الدوائر الخاضعة حتى ذلك الحين لسيطرة جهاز المخابرات الجزائرية تحت وصاية الجيش المباشرة، أي تحت قيادة أحمد قايد صالح.
وفيما بعد تم إضعاف العديد من أتباع الجنرال محمد مدين - من رئيس مكافحة التجسس، الجنرال عبد الحميد "علي" بن داوود إلى قائد الحرس الرئاسي جمال كحاز مجدوب - أو تمت إقالتهم. وفي نهاية المطاف تم في أواخر شهر غشت 2015 اعتقال الجنرال حسن.
وبهذا كانت جميع الاستعدادات قد تم اتِّخاذها من أجل الضربة الحاسمة ضدَّ "إله الجزائر" - ضربة قُدِّر لها أن يتم تنفيذها بعد فترة قريبة. وبحسب المعلومات الرسمية فقد تم اتّخاذ القرار حول ذلك بالفعل في بداية شهر سبتمبر 2015. وبعد تجريده المثير من سلطاته لاذ الجنرال توفيق في صمت طويل الأمد، ولكنه مثير للكثير من النقاشات. ولم يكسر هذا الصمت إلاَّ قبل فترة قصيرة برسالة مفتوحة أرسلها إلى صحيفة يومية جزائرية بعد الحكم على حليفه المقرَّب، وهو الجنرال حسن، بالسجن خمسة أعوام.
وفي الوقت الراهن لا يمكن تقريبًا الجزم في أي اتِّجاه ولمصلحة مَنْ سيتطوَّر هذا الصراع. ولكن في الواقع ربما سيكون من الواضح أنَّ القوى المدنية لن تخرج على أية حال من هذا الصراع قوية بشكل يستحق الذكر. وعلى الأرجح أنَّ السبب بسيط: وذلك لأنَّ الرئاسة، التي كانت حتى ذلك الحين المعارضة الوحيدة الجديرة بالذكر ضدَّ هيمنة الجيش الكبيرة، لم تكن قَطّ ضعيفة وعاجزة إلى هذا الحدّ مثلما أصبحت اليوم.
عندما طلب الجيش الجزائري من عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان وزيرًا للخارجية من عام 1963 وحتى عام 1978، أن يترشَّح لمنصب الرئيس "المُنتخب" في انتخابات عام 1999، التي لم تكن حرّة للغاية، كانت الجزائر بلدًا مزَّقته سبع سنوات طويلة من الحرب الأهلية ومعزولاً تمامًا على المستوى الدولي.
وبالنسبة للرئيس الجديد فقد توفَّرت الظروف المواتية من خلال علاقاته الشخصية وارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية وكذلك من خلال التحوُّل النوعي بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي. وهكذا تمكَّن بوتفليقة من توطيد سلطته بسرعة.
وبعد تعديل دستوري تم من خلاله إلغاء تحديد مدة ولاية الرئيس، أُعيد انتخاب بوتفليقة للمرة الثالثة على التوالي في عام 2009. ولكن فترة ولايته الثالثة تميَّزت منذ البداية ببرود مفاجئ في العلاقات التي باتت تسيطر على الجزائر في الأعوام الأخيرة: أي العلاقة بين بوتفليقة ومدين.
وفي الواقع لا تزال أسباب ذلك غامضة. ولكن على الرغم من ذلك يفترض العديد من المعلقين أنَّ الجنرال توفيق كان يخشى من زيادة قوة الرئيس وقد عارض ولاية العهد الأسرية التي أعدّ لها بوتفليقة، وقد تجلّت في زيادة نفوذ شقيقه الأصغر سعيد، الذي يعتبره الجنرال مدين فاشلاً كليًا.
ويبدو أن الصراع بين رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات انتهى لصالح هذا الأخير. ففي عام 2009 لم يتم فقط تضييق مجال عمل بوتفليقة باستخدام القضاء وحسب، بل لقد اضطر بوتفليقة بعد مجموعة لا نهاية لها من الفضائح إلى إقالة العديد من أقرب المقرَّبين له، وكان من بينهم صديقه وزير الطاقة شكيب خليل.
وكذلك لقد أتى تدهور صحة بوتفليقة في صالح مدين. فبعد إصابته بسكتة دماغية قوية، اضطر الرئيس في ربيع عام 2013 إلى البقاء نحو ثلاثة أشهر في فرنسا من أجل العلاج، قبل أن يتمكّن من العودة - في كرسي متحرِّك - إلى الجزائر.
بوتفليقة - الرجل الذي جعل الانتخابات تسير لصالحه
وعلى الرغم من ذلك وبعد جدالات لا نهاية لها مع المعارضة، تمكَّن بوتفليقة من إعادة انتخابه في شهر أبريل 2014 لولاية رابعة. وهذه الانتخابات سيذكرها الجزائريون بكونها قد فاز فيها رجل "لا يستطيع السير، ولكنه جعل الانتخابات تسير لصالحه".
في هذا البلد، الذي يتم حكمه منذ ردح طويل من قبل ما يعرف باسم "الدولة العميقة" - وهي زمرة مجهولة الهوية ومكوَّنة من جنرالات ورجال الاستخبارات وكبار رجال الأعمال الحكومية - تنتج دائمًا حالة مرض الرئيس إشاعات جديدة حول قدرته على أداء مهامه الرئاسية، وتطرح السؤال حول الذي يمسك فعلاً بمقاليد الحكم في الجزائر.
شهد اليوم الأوَّل من شهر نوفمبر 2015 نقطة تحوُّل مهمة في الجزائر، وذلك حينما نشر تسعة عشر سياسيًا جزائريًا شكوكهم الجادة حول قدرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أداء مهامه الرئاسية. وهذه المبادرة لا تعتبر بالتأكيد أمرًا جديدًا في هذا البلد الشمال إفريقي. ولكن مع ذلك فإنَّ إلقاء نظرة سريعة على قائمة أسماء الموقِّعين التسعة عشر، التي تقلَّصت بعد انسحاب ثلاثة منشقين إلى ستة عشر، يثير أسئلة أخرى.
فإذا استثنينا "التروتسكية" لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمّال، فإنَّ الموقِّعين الثمانية عشر الآخرين، الذين طالبوا بإجراء لقاء مع بوتفليقة، يعتبرون من المقرَّبين كثيرًا من رئيس الجمهورية، أو بعبارة أخرى يعتبرون من أعضاء دائرة مؤيِّديه الداخلية. وهذا يثير شكوكًا كبيرة: فلماذا يا يترى ينشر هؤلاء الأشخاص مطالبتهم بما يفترض أنَّهم يعرفونه بالفعل، أو بما يمكن لهم أن يعرفوه من دون أية صعوبات بفضل اتِّصالاتهم الشخصية؟
أدَّت سلسلة هذه الأحداث بكاملها إلى جعل الكثيرين ينظرون إلى هذه البادرة على أنَّها مناورة لصرف الأنظار وتصبُّ في مصلحة الرئيس. مناورة تهدف إلى دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال مشاركة البلاد مباشرة في هذا الوضع الحساس، الذي بلغ فيه استعراض القوة إلى حدّ لم يكن معروفًا من قبل.
وضع يُذكِّر برئيس تونس المريض الحبيب بورقيبة
يُذكِّر هذا الوضع الراهن في الجزائر العديد من المراقبين بأحداث عام 1987 في تونس، حينما تم تجريد الرئيس التونسي المريض، الحبيب بورقيبة، من منصبه في "انقلاب طبي". وهذه الصيغة التي أصبحت مشهورة، تعود إلى زين العابدين بن علي، وزير الداخلية في تلك الأيَّام والمدبِّر الرئيسي لخطة، كان من شأنها أن رفعته إلى أعلى منصب في الدولة، شغله حتى الاضطرابات التي دخلت التاريخ في وقت لاحق باسم "الربيع العربي"، وقد أجبرته على مغادرة البلاد بسرعة كبيرة في شهر يناير 2011.
وهذا الصراع المرير على السلطة في قمة الدولة يضع الجزائر في وضع اقتصادي صعب مع تزايد التفاوت الاجتماعي والفقر لدى شرائح المواطنين الأضعف. حيث لا يزال اقتصاد البلاد من أقل الاقتصادات تنوعًا في العالم، حيث يشكِّل النفط والغاز أكثر من سبعة وتسعين في المائة من صادرات الجزائر.
وعمليا لم تعد توجد في الجزائر صناعات، بعد أن توقَّفت جهود التصنيع التي تعود إلى حقبة السبعينيات. وفي مثل هذه البيئة فإنَّ الانخفاض المستمر في أسعار "الذهب الأسود" يضع الحكومة الجزائرية في موقف صعب للغاية. وعلى الرغم من استعداد الحكومة الجزائرية لمثل هذا العجز الكبير في الميزانية، إلاَّ أنَّها اضطرت إلى تقليص النفقات وخفض الدعم بشكل كبير حتى لاحتياجات المواطنين الأساسية.
شرعية النظام السياسية المتواضعة جدًا وزيادة الاضطرابات لدى مختلف قطاعات المواطنين يقابلهما من جانب الدولة استخدام كبير ومتزايد للعنف، بهدف تجنُّب الانتفاضات الاجتماعية، التي كان بوسع الدولة أن تحتويها في الماضي بفضل ارتفاع إيرادات بيع النفط والغاز.
حرِّيات محدودة للمعارضة
يؤثِّر تضييق حرِّيات المعارضة أيضًا على عمل العديد من الصحفيين المستقلين والمبادرات الاجتماعية. وخير دليل على ذلك من دون شكّ مصير حسن بوراس، وهو عضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان LADDHوناشط ضدَّ استخدام تقنية التكسير المائي لاستغلال حقول النفط والغاز الصخري في الجنوب، تم اعتقاله من دون أية تهمة في بداية شهر نوفمبر 2015. وفي الوقت نفسه لا تزال الاحتجاجات العنيفة مستمرة من أجل كسب تأييد الأشخاص غير الممثَّلين في النظام السياسي الحالي.
في الثاني من شهر ديسمبر 2015 أدَّت محاولة تفجير مبنى تم بناؤه بشكل غير قانوني إبَّان الحرب الأهلية إلى ردود فعل عنيفة وغير عادية من قبل الشباب في منطقة درقانة الواقعة شرقي الجزائر العاصمة. حيث تسببت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بجرح العديد الأشخاص وأدَّت إلى اعتقال العشرات.
وفي الآونة الأخيرة باتت الاضطرابات الاجتماعية، التي لا يمكن التنبؤ بها، جزءًا من الحياة اليومية السياسية في الجزائر. غير أنَّ عدم القدرة على صياغة مطالب سياسية أوسع، وكذلك عدم التمكُّن من الاتِّصال بحركة عمَّالية صغيرة نسبيًا من حيث العدد وليست مستعدة كثيرًا للقتال، هي عوامل أساسية لعدم قيام معارضة اجتماعية حقيقية في البلاد.
ويبدو أنَّ كلتا المشكلتين لا تزالان من المشكلات الراهنة، على الرغم من أنَّ التعبئة الأخيرة لعمَّال مصنع الشركة الوطنية للعربات الصناعيةSNVIفي مدينة رويبة - وهي القلب النابض للصناعة الثقيلة التي دعمها في السابق الرئيس هواري بومدين - من الممكن أن تكون مؤشرًا يشير إلى أنَّ مستقبل الجزائر يَعِدُ بأكثر من مجرَّد تغيير في الصراعات الدائرة على السلطة داخل الجهاز العسكري.
عن موقع: "قنطرة"