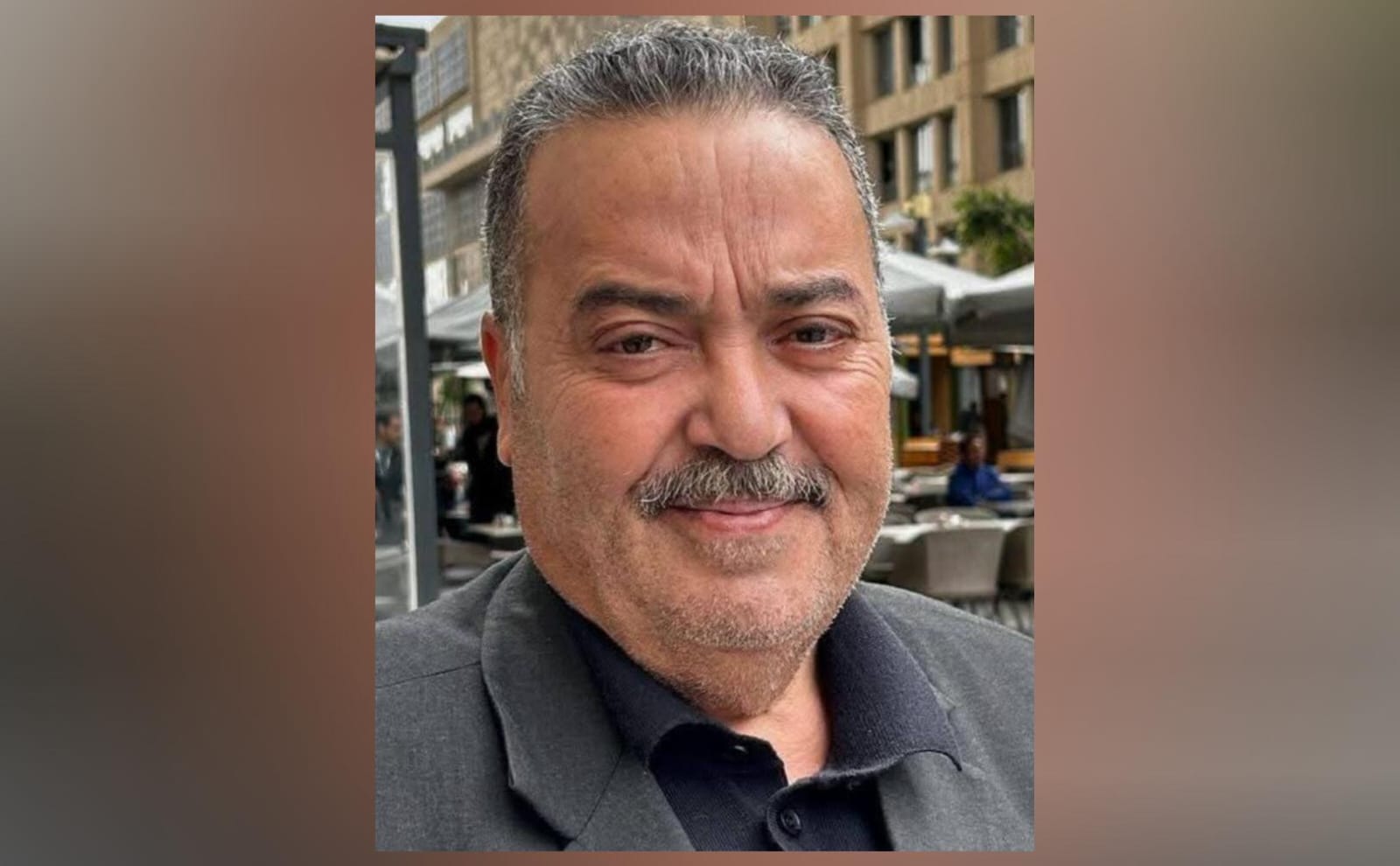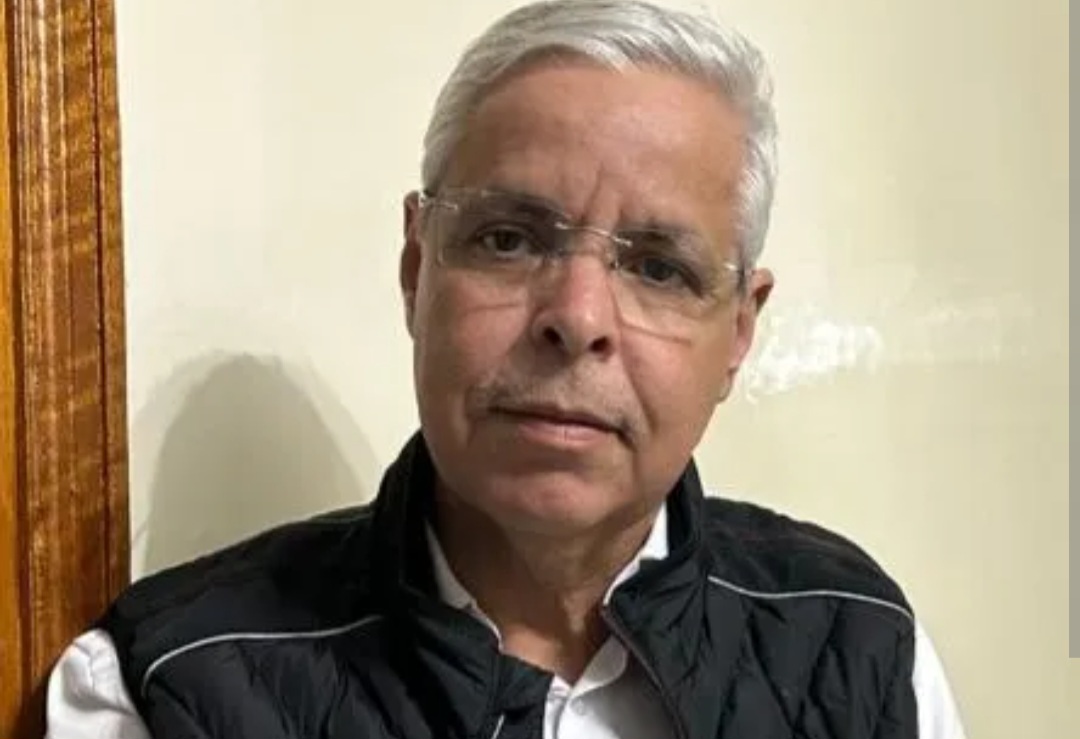تعاني المنطقة العربية حالة فراغ مزمن، فراغ القوة، فراغ القدوة، وفراغ الريادة، بتزامن أيضا مع انعدام مشروع إقليمي جامع وجاد. هذه المعاناة المتفاقمة ليست وليدة اليوم أو معطيات الفترة الراهنة فقط، وإنما هي متواصلة منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية، وتقاسم تركتها وفق اتفاقية سايكس بيكو في منطقة الهلال الخصيب، وغيرها من الاتفاقيات التي تكفلت بتوزيع مناطق نفوذ القوى الإمبريالية الأوروبية في أجزاء أخرى من العالم العربي لم تكن تابعة للعثمانيين.
ورغم أن الحقائق دامغة، والوقائع دالة على تواصل الفراغ وعمقه وجسامته، كان هنالك دائما في هذا العالم العربي من يكابر وينفي وجود الفراغ من الأصل أو يهون من شأنه استنادا على معطيات ظرفية واجتهادات فكرية تم تحميلها أكثر مما تحتمل، كما حصل مع التأويلات الكثيرة التي أعطيت للثورة العربية الكبرى بقيادة شريف مكة، ومع الآمال والطموحات التي علقت على فكرة القومية العربية عندما تسيدت المشهد الفكري العربي منذ أوائل القرن العشرين.
كانت مصر الملكية أول المكابرين في هذا المجال، تقدمت لملء الفراغ مستندة على ريادتها الثقافية والفكرية آنذاك. وحين أدركت حدود إمكانياتها وحتمية الاصطدام مع مصالح القوى الدولية الكبرى اكتفت بامتطاء مشروع هش غير ذي تأثير يذكر هو جامعة الدول العربية، التي سعت بريطانيا إلى تأسيسها للالتفاف على فكرة الوحدة العربية وإفراغها من أي محتوى إيجابي فيها.
استأنفت مصر في عهد الجمهورية محاولات ملء الفراغ من جديد، وهذه المرة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر، مرتكزة ليس فقط على الريادة الثقافية والفكرية، ولكن أيضا على وهج ثورتها والعداء الصريح لإسرائيل ومواجهتها ومن خلالها مجابهة القوى الإمبريالية الكبرى (عدوان السويس 1956)، إضافة إلى دعم حركات التحرر العربية والعالمية (الثورة الجزائرية، ثورة اليمن والتدخل العسكري المباشر فيه) والانخراط الفعال في حركة عدم الانحياز.
وبهذه الأوراق مجتمعة وسياسة إعلامية نشطة قادها آنذاك راديو صوت العرب استطاعت مصر الثورة استقطاب تعاطف جماهيري عربي واسع معها حتى داخل الدول، التي كانت أنظمتها على خلاف كبير مع نظام الرئيس جمال عبد الناصر. وقد مكنها هذا من انتزاع ريادة القومية العربية من الأحزاب التي تأسست في منطقة الهلال الخصيب على أساس هذه الفكرة (حزب البعث بمختلف فروعه وحركة القوميين العرب)، وبطمس بريق الأحزاب الشيوعية العربية، التي كانت أكثر نشاطا وتحركا وقتها.
ولم تكتف القاهرة حينها بهذه الخطوة، وإنما سعت إلى تأكيد حضورها الطلائعي القوي من خلال المساهمة في محاربة حلف بغداد، الذي انتهى مع سقوط النظام الملكي في العراق سنة 1958، ومن خلال تجسيد الوحدة المنشودة ولو جزئيا عبر إعلان الوحدة مع سوريا سنة 1958 فيما سمي آنذاك بالجمهورية العربية المتحدة التي ظلت الاسم الرسمي لمصر مدة تزيد على العشر سنوات بعد الانفصال الذي حصل سنة 1961.
إن هزيمة مصر وسوريا والأردن في حرب يونيو 1967 ستقبر كل محاولات المكابرة العربية المنشأ لملء الفراغ السائد في المنطقة، والذي ستزداد رقعته اتساعا مع خروج القوات البريطانية مما تبقى من إمارات الخليج سنة 1971، التي فشل شيوخها في تأسيس اتحاد الإمارات المتصالحة بعد أن فضلت قطر والبحرين الاستقلال التام، وتركت الإمارات السبع الأخرى تقرر مصيرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يمكن اعتبارها أول مشروع ناجح لفكرة الفدرالية في المنطقة العربية.
مقابل انهيار محاولات الريادة والقيادة المنفردة للمجموعة العربية والسعي للتأثير فيها، ارتفعت نغمة القطرية (بضم القاف وتسكين الطاء)، التي وصلت أوجها فكريا وإعلاميا في مصر أيضا زمن حكم الرئيس أنور السادات بعد انفراده بالصلح والسلام مع إسرائيل، واضطرار العرب إلى مقاطعة نظامه وطرده من جامعة الدول العربية، ونقل مقر هذه الأخيرة مؤقتا من القاهرة إلى تونس.
أحدث هذا التطور الذي لم يكن منتظرا بتلك الحدة مزيدا من التشرذم في صفوف الأمة العربية، وغذى العديد من النزاعات الثنائية التي كانت قد اندلعت بين أعضائها بدافع الهيمنة وبسط النفوذ، كما بدا واضحا من استمرار الجزائر في معاكسة المغرب في مسعاه لاستكمال وحدته الترابية واستعادة أقاليمه الجنوبية، ومن تواصل التوتر الجزائري الليبي، الذي اشتعل بعد تهديد الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين باجتياح تونس إن هي أقدمت على الوحدة مع ليبيا.
وقد كانت بوادر التشرذم في المشرق العربي أكثر عنفا ودموية، سيما بعد ما طرأ من تحولات على القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأردن إثر اعتراف القمة العربية بالرباط سنة 1974 بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وبعد تأجج صراعات جناحي البعث في كل من سوريا والعراق وتبادل الاتهامات بالخيانة بينهما، وبعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، التي زادها ضراوة الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وصراعات المخابرات العربية والدولية التي وجدت في لبنان أرض خصبة لتصفية حساباتها، خاصة بعد دخول القوات السورية سنة 1976 تحت غطاء شرعية قوات الردع العربية.
ساعدت هذه العوامل مجتمعة على اتساع معاناة المنطقة من الفراغ المهول الذي عاشته، ولم تستطع دبلوماسية قمم القادة التي تم اللجوء إليها منذ سنة 1964 من تجسير الفجوات التي أحدثها، واحتواء الصراعات المستترة والعلنية بين مختلف الدول العربية؛ الأمر الذي أسهم في انفتاح شهية إعادة إحياء مشاريع ريادة إقليمية غير عربية.
ولم يكن مستغربا أن تدشن هذه الخطوة إيران بعد نجاح ثورتها المتشحة بالدين الإسلامي، في سعي محموم إلى تجاوز دور دركي الخليج الذي لعبته بلاد فارس زمن حكم الشاه، وتحقيق ريادة الأمة الإسلامية جمعاء وفق ما جاءت به مقتضيات الدستور الجديد للجمهورية الإيرانية، التي جعلت ذلك تكليفا رسميا للسلطات.
ولمباشرة تنفيذ هذا المشروع الإقليمي الريادي لم يكن أمام إيران أسهل من توظيف العداء لإسرائيل، بغية إقناع العرب أو جزء كبير منهم بالاصطفاف وراءها، وعدم الشك في نواياها المذهبية والقومية الفارسية. وقد استهلت هذا المشروع بالاستيلاء على سفارة الدولة العبرية في طهران وتسليمها لممثلية منظمة التحرير الفلسطينية، وبإعلان العداء لأمريكا باعتبارها الشيطان الأكبر الداعم الأكبر للغطرسة الصهيونية، والاحتفال سنويا في آخر جمعة من شهر رمضان الكريم بيوم القدس العالمي كنوع من التعبئة وإبراز الريادة الإسلامية ولو من الناحية الإعلامية فقط.
خلف هذا الستار الذي أتقنت حياكته على مهل وبهدوء كما تحاك السجاجيد الإيرانية عملت طهران من خلال الحرس الثوري بهمة ونشاط على تأسيس ركائز عسكرية وسياسية وإيديولوجية لها على الأرض في العديد من الدول العربية مخترقة مواقع حصينة، ومسجلة انتصارات مذهلة بدوي إعلامي كبير، كما بدا ذلك واضحا في:
1/ تمكن حزب الله اللبناني ذراعها العسكري الذي أسسته ورعته منذ سنة 1982 والموثوق في أعضائه مذهبيا من إرغام إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان سنة 2000، ومد النفوذ الإيراني تبعا لذلك إلى الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وإلى تخوم فلسطين التاريخية.
2/ تزايد التأثير في القرار الفلسطيني عبر تمويل وتسليح حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة بشكل هدد بجدية في فترة من الفترات وحدة الشعب الفلسطيني، وأحرج العديد من الأنظمة العربية التي كان بعضها وما يزال يسعى لتعزيز شرعيته الشعبية بالدعم الذي يقدمه للقضية الفلسطينية.
3/ تطوير العلاقات مع سوريا ونقلها من خانة الشراكة المتكافئة زمن الرئيس حافظ الأسد، حيث تأسست على العداء المشترك لنظام صدام حسين في العراق إلى فرض وصاية ناعمة ثم سافرة على نجله الرئيس بشار الأسد، خصوصا بعد اندلاع الثورة السورية ضده في سياق ثورات الربيع العربي واحتجاجاته.
ومع ذلك، فإن بعض القوى الدولية ومعها بعض الدول العربية في منطقة الخليج وخارجه أيضا لم تقف مستكينة ولا متفرجة على إيران وهي تنفذ مشروعها. كانت هنالك محاولة إجهاضه في المهد مع إعلان العراق الحرب على إيران بإيعاز أمريكي ودعم خليجي سخي. حرب استنزفت البلدين معا لمدة ثماني سنوات اضطر معها الإمام الخميني إلى تجرع السم على حد قوله للقبول بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار، ولكن من دون التخلي عن مشروعه بالهيمنة على المنطقة بأسمال دينية.
وبالنظر إلى الضراوة التي انطلقت بها تلك الحرب، التي ارتدت بعدا قوميا عربيا ضد ما سمي حينها بالنزعة التوسعية الفارسية، كان واضحا أن دائرة الفراغ في العالم العربي ستتوسع بسبب تضاعف حجم الخلافات العلنية والمستترة داخل المنظومة العربية، حيث وقفت سوريا صراحة إلى جانب إيران، واستعرت الحرب الأهلية في لبنان بتأثير العداء العراقي السوري المتبادل والتدخل الإسرائيلي الذي انتهى بخروج فصائل المقاومة الفلسطينية من بيروت، كما نأت سلطنة عمان بنفسها عن موقف الدعم الكبير للعراق من طرف دول الخليج.
وطبيعي في أجواء متوترة كهذه ألا تضع دول الخليج بيضها في سلة واحدة، إذ تحسبا منها للمخاطر المحدقة من جراء هذه الحرب أعلنت سنة 1981 تشكيل مجلس للتعاون فيما بينها كخطوة لتوحيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومنتدى لتنسيق المواقف الخارجية والاستراتيجيات العسكرية متى كان ذلك ممكنا، كما تم الاستنتاج عندما تقرر إنشاء قوات درع الجزيرة.
وسريعا بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عادت طهران لتواصل مسلسل تنفيذ مشروع الهيمنة الإقليمية، معتمدة كثيرا هذه المرة على مبدأ التقية بالتقارب مع الدول الخليجية مستفيدة من الطعنة القاتلة التي وجهها نظام صدام حسين لهذه الدول بغزوه للكويت سنة 1990 وإعلان ضمها للعراق كمجرد محافظة إدارية. وقد ترجم هذا التقارب بعودة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية سنة 1992 (عادت العلاقات وانقطعت في يناير 2016) وعبرها مع دول أخرى كالمغرب سنة 1993.
ولكن هذا الدفء الدبلوماسي للعلاقات مع الدول العربية لم يردع إيران من مواصلة الاشتغال استخباراتيا على تجنيد أتباع ومريدين لأطروحاتها داخل العديد من الدول العربية وتجمعات الجالية العربية بأوروبا، وخاصة داخل التجمعات الشيعية العربية المتذمرة معظمها مما تسميه سياسات إقصائية تطالها في عدد من دول الخليج سواء أكانت تمثل أغلبية سكانية كحال العراق والبحرين أو أقلية كما هو الشأن في الكويت والمملكة العربية السعودية.
أبانت التطورات المتلاحقة بعد ذلك، أن إيران عززت مكانتها كعنصر أساسي في معادلات المنطقة، سيما وقد دفعت خصومها في المنطقة إلى موقع الدفاع عبر إثارتها لقلاقل أمنية داخل دولهم اعتمادا على موالين مذهبيا لها. وسيترسخ ذلك أكثر إثر استفادتها من الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 وإطاحة نظام صدام حسين لتخلفه في السلطة قوى سياسية شيعية تختلف علاقاتها بطهران بين الارتباط كما هو حال تيار مقتدى الصدر، وبين التبعية بالنسبة لحزب الدعوة الإسلامي بزعامة نوري المالكي، الذي تخلى مكرها عن السلطة. وقد مكنها كل ذلك من بلورة هلال شيعي متواصل جغرافيا من طهران إلى بيروت مرورا ببغداد ودمشق مثل هاجسا مؤرقا لدول الجوار العربي بصفة خاصة، ولإسرائيل أيضا.
وحدها ثورات الربيع العربي واحتجاجاته تمكنت من قض مضجع طهران ومنعها من المقايضة سياسيا بهذا الهلال، الذي تعرض لشرخ عميق، حيث لم يعد القرار في العراق كله بيد أتباع إيران، وانكفأ النظام السوري إلى المناطق المأهولة تاركا الامتداد الترابي على طول الحدود مع العراق ساحة صراع بين قوى المعارضة السورية المعتدلة من جهة ، وبين جحافل داعش من جهة أخرى، إضافة للمناطق التي تمكن أكراد سوريا من تحريرها، والشروع في بناء حكم ذاتي لهم بها إسوة بنظرائهم في كردستان العراق.
وبما أن الثورات والاحتجاجات العربية متواصلة منذ خمس سنوات، فقد ساهمت في مضاعفة حجم الفراغ المهول على الساحة العربية، الذي تستميت إيران في ملء جزء كبير منه بعد أن تكسر هلالها الشيعي في سوريا وبات مكلفا ماديا وبشريا، وبعد أن دخلت قوى أخرى إقليمية لشغل هذا الفراغ أبرزها تركيا، التي التفتت حديثا إلى عمقها في الشرق الأوسط عكس إيران التي تخوض في أتونه منذ عقود طويلة زمن الإمبراطورية وزمن الجمهورية الإسلامية.
ويعود الاهتمام التركي بالمنطقة إلى مطلع الألفية الثالثة منذ صعود حزب العدالة والتنمية ذي النفحة الإسلامية إلى سدة الحكم في أنقرة، وتبنيه ما أسماه سياسة العمق الاستراتيجي، بالسعي إلى تصفية كافة المشاكل مع الجيران عبر الحوار والتشاور والتعاون وتكثيف المشاريع المشتركة واتباع دبلوماسية نشطة، منفتحة وفاعلة بأدوات ناعمة وحركة اقتصادية واستثمارية وثقافية إيجابية بهدف إدماج تركيا في شؤون المنطقة لتصحيح ما يعتبره الحزب الحاكم خطأ تاريخيا ارتكبته تركيا الكمالية بالتخلي عن موقع السيد والند في الشرق لصالح موقع التابع والذنب في الغرب الأوروبي.
وقد تأتى لها ذلك إلى حد كبير، خاصة وأنها قد استطاعت أن تلعب بذكاء ورقة القضية الفلسطينية بالدخول في مواجهات دبلوماسية مباشرة ولكن محسوبة مع إسرائيل من دون التركيز على كشف الفشل العربي إزاء القضية كما تتصرف إيران. كما استطاعت أن توظف جيدا معارضتها للغزو الأمريكي للعراق سنة 2003؛ الأمر الذي ساعدها إلى جانب حيويتها الاقتصادية والثقافية من غزو عقول الكثير من المواطنين العرب وقلوبهم، والتوصل إلى إقامة حوار استراتيجي مع دول الخليج وإبرام العديد من اتفاقات التجارة الحرة في المنطقة العربية لعل أبرزها كانت مع المغرب.
ومباشرة بعد هبوب نسائم الربيع العربي وتصدر القوى الإسلامية، المصنفة في خانة الاعتدال ممثلة بالإخوان المسلمين ومن يدور في فلكهم، المشهد السياسي في معظم ساحات الحراك الشعبي، اعتقدت أنقرة أن الفرصة باتت مواتية لتسوق إقليميا نموذجها المرتكز على تعايش سلس بين القيم الإسلامية السمحة، وبين علمانية الدولة وديمقراطيتها.
وبديهي أن تستند أنقرة في ذلك على علاقات الثقة التي نسجتها الحركة الإسلامية التركية بمختلف المسميات التي اتخذتها على مدى سنين طويلة مع حركات إسلامية مماثلة لها في العالم العربي بدءا بالإخوان المسلمين في سوريا ومصر، مرورا بحركة النهضة في تونس وصولا إلى حزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوي في المغرب. ولم يكن مستغربا البتة أن يحظى التطلع التركي هذا بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية، التي لا تزال تعتقد أن الحركات الإسلامية المعتدلة وحدها القادرة على احتواء جنوح الشباب نحو التيارات المتطرفة والإرهابية.
وكما في حالة إيران، فقد استشعرت قوى عربية عديدة من دول ومؤسسات وتنظيمات أيضا، وفي وقت مبكر نوايا تركيا الريادية رغم نعومتها، وعدم اعتمادها على أقليات تابعة لها أو محمية من طرفها. ومن ثم بادرت إلى وأدها إن استطاعت أو تحجيمها قبل أن تتبلور وتكسب المزيد من النفوذ. وقد كانت أكبر ضربة موجعة للمشروع التركي هي الإطاحة عقب تحرك شعبي عارم بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بواسطة الجيش ومباركة وتأييد واضحين من بعض دول الخليج.
إن تلك الضربة إضافة إلى تراجع حركة النهضة التونسية انتخابيا، والفشل الاستراتيجي الذي منيت به في سوريا حيث لم تتمكن من الحصول على مباركة دولية أمريكية بالخصوص لرغبتها في إقامة مناطق آمنة كموطئ قدم لها هناك كانت من الدوافع الرئيسية التي أرغمت الرئيس أردوغان على إعادة النظر في طموحات بلاده الإقليمية، والبحث عن تحالفات تساعده على مواصلة لعب دور مؤثر في شؤون المنطقة ومستقبلها. وهذا ما يبدو قد وجده لدى المملكة العربية السعودية التي عقد معها تحالفا استراتيجيا ثنائيا وانضم إلى التحالف الإسلامي الذي أعلنت عن ميلاده.
وغير خاف على المتتبعين أن العالم العربي ظل عصيا دائما على محاولات إسرائيل الاندماج بشكل طبيعي في نسيجه، ولعب دور الريادة العلمية والاقتصادية والمالية على دوله رغم انتزاعها اعتراف كافة الأنظمة العربية بها بشكل مباشر عبر تبادل البعثات الدبلوماسية والممثليات التجارية والوفود المختلفة أو غير مباشر من خلال الجلوس إليها والتفاوض معها، ولكنها فشلت في التغلغل في الوجدان الشعبي وتحقيق ما كان يحلم به حاييم رامون وزير العدل الأسبق عن حزب العمل، وذلك برؤية مواطنين عرب يتجاذبون أطراف الحديث عن الدولة العبرية وكأنهم يتحدثون عن أي دولة عربية أخرى.
إن هذا الاستعصاء العربي على التسليم بريادة إقليمية غير عربية كان يجب أن يكون حافزا لبلورة بديل عربي جماعي بعد فشل المحاولات المنفردة لملء الفراغ المزمن الذي تغرق فيه المنطقة. إلا أن ذلك لم يحصل، فالجامعة العربية لم تبرح مكانها كسوق عكاظ سياسي والمجالس والاتحادات الجهوية بين مغلولة ومشلولة بشكل غابت معه أي مؤشرات عن بارقة أمل ولو ضئيلة في المستقبل المنظور.
وفي البحث عمن يقف وراء العجز الفاضح ينبغي التفتيش عن الثقة أو بالأحرى عن انعدامها، سيما وأن هذا الانعدام بات وباء مستشريا ليس فقط بين الدول والأنظمة، وإنما بين الشعوب وداخل الكيان القطري الواحد بين مختلف مكوناته ؛ الأمر الذي يؤهل حالة الفراغ لتغدو مزمنة، ومحاولات ملئها من القريب والبعيد مسترسلة مهما تم صدها.