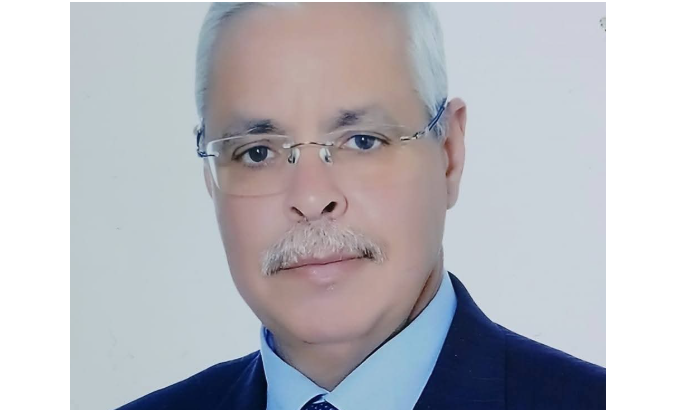إذا كانت الأشياء لا تعرف إلا بضدها، فيمكن المجازفة والقول بأن الأمر ينطبق على الرجال أيضا (والنساء، طبعا). فحينما نصف شخصا ما بأنه أمين أو شهم أو شجاع أو كريم أو صادق أو كتوم... أو لئيم أو حقود أو حسود أو غشاش أو خدَّاع أو غير ذلك من الأوصاف، فإنما لتمييزه عن غيره الذي يحمل صفة مغايرة (مضادة) لتلك التي يتصف بها هذا الشخص.
وتكتسي المسألة أهمية خاصة في العلاقات الاجتماعية وفي الحياة السياسة؛ ذلك أن الأحكام التي نُطلقها والمواقف التي نتخذها من هذا الشخص أو ذاك أو من هذه الجماعة أو تلك، إنما تكون محكومة بالصورة التي كوناها عنه (أو عنها) من خلال الملاحظة أو غيرها. وتأتي المصداقية على رأس الصفات الأساسية التي تميز هذا عن هذا (أو هذه عن هذه)، سواء في العلاقات الخاصة أو العامة. والمصداقية مشتقة من الصدق الذي يعني مطابقة الأفعال مع الأقوال (أو الأقوال مع الأفعال). وفي غياب هذه الخاصية، يصبح المجال مفتوحا أمام الكذب والغش والخداع وغير ذلك؛ وبالتالي، نصبح أمام انعدام الثقة؛ مما يؤثر سلبا على العلاقات ويُنتج مواقف وسلوكات ضارة بالمصلحة الفردية والجماعية. وقد ذم الله عدم تطابق الأقوال مع الأفعال بقوله تعالى: "كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون".
وتحضرني، هنا من تاريخنا القريب، صفة مقاوم (أي البطاقة التي تثبت هذه الصفة) التي حصل عليها البعض، بعد الاستقلال، زورا وبهتانا (إما بالرشوة أو بالنفوذ أو غيرهما) وحُرم منها البعض الآخر ظلما وعدوانا(إما انتقاما أو حسدا أو غير ذلك)؛ وقد مكنت هذه العملية بعض الخونة والجلادين من حمل صفة مقاوم وأصبحوا، بذلك، يُعدُّون من "المجاهدين الأبطال"(أبطال مزيفون طبعا، يستطيعون إخفاء زيفهم على بعض الناس)؛ في حين تم تجاهل كثير من المقاومين الحقيقيين؛ بل فيهم من تم تحويلهم، لحسابات سياسية، إلى خونة، رؤوسهم كانت مطلوبة في وقت ما. وقد خلَّف ذلك جراحا عميقة في الأشخاص كما في الجماعات (والأمثلة على ذلك كثيرة، خاصة خلال ما يعرف في بلادنا بسنوات الجمر والرصاص).
لكن ذلك لم يفت من عضد رجال (ونساء أيضا) صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا؛ ولا نزكي على الله أحدا. ومن هؤلاء الرجال الأستاذ "عبد الرحمان اليوسفي"، أطال الله في عمره، الذي لا تكتب اسمه إلا وتحضر صفة المجاهد، كما تحضر صفة الشهيد مع اسم "المهدي بن بركة" واسم "عمر بن جلون" و"محمد كرينة" وغيرهم من الذين قضوا في الصراع مع الاستبداد والتسلط والاضطهاد، دفاعا عن الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وتحتفظ الذاكرة الفردية والجماعية، إلى جانب الأسماء التي ذكرنا، بأسماء شخصيات سياسية بارزة أخرى، لا يمكن أن تذكرها (أو تتذكرها) دون أن يلح عليك أحد الألقاب الذي ارتبط بها، من قبيل أسد الريف بالنسبة لـ "محمد بن عبد الكريم الخطابي" والزعيم السياسي بالنسبة للأستاذ "علال الفاسي" والقائد التاريخي للاتحاد بالنسبة للأستاذ "عبد الرحيم بوعبيد"؛ وهلم جرا.
لكن حين نذكر اسم الأستاذ "عبد الإله بنكيران"، لا يلح على ذاكرتنا إلا قاموس تسكنه، إلى جانب بعض الأوصاف القدحية التي التصقت بهذا الاسم مثل الشعبوية والتهريج، التماسيح والعفاريت وغيرها من الحيوانات والمخلوقات غير المرئية التي أصبح لها مكان تحت قبة البرلمان وحضور في الخطاب الإعلامي والسياسي.
ويبدو أن السيد بنكيران قد فطن إلى الأمر، ففكر في عمل يخلد به اسمه مع الخالدين. وهل هناك أفضل من الموت في سبيل الله للوصول إلى هذا الهدف؟ وحتى يكون الاسم على المسمى، فقد انتقل الأستاذ "عبد الإله بنكيران"، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية، إلى الدشيرة الجهادية (لا ندري لما ذا تحمل هذا الاسم) بضواحي أكادير، ليعلن من هناك استعداده للموت في سبيل الله؛ وبذلك فقد استحق صفة "مجاهد"؛ وأصبح لزاما علينا، من الآن فصاعدا، أن نسميه المجاهد "عبد الإله بنكيران"، بدل "الشيخ" أو "الولي" التي كنا نتندر بها؛ وقد يكون، ربما، من الأفضل، أن نطلق عليه اسم الشيخ المجاهد والولي "عبد الإله بنكيران".
ودون إثارة الجدل حول هذا الاستعداد للجهاد، بالتساؤل، مثلا، ضد من؟ وللدفاع عماذا؟ وما هي مسوغاته؟، الخ، نبادر إلى القول بأن عبارة الموت في سبيل الله تعني، في لهجتنا المغربية، من بين ما تعنيه الموت المجاني (يعني"باطل")؛ بمعنى الذي لا مبرر له. ومع ذلك، فقد أصبح، منذ اللحظة التي أعلن فيها استعداده لتقديم نفسه قربانا الله، يشترك في صفة مجاهد مع الأستاذ "عبد الرحمان اليوسفي". وهو ما قد يجعله يشعر بالغبطة والرضا على النفس.
لكن، شتان بين جهاد الرجلين؛ إذ لا يمكن الجمع بينهما أو مقارنتهما إلا من باب التضاد. فبالرغم من كونهما تحملا نفس المهام السياسية (الكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي والوزارة الأولى في حكومة التناوب بالنسبة لليوسفي والأمانة للعدالة والتنمية ورئاسة الحكومة بالنسبة لبنكيران)، فإنه لا يستقيم أن نضفي صفة الجهاد على الرجلين دون أن نوضح ما تعنيه كلمة مجاهد المستعملة في حق كل منهما. فبقدر ما هي محملة برمزية وثقل تاريخي كبير حين نستعملها في حق رجل المقاومة وجيش التحرير ورجل النضال الديمقراطي، بقدر ما هي محملة بغير قليل من السخرية والهزل حين نطلقها على رجل تربى سياسيا في أحضان جماعات لا تؤمن إلا بالفكر الأحادي ولا تسعى إلا لنشر قيم الاستبداد والتسلط، بكل الوسائل بما فيها العنف المادي الذي قد يصل إلى التصفية الجسدية.
لقد انخرط عبد الرحمان اليوسفي، وهو في عقده الثاني، في العمل السياسي منذ سنة 1944 وشارك في تنظيم وإدارة المقاومة وجيش التحرير لمواجهة المستعمر بعد إقدام سلطات الحماية على نفي الملك محمد الخامس. وبعد الاستقلال، وجد نفسه في مواجهة الاستبداد والطغيان وفلول الخونة والإقطاع وأذناب الاستعمار؛ مما كلفه الاعتقال والمحاكمات والمنفى. لكنه ظل، مثل إخوانه في النضال، ثابتا على المبدأ.
ولما دقت ساعة الحقيقة وحصلت القناعة في أعلى هرم الدولة بأن البلاد على حافة الانهيار (السكتة القلبية) وأن لا مناص من اللجوء إلى "أعداء الأمس" لإنقاذها -بعدما تبين صواب تحاليلهم وصدق وطنيتهم، بالرغم من كل ما تعرضوا له من أصناف القمع والتنكيل- تم النداء على المجاهد عبد الرحمان اليوسفي بصفته الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وبنخوته المعهودة وأخلاقه الرفيعة، لم يساوم ولم يبتز الدولة (كما يفعل البعض) لقناعته وقناعة إخوانه بأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
انخرط اليوسفي في الجهاد الأكبر من أجل ليس فقط إنقاذ البلاد من السكتة القلبية، بل وأيضا من أجل تمنعيها اقتصاديا ومؤسساتيا ودبلوماسيا واجتماعيا... حتى لا تسقط من جديد في نفس الخطأ ونفس الخطر. ورغم أن صلاحياته الدستورية كانت محدودة وأن الائتلاف الحكومي كان يتكون من سبعة أحزاب، فقد استطاع الرجل، مع فريقه الحكومي، أن يحقق للبلاد في ظرف ولاية واحدة ما لم تحققه أية حكومة (باستثناء، ربما، حكومة عبد الله إبراهيم) في أكثر من ولاية لا قبل التناوب التوافقي ولا من بعده.
ورغم أن التجربة أُجهضت لعوامل ليس المجال هنا للخوض فيها، فإن تأثيرها الإيجابي على الأوضاع العامة في البلاد، رغم قصر المدة، لا ينكرها إلا جَحود. لقد أثبت اليوسفي بالملموس أنه رجل دولة بكل معنى الكلمة. لقد وضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الحزب. كما أبان عن علو همة وخلق سياسي رفيع؛ بحيث لم يعمل على تسويق منجزات حكومته حزبيا، وذلك احتراما لحلفائه. لكن المغاربة فهموا الدور الذي لعبه اليوسفي وإخوانه في الحزب وقدروا قيمة ما أُنجز، فبوئوا الاتحاد الاشتراكي المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لسنة 2002.
لكن ما وقع بعد ذلك أثَّر بشكل سلبي على التجربة الديمقراطية التي عرفت انتكاسة حقيقية بسبب ارتفاع نسبة العزوف عن المشاركة في التصويت؛ ويمكن أن نرى في ذلك نوعا من الاحتجاج على الخروج على المنهجية الديمقراطية (وهو ما دفع اليوسفي إلى اعتزال السياسة) أو نوعا من غياب الثقة في تجربتنا الديمقراطية ومؤسساتها أو عقابا للاتحاد الاشتراكي على استمراره في حكومة "جطو" الذي عُين وزيرا أول مكان اليوسفي أو غير ذلك من التفسيرات. لكن ما هو مؤكد هو أن العزوف عرف أعلى مستوياته في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 (رغم الخطاب الملكي الذي حث المواطنين على المشاركة في التصويت)، التي تراجع فيها الاتحاد الاشتراكي من المرتبة الأولى إلى المرتبة الخامسة.
وإذا كان هذا هو مسار المجاهد عبد الرحمان اليوسفي باختصار، فماذا يميز مسار "المجاهد" عبد الإله بنكيران؟ لقد تميزت خطواته الأولى في السياسة، وهو أيضا في عقده الثاني، بفترة تعاطف مع تنظيمات يسارية وتقارب من أحزاب الحركة الوطنية، قبل أن يلتحق بالشبيبة الإسلامية؛ وقد فعل ذلك مباشرة بعد عملها الإجرامي الذي حرم الحركة الديمقراطية والتقدمية، بل والبلاد كلها، من إطار وطني في أوج عطائه المهني والفكري والسياسي والإعلامي؛ إنه الشهيد عمر بن جلون. ويصعب أن نرى في هذا الانخراط شيئا آخر غير المباركة للعمل الشنيع الذي قامت به هذه المنظمة الإرهابية؛ فلا شك أن ذلك قد صادف هوى في نفسه؛ مما جعله يحسم التردد في الانتساب الذي كان يعيش فيه من قبل. وسيتأكد الأمر، بعد ذلك، بخروجه، هو و"الرميد" وآخرون، في مظاهرة احتجاجية ضد الأحكام التي صدرت في حق منفذي الجريمة التي ظل مدبروها خارج المتابعة.
وسوف يصبح "بنكيران"، في وقت وجيز، من قيادات التنظيم الإجرامي الذي اغتال الإطار الاتحادي البارز؛ كما سيترأس، في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، "الجماعة الإسلامية" التي انفصلت عن "الشبيبة الإسلامية". وسوف يستجدي، باسم جماعته، (ويستنجد بـ) أحد الجلادين الكبار والخبير "المبرَّز" في مجال إفساد الحياة السياسية والحزبية ببلادنا (وأعني به الراحل إدريس البصري)، في رسالة سرية (والتي أصبحت معلومة في المدة الأخيرة) للوزير القوي آنذاك، بقوله: "نأمل أن تتداركنا عناية الله على يدكم".
ولمن بعرف من هو "إدريس البصري" وما الدور الذي كان يضطلع به في البلاد التي أصبحت، في نهاية التسعينيات من القران الماضي، على حافة الانهيار، تكفيه هذه الجملة ليعرف من هو"بنكيران" وما هي التنشئة السياسية التي تلقاها؛ ولذلك، سوف لن يستغرب المواقف السياسية الحالية لرئيس الحكومة؛ فبالرغم من تغير الظروف وحدوث الحراك الديمقراطي الذي أثمر دستورا جديدا متقدما جدا بالمقارنة مع الدساتير السابقة، فإن عقلية "بنكيران" لم تتغير كثيرا وبقيت مطبوعة بالنزوع نحو الاستبداد.
المهم أن المسار السياسي للسيد "بنكيران" قد قاده إلى قيادة حزب العدالة والتنمية، حيث سيصبح أمينه العام سنة 2008؛ وبهذه الصفة عُين رئيسا للحكومة طبقا للمنهجية الديمقراطية التي حرص الصف الديمقراطي والتقدمي على أن يتم التنصيص عليها في دستور فاتح يوليوز 2011، تجنبا لما وقع في سنة 2002.
لكن هل تصرف، يوما، "بنكيران" كرئيس للحكومة؟ لا نعتقد ذلك. إنه لم يستطع التخلص من الجلباب الضيق لحزبه؛ وذلك لكونه مهووس ليس بخدمة البلاد، بل بالحفاظ على شعبيته وشعبية حزبه. إنه في حملة انتخابية دائمة منذ أن اعتلى كرسي رئاسة الحكومة. فسواء في لقاءاته مع وسائل الإعلام أو في البرلمان أو في تجمعاته الحزبية، همه الوحيد هو تسويق صورته وصورة حزبه وكأننا في محطة انتخابية لا متناهية.
ومن هو من هذا المستوى من التفكير لا يمكن أن تنتظر منه الشيء الكثير؛ بل لا يمكن أن تتوقع منه إلا الأسوأ، لأن ما يحركه هو النزوع نحو الاستبداد والاستفراد بكل شيء. لنُذكِّر، هنا، بمحاولاته، في بداية هذه الولاية، الجمع بين مهمته كرئيس للحكومة وبين مهمة المعارضة؛ مما يعني أن الرجل لم يستوعب مقتضيات الدستور الجديد ولم يع متطلبات المرحلة؛ أو هو يتغاضى عن ذلك لأن البناء الديمقراطي الحقيقي لا يدخل في حساباته.
وحتى يغطي ضعفه وفشله في مواجهة المشاكل الحقيقية للبلاد، باعتباره المسؤول عن تدبير الشأن العام، تجده يتنصل من مسؤولياته ويختبئ، تارة، وراء الملك وبشكل يفتقر إلى اللباقة والكياسة بحيث يقحمه في أشياء تمس بوضعه الاعتباري، وتارة أخرى، وراء نظرية المؤامرة، بأسلوب فرجوي لا علاقة له بالسياسة. ويستحق، في الواقع، أن ينال بطاقة الممثل على تشخيصه السيئ للمظلومية ولدور الضحية.
وبعد أن شعر بنهاية "صلاحية" التماسيح والعفاريت وغيرها من الكائنات الغريبة التي أدخلها إلى المشهد السياسي ليجعل منها أبطال العرقلة والتشويش عليه وعلى حزبه وحكومته، انتقل إلى ما هو أخطر، فأعلن "بنكيران"، صراحة، أنه مهدد في حياته من جهات، قال إنه لن يكشفها، وأنه مستعد للجهاد.
والأمر، في هذه النازلة، لا يخلو من شيئين، أحلاهما مر وكلاهما من الخطورة بمكان على صورة البلاد ومستقبلها: فإما أن رئيس حكومتنا لا يعي ما يقول ولا يستحضر خطورة كلامه وغرابة مواقفه؛ وإما أنه واع بذلك وأن ما يهمه هو استجداء العطف، ما دمنا في مرحلة التحضير للانتخابات وما دامت الحصيلة هزيلة إن لم نقل ثقيلة بسلبياتها. ولذلك، فلا بأس من استخراج جثة المرحوم "باها" لذرف الدموع (دموع التماسيح طبعا) وبعث الشك من جديد في ظروف الوفاة، رغم كل التقارير والبيانات السابقة؛ ناهيك عن إعلان الجهاد أو على الأقل الاستعداد له؛ مما يلوث المناخ السياسي في بلادنا ويقدم صورة سلبية عنها.
صحيح أن جهاد "بنكيران" هو جهاد بالقوة (بالمفهوم الفلسفي) وليس جهادا بالفعل كالذي مارسه عبد الرحمان اليوسفي، سواء ضد الاستعمار أو ضد الاستبداد أو ضد السكتة القلبية التي كانت تهدد المغرب في نهاية التسعينيات من القرن الماضي. لكن في كلام "بنكيران" ما يربك وما يبعث على القلق، خصوصا إذا ما استحضرنا موقفه القديم من اغتيال عمر بن جلون من قبل ما كان يسمى بالشبيبة الإسلامية التي "ورثها" بنكيران تنظيميا وسياسيا.
إن إقدام "بنكيران" على بعث الشك من جديد حول ظروف وفاة "باها" وادعاؤه أنه مستهدف في حياته من بعض الجهات وإعلانه الاستعداد للجهاد وغيرها من مواقف لا تليق بالرجل الثاني في الدولة، لهي مؤشرات غير مطمئنة إطلاقا.
وما هو مؤكد -حسب ما نعيشه وما نراه من ترد على مستوى حقوق الإنسان (بما فيها حقوق المرأة) والقدرة الشرائية للفئات العريضة من المواطنين (الفقراء وذوي الدخل المحدود) وإغراق البلاد في الديون الخارجية وتردي مستوى الخطاب السياسي، الخ- هو أن السيد بنكيران يسير بالبلاد نحو الكارثة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسيادية والدبلوماسية وغيرها.
ولن ينقذنا من هذا المصير لا استطلاعات الرأي المخدومة ولا الشعبية المزعومة ولا الضحك على الفئات الهشة بإيهامهم بأن الحكومة تعمل لصالحهم (بينما أصواتهم في الانتخابات المقبلة هي المستهدفة)؛ وحتى تخدع الجميع، تقوم باختيار بعض الفئات التي لا تمثل إلا النزر القليل من بين الذين يعشون الهشاشة كالأرامل، مثلا (وحتى لا يفهم من كلامنا بأننا ضد مثل هذه الإجراءات الجزئية التي تستفيد منها بعض الفئات، ننبه إلى أن ما نرفضه هو أن يُتخذ ذلك تبريرا للإجهاز على المكتسبات وتقديم ذلك على أنه إصلاح؛ هذا الكذب على الذقون هو الذي نرفضه) وتقدم ذلك كإنجاز كبير وكفتح مبين .
ومن المؤكد أن الهشاشة سوف تزداد لكون عدد لا يستهان به من الذين كانوا (أو هم الآن) يصنفون ضمن الطبقة المتوسطة، سيجدون أنفسهم في عتبة الفقر أو تحتها، بعد أن أعدمت الحكومة صندوق المقاصة (ولا تخجل أن تسمي ذلك إصلاحا) الذي كان يضمن استقرار الأسعار.
وقد فتحت حكومة الحزب الذي يدعي المرجعية الإسلامية، الباب على مصراعيه للبرالية المتوحشة لغرس أنيابها في الجسد النحيل والعليل للفئات المستضعفة من هذا الشعب الذي كان ينتظر الكثير من الذين عزفوا، خلال انتخابات 2011، (ويعزفون دائما) على أسطوانة محاربة الفساد (فإذا به زاد) وعلى الوتر الحساس الذي يدغدغون به عواطف المغاربة، في انتهازية مقيتة ومُقرفة؛ ألا وهو ديننا الحنيف الذي يتم استغلاله بشكل بشع.
ولا أريد أن أختم هذا المقال (وأختمه، في الواقع، بشكل تعسفي حتى لا أترك القلم يسيل بسبب ما أشعر به، كمواطن يحلم أن يكون المغرب يوما في مصاف الدول الديمقراطية والمتقدمة، من خيبة أمل -مع هذه الحكومة ومع رئيسها وحزبه- فيما يخص تعزيز البناء الديمقراطي لبلادنا وتحصين الاستثناء المغربي)، ما دام عنوان هذا المقال يحمل اسمين، تدل كل المعطيات على وجودهما على طرفي نقيض في كل شيء، لن أختمه، إذن، دون أن أشير إلى القضية الوطنية وإنجازات كل منهما في هذا المجال على المستوى الدبلوماسي. يعلم الجميع أن في الرصيد الدبلوماسي لـ "عبد الرحمان اليوسفي" ما لا يقل عن 25 دولة سحبت اعترافها بالجمهورية المزعومة بفضل تدخله واستثمار علاقاته. أما فيما يخص السيد "بنكيران"، فقد عرفت القضية الوطنية في عهده فترات عصيبة وهزات قوية؛ ولولا التدخل المباشر والصارم لملك البلاد، لكنا، الآن، في موقف لن نحسد عليه.