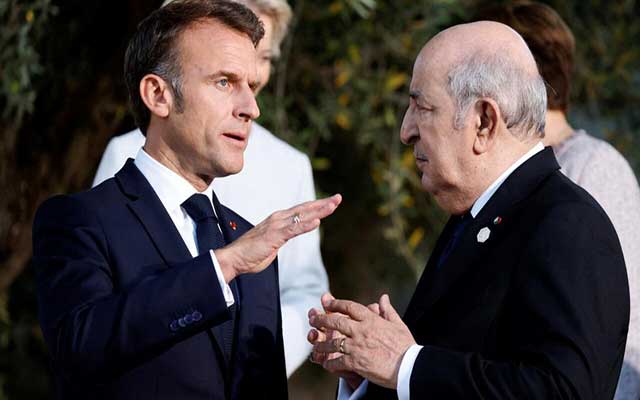من يطالع مضامين مباراة توظيف أطر التدريس عندنا يظن للحظة أنه أمام مشروع توظيف تربوي قوي، وأن الأمر متعلق بتقويم مهني في سياق ترقية، قبل أن يكتشف سريعا أن الأمر لا يعدو كونه عبثا بيروقراطيا، وان الاختبار " الغول" المرهق هو اختبار لمرشح يسأل عن عالم لم يدخله، بخطاب مهني غريب...خطاب يخلط بين مباراة تصب في التكوين ، وامتحان مهني كوظيفة، يفرز ترقية في سياق ما راكمه مدرس خبر الميدان.
المباراة العجيبة تبدو كأنها محاولة مرتجلة لالتقاط “شيء ما” في المترشح، دون أن يعرف واضعوها ما هو ذلك الشيء أصلا...
الأسئلة، بطابعها الملتبس والمعرفي التراكمي، تطلب من المرشح أن يتصرف كخبير، وأن يتحدث بلسان ممارس قديم، وأن يحفظ تفاصيل لا يعرفها إلا من عاش القسم فعلا... وكأن واضع المباراة يصرعلى اختبار “مدرس ” اختبارا مهنيا، في حين أن المطلوب في الأصل هو التقاط البذرة الأولى التي يمكن أن تنمى وتربى....
هذا الخلط يكشف عطبا أعمق: غياب تصور واضح عن طبيعة المرشح الذي نريد ليخضع للتكوين حتى نسلمه صناعة المستقبل... وليس بالضرورة من سهر الليالي، ليحفظ عن ظهر قلب، تعريفات لا تصنع " ملمح المدرس" واقتفاء التاريخ المعرفي التربوي عبر الوقوف على أعلام ومدارس مختلفة... سؤال انتقاء مرشح لمهنة التدريس هو سؤال مرتبط بالأبعاد النفسية والاجتماعية والتواصلية ثم القابلية للمهننة لا سؤال قياس الذاكرة و الاحتمالات خارج التكوين...
أي وعي إنساني نريد أن يتجذّر؟ أي حسّ تربوي نرجو أن ينمو؟ بدلا من ذلك، تُختزل العملية كلها في أسئلة سطحية معرفية لا تقوم الملمح المهني الممكن بل المدرس الجاهز ، فتحاول أن تقدّم فرضية الاحترافية على فرضية قابلية ممارسة مهنة مركبة المعطيات.. في الحقيقة هذه المباراة تكشف خوف المؤسسة من مواجهة السؤال الحقيقي: هل نعرف فعلا من هو “المرشخ” في زمن متغير؟
في التجارب الرصينة عبر العالم، القيمة لا تكمن في الامتحان ولا في التقنية، بل في القدرة على فرز الإنسان الذي يملك استعدادا داخليا ليكون مربيا قبل أن يكون ناقلا للمعرفة. ليس الإنسان الذي يحفظ مراحل الدرس، بل الذي يفهم لماذا يدرّس الدرس أصلا... ليس الذي يعدد الحصص الأسبوعية، بل الذي يدرك معنى الزمن داخل عقل المتعلم. ليس الذي يحفظ مرجعيات جاهزة، بل الذي يتساءل عن جدواها ويعيد تشكيلها مع الواقع.
الاختيار الحقيقي للمرشح لا يقاس بورقة ولا بتمرين، بل بملامح أعمق: قدرة على الإصغاء، حسّ إنساني يلتقط ما وراء الكلمات، مرونة فكرية تسمح له أن يرى الطفل قبل المقرر، ووعيا اجتماعيا يجعله يدرك موقعه في معركة الوعي والعدالة والمعنى. هذه أمور لا تختبر بالأسئلة، بل تقرأ ضمن شبكة تقويم مركبة، تستجلي طريقة تفكير المرشح، في لغته، في قدرته على ربط الفكرة بسياقها، وفي نظرته إلى دور المدرسة في المجتمع...
لكن مباراة التوظيف الحالية تحاول الإمساك بالدخان بيدين إداريتين. تريد أن تحدد “الجاهزية المهنية” بلمسة واحدة، بينما الجاهزية الحقيقية ليست وصفة ولا معادلة. هي القدرة على أن يكون المدرّس شاهداً على زمنه، وفاعلاً في حياة المتعلم، ورابطا بين المعرفة والإنسان. هي حسّ نقدي، وتواضع فكري، ووعي بأن التعليم ليس وظيفة… بل مسؤولية وجودية... وهذا لا يقاس بالأسئلة التراكمية، بل باختبار متعدد الملامح، ولا وزن فيه للمعرفة البيداغوجية... لأنها مهنة لا تلتفت للماضي، بل تحتاج لعقل متجدد كل يوم.
لذلك تبدو المباراة الحالية بلا روح. لا هي قادرة على تمييز الموهبة، ولا على التقاط الشرارة الإنسانية، ولا على السؤال عن العمق الذي يجعل المرشح ذا قابلية ليصبح مربيا: ولذلك الانحياز الفطري للتربية، وذلك القلق النبيل الذي يجعل صاحبه يرفض الجهل، وذلك الشغف بأن يترك في الآخر أثرا لا يزول.
فحين نفتقد هذا البعد، نصنع مباراة تصلح لاختيار كتبة، لا مربين. نختار من يجيد الإجابة، لا من يجيد الإصغاء. من يجيد الحفظ، لا من يجيد الفهم. من يجيد اتباع التعليمات، لا من يجيد طرح الأسئلة.
ولذلك كله، ما نحتاجه ليس “تقنيات انتقاء” جديدة، بل شجاعة السؤال: من هو المدرس الذي نريد أن يقف أمام أبنائنا؟ وما الذي يجعل إنسانا قادرا على أن يكون جسراًط بين العالم والطفل؟ حين نعرف الجواب، لن نحتاج مباراة تعجيزية، بل نظاما يرى الإنسان قبل النقطة.
المباراة الحالية جديرة بأن تكون امتحانا مهنيا للترقية، موجهة لمدرسين مارسوا حتى نضجوا، وليس لمرشح عليه أن يلعب دور المدرس والخبير ليعبر جاهزا معرفيا للتكوين.
خالد أخازي، كاتب وإعلامي