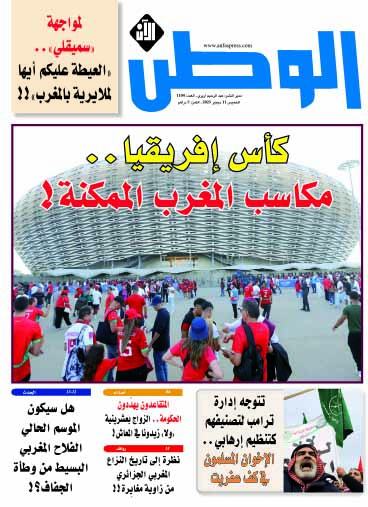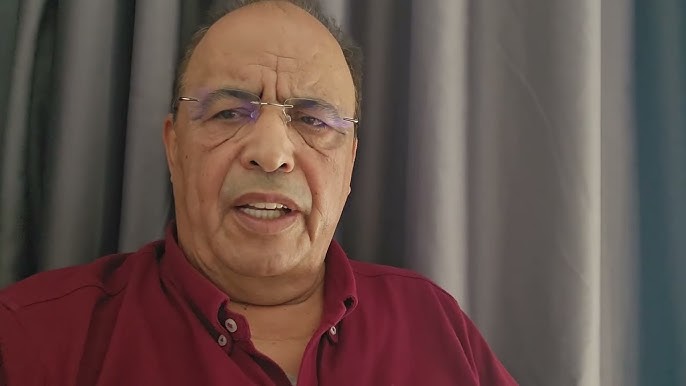تأتي هذه القراءة النقدية للدورية رقم 13440 باعتبارها أول محاولة لتنزيل القانون 25-14 في ظل غياب التنسيق مع وزارة المالية وتجاهل تجربة الخزينة العامة. الدورية تعكس تصورًا إداريًا أحاديًا لإصلاح يفترض أن يكون تشاركيًا ومؤسساتيًا. تسعى هذه القراءة إلى تفكيك مضمون الوثيقة، وتشخيص ثغراتها، وتحذير من هشاشة إصلاح بلا أدوات واضحة.
1. أزمة مؤسساتية ثنائية: نحو إعادة هندسة السلطة الجبائية خارج التوافق
تشكل دورية وزير الداخلية رقم 13440 الصادرة بتاريخ 5 غشت 2025 لحظة فاصلة في مسار إعادة تنظيم منظومة الجبايات المحلية، ليس فقط لكونها تسعى إلى تفعيل مقتضيات القانون 25-14 المعدّل والمتمم للقانون 47-06، بل لأنها تعكس تحولًا عميقًا في مراكز السلطة الجبائية داخل الدولة، يُنذر بخلخلة توازنات قائمة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.
ورغم أن الدورية تعلن ضمنيًا نيتها تعزيز كفاءة التحصيل عبر الاستفادة من تجربة قباض الضرائب التابعين للمديرية العامة للضرائب، فإنها تتجاهل بشكل تام الإشارة إلى الخزينة العامة للمملكة، المؤسسة التي راكمت تجربة طويلة في مجال التحصيل المحلي، والتي استطاعت، خاصة بعد صدور القانون 07.20، أن تطور آليات رقابة محاسباتية ناجعة أتاحت لها تفكيك شبكات التهرب الضريبي، لا سيما في الرسوم العقارية بالمدن الكبرى. كالديون المتعلقة بالرسم على الاراضي الحضرية غير مبنية
غياب التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية – كما يتضح من منهجية إعداد الدورية – يكشف عن تصور انفرادي لإصلاح من المفترض أن يكون مؤسساتيًا وتشاركيًا، الأمر الذي يعزز فرضية انزياح وزارة الداخلية نحو هندسة سلطوية مالية جديدة، يكون فيها الجهاز الترابي تحت وصايتها هو مركز الثقل الجديد في تدبير الجبايات، في قطيعة واضحة مع تقاليد المحاسبة العمومية القائمة على الاستقلالية الوظيفية والرقابة المندمجة ومبدأ فصل السلط بين الامرين بالصرف والمحاسبين العمومين
2. الرسم على الأراضي غير المبنية: تعقيد مُمَنهج يشرعن التهرب بدل محاربته
تُظهر القراءة الكمية لمحتوى الدورية أن أكثر من 34% من مفرداتها مخصصة للرسم على الأراضي غير المبنية (TNB)، وهو مؤشر بالغ الدلالة على الأهمية المالية والسياسية لهذا الرسم. لكن بدل أن يتم تبسيط المساطر وتحيين أدوات المراقبة، تقدم الدورية مقاربة معقدة ترتكز على تصنيف ثلاثي للمناطق حسب مستوى التجهيز (مجهزة، متوسطة، ضعيفة)، تُسند الجماعات مهمة تحديدها، رغم ما تعانيه هذه الأخيرة من هشاشة تقنية ومعلوماتية مزمنة.
ويُعد هذا التعقيد في التحديد الميداني لوعاء الرسم، في غياب قواعد دقيقة وشفافة للتقييم، آلية شبه مؤسسية لإضفاء طابع قانوني على الهروب من الأداء، حيث يمكن للوبيات الأراضي – خصوصًا في المدن الكبرى – المناورة داخل الفجوات التفسيرية التي تسمح بها هذه التعقيدات، وتقديم اعتراضات تؤجل الأداء، أو تعفي منه كليًا. وهكذا، يتحول التصنيف من أداة عقلنة إلى أداة تفكيك الوعاء الجبائي، مما يُحوّل الإصلاح إلى واجهة لإعادة إنتاج الفوارق الجبائية بدل الحد منها.
3. دورية تكرّر القانون بدل تفسيره: إخفاق في التأويل التنظيمي
تُعد الدورية رقم 13440 محاولة تنظيمية لإعطاء مضمون تطبيقي للقانون 25-14، إلا أنها – عوضًا عن أن تكون إطارًا تفسيريًا يذلل العقبات ويوجه الفاعلين المحليين – تحوّلت إلى إعادة سرد موسّعة لمواد القانون، دون أي اجتهاد تأويلي، أو تطوير إجرائي. وهو ما يُفرغها من مضمونها كمرجع إداري لتفعيل إصلاح بحجم الجبايات الترابية، ويُحول تنزيل القانون إلى عملية مفتوحة على التأويلات الفردية والتطبيقات غير المتجانسة.
ورغم أن الدورية جاءت في سياق مؤسساتي حساس، يتطلب إعادة بناء الثقة بين الإدارة المركزية والجماعات الترابية، إلا أنها أغفلت خمس قضايا محورية لم يتم تناولها بأي وضوح أو دقة، وهي: شروط وآليات تعيين القابض الجماعي وتوصيفه الإداري والقانوني؛ مصير الباقي استخلاصه وكيفية ترحيله وتوزيعه بين القابض الخزينة إلى القابض الجماعي المنشود؛ منهجية تسليم الملفات والتقارير من الخزينة العامة للجماعات؛ خصائص النظام المعلوماتي الجديد وكيفية تكامله مع الأنظمة الوطنية الأخرى؛ ثم غياب أي تصور حول الحوافز والتعويضات والمسؤوليات المالية والقانونية للمكلفين الجدد بالتحصيل أي القباض الجماعيون
4. القابض الجماعي: تأطير قانوني غائب ومساطر غير شفافة
ينص القانون 25-14 صراحة على أن القابض الجماعي هو محاسب عمومي، غير أن الدورية لم تُحدد طبيعة الشروط الإدارية أو المهنية التي تخول الولوج إلى هذا المنصب، ولم تُفصّل في تركيبة الملف، أو آليات الاقتراح من طرف الولاة والعمال. كما لم توضح الدورية طبيعة الدعم الفني والموارد البشرية التي ينبغي توفيرها لهذا القابض حتى يُؤدي مهامه بكفاءة، علماً أن المنصب يستوجب خبرة تقنية، وجاهزية قانونية، ومعرفة دقيقة بمساطر التحصيل والمراقبة، لا تتوافر غالبًا لدى الأطر الجماعية التقليدية.
5. الباقي استخلاصه: 40 مليار درهم خارج تصور الدورية
أحد أبرز الإغفالات التي تُضعف الدورية هو صمتها الكامل عن مصير الباقي استخلاصه الذي يتجاوز 40 مليار درهم. لم تحدد الجهة التي ستتكفل بتحصيل الديون الصادرة قبل 2026، ولا كيفية تقاسم الملفات بين القابض الجماعي وقباض الخزينة. هذا الغموض يُهدد بثنائية جبائية خطيرة، تُربك العلاقة بين المواطن والإدارة، وتفتح المجال لمنازعات قضائية بسبب التنازع في الصلاحيات أو إشكاليات التقادم والانقطاع عن المتابعة.
6. منظومة انتقالية غائبة: لا آجال ولا محاضر تسليم
لم تُحدد الدورية أي جدول زمني واضح لعملية تسليم الملفات الجبائية من قباض الخزينة إلى القابضين الجماعيين، كما غاب أي تصور لمحاضر التسليم، أو المعايير التقنية لمطابقة البيانات. في ظل غياب هذا التأطير، يُصبح تنزيل الإصلاح مرهونًا بمبادرات محلية قد تُفضي إلى اختلالات محاسباتية، وانقطاع في حلقات المراقبة، وتفكك في السلسلة المؤسساتية التي يفترض أن تحمي المال العام وتُؤمن استمرارية التحصيل.
7. النظام المعلوماتي الجديد: نسق رقمي موازٍ دون قابلية للتكامل
أعلنت الدورية عن إطلاق نظام معلوماتي خاص بتدبير المداخيل المحلية من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية، دون تقديم أي تفاصيل تقنية دقيقة حول بنيته أو مدى تكامله مع المنصات الوطنية الأخرى مثل نظام GIR المعتمد من طرف الخزينة العامة للمملكة، أو قواعد بيانات المديرية العامة للضرائب (DGI) والمحافظة العقارية (ANCFCC). ويزداد الغموض خطورة عندما نعلم أن هذا النظام سيكون مخصصًا لتحصيل الديون المحلية، وسيُعهد إليه بإصدار شهادات الإبراء الجبائي، في انفصال تام عن المنظومات الرقمية الوطنية. وإذا كان نظام GIR قد تطلب هيكلة مؤسساتية متكاملة تضم موارد بشرية متخصصة في نظم المعلومات، قادرة على العمل بمنطق التجريب المستمر والمرونة التقنية داخل وحدة رقمية متخصصة، فإن محاولة بناء نظام موازٍ دون هذا الإطار ستضيف تحديات جديدة إلى إشكالية نُدرة القابضين الجماعيين، من خلال الحاجة إلى كفاءات تقنية إضافية في مجال التدبير الجبائي الرقمي، ما يُنذر بإنتاج منظومة غير متكاملة، ويحول الرقمنة من أداة للشفافية والنجاعة إلى عبء تنظيمي جديد يعمق هشاشة الجماعات الترابية.
8. حوافز مهنية غائبة رغم جسامة المهام
يحمل القابض الجماعي مسؤوليات مالية ومحاسباتية معقدة، تشمل تحصيل الجبايات، تنفيذ إجراءات الحجز والتنفيذ، مواجهة الطعون الإدارية والقضائية، وتحمل التبعات القانونية لأي تقصير أو خطأ في التقدير أو المعالجة. ورغم جسامة هذه المسؤوليات، لم تتطرق الدورية إلى أي نظام واضح للتعويضات أو الحوافز، سواء من خلال التنصيص على تغطية قانونية أو تأمين مهني، أو منح مكافآت تُراعي طبيعة المخاطر المهنية. كما لم توضح ما إذا كانت التعويضات ستُحتسب على أساس نتائج التحصيل أو حجم الباقي استخلاصه، وهو ما يُعمق من غموض الإطار المهني. وتجدر الإشارة إلى أن تجارب المقارنة الدولية في المجال الجبائي تُبيِّن أن أغلب الجماعات الترابية لا تعتمد نظام مكافآت للمردودية لفائدة القابضين، نظرًا لأن صرف أي تعويض مرتبط بضرورة أن تُدبِّر الإدارة المعنية ميزانيتها بصفتها محاسبًا عموميًا، لا آمِرًا بالصرف، وهو ما لا يتوفر في الحالة المغربية، ما يجعل من الصعب تبني نموذج تحفيزي حقيقي دون تأطير قانوني دقيق.
خلاصة: إصلاح جبائي بتصوّر إداري ضيق وهندسة سلطوية بلا أدوات تنفيذ
تكشف دورية وزير الداخلية رقم 13440 عن تصور إداري عمودي لإصلاح جبائي يُفترض أن يكون مؤسساتيًا، تشاركيًا، ومؤسسًا لتحول نوعي في العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية. غير أن مضمونها، بدل أن يُقدّم خارطة طريق واضحة لتفعيل مقتضيات القانون 25-14، انزلق نحو إعادة صياغة للنص القانوني نفسه، دون اجتهاد تنظيمي، أو تدقيق في الأدوات، أو تفصيل في الضمانات. إن إصلاحًا بهذا العمق لا يمكن أن يُختزل في نقل مهام، أو استحداث منصب، أو تطوير برنامج معلوماتي، بل هو مشروع دولة يتطلب هندسة شاملة تُعيد توزيع السلطة الجبائية وفق منطق التكامل لا الصراع، وتُؤسس لإدارة مالية محلية مؤهلة، محصّنة، ومحفَّزة. إصلاح بدون إطار قانوني يحدد المسؤوليات، وبدون منظومات رقمية قابلة للتكامل، وبدون موارد بشرية مهيأة ومدعومة، لن يكون سوى وصفة لإعادة إنتاج الهشاشة، وتعميق فجوة الثقة، وشرعنة فوضى جبائية تُهدد التماسك المالي للجماعات.
د. سعيد بوحاج
باحث ممارس
باحث ممارس