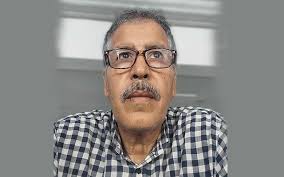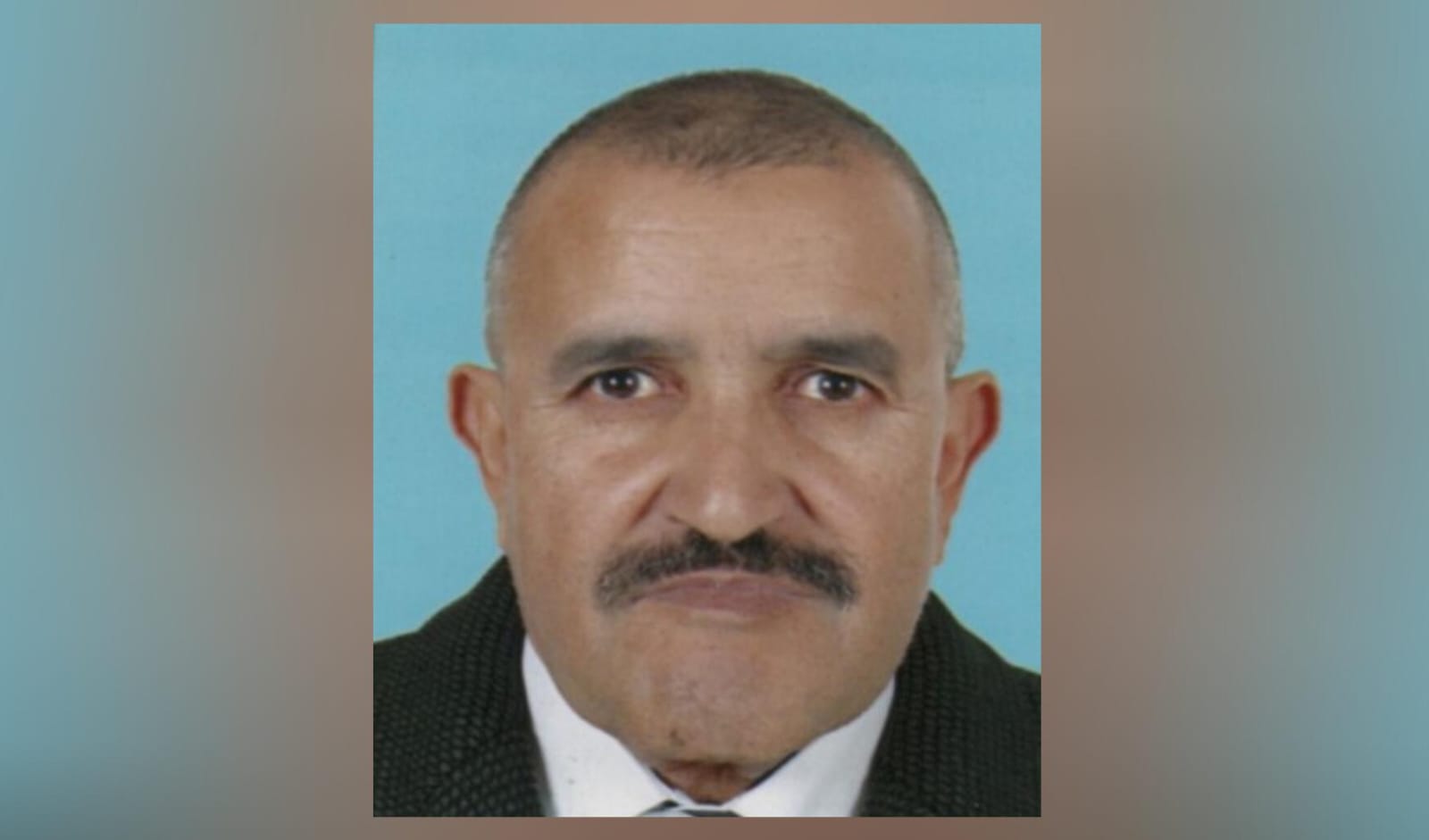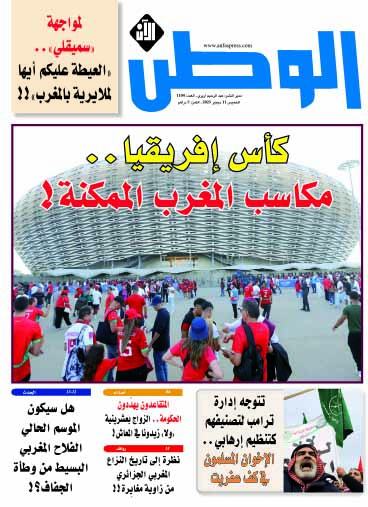قال محمد الخمسي، الأستاذ الجامعي، أن التصوف في الجانب العلمي ذو طبيعة خاصة تكشف عنه كتب التراث بالجمع بين الظاهر والباطن في الأفعال والأحوال، فالتصوف في الإسلام مسار روحي يركز على تزكية النفس والتقرب إلى الله من خلال العلم والعمل، حتى إن الصوفية ترى أن العلم والعمل هما جناحان يطير بهما السالك إلى الله، وأن التصوف ليس مجرد سلوكيات أو شعارات، بل هو تطبيق عملي للإسلام في جميع جوانبه الظاهرة والباطنة.
مداخلة الخمسي جاءت ضمن فعاليات مهرجان عيساوة بمكناس الذي اختتم مؤخرا.
وكانت مداخلة الخمسي تحت عنوان: "الأخلاق الصوفية في الحياة العلمية المغربية"، ضمن ندوة تندرج في إطار موضوع: "إمارة المؤمنين: الضمانة الروحية والدستورية للحقوق والحريات".
من هنا كانت مساهمة الخمسي في تناول التصوف وعلاقته بالعلوم المعاصرة، حيث اعتبر أهل التصوف السني أن العلم ضروري بل هو أساس التصوف، وأن السالك لا يستغني عن العلم في أي مرحلة من مراحل سلوكه، وأنواعه أي العلم لا يشمل فقط العقائد، وأحكام الشريعة، وأحوال القلوب، وأخلاق السالكين وما تميزوا بالحديث فيه العلم اللدني الذي يفيض على القلب من الله مباشرة دون واسطة، وهو ما يسمى بالعلم الباطني أو علم الشهود. ونحن في هذا العصر غارقين في علم الشهود وهو على ضروب حقيقية ومنها ما تعلق بعلوم عصرية حديثة إذ الحقائق فيها بالأثر والوقع على عالم المحسوسات والماديات دون أن يكون فيها الدليل إلا بالرموز الرياضياتية والقوانين الفيزيائية، ولا يقول عاقل بالدليل على مشاهدها بالحواس سواء اللمس أو الصورة، فلا يطالب أخد بصورة لحقل الجاذبية أو تصوير حقل مغناطسي، فعلوم الحقول THEORIE DES CHAMPS قائمة على التحليل للرموز و القوانين والاثار.
مما يجعل البشرية أمام مجال علمي غاية في التعقيد كل مفاتحه إشارات وعلامات وعلاقات لا نكتشف آثارها ونعرف كثيرا من أسرارها إلا من خلال الاشارات والعلاقات في عالم الارقام والقوانين وتخضع للمختبرات والرصد دون أن يكون لها وجود ملموس في كل مراحلها، وهذا جزء من الغيب باعتباره مغيب عنا. ليستعرض نماذج من علوم عديد سواء ما تعلق بنظرية الحقول في الفيزياء، أو العلوم الزمكانية، وعلوم الكوانتيك، وغير ذلك.
مداخلة الخمسي جاءت ضمن فعاليات مهرجان عيساوة بمكناس الذي اختتم مؤخرا.
وكانت مداخلة الخمسي تحت عنوان: "الأخلاق الصوفية في الحياة العلمية المغربية"، ضمن ندوة تندرج في إطار موضوع: "إمارة المؤمنين: الضمانة الروحية والدستورية للحقوق والحريات".
من هنا كانت مساهمة الخمسي في تناول التصوف وعلاقته بالعلوم المعاصرة، حيث اعتبر أهل التصوف السني أن العلم ضروري بل هو أساس التصوف، وأن السالك لا يستغني عن العلم في أي مرحلة من مراحل سلوكه، وأنواعه أي العلم لا يشمل فقط العقائد، وأحكام الشريعة، وأحوال القلوب، وأخلاق السالكين وما تميزوا بالحديث فيه العلم اللدني الذي يفيض على القلب من الله مباشرة دون واسطة، وهو ما يسمى بالعلم الباطني أو علم الشهود. ونحن في هذا العصر غارقين في علم الشهود وهو على ضروب حقيقية ومنها ما تعلق بعلوم عصرية حديثة إذ الحقائق فيها بالأثر والوقع على عالم المحسوسات والماديات دون أن يكون فيها الدليل إلا بالرموز الرياضياتية والقوانين الفيزيائية، ولا يقول عاقل بالدليل على مشاهدها بالحواس سواء اللمس أو الصورة، فلا يطالب أخد بصورة لحقل الجاذبية أو تصوير حقل مغناطسي، فعلوم الحقول THEORIE DES CHAMPS قائمة على التحليل للرموز و القوانين والاثار.
مما يجعل البشرية أمام مجال علمي غاية في التعقيد كل مفاتحه إشارات وعلامات وعلاقات لا نكتشف آثارها ونعرف كثيرا من أسرارها إلا من خلال الاشارات والعلاقات في عالم الارقام والقوانين وتخضع للمختبرات والرصد دون أن يكون لها وجود ملموس في كل مراحلها، وهذا جزء من الغيب باعتباره مغيب عنا. ليستعرض نماذج من علوم عديد سواء ما تعلق بنظرية الحقول في الفيزياء، أو العلوم الزمكانية، وعلوم الكوانتيك، وغير ذلك.
الحسيني: الحكمة والفضيلة
أما المداخلة الثانية التي تقدم بها عبد الواحد الحسيني بعنوان: "السلام الروحي والسلام الاجتماعي من خلال تعاليم المتصوفة"، فانطلقت من نص تاريخي هندي يزاوج بين الجمال والفكر، وهو كتاب "تعاليم المتصوفين" للموسيقار والشاعر الكبير حضرة عنايت خان، موحد الشرق والغرب على تعلّم كيفية إدراك الله. وهو عمل يقدم نظرة معمقة في عالم الصوفية، حيث يستكشف جوانب مختلفة من المعرفة الروحية والحكمة الصوفية، ويوجه القارئ نحو صفاء داخلي وتحرر روحي من خلال استكشاف تعاليم الصوفية وممارساتها.
أما المداخلة الثانية التي تقدم بها عبد الواحد الحسيني بعنوان: "السلام الروحي والسلام الاجتماعي من خلال تعاليم المتصوفة"، فانطلقت من نص تاريخي هندي يزاوج بين الجمال والفكر، وهو كتاب "تعاليم المتصوفين" للموسيقار والشاعر الكبير حضرة عنايت خان، موحد الشرق والغرب على تعلّم كيفية إدراك الله. وهو عمل يقدم نظرة معمقة في عالم الصوفية، حيث يستكشف جوانب مختلفة من المعرفة الروحية والحكمة الصوفية، ويوجه القارئ نحو صفاء داخلي وتحرر روحي من خلال استكشاف تعاليم الصوفية وممارساتها.
لقد حاولت الكلمة إبراز العلاقة بين الموسيقى والتصوف والفلسفة، إذ الحكمة هي التصوف، والمتصوف حكيم، لأن مسلك الكشف والفيض الإلهي والنظر يوصل إلى حقيقة واحدة، هي معرفة الله عن طريق معرفة الموجودات، مع اختلاف في الأحوال. فالحكمة والفضيلة تتجلى عندما يصحو القلب للحب والخير. كما حاولت التأكيد على أهمية الحب كقوة دافعة للنمو الروحي، وكيف يفتح الحب القلب والعقل للمعرفة؛ وكيف أن القداسة لا ترتبط بالمباني والأماكن، بل بإيمان الفرد وروحانيته، وبينت كيفية اتصال الصوفي بالله من خلال الحب والتقوى؛ المراحل التي يمر بها المتصوف في رحلته نحو العالم الروحي.

لتختم المداخلة بمسألتين في غاية الفرادة، الأولى معرفية في مفهوم الدين عند المتصوفة، والذي لخصته أطروحة خان في الحب الإلهي وعدم الإضرار بالآخرين، ومحاولة بناء الاتساق والتناغم مع الموجودات، لأن اللاتناغم يتعب الأفراد ويوقعهم في الضجر والقلق والغضب مما ينشأ عنه خصومات وصراعات وأذى. وأورد مقولة مهمة في سياق العلاج وهي عدم مقاومة الشر، مع الثبات على المبدأ كجلمود الصخر في البحر تنكسر عنده الأمواج. والثانية نفسية تتمثل في الرضا، وذلك عبر سعة الأفق، والنظر إلى النعمة على قلتها بالقناعة، فالعطاء الإلهي هو ما يصلح العبد لا ما يتمناه؛ فعندما يتراكم السخط وعدم الرضى في داخلك، فإن هذا سيترك أثره في نفسيتك، وعلى سلوكك.
هلالي: التربية النفسية الصوفية
وعرضت المداخلة الثالثة لعبدالإله هلالي لموضوع (أهمية التربية النفسية-الصوفية في الوقاية من التطرف الديني)، حيث سعت لإبراز أهمية التشبع بقيم التسامح والتعايش الديني في اكتساب روح المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. بهدف الوصول إلى المساعدة على التحلي بسمات المعتقد الصحيح والسلوك التديني العميق والمرن، من خلال التدريب الذهني والسلوكي والاستفادة من برامج التربية النفسية على تدين سليم، مستنبط من الخلاصات العلمية-النفسية ومن التجارب التربوية المتفق عليها في المسالك الصوفية المغربية والكونية؛ إذ للتعصب الديني الأثر الكبير في نخر الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي لكل الشعوب والدول الإسلامية بدورها تعاني من تأثير التعصب الديني والتطرف على التماسك الاجتماعي.
يعمل التطرف الديني والميول إلى السلوك الإرهابي على تشويه صورة الإسلام أمام العالم. حيث أصبحت المجتمعات الغربية تمارس ضغطا كبيرا على الجاليات الإسلامية، وتحد كثيرا من أنشطتها الاجتماعية ذات البعد الديني، نظرا لمخاوفها من تمظهرات التعصب والتطرف في النزوع نحو العنف والعدوانية، وخشيتها الكبرى من الإرهاب والأعمال التخريبية باسم الدين.
ونظرا لفشل المقاربة الأمنية في الحد من التعصب والتطرف الديني، وكذلك محدودية دور الفقهاء والمرشدين الدينيين في توجيه وتصويب أفكار المتطرفين نحو الفكر السليم، فقد تم تجريب تأسيس منهجية سيكولوجية مغربية تجمع علم نفس التدين، علم النفس الإكلينيكي وتقنية التربية-النفسية مع المرتكزات الأساسية-الأصلية للعقيدة الإسلامية وروح التربية الروحية المستمدة من المدارس الصوفية، وتهدف إلى إبراز أهمية التربية النفسية على التدين السليم واكتساب أفكار دينية مستنيرة، تستجيب لتطلعات الشباب العقائدية وتنسجم مع روح المجتمع المغربي.
فالتربية النفسية-الصوفية على الرحمة، والسلام، والتعايش والتسامح. كقيم إسلامية عليا تجعل من الفرد أكثر مرونة في أفكاره ومعتقده ومتقبلا لاختلاف أفكار الآخرين عنه.
البركة: وسطية التصوف المغربي
أما المداخلة الرابعة للدكتور محمد البركة فعرضت لموضوع، "الوسطية في التجربة الصوفية المغربية"، حيث ركزت على المدخل المفهومي للتصوف باعتباره متجذرا في التجربة المغربية قبل الإسلام وأثناءه، حتى إن التربة المغربية على مدى تاريخها الطويل لم تكن مفصولة عن الجانب الروحي والغيبي، ولعل هذا ما يفسر التداول المعلن للفظ الصلحاء والعباد قبل القرن الثاني الهجري وخلاله مع (صالح بن طريف المطغري أمير إمارة برغواطة، وصالح بن منصور أمير إمارة نكور، ..)، وظهور عدد من الكتابات تحمل في عنوانها اللفظ نفسه، مثل كتاب (المستفاد في مناقب العباد) للتميمي (ت.604هـ)، وكتاب (المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف) للبادسي (ت.722هـ) وغيرهما، ولعل قيمة هذا المعنى هو ما عبر عنه ابن الزيات (ت.627هـ) في كتابه (التشوف إلى رجال التصوف) حين قال: ((إنه لم يخل زمان من ولي من أولياء الله تعالى يحفظ الله به البلاد ويرحم به العباد))، قبل أن يعرض لصفة الأولياء ومحبتهم ومجالستهم وأحوالهم ...
أما المداخلة الرابعة للدكتور محمد البركة فعرضت لموضوع، "الوسطية في التجربة الصوفية المغربية"، حيث ركزت على المدخل المفهومي للتصوف باعتباره متجذرا في التجربة المغربية قبل الإسلام وأثناءه، حتى إن التربة المغربية على مدى تاريخها الطويل لم تكن مفصولة عن الجانب الروحي والغيبي، ولعل هذا ما يفسر التداول المعلن للفظ الصلحاء والعباد قبل القرن الثاني الهجري وخلاله مع (صالح بن طريف المطغري أمير إمارة برغواطة، وصالح بن منصور أمير إمارة نكور، ..)، وظهور عدد من الكتابات تحمل في عنوانها اللفظ نفسه، مثل كتاب (المستفاد في مناقب العباد) للتميمي (ت.604هـ)، وكتاب (المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف) للبادسي (ت.722هـ) وغيرهما، ولعل قيمة هذا المعنى هو ما عبر عنه ابن الزيات (ت.627هـ) في كتابه (التشوف إلى رجال التصوف) حين قال: ((إنه لم يخل زمان من ولي من أولياء الله تعالى يحفظ الله به البلاد ويرحم به العباد))، قبل أن يعرض لصفة الأولياء ومحبتهم ومجالستهم وأحوالهم ...

هذا وركزت المداخلة على التجربة الصوفية عند الشيخ أبي عبد الله محمد بن عيسى الفهدي السفياني (توفي سنة 933هـ)، الذي كان لتلقيه العلم بفاس وغيرها، وجلوسه للتدريس بالجامع الأعظم بمكناس وبمسجد الفتيان، ثم تحوله إلى أخذ مبادئ الطريقة الجزولية عن شيخه أحمد الحارثي بمكناس، ثم عن شيخه عبد العزيز التباع بمراكش، ليجمع بين الفقه والتصوف في غير انفصال، ولعل هذا ما دعاه إلى كتابة أوراد وأحزاب للذكر والدعاء لمورديه، طلبا للوسطية في غير تنطع ولا انحراف، بل في ارتباط وثيق بروحانية الإسلام الداعي للتوحيد الخالص، القائم على الصدق، يقول الشيخ زروق (ت.899هـ): ((من له نصيب من صدق التوجه له نصيب من التصوف، ... فلا تصوف إلا بفقه، ولا فقه إلا بتصوف، ولا هما إلا بالإيمان)). ليختم كلمته بالدعوة إلى إحياء الذكرى 500 لوفاة الشيخ الكامل خلال السنة المقبلة (1526- 2026) ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان عيساوة، بملتقى علمي دولي يبحث في الأبعاد العامة للطريقة العيساوية (الروحية، والعلمية، والتربوية، والاجتماعية، والتنموية، ..).
الشاوف: معاني ودلالات إمارة المؤمنين
في حين جاءت المداخلة الخامسة للدكتور أحمد الشاوف لتتناول موضوع (إمارة المِؤمنين: معاني ودلالات)، حيث تميز المغاربة منذ الدولة الإدريسية، باستقرارهم السياسي، وتوجههم السني الوسطي المعتدل، وبوحدة العقيدة، والمذهب، والسلوك، وهي الثوابت والخصوصيات الدينية التي ارتضاها المغاربة وأجمعوا عليها منذ قرون خلت.
في حين جاءت المداخلة الخامسة للدكتور أحمد الشاوف لتتناول موضوع (إمارة المِؤمنين: معاني ودلالات)، حيث تميز المغاربة منذ الدولة الإدريسية، باستقرارهم السياسي، وتوجههم السني الوسطي المعتدل، وبوحدة العقيدة، والمذهب، والسلوك، وهي الثوابت والخصوصيات الدينية التي ارتضاها المغاربة وأجمعوا عليها منذ قرون خلت.
ومن الثوابت إمارة المؤمنين التي ظلت نظاما ثابتا راسخا من ثوابت الأمة المغربية، وركنا من أركان وجودها، لا تستقيم حياتها إلا في ظله، ولا تطمئن القلوب إلا مع قيادته. فهي مصدر قوة وتوحيد وإجماع وتكامل ووحدة للمغاربة على مر العصور، ونموذج مغربي فريد، يقوم على المساهمة في بناء الدولة المغربية المدنية الحديثة القائمة على مرجعية الأمة في تدبير شؤونها العامة، وعلى ضمان الحقوق الأساسية للأفراد والمساواة فيما بينهم.
ومن الثوابت التصوف السني على مذهب السلف الصالح كالإمام أبي القاسم الجنيد المتوفى سنة 297هـ. والتصوف ليس مذهبا قائما على حدود ضيقة أو أصول أو قواعد محدودة، ولا هو علم ذو حدود خاصة وموضوعات معينة، وإنما هو سلوك ومعاملة وزهد وعبادة، وعزوف عن الدنيا وإقبال على الله، وتميزت مصنفات فقهاء المالكية باشتمالها على مقدمة في الاعتقاد وأصول الدين، ثم أحكام العبادات والمعاملات، ثم الآداب والأخلاق الإسلامية ومحاسن الشريعة ومكارمها وفضائلها وقيمها، فيما يصطلحون عليه بالجامع في ختام مصنفاتهم، ليكون ذلك غذاء للقلب والروح.
الفلوسي: عناية السلاطين بالتصوف
أما المداخلة السادسة للدكتور أحمد الفلوسي فقدمت صورا عن (عناية سلاطين المغرب بالتصوف)، مركزة على ظهائر التوقير والاحترام الصادرة في حق الأولياء وذويهم بداية من عصر بني مرين، وبخاصة زمن السلطان أبي الحسن، لما استوى علم التزكية على سوقه واستقل عن مشاربه المشرقية، مرورا بعهد الدولة السعدية التي احتفى سلاطينها بالزوايا وأهل الله أيما احتفاء، حتى إن بعض ملوكها سلكوا طريق القوم ولبسوا خرقة التصوف مثل السلطان عبد الله الغالب والسلطان أحمد المنصور الذهبي وغيرهما، وازدادت الرعاية بالطرق الصوفية مع سلاطين الدولة العلوية من خلال إصدار ظهائر سلطانية شريفة سواء تعلق الأمر بالإشراف على مؤسسات التصوف وتدبيرها، أم ارتبط بظهائر التوقير والاحترام للسادات والأولياء وذويهم، أم بظهائر الإنعام بالهبات والمنح والتحرير من الكلف المخزنية.. واستمرت هذه العناية السابغة بالتصوف وأهله من عهد السلطان مولاي إسماعيل مؤسس الدولة إلى يوم الناس، وما اجتماعنا على مدار يومين في إطار هذا الملتقى الدولي الأول إلا مظهر جلي للاهتمام والحفاوة التي يلقاها علم التزكية بطرقه وزواياه ورموزه في كنف دولة العلوية وملوكها الأماجد، ليقينهم التام بأن التصوف معين لا ينضب، وضرورة روحية تربوية وسلوكية، لا بد من التوسل بها لعلاج مشكلات العصر، وإيجاد الحلول المناسبة لأزماته الخانقة.
محداد: التصوف والأمن الروحي
لتختم الجلسة بمداخلة الدكتور فؤاد محداد الموسومة بـ(التصوف وأثره في تحقيق الأمن الروحي بين المدارسة والممارسة)، حيث عرض في البداية للعلاقة الوطيدة بين التصوف والتزكية الروحية، إذ هما مصطلحان لمسمى واحد، فالتزكية وظيفة نبوية بنص التنزيل وهي إحدى الوراثات النبوية، إذ العلماء ورثة الأنبياء: فمنهم من ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم الفقه، ومنهم ورث القراءات القرآنية، ومنهم من ورث التزكية ... وهي كلها تخصصات دقيقة تُطلب عند أهلها، فلكل دائرة علمية، ولكل حقل معرفي أو عرفاني أعلامه الذين برزوا فيه.
وهذا المسلك في التلقي يعتبر من الأمن العلمي والمنهجي؛ لأن من معاني الأمن أن يتكلم المتكلم فيما يحسنه ويحذقه. لذلك كانت معاني الأمن متعددة، من جملتها بل في مقدمتها الأمن الروحي، وهو تخصص نبغ وبرز فيه أهل التصوف، فالتصوف والأمن الروحي وجهان لعملة واحدة. ومن المتفق عليه أن الأمن الروحي لا يدرك بمجرد المطالعة والمدارسة؛ وإنما يُنال بالممارسة بصحبة الكُمّل، فمن جالس جانس:
والروح كالريح إن مرت على عطر ** طابت وتخبث إن مرت على الجيف
والتصوف تربية روحية، وتهذيب للنفس البشرية من رعوناتها وشهواتها، ومعالجة الأمراض النفس الظاهرة والباطنة التي عقدتها مسيرة الحياة، وطبيعة العصر، وهو زكاة وطهارة تروم تحقيق الأمن الروحي، الذي يعتبر ضرورة تربوية، تنشد طلب ما عند الله ((ما عندكم ينفذ وما عند الله باق)).