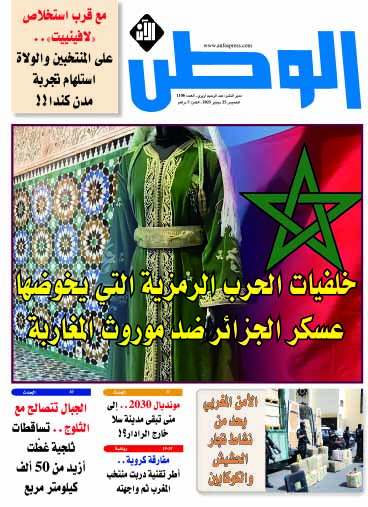توصلت "أنفاس بريس " بمقال مم طرف توفيق مفتاح، مفتش تربوي، يتطلب فيه إلى كشكل الاعتداءات المتكررة ضد الأساتذة من قبل التلاميذ. وهي الظاهرة التي يؤكد العديد من المراقبين أنها في حالى تزايد مستمر. وفيما يلي نص مقال المفتش توفيق مفتاح.
" أود أن أعبّر عن استنكاري لفعل الاعتداء الشنيع الذي أدى إلى مقتل المرحومة الأستاذة هاجر بمدينة أرفود، كما أعبر عن تضامني الإنساني والمهني المطلق مع كل من يتعرض لأي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء من أي جهة كانت، داخل المؤسسات التعليمية والتكوينية أو خارجها. وأغتنم الفرصة لتقديم خالص التعازي والمواساة لأسرة الأستاذة الفقيدة، شهيدة الواجب المهني.
تعلمون أن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي المغربي أصبحت تتنامى خلال العقود الأخيرة، وأضحت تشكل مصدر قلق متزايد بسبب تأثيرها السلبي على البيئة التعليمية والسلامة النفسية والجسدية للتلاميذ ولكافة الأطر التربوية والإدارية، سواء من خلال الاعتداءات الجسدية واللفظية بين التلاميذ، أو العنف الرمزي والاجتماعي، وأحيانا باحتكاكات ومواجهات بين التلاميذ والأساتذة والإدارة، تترتب عنها جروح وأضرار بدنية ونفسية.
ومن المؤكد أن كل الأفعال والممارسات الناتجة عن العنف لا يمكن البتة تبريرها، وهي مرفوضة كليا، خاصة في مجتمعات تحمل قيما تعلي من مكانة الأب والأم والمربي والمعلم. فالمجتمع المغربي، مثل العديد من المجتمعات ذات الجذور التاريخية والثقافية العميقة، يحمل تصورات وقيما راسخة حول الأدوار الاجتماعية للمعلم، تقدم المربي في صورة الوالد والمعلم والعالم والفقيه الذي يتمتع بهالة من القداسة والاحترام. هذه الصورة هي نتاج تفاعل معقد بين العوامل الدينية والاجتماعية والتاريخية التي شكلت الذهنية الجماعية المغربية عبر القرون.
وأذكر هنا العبارة الشعبية الشائعة “اللي ربّاك، أكبر منك”، أو “الوالد يُربّي، والمعلم يُؤدب”، التي تعكس تقديس دور القائم على التربية في المجتمع المغربي. ورغم بقاء هذه الصورة رائجة، إلا أنها تواجه تحديات وتخضع اليوم لإعادة تشكيل تحت ضغوط الحداثة والعولمة والتطور الرقمي والتكنولوجي، وفي مواجهة التحولات الاجتماعية العميقة، مع صعود النموذج الفرداني، وتقلص كل أشكال السلطة الأبوية، وظهور خطابات تطالب بإعادة النظر في السلطة المطلقة للمربي، خاصة في قضايا مثل التأديب التربوي.
فالتعليم الحديث حول دور المدرس من “مربٍّ قدوة“ إلى “موظف“ في نظام تعليمي بيروقراطي، أضعف هيبته التقليدية. لكن تظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية مثل التفكك الأسري، والهشاشة النفسية للمراهقين، والتعرض للعنف خارج المدرسة، من العوامل المنتجة لهذا العنف. كما أن انتشار المحتويات العدوانية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض التلاميذ المفرط لمشاهد وصور التعنيف بالمجتمع، يقلل باستمرار من حساسيتهم تجاه التصرفات العنيفة في الواقع. والأخص، الانتشار الواسع لمقاطع فيديو على وسائل التواصل تُظهر تلاميذ يستهزئون بالمدرسين أو يهاجمونهم، مما يعمّق إشكالية تحقير مؤسسة المدرسة وإهانة رموزها. لعلها معطيات تحيلنا إلى تأثير التكنولوجيا على سلوك وقيم الناشئة، وحاجتهم الشديدة إلى الاستقطاب والإثارة وشد اهتمام المحيط والمجتمع، وهو بمثابة جواب على التهميش والحرمان الذي يعانون منه، ورغبة منهم في تحقيق ذواتهم بصيغ أخرى حتى ولو كانت غير مشروعة.
هذه الممارسات تُحفز على انتشار العنف، في غياب آليات اجتماعية للتأطير التربوي والنفسي والأخلاقي، وضعف قنوات التواصل والحوار والتوجيه والإرشاد داخل الأسرة والمؤسسات التعليمية. وأمام حالة الإحباط لدى فئات واسعة من التلاميذ، خاصة في مواجهتهم لصعوبات التعلم، والفشل في متابعة الدراسة، وضغط الالتزامات المدرسية، في غياب برامج وآليات حقيقية وفعالة لمواكبتهم نفسيًا ودراسيًا.
إن انتشار العدوانية والعنف في الوسط المدرسي لا يمكن فصله عن السياق العام للمنظومة التعليمية المغربية، التي تعاني من تحديات هيكلية وبنيوية متعددة، من تراجع لجودة التعليم، واكتظاظ في الأقسام، مما يصعّب على المدرس بناء علاقة فردية ناجحة مع أزيد من أربعين تلميذًا في القسم الواحد، مما يزيد من صعوبات التواصل وسوء الفهم والاحتقان السريع في العلاقات.
تضخم هاجس الرفع من مؤشرات التعلم على حساب الاهتمام بتحسين مؤشرات التربية والارتقاء بالقيم، جعل المؤسسات التعليمية والتكوينية تتراجع عن أدوارها التربوية، وأصبح تركيز المنظومة التعليمية منصبًا على إجراء الامتحانات وتحقيق أعلى النقط والمعدلات التي تفتح آفاق الترقي الاقتصادي، أكثر من التربية على القيم أو السلوك، مما حول المدرسة إلى فضاء تنافسي عدائي.
هذا، فضلًا عن غياب الاهتمام بتطوير وتقوية مهارات الأطر التربوية والإدارية في إدارة الصراعات والتربية الإيجابية لمواجهة الصعوبات المهنية ذات الصلة بالتحديات الثقافية والاجتماعية، ومشكلات التهميش المدرسي، خاصة ضعف الإنصاف والتفاوتات الصارخة في فرص التعليم بين القطاعين العام والخاص، والوسط الحضري والوسط القروي، وأحيانًا كثيرة بين أحياء ومناطق داخل نفس المدينة.
إن تلاميذ اليوم لم يعودوا منعزلين عن معرفة ما يجري في محيطهم وفي العالم، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرارهم النفسي ونظرتهم للمحيط وللمدرسة والمجتمع، أمام ما يواجهونه من مخاوف وتهميش وتحديات.
إن حادثة الاعتداء على الأستاذة هاجر تعد انعكاسًا لأزمة أعمق، وليست حادثًا معزولًا، بل هي نتيجة تراكم لعدة عوامل، أبرزها انهيار هيبة المدرس، وتراجع مكانته الاجتماعية، خاصة بسبب تزايد أشكال العنف الرمزي واللفظي والمادي تجاهه في المجتمع.
ومعلوم أيضًا أن تفكك العلاقات البيداغوجية في مؤسسة المدرسة، أدى إلى انفراط عقد الثقة بين المدرسة والتلميذ والأسرة والمجتمع، حيث تحولت المدرسة من فضاء للتعلم والحوار إلى ساحة للصراع بين التلاميذ والمدرسين، وأحيانًا بين المجتمع والمدرسة، في ظل ضعف آليات الحماية المهنية، وعدم وجود أنظمة فعالة ووقائية أو إجراءات سريعة لحماية الأطر التربوية والإدارية من الاعتداءات.
أصبحنا نعاين حالات تهرب كثير من المدرسين من التدخل أمام أشكال كثيرة من العنف التي تُمارس عليهم، خوفًا من المواجهات أو الاتهامات، كما أن بعض المدرسين يفضلون عدم توبيخ التلاميذ حتى لو أخطأوا، مما أفقد المدرسة دورها التربوي. في الوقت الذي لم تعد تشارك الأسر في تربية وتأديب الأبناء، معتبرة أن المدرسة هي المسؤولة أساسًا عن التربية، وترفض في الوقت ذاته أي إجراءات تأديبية لهم، بل تتدخل أحيانًا لتحميل المدرس أو المؤسسة التعليمية مسؤولية المشاكل التي يواجهها أبناؤها، بدلًا من تحمّلها المسؤولية التربوية إلى جانب المدرسة.
مما أضعف الاحترام والتعاون المتبادل بين كل الأطراف، وسرّع في تراجع قيم الاحترام والتعاون في المجتمع عامة، وانعكس ذلك على سلوك التلاميذ.
إن مختلف ممارسات العنف التي تحدث داخل المجتمع المدرسي ليست مجرد “حوادث عابرة”، بل هي نتيجة لتراكم إخفاقات المنظومتين التعليمية والاجتماعية، التي تحتاج معالجتها إلى أفق استراتيجي ومخطط وطني عاجل يُعيد للمدرسة دورها كفضاء للتعلم والاحترام، مع معالجة الأسباب العميقة للعنف، من هشاشة اجتماعية وغياب لسياسات عمومية وقائية، التي بدون إصلاح حقيقي لها، قد تتكرر مثل هذه الأحداث المأساوية.
فالحاجة ملحة جدًا لتعزيز التربية على القيم، وإشراك فعلي للأسرة في مؤسسة المدرسة، مع تفعيل دور جمعيات الآباء والأمهات، وتحسين البنى التحتية للمؤسسات التعليمية، بتوفير فضاءات آمنة، وأنشطة لتخفيف التوتر العاطفي والنفسي، وضبط انفعالات التلاميذ، باستيعاب طاقاتهم الفكرية والإبداعية وتحقيق مختلف احتياجاتهم الإنسانية والعاطفية، وإشباعها معرفيًا وثقافيًا وقيميًا، وذلك بخلق التوازن المطلوب بين المعارف والقيم والمهارات والحقوق والواجبات.
إضافة إلى اعتماد قوانين رادعة تُطبق عقوبات واضحة على كل ممارسي العنف بالمدرسة، مع التركيز على التربية والإصلاح والتنشئة الاجتماعية والإنسانية، وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس، وتقوية مهارات كل الفاعلين في المؤسسات التعليمية على إدارة الصراعات والتعامل مع السلوكيات والممارسات العدوانية.
ظاهرة العنف في المنظومة التعليمية المغربية تتطلب مقاربة شاملة تعالج الأسباب الجذرية، عبر مراجعة للسياسة التعليمية، تؤسس لإعادة بناء الثقة بين المدرسة والمجتمع، وبتضافر جهود المدرسة والأسرة والمجتمع، خاصة الإعلام. تسمح بتحويل المؤسسة التعليمية إلى فضاء للحوار والاندماج الاجتماعي والثقافي، بدلًا من إطار للصراع والمواجهة، لضمان تعليم جيد وآمن للجميع.
لا شك أن تفكك العلاقة التربوية داخل الوسط المدرسي ليس حتميًا، لكنه يتطلب إرادة سياسية ومجتمعية. فالمدرسة يجب أن تعود مؤسسة تربوية قبل أن تكون جهازًا لاستصدار النقط والمعدلات أو مجرد نظام للامتحانات المدرسية يُكرّس التفاوتات الاجتماعية والطبقية، وأن تتحول إلى منظومة تربوية تُركز على بناء الإنسان، قبل إنجاز البرنامج الدراسي."