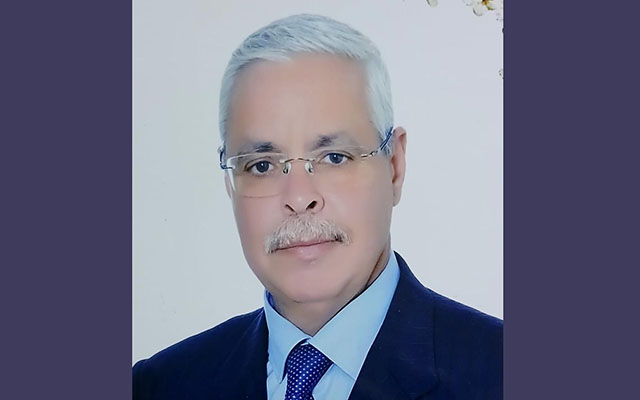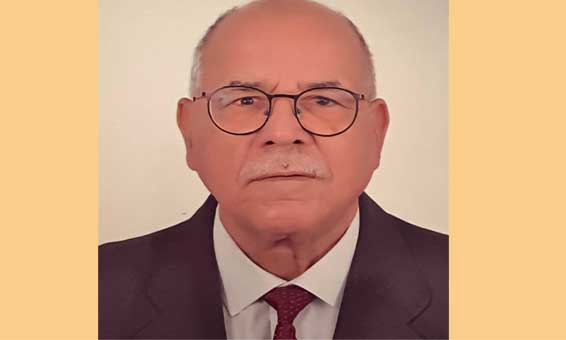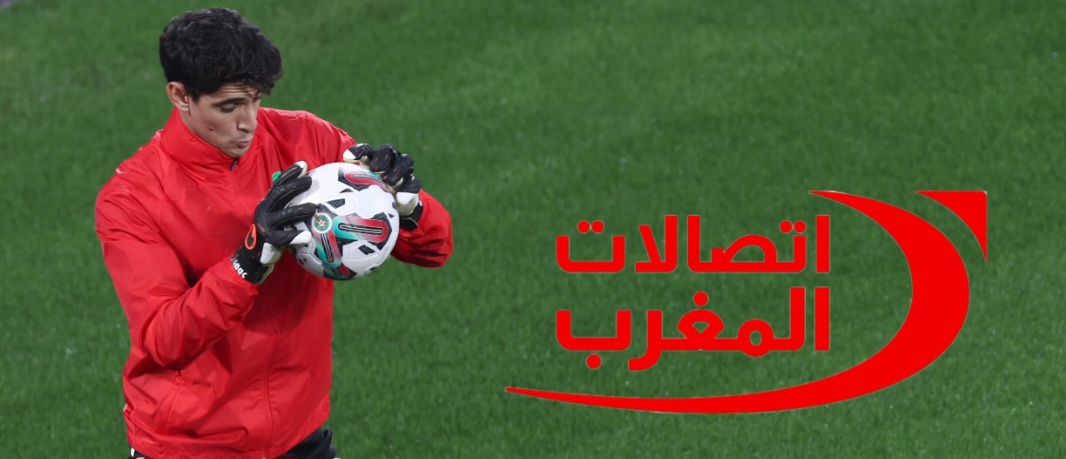منذ الإستقلال، اضطلعت وزارة الداخلية بدور محوري في تسيير الشأن العام وضبط توازنات السلطة. وبلغ هذا الدور ذروته خلال فترة الوزير السابق إدريس البصري (1979-1999). حاز البصري صلاحيات واسعة جعلت وزارة الداخلية أشبه بحكومة موازية تشرف على مجالات تتجاوز نطاق الأمن والإدارة الترابية.الانطباع السائد انذاك كان هو ان هذه الوزارة تقوم بترتيب كل ما يعجز عنه باقي أجهزة الدولة. هذه الخلفية التاريخية رسّخت نهجاً مركزياً ظل يؤثر على عمل الوزارة لحدود اليوم رغم مختلف الإصلاحات السياسية والدستورية التي ثم تحقيقها كما يظهرها تحليل الوضع الحالي بالأرقام والمعطيات.
1/استمرار تركز الاختصاصات وتداخلها عبر قطاعات متعددة
على الرغم من الإصلاحات التي راكمتها المملكة خلال 25 سنة الأخيرة ، لا تزال وزارة الداخلية تحتفظ أو تتداخل في اختصاصات عدة يفترض نظرياً أنها من مهام قطاعات أخرى. هذا الوضع هو امتداد لإرث فترة البصري حين كانت الداخلية تشرف على ملفات متنوعة. فعلى سبيل المثال، تاريخياً “أشرفت وزارة الداخلية سابقا على جميع اللجان العمومية المختصة بالأعمال والاستثمار في مختلف مناطق المملكة” ، مما جعلها لاعباً رئيسياً حتى في القرارات الاقتصادية والاستثمارية. اليوم، ما زالت بعض مظاهر هذا التداخل قائمة:
• قطاع الماء والكهرباء: تشرف الداخلية حالياً على إعادة هيكلة خدمات توزيع الماء والكهرباء عبر إنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات. فقد أصدرت الوزارة سنة 2024 نموذج عقد لتدبير هذه الشركات التي ستتولى توزيع الماء والكهرباء والتطهير، لتحل محل وكالات ومكاتب مستقلة كانت تابعة لوزارات تقنية . أي أن الداخلية أصبحت عمليا الجهة الوصية على مرافق حيوية للبنية التحتية (الماء، الكهرباء، الصرف الصحي) في مختلف جهات المملكة.
على الرغم من الإصلاحات التي راكمتها المملكة خلال 25 سنة الأخيرة ، لا تزال وزارة الداخلية تحتفظ أو تتداخل في اختصاصات عدة يفترض نظرياً أنها من مهام قطاعات أخرى. هذا الوضع هو امتداد لإرث فترة البصري حين كانت الداخلية تشرف على ملفات متنوعة. فعلى سبيل المثال، تاريخياً “أشرفت وزارة الداخلية سابقا على جميع اللجان العمومية المختصة بالأعمال والاستثمار في مختلف مناطق المملكة” ، مما جعلها لاعباً رئيسياً حتى في القرارات الاقتصادية والاستثمارية. اليوم، ما زالت بعض مظاهر هذا التداخل قائمة:
• قطاع الماء والكهرباء: تشرف الداخلية حالياً على إعادة هيكلة خدمات توزيع الماء والكهرباء عبر إنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات. فقد أصدرت الوزارة سنة 2024 نموذج عقد لتدبير هذه الشركات التي ستتولى توزيع الماء والكهرباء والتطهير، لتحل محل وكالات ومكاتب مستقلة كانت تابعة لوزارات تقنية . أي أن الداخلية أصبحت عمليا الجهة الوصية على مرافق حيوية للبنية التحتية (الماء، الكهرباء، الصرف الصحي) في مختلف جهات المملكة.
• التعمير والعقار: ما زال للداخلية دور بارز في مجال التعمير (التخطيط الحضري والترابي) وتدبير العقار على المستوى المحلي. فالوالي أو العامل ممثل الداخلية يترأس في العادة لجان التخطيط والوكالات الحضرية، ويملك صلاحية الموافقة على تصاميم التهيئة والترخيص لمشاريع البناء الكبرى. هذا يعني أن قرارات التوسع العمراني واستغلال الأراضي تخضع لمراقبة الداخلية إلى جانب وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان.
لا زالت الوكالة الحضرية للدار البيضاء، اكبر قطب حضري للمملكة، تشكل استثناءات غريبا وغير مفهوم، تحت وصاية الداخلية رغم الطلبات المتعددة للوزراء الذين تداولوا على قطاعات السكن والتعمير.
• البيئة والتعدين المحلي: تظهر شراكة وزارة الداخلية مع وزارة البيئة في برامج مثل البرنامج الوطني للتطهير السائل، حيث تعمل الجماعات المحلية تحت إشراف الداخلية وبدعم القطاع البيئي لتنفيذ مشاريــع معالجة المياه العادمة . كذلك تلعب السلطات المحلية (الداخلية) دوراً في مراقبة الأنشطة ذات الأثر البيئي على المستوى الترابي كالمقالع وغيرها.
• التنمية البشرية ومكافحة الفقر: منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) عام 2005 من قبل الملك، أُنيط تنفيذها عملياً بوزارة الداخلية عبر الولاة والعمال. فوزير الداخلية هو الذي يعرض حصيلة هذه المبادرة أمام البرلمان، والعمال يرأسون اللجان الإقليمية للتنمية البشرية. هكذا أصبحت برامج محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي ضمن نطاق إشراف الداخلية، رغم طابعها الاجتماعي-الاقتصادي الذي يتقاطع مع وزارات أخرى (التضامن، الصحة، التعليم…).
• الاستثمار والتنمية الاقتصادية المحلية: لا تزال الداخلية فاعلاً محورياً في تيسير الاستثمار على المستوى الجهوي. فالقانون الجديد لمراكز الاستثمار الجهوية رقم 47-18 وضع مجالس إدارتها برئاسة والي الجهة (ممثل وزارة الداخلية) . وبذلك يتصدر الوالي توجيه سياسات تحفيز الاستثمار والتنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين (وكالات التنمية، غرف التجارة والفلاحة، etc.) . وجود الوالي على رأس هذه المراكز يضمن استمرار تأثير الداخلية في قرارات التنمية الاقتصادية وجذب المشاريع لكل جهة.
هذا الامتداد لاختصاصات وزارة الداخلية عبر قطاعات البيئة والمرافق والخدمات الاجتماعية والاستثمار يجعلها وزارة فوق-قطاعية. فرغم وجود وزارات تقنية متخصصة، تظل الداخلية بمثابة حلقة وصل ومتحكم في تنفيذ سياسات تلك القطاعات على المستوى الترابي. وقد يكون لهذا الوضع مبرراته العملية كتسهيل التنسيق وضمان حضور الدولة محلياً، لكنه يخلق أيضاً تداخلاً في الصلاحيات وازدواجية في الوصاية الإدارية على الكثير من الملفات.
2/ التأثير المؤسسي لتداخل الصلاحيات على فعالية السياسات
إن تركيز هذه الصلاحيات المتشعبة بيد وزارة الداخلية أدى إلى تأثيرات مؤسسية ملحوظة على أداء السياسات العمومية. أول هذه التأثيرات يتمثل في تضارب الاختصاصات وضعف التنسيق بين الفاعلين. فحين تتداخل أدوار وزارة الداخلية مع وزارات أخرى (كالطاقة أو الإسكان أو الفلاحة)، قد يحصل إرباك حول من المسؤول عن وضع السياسة ومن المكلف بالتنفيذ. هذا التشابك يعيق المساءلة والفعالية؛ إذ يصعب تحديد جهة واحدة مسؤولة عن نجاح أو فشل برنامج معين عندما تكون عدة جهات تتقاسمه.
إن تركيز هذه الصلاحيات المتشعبة بيد وزارة الداخلية أدى إلى تأثيرات مؤسسية ملحوظة على أداء السياسات العمومية. أول هذه التأثيرات يتمثل في تضارب الاختصاصات وضعف التنسيق بين الفاعلين. فحين تتداخل أدوار وزارة الداخلية مع وزارات أخرى (كالطاقة أو الإسكان أو الفلاحة)، قد يحصل إرباك حول من المسؤول عن وضع السياسة ومن المكلف بالتنفيذ. هذا التشابك يعيق المساءلة والفعالية؛ إذ يصعب تحديد جهة واحدة مسؤولة عن نجاح أو فشل برنامج معين عندما تكون عدة جهات تتقاسمه.
ثانياً، تؤدي هذه المركزية المفرطة إلى بطء في تنفيذ الإصلاحات المقررة على الورق. فرغم دستور 2011 الذي نص على اللامركزية والجهوية المتقدمة، بقي تفعيل نقل الاختصاصات يسير ببطء شديد. لا تزال القرارات ذات الأثر المالي مثلاً خاضعة لتأشيرة وزارة الداخلية أو الوالي أو العامل قبل تنفيذها من طرف الجماعات . هذا يعني أن حتى بعد انتخاب مجالس ترابية وإعطائها صلاحيات قانونية، تستمر السلطة المركزية (الداخلية) في التحكم العملي بصرف الميزانيات واتخاذ القرارات المالية الكبرى. وقد أقرت الحكومة مؤخراً بضرورة تبسيط هذه الإجراءات؛ إذ جاء في توجيهاتها إلغاء عرض بعض النفقات على ولاة الجهات للمصادقة بغرض تقليص آجال أداء مستحقات المقاولات . هذا اعتراف ضمني بأن تدخل السلطة الوصية يؤخر إنجاز المشاريع ويعرقل دينامية الاستثمار على المستوى المحلي.
ثالثاً، على مستوى صنع القرار المحلي، غالباً ما تتغلب الرؤية الأمنية والإدارية لوزارة الداخلية على الاعتبارات التنموية التخصصية. فعندما يكون الوالي أو العامل هو المقرر في قضايا التعمير أو البيئة مثلاً، قد يتخذ القرار بمنطق المحافظة على النظام العام أو التحكم في المجال الترابي أكثر من مراعاة البعد التقني أو التنموي الخالص. بالتالي، قد لا تتلاءم بعض القرارات مع حاجات السكان أو مخططات التنمية القطاعية طويلة المدى، مما يقلل من فعالية السياسات العمومية في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
بشكل عام، أدى استمرار هيمنة الداخلية إلى إبطاء تكيّف الإدارة المغربية مع مستجدات الدستور والنموذج التنموي الجديد. فاللجنة الخاصة بالنموذج التنموي (تقرير 2021) شدّدت على ضرورة إدماج البعد الترابي في التنمية وتقوية التكامل بين اللامركزية (تفويض السلطة للمنتخبين) واللاتمركز (تفويض سلطة الإدارة المركزية لممثليها) .
إلا أن هذا يستوجب تغييرات عميقة في ثقافة وممارسات وزارة الداخلية لتقبل تقاسم الصلاحيات وتمكين الفاعلين المحليين. وبقاء الأمور على حالها يهدد بتأجيل تحقيق غايات النموذج التنموي الجديد الذي يطمح إلى حكامة جيدة وتعاون وثيق بين المركز والجماعات الترابية.
3/ وزارة الداخلية وتدبير الجماعات المحلية: الدور والمردودية
تتمثل إحدى أهم صلاحيات وزارة الداخلية التقليدية في الإشراف على الجماعات الترابية (الجماعات والجهات) عبر نظام الوصاية الإدارية. فرغم انتخاب المجالس الجماعية، يظل الوالي أو العامل ممثلاً للداخلية يمارس رقابة على قراراتها لضمان انسجامها مع القوانين والسياسات العامة. ويمنح القانون العامل صلاحيات واسعة في هذا الصدد، منها إعطاء التأشير المسبق على ميزانيات الجماعة وقرارات التعمير، وحتى اقتراح حل المجلس أو عزل رئيسه عند الاقتضاء. وبحسب المجلس الأعلى للحسابات “تخضع جميع القرارات ذات الوقع المالي للجماعات الترابية … لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو الوالي أو العامل” ، مما يؤكد هيمنة الداخلية على مفاصل التدبير المحلي. صحيح أن هذه الرقابة تهدف نظرياً لضمان قانونية وحسن استعمال المال العام، لكنها عملياً تحدّ من حرية التصرف وسرعة الإنجاز لدى المجالس المنتخبة. ورغما كل ذلك فالعدد الكبير للمنتخبين الذين أدينوا من قبل المجلس الأعلى للحسابات وصل لاعداد جد مقلقة دون الإشارة إلى سوء التدبير المستشري وضعف مردودين هذه المجالس في قدرتها على تحسين اوضاع المجالات الترابية التي تشرف عليها.
تتمثل إحدى أهم صلاحيات وزارة الداخلية التقليدية في الإشراف على الجماعات الترابية (الجماعات والجهات) عبر نظام الوصاية الإدارية. فرغم انتخاب المجالس الجماعية، يظل الوالي أو العامل ممثلاً للداخلية يمارس رقابة على قراراتها لضمان انسجامها مع القوانين والسياسات العامة. ويمنح القانون العامل صلاحيات واسعة في هذا الصدد، منها إعطاء التأشير المسبق على ميزانيات الجماعة وقرارات التعمير، وحتى اقتراح حل المجلس أو عزل رئيسه عند الاقتضاء. وبحسب المجلس الأعلى للحسابات “تخضع جميع القرارات ذات الوقع المالي للجماعات الترابية … لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو الوالي أو العامل” ، مما يؤكد هيمنة الداخلية على مفاصل التدبير المحلي. صحيح أن هذه الرقابة تهدف نظرياً لضمان قانونية وحسن استعمال المال العام، لكنها عملياً تحدّ من حرية التصرف وسرعة الإنجاز لدى المجالس المنتخبة. ورغما كل ذلك فالعدد الكبير للمنتخبين الذين أدينوا من قبل المجلس الأعلى للحسابات وصل لاعداد جد مقلقة دون الإشارة إلى سوء التدبير المستشري وضعف مردودين هذه المجالس في قدرتها على تحسين اوضاع المجالات الترابية التي تشرف عليها.
انعكس هذا الوضع على مردودية التدبير المحلي في المغرب. فكثير من الجماعات، خاصة القروية منها، تعاني من ضعف الموارد البشرية الكفئة والمالية وعجز في التخطيط الاستراتيجي، ما أدى إلى تواضع الخدمات المقدمة للساكنة. وبفعل هيمنة الوصاية، اعتاد العديد من المنتخبين الاتكال على تدخل السلطات الإقليمية بدل المبادرة الذاتية. كما أن القرارات المحلية الجريئة (كاستثمارات كبيرة أو شراكات دولية) قد تُجهض أو تُعدّل إذا اعتبرتها الداخلية غير مناسبة. والنتيجة هي نوع من الجمود على المستوى المحلي: مشاريع تنموية معطلة أو بطيئة، ميزانيات غير مستثمرة بالكامل، وبنية تحتية متردية في بعض المناطق رغم المرونة المتاحة قانونياً للجماعات.
من جهة أخرى، كرس هذا الإشراف القوي هيمنة وزارة الداخلية على قطاع الجماعات نفسه داخل الهيكل الحكومي. فرغم إحداث مديرية عامة للجماعات الترابية، بقيت عملياً تحت وصاية وزير الداخلية وهو ماشكل خطئا كبيرا.
وهذا يعني أن سياسات اللامركزية وإصلاح الإدارة المحلية تصاغ داخل بيت الداخلية، ما يجعل التغيير مرهوناً بإرادتها. وقد شهدنا تقدماً محدوداً في نقل بعض الاختصاصات القطاعية للجماعات وفق القوانين التنظيمية لـ 2015، لكن التنفيذ الملموس لا يزال متباطئاً. في المحصلة، تعترف الدولة بأن الأداء التنموي المحلي ليس بالمستوى المطلوب. وتُظهر المؤشرات أن المغرب يخصص تمويلاً هاماً للجماعات (نحو 3.6% من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 موجهة لميزانيات الجماعات الترابية ، وهي نسبة أعلى من بعض دول الجوار)، لكن العائد على هذا الإنفاق يبقى دون الطموح بسبب إكراهات الحكامة والتداخل المؤسساتي. ويبقى مؤشر التنمية البشرية أكبر مرآة لضعف هذا المسار.
4/ هيكلة الجماعات الترابية: العدد، التوزيع والتكلفة
يبلغ عدد الجماعات الترابية حاليًا 1538 جماعة، منها 256 جماعة حضرية (بلدية) و1282 جماعة قروية . هذا العدد الكبير ناتج عن التقسيم الإداري والترابي الذي تراكم منذ عقود، حيث أحدثت جماعات كثيرة لتقريب الإدارة من المواطنين وتمكين المشاركة المحلية. غير أن التوزيع الديمغرافي لهذه الجماعات شديد التباين: فبعض الجماعات في الحواضر الكبرى تضم مئات الآلاف أو ملايين السكان (مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش والرباط وفاس وغيرها)، في حين أن كثيرًا من الجماعات بالوسط القروي صغيرة جداً لا يتعدى عدد سكانها بضعة آلاف أو أقل. على سبيل المثال، توجد جماعات قروية يقل سكانها عن 3000 نسمة وأصغرها بالكاد يفوق ألف نسمة . ورغم محدودية ساكنتها، تتحمل هذه الوحدات النائية تكاليف بنيوية ثابتة كإدارة ومجلس منتخب وموظفين وتجهيزات.
يبلغ عدد الجماعات الترابية حاليًا 1538 جماعة، منها 256 جماعة حضرية (بلدية) و1282 جماعة قروية . هذا العدد الكبير ناتج عن التقسيم الإداري والترابي الذي تراكم منذ عقود، حيث أحدثت جماعات كثيرة لتقريب الإدارة من المواطنين وتمكين المشاركة المحلية. غير أن التوزيع الديمغرافي لهذه الجماعات شديد التباين: فبعض الجماعات في الحواضر الكبرى تضم مئات الآلاف أو ملايين السكان (مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش والرباط وفاس وغيرها)، في حين أن كثيرًا من الجماعات بالوسط القروي صغيرة جداً لا يتعدى عدد سكانها بضعة آلاف أو أقل. على سبيل المثال، توجد جماعات قروية يقل سكانها عن 3000 نسمة وأصغرها بالكاد يفوق ألف نسمة . ورغم محدودية ساكنتها، تتحمل هذه الوحدات النائية تكاليف بنيوية ثابتة كإدارة ومجلس منتخب وموظفين وتجهيزات.
تشير المعطيات إلى اختلال في الجدوى الاقتصادية لهذه الجماعات الصغيرة. فالموارد المحلية (جبايات ورسوم) في معظم القرى ضئيلة جدًا، مما يجعلها تعتمد شبه كلياً على الدعم المالي للدولة (في شكل حصص من الضرائب المشتركة وتحويلات صندوق التجهيز الجماعي وغيرها). وهذا يخلق عبئًا على الميزانية العامة مقابل مردودية ضعيفة محلياً. بل إن بعض الجماعات القروية تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة لتغطية نفقاتها دون أن تقابلها موارد ذاتية أو خدمات تناسب تلك التكلفة. وتُظهر تقارير مالية أن حوالي 60% من موارد التسيير للجماعات تأتي من تحويلات الدولة ، ما يدل على ثقل الإنفاق المركزي على الجماعات. وفي المقابل، العديد من هذه الجماعات بالكاد توفر الحد الأدنى من الخدمات لسكانها.
لقد أثار هذا الوضع نقاشاً حول جدوى الحفاظ على هذا العدد الكبير من الوحدات الترابية. فهناك جماعات قروية يُقدَّر أنها تستهلك عشرات الملايين من الدراهم سنويًا (أي عدة مليارات من السنتيمات) لتسيير شؤون بضع آلاف من السكان فقط. على سبيل المثال، سُجّل أن بعض الجماعات لا يتجاوز سكانها 2500 نسمة وتستنزف ميزانية تفوق 40 مليار سنتيم سنوياً (أي ما يعادل 400 مليون درهم) بين رواتب وتسيير ومشاريع محدودة، ما يجعل تكلفة الفرد فيها مرتفعة جداً. ورغم أن هذا الرقم قد يختلف من جماعة لأخرى، فإن الخلاصة هي أن نموذج التقسيم الحالي مكلف وغير فعال في كثير من الحالات. وقد تكون هناك حاجة إلى دمج بعض الجماعات أو تعزيز التعاون فيما بينها عبر آليات مثل مجموعات الجماعات (التجمعات intercommunales) لتحقيق وفورات الحجم ورفع الكفاءة. بالفعل، يدعو النموذج التنموي الجديد إلى “جماعات ترابية جديدة” أكثر ملاءمة للتحديات الحالية ، وربما يكون المقصود إصلاح الخريطة الجماعية بما يقلص الوحدات الصغيرة جدًا أو يعيد توزيعها بشكل عقلاني اقتصاديًا واجتماعيًا.
5/ تداعيات التقسيم الترابي الحالي على التنمية والهجرة القروية
أسهمت هذه البنية الترابية المجزأة في عرقلة التنمية المحلية المتوازنة وسرّعت وتيرة الهجرة القروية خلال العقود الماضية. فالكثير من الجماعات القروية الصغيرة عجزت عن توفير فرص عيش كريمة أو خدمات أساسية بجودة مقبولة لسكانها، نتيجة ضعف الإمكانات وضعف الحكامة. وفي غياب الاستثمار الاقتصادي المحلي وافتقار الشباب للبنية التحتية والإنتاجية، ارتفعت معدلات الهجرة من القرى نحو المدن بحثاً عن فرص أفضل. وتشير ارقام حديثة إلى أن النزوح القروي أفرغ فعلياً العديد من الجماعات من السكان وأدى إلى تراجع سكاني في مجالات قروية واسعة، حيث تركز السكان تدريجياً في هوامش المدن الكبرى . هذا التحول السكاني ترك خلفه مناطق شبه فارغة أو تسكنها فئات متقدمة في السن، وفقدت القرى قاعدة شبابها العاملة. وتظهر الأرقام الأخيرة للإحصاء العام مشهد بعض المناطق بشمال وشرق البلاد ومناطق الأطلس المتوسط بأن الزراعة فيها اضمحلت وحصل انتشار للأراضي البور نتيجة ترك الفلاحين لأراضيهم والهجرة الجماعية .
أسهمت هذه البنية الترابية المجزأة في عرقلة التنمية المحلية المتوازنة وسرّعت وتيرة الهجرة القروية خلال العقود الماضية. فالكثير من الجماعات القروية الصغيرة عجزت عن توفير فرص عيش كريمة أو خدمات أساسية بجودة مقبولة لسكانها، نتيجة ضعف الإمكانات وضعف الحكامة. وفي غياب الاستثمار الاقتصادي المحلي وافتقار الشباب للبنية التحتية والإنتاجية، ارتفعت معدلات الهجرة من القرى نحو المدن بحثاً عن فرص أفضل. وتشير ارقام حديثة إلى أن النزوح القروي أفرغ فعلياً العديد من الجماعات من السكان وأدى إلى تراجع سكاني في مجالات قروية واسعة، حيث تركز السكان تدريجياً في هوامش المدن الكبرى . هذا التحول السكاني ترك خلفه مناطق شبه فارغة أو تسكنها فئات متقدمة في السن، وفقدت القرى قاعدة شبابها العاملة. وتظهر الأرقام الأخيرة للإحصاء العام مشهد بعض المناطق بشمال وشرق البلاد ومناطق الأطلس المتوسط بأن الزراعة فيها اضمحلت وحصل انتشار للأراضي البور نتيجة ترك الفلاحين لأراضيهم والهجرة الجماعية .
هذه الهجرة القروية لها انعكاسان خطيران على التنمية المستدامة:
أولاً، ازدحام وضغط متزايد على المدن ومستويات بطالة مرتفعة في الأحياء الحضرية الفقيرة، يقابله نزيف للقدرات البشرية في البوادي. أي أن الثروة البشرية تهجر أماكنها الأصلية بدل أن تسهم في تنميتها، مما يفاقم الاختلالات المجالية. وثانياً، تراجع الإنتاج الفلاحي والمحلي في القرى المهجورة، وإهمال الموارد الطبيعية المحلية، مما يهدد الأمن الغذائي ويزيد الاعتماد على الواردات والمدن. وإذا استمر هذا الاتجاه بدون تصحيح عبر إنعاش التنمية القروية، ستبقى الفوارق بين المركز والهامش قائمة بل ومتوسعة.
أولاً، ازدحام وضغط متزايد على المدن ومستويات بطالة مرتفعة في الأحياء الحضرية الفقيرة، يقابله نزيف للقدرات البشرية في البوادي. أي أن الثروة البشرية تهجر أماكنها الأصلية بدل أن تسهم في تنميتها، مما يفاقم الاختلالات المجالية. وثانياً، تراجع الإنتاج الفلاحي والمحلي في القرى المهجورة، وإهمال الموارد الطبيعية المحلية، مما يهدد الأمن الغذائي ويزيد الاعتماد على الواردات والمدن. وإذا استمر هذا الاتجاه بدون تصحيح عبر إنعاش التنمية القروية، ستبقى الفوارق بين المركز والهامش قائمة بل ومتوسعة.
لذلك فإن إصلاح التقسيم الترابي وتجويد حكامة الجماعات الترابية بالوسط القروي جزء أساسي من حل معضلة الهجرة والتنمية بشكل عام. فالمطلوب هو تحفيز التنمية المحلية بتجميع الموارد وتنشيط الاقتصاد القروي (عبر تطوير صناعات تحويلية صغيرة، تعاونيات، سياحة إيكولوجية…) وإعادة تأهيل البنية التحتية (طرق، مدارس، مستشفيات) لجعل العيش في القرى خيارًا ممكنًا لشبابها. النموذج التنموي الجديد أدرك هذا الربط، حيث شدد على العدالة المجالية وضرورة تقليص الفجوة بين المناطق. وتحقيق ذلك يمر حتماً عبر تمكين وحدات ترابية ذات حجم وقدرة كافيين للاضطلاع بدورها التنموي، بدل استمرار الوضع الراهن الذي تنتشر فيه جماعات كثيرة عاجزة تعتمد كلياً على المركز.
6/ نحو توازن جديد بين المركز والمجال الترابي
يتبين أن إرث وزارة الداخلية من تركيز للصلاحيات وتوسع في الاختصاصات لا يزال ممتداً رغم التحولات الدستورية والنموذج التنموي الجديد. هذا الإرث منح الداخلية قدرة على الضبط والتنسيق، لكنه في المقابل أضعف المبادرة المحلية وأدى إلى تداخل مربك في صنع السياسات وتنفيذها. وللمضي قدماً في إرساء حكامة رشيدة وتحقيق تنمية عادلة، لا بد من إعادة رسم حدود دور وزارة الداخلية بحيث تنخرط أكثر في دعم قدرات الفاعلين المحليين بدل الاستئثار بالقرار عنهم. إن تفعيل الجهوية المتقدمة كما نص عليها دستور 2011، وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد، يتطلبان تحولاً بنيوياً في عقلية وممارسات الإدارة الترابية: تحول من منطق الوصاية المطلقة إلى منطق الشراكة والتأطير.
يتبين أن إرث وزارة الداخلية من تركيز للصلاحيات وتوسع في الاختصاصات لا يزال ممتداً رغم التحولات الدستورية والنموذج التنموي الجديد. هذا الإرث منح الداخلية قدرة على الضبط والتنسيق، لكنه في المقابل أضعف المبادرة المحلية وأدى إلى تداخل مربك في صنع السياسات وتنفيذها. وللمضي قدماً في إرساء حكامة رشيدة وتحقيق تنمية عادلة، لا بد من إعادة رسم حدود دور وزارة الداخلية بحيث تنخرط أكثر في دعم قدرات الفاعلين المحليين بدل الاستئثار بالقرار عنهم. إن تفعيل الجهوية المتقدمة كما نص عليها دستور 2011، وتنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد، يتطلبان تحولاً بنيوياً في عقلية وممارسات الإدارة الترابية: تحول من منطق الوصاية المطلقة إلى منطق الشراكة والتأطير.
سيظل للداخلية دور جوهري بحكم وظيفتها في حفظ الأمن وتنسيق الإدارات، لكن هذا الدور يجب ألا يكون على حساب إبطاء عجلة الإصلاح والتنمية المحلية. المطلوب هو إيجاد توازن جديد بين المركز والجهات: توازن يضمن وحدة الدولة وسيادة القانون من جهة، ويكفل تمكين المجالس المنتخبة وتحملها لمسؤوليات التنمية من جهة أخرى. كذلك ينبغي ترشيد الخريطة الترابية بدمج أو تقوية الجماعات المحدودة السكان، حتى تصبح كل جماعة قادرة على تسيير شؤونها بكفاءة عالية وموارد كافية. تلك خطوات إصلاحية شاقة لكن لا غنى عنها إذا اردنا التحرر من قيود الماضي والمضي نحو حكامة محلية معقلنة وفعالة تساهم في تحقيق تطلعات المواطن في كافة ربوع المملكة.