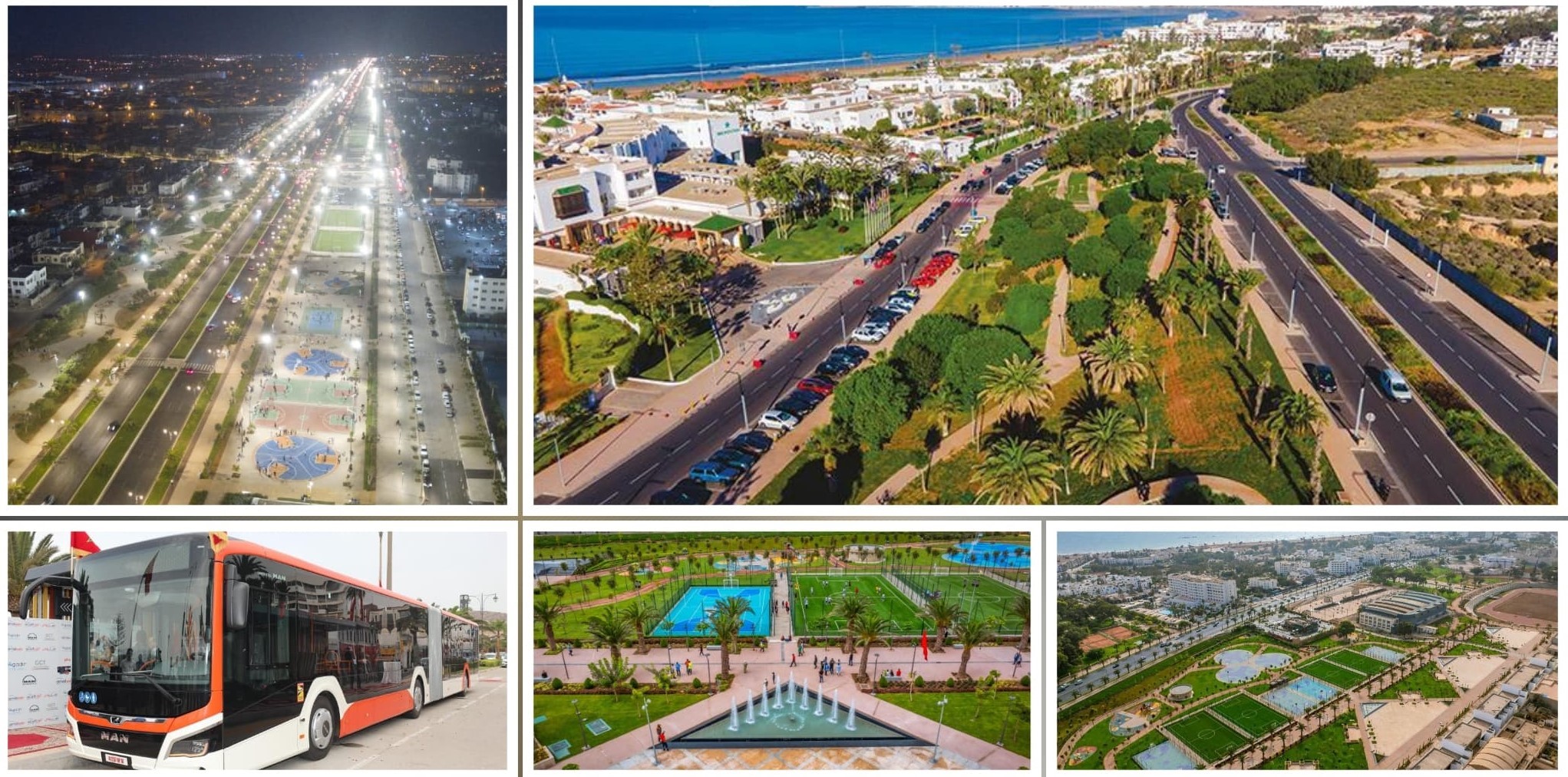كنت أتتبع، مثل الجميع، من محبي الشعر ومحبي فلسطين، أخبار مرض الشاعر الفلسطيني الكبير سميح القاسم، خلال الأسابيع الأخيرة. وحين جاء خبر نعيه، عادت إلي تفاصيل لقاء أخوي جمعني به بالدارالبيضاء منذ ثمان سنوات، سنة 2006. أذكر أن اللقاء تم بعشي في فندق فرح بشارع الجيش الملكي، بحضور الصديق بشر بناني، الذي كان له فضل ترتيب ذلك اللقاء الممتع والحميمي مع شاعر فلسطين الكبير. هنا أود أن أشرككم في متعة نتيجة ذلك اللقاء وهي حوار مطول معه، كان سجاليا، صادقا، اكتشفت فيه سميح القاسم آخر، سادرا في إنسانيته الرفيعة، منتصرا لحقوقنا المغربية في معانيها الوطنية الحق، فكان درسا للكثيرين. ولأنه كان سياسيا قريبا من اليسار الفلسطيني في معناه الماركسي ذات زمن، فإن ما قاله لي حول عدالة قضية وحدتنا الترابية بأقاليمنا الصحراوية الغربية الجنوبية، بادر صديق صحراوي شاب ممن هم منخرطون في فكرة الإنفصاليين بالعيون، للإتصال بي، كي يناقشني في تصريحاته تلك، التي كانت درسا له كما قال، في معنى الإنتصار لسقف الوطنية (وتلك حكاية أخرى ليس هنا مجالها على كل حال).
جاء إلينا، نحن المغاربة، حينها سميح القاسم في أول زيارة له إلى المغرب، استجابة لدعوة جمعية التضامن المغربي الفلسطيني لإحياء لذكرى يوم الأرض، حيث أحيى أمسيات شعرية بكل من فاس، الرباط والدارالبيضاء، فكانت فرصة كي ألتقيه وكان هذا الحوار الممتع
- لو نبدأ، الأستاذ سميح القاسم، بسؤال البدايات، من باب محاولة رسم ملامح بورتريه خاص بك·· كيف جئت إلى الشعر؟! وكيف فتح سميح القاسم عينيه على هذا العالم؟!
تبدأون بالأسئلة الصعبة، التي حاولت كثيرا، أن أجيب عنها ببساطة، لكنها أسئلة تعيدني دائما إلى خاصية التركيب، في الحياة وفي الشعر·· أحاول مرة أخرى، الإجابة، مكررا رفضي الدائم لمحاولات الفصل بين الأرض (مادمنا نلتقي في المغرب، بمناسبة إحياء يوم الأرض) وبين الشعر·· بين التراب، وبين القصيدة· وأعتقد أنكم كعرب مغاربة، في هذه الأيام بالذات، وأنتم تدافعون عن قطعة أرض مغربية، هناك شركات تعدين ولصوص بنوك يحاولون تحويلها إلى دولة مستقلة باسم حقوق الإنسان وباسم حق تقرير المصير·· فهذا الوجع الذي تحس به، وأرجو أن تكون تحس به، هو الوجع الذي يرافقني من طفولتي·· فوطني الصغير الذي تحول إلى مشكلة، وإلى صراع دولي، وإلى معادلات قانونية وسياسية وشرعية، خارج أي تناسب منطقي، تحول هذا الوطن الصغير، من حجر وشجر وقبر ومدرسة، إلى هاجس شعري بالفطرة، بدون مقدمات ولا مماحكاة فلسفية، ولا ثرثرات شعروية، وبدون هرطقات تنظيرية، كما يصيب الشعر العربي والأمة العربية والعقل العربي والطعام العربي، منذ عقود من الزمن·· هكذا، بدأت قصيدتي، بالوجع الشخصي، الذي هو وجع شعب ووجع وطن، ولا تستطيع أن تجد فيه الحد، بين ماهو ذاتي وما هو عام، بين ما هو فردي وما هو قومي، لأن الخطر الذي تهددني ومازال، يتهدد آخرين، هم من اصطلحوا على تسميتهم بأبناء شعبي الفلسطيني· لذلك، فميلاد التجربة الشعرية، وميلاد القصيدة، والهاجس الفني، والقلق الشعري، يبدأ من جرح صغير في خاصرة الطفولة، ويستمر إلى الجرح الكبير في جبين الأمة والإنسان في المطلق·
- ما أثارني، أستاذ سميح، وأنا أستمع إلى جوابك، هو التساؤل، إن كان لايزال للقصيدة دور في تحريك ماء التاريخ، وفي التأثير في عيون الناس وفي وجدانكم؟!
اسمح لي أن ألفت نظرك، إلى أنني كنت، ومازلت، خارج هذا الكوكب الشائه الذي يسمى الوعي العربي الراهن، في الشعر وفي السياسة وفي الفن وفي الموسيقى وفي الصحافة وفي الزي، وفي كل شيء·· أنا من خارج هذا الكوكب الأرضي الشائه، الملوث، الذي يسمى الآن، اعتباطا، بالحياة الثقافية العربية·· فالمقولات السائدة في الحياة النقدية العربية، لا تعنيني على الإطلاق، ومعظم التجارب الشعرية والفكرية والسياسية أيضا، لا تعنيني، لأنني أعتبرها ضربا من الاستنساخ الأحمق لتجارب أوربية وأمريكية غير أصيلة، وهي ليست نابعة لا من وجعي الفردي ولا من وجعي القومي· أنا ضد الاستنساخ في الثقافة وفي الفكر، وفي الفن وفي الحياة أيضا·· ولا يوجد في ما يسمى الثقافة العربية، سوى الاستنساخ والتقليد، وطغيان الشعور بالنقص والقزامة إزاء كل ما هو غريب·· وأنا أعرف هذا الغريب من الشعر الفرنسي والأمريكي والبريطاني، لكن، ليست لدي عقدة الشعور بالنقص لا اتجاه سان جون بيرس، أو ت· س· إليوت، أو إزراباوند، أو أي كائن من هذه الكائنات، التي يجتمع فيها القبح والجمال، أنا أحددها، ولا أسمح لأي جهة أن تحدد لي ذائقتي الأدبية والمجالية··
- هل ما يميز سميح القاسم، والجيل الذي ينتمي إليه، جيل توفيق زياد وكمال ناصر والروائي الكبير إميل حبيبي وغيرهم، أنكم أصلا من الداخل، من فلسطينيي 48، وأنكم عشتم خصوصية تجربة، وهبتكم عمقا إنسانيا ونضاليا وإبداعيا···
اسمح لي، أن أستفزك بدوري، أنت تقول لي إنني من فلسطينيي 48، وأنا أقول لك إنني من أعماق المغرب، مثل أي مغربي تماما، ولا أسمح لأي مغربي، من أكبر رأس إلى أصغر رأس، أن يزايد علي في مغربيتي، ولا أن يزايد علي المصريون في مصريتي، ولا العراقيون ولا اللبنانيون·· أنا هنا مثلك، وإن لم تشأ، فأكثر منك· فلا الجغرافيا تحكمني، إلا بقدر ما يحكمني الظرف التاريخي، في هذه الجغرافيا·· نكبت فلسطين، فحكمت بنكبتها·· ينكب العراق اليوم، فأحكم بنكبته·· ولا سمح الله، ولا سمح الله، أن تقام دولة معادن في صحراء المغرب، فينكب المغرب، فيكون ذلك نكبة لي أيضا·· أنا لست ابنا لجغرافية محددة، ولا أسمح لأحد بوضعي في خانة، بل إنني أعتبر نفسي أكثر الشعراء في المغرب مغربية، وأيضا في مصر والعراق، لأنني شاعر هذا الوطن وهذه الأمة وهذه الإنسانية· إنني ضد هذه الاقليمية، وافهموها للمرة الألف، أنا ضد سايكس ـ بيكو، الذي هو أخطر وأسفل (من السفالة) مشروع تعرضت له الأمة العربية· وهو ليس موضوعا تاريخيا يعود للماضي، بل هو قائم وجاثم على صدورنا وعلى قصائدنا وعلى أفكارنا، وهو يهدد بالاتساع· فعلى كل بئر نفط، يريدون إقامة دولة عربية، وعلى كل منجم نحاس أو فوسفاط، أو موقع مياه، يريدون إقامة دولة عربية·· فمازلنا متورطين في هذا المشروع، فهو ليس مشروعا مضى، بل هو حاضر اليوم وغدا·· لذلك، الإقليمية لا تعنيني، إلا من حيث القضايا التي تقع، في هذا الإقليم أو ذاك، وحمى قصيدتي الفلسطينية، هي حمى قصيدتي بخصوص مدينتي سبتة ومليلية· فمن مَن شعراء المغرب يتحدث اليوم عن هاتين المدينتين السليبتين؟! فوضع المدينتين، هاجس أنا مسكون به دوما، وهو حاضر في قصائدي، وكذا وضع الأهواز واسكندرون، تماما بنفس القدر الذي تحضر فلسطين· هذا أنا، إما أن تأخذوني على علاتي، أو اذهبوا إلى المدرسة الفرنكفونية أو الأنجلوفونية، للبحث عن تجارب شعرية، وهموم ثقافية أخرى ليست مرتبطة بذواتنا القومية·
- يهمني، أن أطرح معك، سؤالا يشغلني دوما، يرتبط بما أحب تسميته بـ ثقافة الانتفاضة·· فالانتفاضة، أكيد، أنها قد خلقت ثقافتها في فلسطين، مثلما أنها قد خلقتها في العالم·· فمن موقعك كشاعر، كيف تقرأ ملامح هذه الثقافة في الداخل، في العمق الفلسطيني؟!
هناك حاجة، أو هواية لدى الباحث أن يحلل ويجزئ، حتى يقرأ المرحلة، وهو يضطر لإقصائها بعض الشيء، عن مراحل سابقة أو لاحقة، فهذه من طبيعة البحث الأكاديمي· لكنني، ليست باحثا أكاديميا، لذلك لا أتعامل مع الظواهر الحياتية والثقافية والشعرية والسياسية بفصلها عن مراحل سبقتها أو تتبعها، بل بالانخراط في عضوية التلاحم بين هذه المراحل جميعها· الانتفاضة لم تفاجئني، لأن إرهاصاتها موجودة في قصيدتي، موجودة في رؤياي الشعرية والفكرية·· لأن الاحتلال والقمع والسطو التاريخي الذي وقع على وطني وشعبي، لا يمكن أن يتحول الى مجرد موقف فكري، من شأني قبوله أو رفضه، بل هي مسألة دفاع عن الحياة، عن الكينونة الشخصية، قبل القومية، والفردية قبل الوطنية، والذاتية قبل الكونية· فهذا التداخل بين الشخصي والعام، وبين مراحل التاريخ والتطورات السياسية والفكرية التي تحدث بعنف في هذه المساحة من الجغرافيا، فهذا التلاحم العضوي الحاد، يخلق وهجه الروحي وحاجته الثقافية من مرحلة إلى أخرى· لذلك، فشعر الانتفاضة، مندرج في هذا السياق الحامي· ولابأس، أن أذكركم، أن قصيدتي رسالة إلى غزاة لا يقرأون والتي اشتهرت باسم تقدموا، كانت ما يشبه الطلقة الأولى، في شعر الانتفاضة وأصبحت أشبه بالنشيد الوطني لها، يحفظها الشيوخ والأطفال، النساء والرجال، فهذه القصيدة لم تكتب بقرار ثقافي، بل كانت نتيجة للمشاركة في تظاهرة كبرى، في القدس، حول أسوار القدس، حيث تعرضنا لاعتداء قوات الاحتلال، وقصفنا بقنابل الغاز، وأصيبت برلمانية إيطالية، كانت إلى جانبي، وفقدت إحدى عينيها، وأحسسنا أننا في مواجهة مباشرة مع الموت·· لذلك، كانت إيقاعات هذه القصيدة، من إيقاعات هذه المظاهرة، التي شاركت فيها جسديا وروحيا وفكريا·· وقاموسها الروحي والإيقاعي، كله نتاج مباشر لحالة دفاع عن الحياة وعن النفس· وبطبيعة الحال، لمشاركة آخرين لي، في هذه الحالة الوجدانية، كان طبيعيا، أن يولد ما عرف في ما بعد بأدب الانـــتفاضة، كما أدب المـــقاومة سابقا·· فالعمل الفني أو الشعري، هو حالة قصوى من الدفاع عن النفس في مواجهة موت مباشــر··
- جدار شارون العنصري، الذي يخترق جسد فلسطين، كيف تتأمله من موقعك كإنسان وكشاعر؟!
أنا أسميته بالساطور·· ساطور الجزار·· وهي ليست لعبا لغويا، فقد دعيت إلى رام الله، من قبل الأخ ياسر عبد ربه، وزير ثقافة ووزير إعلام سابق، لكن الحاجز الاسرائيلي منعني من دخول المدينة، وكان هذا الحاجز بجانب الساطور الذي يسمى جدارا مجازيا· فأنا لا أسميه بالساطور مجازيا، هو ساطور، ويسمى مجازيا بالجدار، لأنه ساطور في لحم وعظم وطني وشعبي· لكن، كما كل أفعال الاحتلال ونقائص العنصرية، وفظائع الحمق التاريخي، فلن يكون هذا الساطور كما يشتهيه شارون وورثته الآن، حدا نهائيا للحياة في بلدي· فالنهايات التي تكون في مباريات كرة القدم، لا يحققها أو ينجزها المتفرجون، بل اللاعبون على الميدان·· واللاعبون هنا، هم شعب قوي، مجرب، معروف· ويستطيع أولمرت أن يعقب على لعبته كما يشاء، لكن النتيجة النهائية ليست في جيبه··
- ننتقل إلى القصيدة، وبالتحديد قصيدة سميح القاسم، فمن ملاحظاتي، أن هناك حضورا قويا للتاريخ ولعناوين الأمكنة في شعرك، حتى لأكاد أقول إننا بإزاء ذاكرة للمكان تخاطب العالم·· لماذا هذا الإختيار الشعري الممجد للمكان وللذاكرة؟
سأكون مدعيا ومتعجرفا إذا قلت إنني اخترت هذه الحالة، أو هذه المسألة· فأنا أكتشف لاحقا أنني تورطت في حالة شعرية تشبه المس العقلي، ويلفت نظري النقاد إلى أمور لا أدعي، وليس من حقي ذلك، التخطيط لها· أنا أتبع تخطيط براكيني الداخلية وأعاصيري الخاصة· والعالم يتحدث عن تسونامي وقوته، وحتى موازين ريختر للزلازل، ستفشل في قياس ما يدور في أعماقي، على المستوى الفردي وعلى المستوى القومي والوطني والإنساني· سمه هوسا، أو جنونا، لكن، لدي إحساس عميق بأنني أشبه بحارس الغابات الذي يمنع الصيد ويدافع عن أزهار لا يراها سواه، وعن كائنات حية صغيرة لا تراها سوى عين محبته· أعتقد أنه هذه حالتي مع الوطن ومع الشعب ومع الأمة ومع الإنسان في المطلق·
- ألهذا قلت، مرة، الأستاذ سميح، وأنت تخاطب العدو: فاشحد مداك على جراحي/ إنني قربان كلمة ؟
هذا كلام قلته منذ نصف قرن أي أربعين سنة·· وأنا أجدده اليوم وأتبناه كاملا· وأعترف أنني قلت ذلك أمام التاريخ·
- ونفس الشئ قلته في ديوانك لا أستأذن أحدا ، حين قلت: لا أستأذن أحدا، بهدوء وروية/ أقدف وردة حريتي/ أقدف حجري في وجه الكرة الأرضية ؟·
وأغني للحرية·· نعم، نعم قلتها ولاأزال· أترى، أنت تكتشف أمورا لم أخطط لها، ولكن لاحقا أنت تكتشفها، والباحثون يكتشفون أمورا هم أقدر مني على رؤيتها· لأن الشاعر لا يستطيع أن يرى ذاته كما يراها الآخرون· هم يبصرون تفاصيل جسدك الشعري وتقاطيعه، بشكل أدق مما تفعل أنت، فأنت تعيش الحالة الشعرية والروحية، والآخرون يتمثلونها ويعيشونها·
- انطلاقا من هذا العمق في التصور للشعر، ألا ترى معي أستاذ سميح، أن حضور الإيديولوجي، لربما يضر بصفاء الصورة الشعرية؟
حضور السياسي والإيديولوجي والفكري والثوري والرومانسي، في شعري، هو عندي مسألة تلقائية· فأنا لا أحددها أو أقررها أو أختارها، تماما مثلما لا أختار لا المكان ولا الزمان· لكنني أريد أن أناقش الموقف السياسي الذي تطرحه هذه النظرية، أي نظرية ما يسمى بالشعر الصافي والفن الصافي، والثقافة المنزهة عن تفاهات الحياة· وما يسمى بتفاهات الدنيا، كما يقولون، هو وطن وأطفال وآباء وأجداد وتاريخ وحضارة ومصير· والإيديولوجيا بالنسبة لي، ليست حوارا في مقهى مع صديق أو خصم، بل هي مسألة حياة أو موت· فأنا لم أنظم في حياتي برنامج حزب أو حكومة، أو قرارات هيئة الأمم المتحدة، بل قلت دائما، إن هذه الإطارات صغيرة علي، والأمم المتحدة صغيرة جدا على هاجسي الشعري والإنساني، فهي أشبه بدمية أطفال أمام قصيدتي· لذلك، لم أقحم ولا أقحم لا الجغرافيا ولا التاريخ ولا الإيديولوجيا ولا الموقف السياسي، في قصيدتي وفي سلوكي أيضا·
- هناك إحساس، أستاذ سميح، لدى عدد من النقاد والقراء، كما لو أنك تنتصر اليوم أكثر للبنية التقليدية في القصيدة العربية· وحين أقول العودة إلى البنية التقليدية، فكما لو أنك قد أصبت بنوع من الخيبة من التجربة السابقة للشعر العربي الحديث؟
لا، لا، أبدا·· أنا أعتز بالتراث الشعري العربي كله، من الشعر الجاهلي إلى يومنا هذا· فالأمة العربية أمة شعر، ولم تقصر في ميادين الشعر بمثل ما قصرت في ميادين القتال والإقتصاد والزراعة والتكنولوجيا، للأسف الشديد· وأحب دائما أن أستشهد بما كان يقوله لي أصدقاء قدامى، رحمة الله عليهم، هم السابقون ونحن اللاحقون، مثل الشاعر الفرنسي لوي أراغون، والإسباني رافاييل ألبرتي، واليوناني يانيس ريتسوس، وغيرهم من شعراء أروبا الكبار، الذين كانوا يعتزون بخصوصية الشعر العربي، ويسخرون من الشعراء العرب الذين يريدون أن يشبهوهم، وكانوا يضحكون بصخب حين أقول لهم إن نهايتي هي حين أحاول أن أشبههم، وأنني لا أريد أن أشبههم، وأنني أريد فقط أن أشبه ذاتي، أن أكون أنا فقط· لا أريد أن أكون شكسبير الثاني ولا إليوت الثاني ، ولا المتنبي الثاني· فهذه الحالات والتصورات، أدخلتني في مواجهات مفتعلة مع بعض الجهات النقدية، التي أحبها ولا أحترمها·
أنا أريد أن أحيلكم على ما قالته سلمى الخضراء الجيوسي، حين أكدت أنها لم تجد ما يسمى ما بعد الحداثة ، إلا في قصيدة سميح القاسم في الشعر العربي· وهي حين تقول ذلك، لا تقوله عبثا، بل ردا على باطل صحفي إعلامي·
لقد بنيت ما أسميه محور الحداثة في الشعر العربي الحديث، وقصيدتي هي تجسيد للحداثة الشعرية العربية، لأنني بنيت حداثة شعرية غير مستوردة، لا بالقطعة ولا بالجملة· فأنا أومن بالحداثة من داخل ثقافتي، وليس بالحداثة المستوردة· ولا أومن بالمستنسخ الثقافي والشعري، بل أومن بالإبداع الشعري، ولا حداثة بدون أصالة· فحداتثي تستمر من أصالتي· الذي لا يعرف الشنفرى وعروة بن الورد والمتنبي والمعري وأبا نواس، من داخلهم، من عمق أعماقهم، لا يمكن أن يكون حداثيا· فأنت لا تبني حداثة من فراغ· ونظريات الهدم و الإلغاء، كلها تقوم على ضحالة في الطاقة الشعرية وفي الوعي والثقافة· بل أكثر من ذلك، ولاستفزاز هذا التقول الحداثي، ولإهانته، قلت مرة إنني أتمنى أن أتمكن من الإقتراب من حداثة القرآن·
هل وصل أحدهم إلى حداثة آية صغيرة في طرف القرآن الكريم؟!·
فأنا أجد في القرآن حداثة، وأجد الصور السينمائية عند امرئ القيس مكر، مفر، مقبل، مدبر معا···، فالصورة هنا معجزة· أو إذا الرضيع بكى من خلفها اتجهت بشق، وشقي تحتها لم يحول ، الله على هذه الصورة الجنسية الإنسانية المدهشة· فهذه الصور الفنية موغلة في حداتثها، رغم أنها قيلت قبل ألف عام· بالتالي، نحن لم نتفق على مفهوم الحداثة، ولن نتفق، لأن هناك من يضعها بمقاييس غير صاعدة من تاريخنا وهمنا ومن مخزوننا الروحي والشعري· مثلا، ليتركوا المتنبي، ولا يقتلوه مرة أخرى، فالرجل قتل مرة وهذا يكفي، فحداتثه بعيدة في عمقها التاريخي والفني والإبداعي، وودت لو يحللوا بيتا واحدا من شعره مثل : واقف تحت أخمصي قدر نفسي/ واقف تحت أخمصي الأنام ، كنت أتمنى من خريجي وكالات الأنباء الأجنبية هؤلاء لو يحللوا تراثنا للتعاون في بناء حداتثنا· لذلك، لهم دينهم ولي دين، حتى في الشكل الكلاسيكي· وأنا لا أريد أن ألغي العروض العربي، لأنه أكبر ثروة موسيقية إيقاعية في تاريخ البشرية، فهو ثروة مدهشة وجمال لا حدود له، يسفه ويزور ويساء له· وكل من يقول إن الأوزان العربية قيود، فهو لا يفقه فيها شيئا، إنها أجنحة حرية وتحديات إبداع لا يوصف، وعليك أن تستوعبها وتستبطنها، أي أن تكون من داخلك· لنكن أحرارا دون أن نكون حمقى·
- لا يمكن أن ألتقي سميح القاسم، ولا أسأله عن محمود درويش·· فكتاب الرسائل ، الذي أصدرتماه معا، قرأته بمتعة· ما الذي يعنيه لك محمود وتلك الحميمية في كتابة تلك الرسائل بينكما؟
محمود أخي·· هو أخي الأصغر، كما تعرفون·· وهو شقيق شعري·· لكن، ما يغضبني أحيانا، هو أن أسأل عن شاعر فلسطيني، وأن يسأل شاعر مغربي عن شاعر مغربي، أو شاعر عراقي عن شاعر عراقي· بينما أحب أن أسأل عن محمود درويش وعن محمد بنيس وعن الجواهري رحمة الله عليه، كنت أتمنى أن نصل إلى حالة من الوحدة الشعرية، لكن هذه مشكلة قائمة وستظل· وما أخشاه هو أن يحددوا لنا حتى الحب، بحيث على الفلسطيني أن لا يحب سوى الفلسطينية، ولمن أترك الجميلات المغربيات ؟! ( ضحك )··
- أختم بياسر عرفات··
أوه، لا إله إلا الله·· ياسر عرفات ظلم جدا، ما زال يظلم، وهو ظاهرة إنسانية فريدة جدا لدى شعوب الأرض· تحمل من الإخوة أكثر مما تحمل من الأعداء· هو دونكيشوط الحلم الفلسطيني·