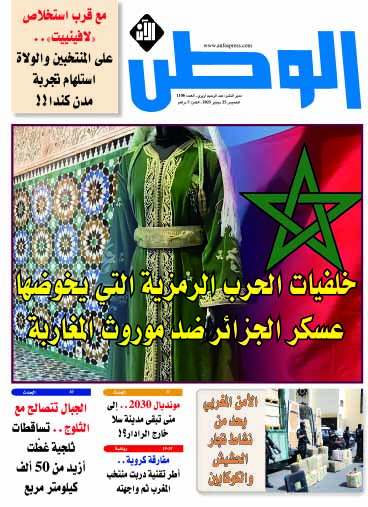القصة فنٌّ أدبي نثري، يتناول مجموعة من الوقائع والأحداث التي قامت بها شخصيات معنية في زمان ومكان معينين، وهي من الأجناس الأدبية التي تلقي اقبالا كبيرا من لدن القراء، نظرا لما تصف من أحداث وتصف من عوالم، وتعالج من قضايا، وتعكس من رؤى بطريقة مختصرة تستجيب لفضول القارئ الذي يتقصى النهاية، وحلِّ العقدة وجمع شتات الحكاية.
ولهذا لا غرو إن وجدنا النقد الأدبي ظلَّ يواكب هذا الجنس الأدبي بالدراسة والتحليل، نظرا لقيمته الفنية والأدبية والفكرية، وهو الفن الذي يتسم بالمراوغة والتمرد والكشف والتجريب، فالنقد يفجِّر النص ويبحث في جمالياته ويتلمَّس مظاهر الإبداع والفرادة فيه، اعتمادا على مقاربات لكل منها معايير، ومناهج لكل منها آليات ومُحدِّدات.
ونظرا للقيمة الفنية والأدبية والفكرية التي تميز المجموعة القصصية "خواطر حمودة" في رصد وقائع فريدة للكاتب المغربي "محمد يسين"، فإننا نجد أن القصص التي حوتها المجموعة ممتدة فنيا إلى ما هو أبعد من أن يحيط به كاملا مقال أو دراسة عابرة، ذلك أن كل قصة في المجموعة قد تنتمي إلى عالم أو فضاء اجتماعي وإنساني مختلف، أحيانا يأتي عفويا، وأحيانا أخرى يقصد الكاتب أن يصنع هذا التعدُّد لغرض في نفسه، قد يكون هو الربط بين سذاجة وبراءة الماضي، وحكمة ونضج الحاضر المجيَّد في حمودة الصغير الذي بداخله، كما تختلف أساليب الحكي وطرق السرد عنده من قصة لأخرى، كما كان في كل حكاية أو قصة يتقمص حدثا بعينه، يستجيب لحالته النفسية، فيستحضره أحيانا من عمق ذاكرته وأحيانا أخرى من واقعه ومسار حياته، أما الشخصيات، فهي إما متباينة، أو متنافرة ومتناقضة، أو شخصيات مسطحة وجامدة تحمل أبعادا رمزية تستثير القارئ وتستفزه لمسائلة النص والنبش في أسراره.
لقد وجدت أن التفكير في طريقة ممنهجة علميا ونقديا للتعامل مع مجموعة من القصص يتطلب البحث عن نقطة التقاء، أو مرجع انتهاء لكل قصص المجموعة على تفرقها واختلاف مواضيعها، كأن ننظم القصص كافة على اختلاف عوالمها، وتعدد شخصياتها وزمانها ومكانها في مسرب واحد لا نزعم بالضرورة أنه يمثل كل تفاصيلها وجزئياتها، ولكنه يحيط بالصورة الكلية أو المعنى الجامع الذي يشغل الكاتب في شعوره أو لا شعوره.
وبناء على هذا الاقتراح النظري لمساءلة المجموعة القصصية واستكناه بعض خصائصها الفنية يمكن الإشارة إلى العناصر التالية:
1- العتبات النصية.
2- الكتابة المتوسِّلة.
3- البعد الاجتماعي من خلال المعتقدات الشعبية، ورصد بعض الوقائع الاجتماعية.
4- الدلالات الرمزية في بعض القصص.
5- اللغة والأسلوب.
1- العتبات النصية.
2- الكتابة المتوسِّلة.
3- البعد الاجتماعي من خلال المعتقدات الشعبية، ورصد بعض الوقائع الاجتماعية.
4- الدلالات الرمزية في بعض القصص.
5- اللغة والأسلوب.
1- العتبات النصية: أولى الكاتب أهمية كبيرة للعتبات النصية في مجموعته القصصية، وهي تشمل عنوان المجموعة، واقتباسات وإهداء وغير ذلك مما يسمِّه "جيرار جنيت" المصاحب النصِّي، وتكمن أهمية العتبات النصية في مساهمتها القوية في فهم النص بوصفها من خلاله، فالعنوان يحيل البطل وهو "حمودة"، ثم موضوع قصصه/ حكاياته وهي خواطر ترصد وقائع ظلت راسخة في ذهنه، عالقة بفكره لأنها فريدة، وهذا ما يستفز القارئ لمعرفة هذه الواقع ومصدر الإثارة فيها والغرابة، أما الاقتباس فهو عبارة عن آية قرآنية من سورة يوسف، توثق لحدث الكذبة التي حبكها إخوة يوسف، فلم تجد مكانها في منطق النبي يعقوب عليه السلام الذي اهتدى بحدسِه ومشاعره إلى الحقيقة، لكنه لم يجد إلا الصَّبر الجميل ضماذاً لِجُرحٍ لن يندمل، ويبقى السؤال لماذا بالضبط هذا الحدث يجعله الكاتب مفتاحا لمجموعته، القصصية، وكأنه يريد أن يقول للقارئ، أن إخوة يوسف منتشرين بيننا، وأن الذئب بريء مما نسب إليه، وأن الحكمة عند البلاء والابتلاء والشدة تقتضي التسلح بالصبر، وحقا عند قراءة المجموعة القصصية سنجد هذه الأبعاد حاضرة بقوة في بعض النصوص، أما الاقتباس الثاني فهو للأصمعي، عن أعرابي حدثه عن حوار رجل عني مع كلبه، بعدما أصابتهم المجاعة، وينطوي البيت الشعري الشاهد على وصف أو إعطاء صورة عن الغني الذي جاع بعد غنى وشبع، لكنه بمجرد ما يستعيد توازنه ولو افتراضا، سوف يعود إلى تكبره.
يقول الأعرابي: تشكَّى إلي الكلب شدة جوعه، وبي مثل ما بالكلب أو بي أكثر، فقلت: لعل الله يأتي بغيِّه فيضحي كلانا قاعدا يتكبر، يبدو أن "حمودة" الذي لا نعرف سنه بعد، سوف يرصد في خواطره وقائع لا تخلو من الإثارة والتشويق، وقائع يقوم فيها الصراع بين الخير والشر، وتلعب فيها الحكمة دور القاضي الذي يدين هذا ويبرِّئ ذاك، فالاقتباسات إلى جانب العنوان حتما ستجعل القارئ يتساءل عن علاقة قصة يوسف عليه السلام المليئة بالعبر بالوقائع التي ستكشف عنها خواطر حمودة.
أما الإهداء فهو أيضا يتأرجح بين الإضاءة والتعقيم، لعبة ألغُمَّيضة كما أحببت أن أصفها، أنا موجود ولكن يجب أن تبحث عني، فالكاتب مُمتن لملهمته التي شجعته على خوض غمار الكتابة، ومن باب الاعتراف بالجميل أن يهديها مجموعته القصصية ناهيك عن أمِّه وفلذات كبده أنس وهيثم، هذا هو الجزء الحاضر، الواضح أما الغائب المختفي فيظهر في قوله: "إلى كل يافع ويافعة لم تغادر مخيلتهما، تمثلات استعصى عليهما ضبطها على مسافة العمر" وقوله أيضا: "إلى كل من حمل همَّ جغرافية عصية الفهم". فكأنه يهدي مجموعته إلى أحبابه الذين يعتبرهم رفقاء الدرب وإلى كل من تحمل همَّ السؤال مثله والبحث عن ماهية الحياة وجوهرها وعن حقيقة الوجود وقيمته.
وبالانتقال إلى عناوين القصص التي تضمنتها المجموعة سنجد أنفسنا أمام مزيج لطيف من العناوين الملفتة المستفزة للقارئ. سواء كان دارسا أو عاشقا لفعل القراءة، فبعض العناوين تحيل على الواقع وتبعته من مرقده في ذاكرة كل إنسان شهيد أحداث الجائحة وعاشها بتفاصيلها المرعبة المُلغمة، الغامضة، مثل "مقهى كوفيد 19"، وقصة "الدببة والقردة في زمن كوفيد 19"، فلا أحد منا يريد أن يتذكر ما مرَّ بنا من خوف وهلع بسب تفشي الفيروس القاتل، ولكن نفس الوقت فضولنا سوف يدفعنا للبحث في القصتين عن حقيقة لم تكشف عنها وسائل الإعلام ولا الأحداث ولا العلم، حقيقة الفيروس، انتشاره ثم اندثاره، وما حصل بين الفترتين الزمنيتين من أحداث. كما نجد عناوين أخرى ذات طابع شعبي ترتبط بطقوس وعادات متعارف عليها في مجتمعنا المغربي مثل قصة "التَّحْرِيرَة"، قصة "العباسية"، وقصة "السقطة"، أما قصة حيرة بين "بركة الشريف" و"بركة اللقلاق"، فهي تختصر المضمون في المعتقد الذي أثر في سلوك الناس قديما والبعض حديثا من خلال الإيمان ببركة الأولياء، وتقديس بعض الحيوانات أو التطير منها.
هذا ولا تخلو العناوين من المراوغة الفنية التي تغازل ذكاء المتلقي وتجذبه إلى القصة طوعا بالإحالة على مرجعيات سياسية أصبح الخوض فيها ضرورة تمليها الأحداث الاجتماعية المتأزمة، مثل قصة برلماينو جزيرة "نيبالا"، ومعجم الطير ورموز الأحزاب السياسية و"جماعة المِقَصِّيِّين".
إن الكاتب باختياره العناوين المثيرة استطاع أن يلامس الواقع القديم بمعتقداته الخرافية، وتقاليده وأعرافه، مثل قصة "المعصرة"، وقصة الكتاب، المسيد، وقصة «لعبة النرد"، والواقع المعاصر بأحداثه السياسية عبر اقتحام مواضيع لطالما شغلت الرأي وأرَّقت المثقفين.
أما في قصة "حَدْسُ معشر الطير" فإن البطل كعادته وهو في شرفته يحتسي القهوة، أزعج عصافيره التي لازالت تحافظ على ساعتها البيولوجية، في حين يخضع الناس للقرار الحكومي بنقص ساعة، مما أثر على نفسيتهم وسلوكهم ولكن لأن الشعب حكيم فإنه يحاول التعايش مع الوضع تحت شعار "الفياق بكري بالذهب مشري".
لا يسع حمودة إلا أن يحترم عصافيره فاعتذر لها وهو يستنكر الزائد والناقص تعسفا على لغة الرياضيات.
2- المعتقدات الشعبية وأبعادها الاجتماعية: يحضر "حمودة" صاحب الخواطر في المجموعة القصصية بشخصيتين، فهو أحيانا الطفل الصغير المشاكس، المتمرد، الحامل لأسئلة الطفولة بمنطقها وفلسفتها، وأحيانا أخرى هو الرجل الناضج، العجوز كما يحب أن يلقِّب نفسه، المثخن بأسئلة الواقع الذي لم يعد غامضا عنده مثلما كان في الطفولة، يأخذنا معه في الزمن الحاضر إلى شرفته حيث يحتسي قهوته ويلاطف عصافيره، يقرأ جريدة أو يتصفح هاتفه المحمول أو يتأمل في الفضاء المحيط به ويعود بنا أيضا إلى الماضي ليلتقط أحداثا تنقشع في مخيِّلته بين الفينة والأخرى. لأنها تركت بصمتها في حياته وأصبحت جزء، من ماضيه ونافذة يطل منها على حاضره وهو يقارن بين شقاوة الأمس وحنكة اليوم، فالمسكين هو ذلك العجوز الذي يظهر في قصة متقاعد في "جزيرة الوقواق" رجلا يتخبط في مخاوفه من المشي وقد بلغ من الكبر عتيا، ورغم أنه لا زال يشعر باللياقة والطاقة فإن الانتظار في قاعة الصندوق المغربي للتقاعد للحصول على بعض الوثائق الإدارية وانتظار الدور، يجعله يشعر بالحسرة على سنوات العطاء التي لم تثمر اعترافا بتضحياته وتضحيات كل رجال التعليم مثله، وهو أيضا ذلك الطفل المشاكس الذي يحاول الانفلات من قبضة الخرافات التي كانت تسعى جدته تربيته عليها، ففي قصة "حيرة بين بركة الشريف وبركة اللقلاق"، يتذكر حمودة دعوة جدته إياه لزيارة مقدم الزاوية للحصول على بركته قبل اجتياز الشهادة الابتدائية، لا زالت صورة الرجل مُرتسمة في ذاكرته، بجلابيبه، وبرنسه الرمادي، وسبحته الطويلة المختلفة عن المقاس المعتاد، فقد اصطحبته الجدة ذات يوم إلى المقدم الذي مسح على رأسه وبصق في فمه بعد وضع مقدار ملح جعل ريقه يشعر الصغير حمودة بالاشمئزاز، أما اللقلاق فقد كان أهل القرية يلقبونه "بالشريف" وكانت الجدة تشحن خيال الطفل الصغير بأفكار ومعتقدات عن تقديس هذا الطائر الذي لم يتردد هذا الأخير في إصابته بحجر من مِقْلَاعِه اليدوي، فبعد أن رسب حمودة في الامتحان، ظل يتساءل عن بركة مقدم الزاوية مقابل محاولة إيذاء اللقلاق الشريف، فهل قوة الطائر بمنطق الجدة كانت أقوى من بركة المقدم أم أن النتائج لها علاقة بالجد والمثابرة والاستعداد الجيد.
كان "حمودة" الفيلسوف الصغير يحاول أن يفك طلاسم معتقدات آمن بها الكبار من أهله، فأثرت في سلوكهم وعلاقاتهم، ومثل ذلك نجده في قصة الضفدع" التي يتذكر فيها «حمودة" عودته من المدرسة بعد متابعته درس التفتح العلمي حيث تسرَّح أستاذه ضفدعة على طاولة الاشتغال، فقد فوجئ بجدته وهي تنثر حفنة الملح على ظهر ضفدع كبير، فهم من كلامها أنها تستعطف أهل المكان المتجسد في جسم الضفدعة ليذهبوا بسلام.
انتفض حمودة من خوفه الذي كانت الجدة تحاول إثارته وركل الضفدعة بقوة جعلتها تتطاير في الهواء، ثم تصنع الألم وصرخ مستنجدا بجدته موهما إياها بأنه تعرض للأذى بسبب الأذى الذي ألحقه بالضفدعة، ولكنه عندما رأى جدته كاد يغمى عليها أرجع رجله سيرتها الأولى. إنه يحاول أن يثبت لنفسه رغم صغر سنه أنه الأكثر عقلانية وفهما للأمور المحيطة به، يحاول أن ينشأ على الحكمة والعقل والمنطق، لا على الخرافات والتخلف والجهل، لقد كان يعيش وهو طفل صغير تضاربا بين المنطق والعقل، وبين المعتقدات التي كان من المستحيل إقناع الناس بخطئها ولذلك يكتفي بأن يتمرد عليها ولو يرفضها في الخفاء.
لا تخلو حياة "حمودة" من المغامرات الطريفة، وفي بعض قصصه/ خواطره يأخذنا معه إلى "عيون تيطيوين ليحتج على الواقع الذي يعيشه في ظل ندرة المياه، وليتأمل في ملكوت الله في رحلة وجودية يحضر فيها البعد الفلسفي، كما يتذكر في قصة "المسيد" موطنه القديم الذي تلقى فيه التعليم الأصيل، وترسخت مع التعليم معاملات وسلوكات بين أناس كانوا بسطاء في تفكيرهم وأسلوب عيشهم، وفي قصة "المعصرة" يصف طريقة عصر الزيتون التقليدية، لكن عنصر الخر افة يظل حاضرا عند أهل قريته الذين كانوا يلتزمون باحترام، أصحاب المكان أو بركة المكان بعدم الكلام والتزام الصَّمت أثناء الضغط على حمولة الزيتون المفروم، ولكن يبدو أن هذه المعتقدات المتعارف عليها والمعمول بها هي السِّمة المميزة لأناس أفرطوا في الخيال، فكانت حياتهم هادئة مستقرة في حين نحن الذين أفرطنا في العقل، نتجرع مرارة الحقيقة، حقيقة مجتمع يتحكم فيه حكام جزيرة نُبالا" والمقصيين، وغيرهم الذين يقرون المصير.
3- الدلالات الرمزية في بعض القصص: المبدع الحقيقي هو الذي يستطيع أن يغلِّف رؤاه ويجعل القارئ يشعر باللذة والإشارة، وهو يتقفى أثره المخفي من النص، ولن يستطيع المبدع ذلك إلا من خلال استخدام الرموز فكل نصٍّ أدبي ل بعدان: خارجي ميسور التناول، وداخلي غائر في أعماق النص يجعله المبدع وسيلة فنية عميقة تستجيب للدوافع الفنية وما تبعثه من إيحاء وما تثيره من متعة وتأمل، الكاتب محمد يسين في مجموعته القصصية يعالج قضايا اجتماعية شائكة ضمن حبكة القصص التي تبدو في ظاهرها بسيطة، لكن سرعان ما يفاجئننا بعبارات رنَّانة تخطفنا من هدوء الأحداث إلى صخب الحقيقة التي تكتشف عنها فالحيوانات في كل القصص رموز حتى العصافير التي يحاورها وهو في شرفته أحيانا تحمل موقفا كأي إنسان يحب أن يجادل ويحاجج ويناقش، والتحريرة ففي القصة يتذكر حمودة أيام الصبا، وفقيه الكُتَّاب الذي كان يثبت العصا في السقف، ولا تسقط هذه العصا إلا عند ارتفاع حناجر الأطفال بترديد القرآن الكريم، ورغم الحماس الذي تثيره فيهم هذه العملية التحفيزية، فإنهم ينتظرون بشغف ضيف المسيد الذي سوف يحرّرهم، ويحصلوا على وقت مستقطع للاستراحة. أما قصة "فك الارتباط" فإن الهر "فيكي" يرمز فيها حسب استنتاجات حمودة، إلى الوفاء، فهو يذكره بالشعب الفلسطيني الذي كان يمسك بمخالبه، ويطوق وطنه بإراداة قوية مثل ذلك الهرّ الذي تغير سلوكه من الهدوء إلى التمرد والثورة والغضب بمجرد ما أحسّ بأن العجوز "حمودة" سوف يعيده إلى الجمعية التي أخذه منها بعد بلوغه. قد أوحى له الهرّ بقيمة الارتباط بالمكان وأهل المكان ومن خلال سلوكه أدرك قساوة الترحيل القصري لدى الشعب الفلسطيني. أما تعرض الشاب عبد الله للقتل في حادث شجار بينه وبين أحد سكان القرية في قصة "قتل ومنطقيتة، لأن موعد سقي الماء كان يضبط على الساعة، والساعة متغيرة وغير ثابتة، فهل الساعة المقصودة هي الساعة الحَسنية(الفلاجية)، أو قمرية أم هي الساعة الإدارية، الجديدة أو القديمة.
3- الدلالات الرمزية في بعض القصص: المبدع الحقيقي هو الذي يستطيع أن يغلِّف رؤاه ويجعل القارئ يشعر باللذة والإشارة، وهو يتقفى أثره المخفي من النص، ولن يستطيع المبدع ذلك إلا من خلال استخدام الرموز فكل نصٍّ أدبي ل بعدان: خارجي ميسور التناول، وداخلي غائر في أعماق النص يجعله المبدع وسيلة فنية عميقة تستجيب للدوافع الفنية وما تبعثه من إيحاء وما تثيره من متعة وتأمل، الكاتب محمد يسين في مجموعته القصصية يعالج قضايا اجتماعية شائكة ضمن حبكة القصص التي تبدو في ظاهرها بسيطة، لكن سرعان ما يفاجئننا بعبارات رنَّانة تخطفنا من هدوء الأحداث إلى صخب الحقيقة التي تكتشف عنها فالحيوانات في كل القصص رموز حتى العصافير التي يحاورها وهو في شرفته أحيانا تحمل موقفا كأي إنسان يحب أن يجادل ويحاجج ويناقش، والتحريرة ففي القصة يتذكر حمودة أيام الصبا، وفقيه الكُتَّاب الذي كان يثبت العصا في السقف، ولا تسقط هذه العصا إلا عند ارتفاع حناجر الأطفال بترديد القرآن الكريم، ورغم الحماس الذي تثيره فيهم هذه العملية التحفيزية، فإنهم ينتظرون بشغف ضيف المسيد الذي سوف يحرّرهم، ويحصلوا على وقت مستقطع للاستراحة. أما قصة "فك الارتباط" فإن الهر "فيكي" يرمز فيها حسب استنتاجات حمودة، إلى الوفاء، فهو يذكره بالشعب الفلسطيني الذي كان يمسك بمخالبه، ويطوق وطنه بإراداة قوية مثل ذلك الهرّ الذي تغير سلوكه من الهدوء إلى التمرد والثورة والغضب بمجرد ما أحسّ بأن العجوز "حمودة" سوف يعيده إلى الجمعية التي أخذه منها بعد بلوغه. قد أوحى له الهرّ بقيمة الارتباط بالمكان وأهل المكان ومن خلال سلوكه أدرك قساوة الترحيل القصري لدى الشعب الفلسطيني. أما تعرض الشاب عبد الله للقتل في حادث شجار بينه وبين أحد سكان القرية في قصة "قتل ومنطقيتة، لأن موعد سقي الماء كان يضبط على الساعة، والساعة متغيرة وغير ثابتة، فهل الساعة المقصودة هي الساعة الحَسنية(الفلاجية)، أو قمرية أم هي الساعة الإدارية، الجديدة أو القديمة.
لقد اختار القوم في ضبط الساعة، غابت الحيثيات وثبت القتل، فماذا لو كان تغير الساعة وراء كل الفضيحة.
إن القصص أو الخواطر التي يرصد فيها حمودة الوقائع الفريدة تقوم على دلالات رمزية وتشكل معادلا موضوعيا لأحداث كبرى، وتحمل أسئلة سياسية، وفكرية وفلسفية ودينية قد تشكل فارقا في حلِّ معضلات اجتماعية، فكل قصة لا تخلو من حكمة أو عبرة يمكن أن نستنتجها من كل حدث أو حوار أو وصف مهما بدا بسيطا أو عابرا أو ثانويا أو سطحيا.
إن القصص أو الخواطر التي يرصد فيها حمودة الوقائع الفريدة تقوم على دلالات رمزية وتشكل معادلا موضوعيا لأحداث كبرى، وتحمل أسئلة سياسية، وفكرية وفلسفية ودينية قد تشكل فارقا في حلِّ معضلات اجتماعية، فكل قصة لا تخلو من حكمة أو عبرة يمكن أن نستنتجها من كل حدث أو حوار أو وصف مهما بدا بسيطا أو عابرا أو ثانويا أو سطحيا.
4- اللغة والأسلوب: لقد استطاع حمودة العجوز أن يجيب عن أسئلة حمودة الطفل التي ظلت عالقة في ذهنه، وتجسدت في أحداث قرر أن يختزنها في ذاكرته إلى اليوم، وهو الآن يستعيدها كما هي، ولكن يضفي عليها كل تفسيرات والتأويلات التي تناسبها، فهو أحيانا يتحدث بضمير المتكلم ليكشف عن هويته، وأناه وأحيانا أخرى يتحدث عن نفسه الغائبة أو ذاته التي يراها في بطل آخر يتقفَّى أثره ويصف إحساسه ويستبطن أغواره، لكن دون أن يغير اسمه. فحمودة في الرؤية من الخلف مثلا في قصة "الطلبة"، و"الضفدع"، هو نفسه "حمودة" في الرؤية المصاحبة ونجده مثلا في قصة محنة شجرة، وقصة "عيون تطوين"، وقصة "حديث الذبابة"، وقصة "فك الارتباط" وغيرها.
إن الحضور والانكشاف، والغياب والتواري جعلا من حمودة الطفل والعجوز يتناوبان على إمتاعنا بحكايات هي الموغلة في القدم، الموغلة في الحكمة والموغلة في الفلسفة، وذلك باستعمال تقنيات مثل الحوار الداخلي الذي لا يمكن تحليله إلا من خلال الاسترشاد بمعطيات الذاكرة وقدرتها على الاسترجاع والتذكر انطلاق من محفزات الحاضر، وقد دعا هذا الأمر إلى تبين علائق التشابك بين الذاكرة المسترجعة للصور، والمخيلة المؤسسة لها، وذلك كله ينشط في ضوء فلسفة اتجاه أدبي مهم، وهو تيار الوعي الذي يقود القصة في سياقها العام نحو خطاب الوعي وإمكانات التوليد الذهبي للتخلص من كل الأسئلة العالقة التي تثقل أحيانا الذاكرة، وتتعب نفسيا الكاتب/ المبدع.
أما لغة المجموعة القصصية، فهي لغة تقريرية تقوم على الوصف والسرد والحوار بنوعيه، كما تستعمل العامية على سبيل التناص، أي تناصص القصص مع نصوص أو عبارات أو جعل أو فقرات عامية، لكنها لا تخلُّ بجماليات السياق ولا تؤثر في البناء اللغوي العام للنص، فتوظيف اللغة العامية تمَّ بطرق إبداعية جعلت القارئ يستسيغ ألفاظها، خاصة وأنها تأتي على لسان الشخصيات التي تحاورت بها مع بعضها، مما أضفى عليها طابع الواقعية، فأصبحنا ونحن نقرأ "حمودة" الذي كان يعيش الحدث ويختزنه في ذاكرته تتحدث بلسانه ولسان شخوصه، ونفهم إشاراته وعباراته يقول الكاتب في قصة "عيون تطوين" ص74، "تذكرت قوله كان جدي يرددها عند كل إشكال قائلا: "إوى هنا عواج الفقوس"، ويقول في صخرة الريزو "الويفي". ص 69، هي نبتة الدوم أو "اعزف" كما نسميها، أحالت التسمية، حمودة على جمل، تعوَّد على سماعها من الجدة حين تقول "سبحان مخضر الدّوم في الصمايم". ويقول في قصة العباسية ص 55 واصفا موسم الحصاد: "بعد ذلك يأتي دور "الألواح" هي معدات كالمدرات غير أنها تنتهي بقطعة من خشب العرعر (مربعة الشكل) تستعمل في عملية التصفية(فصل الحبوب عن التبن)، حركات وحركات تتخللها شاعرية، تتوسل للرياح "ياهبوبة يا هبوب دِّي التبن خلي الحبوب، هذا وتخلل القصص ألفاظ عامية تعمَّد الكاتب تأثيث متخيله السردي بها لتطبعه بهويته المغربية، ويكون مرجعا لكل قارئ صغير السن ربما في عصره هذا لم يعد يسمع مثل هذه الكلمات، أو يسمعها ولا يعرف دلالتها، مثل حصير من "الشمار"، جرة فخار "حلابة"، موقد النار "الكانون"، العصا الطويلة "منفط" الإناء الأبيض "طبسيل"، يغرف الزيت من "النقير، "الصَّابة"، هذا ولا تخلو القصص من الاستشهاد بآيات قرآنية، تزكي أفكار البطل وتجعله يتدبر القرآن، ويستحضر عبره، فقد استشهد بقوله تعالى في سوره النمل: "﴿قَالَ اَ۬لذِے عِندَهُۥ عِلْمٞ مِّنَ اَ۬لْكِتَٰبِ أَنَآ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَنْ يَّرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَۖ فَلَمَّا ر۪ء۪اهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُۥ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّے لِيَبْلُوَنِيَ ءَآشْكُرُ أَمَ اَكْفُرُۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّے غَنِيّٞ كَرِيمٞۖ 41﴾"، ويقول في قصة عيون تطوين تذكرت آية الذكر الحكيم: "﴿۞أَوَلَمْ يَرَ اَ۬لذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ اَ۬لسَّمَٰوَٰتِ وَالَارْضَ كَانَتَا رَتْقاٗ فَفَتَقْنَٰهُمَاۖ وَجَعَلْنَا مِنَ اَ۬لْمَآءِ كُلَّ شَےْءٍ حَيٍّۖ اَفَلَا يُومِنُونَۖ 30﴾"
يربط "حمودة" في كل خواطره بين الواقع، بين المنطق والعقيدة ويحاول أن يضعنا أمام نصائح وتوجيهات ضمنية، لنستفيد من تجاربه ليس بصيغة الآمر الناهي، ولكن بصيغة الجدال والحجاج في قالب سردي الغرض منه ضرب المثل، وأخذ العبرة والاستفادة من تجارب الآخرين، وتوجيه الرأي العام، وإدانة الواقع ورفض أشكال الظلم والاستبداد.
وفي الأخير لا يسعني إلا أن أعرب عن إعجابي الشديد بأسلوب "حمودة" في النظر إلى الحياة وفهمها انطلاقا من مرجعيات دينية ونفسية وفلسفية وغيرها، فالطفل فينا لا يكبر وتظل بعض أحداث الماضي حاضرة فيه، تزعجه وتؤرقه متى تعرَّض للاستفزاز في الحاضر، ولكن لو استرجعنا تلك الحداث وحلّلناها وفسرناها سنجدها خبرة لم يُكشف عنها آنذاك لأن عقلنا الصغير لا يمتلك آليات لتفسير كل ما يجري، إذن يجب أن نتحول إلى "حمودة" العجوز الحكيم الهادئ، المتصالح مع ذاته، الذي يجد في شرفته عصافيره التي تؤنس صمته، وقهوته التي تبث فيه لذة الحياة، "فحمودة" الطفل لم يعد منزعجا من الماضي ولا خائفا من المعتقدات التي تربى عليها، لأنه يتفسح في المدينة، يراقب ويتابع أخبار الحملات الانتخابية، يتردد على مقهى كوفيد 19، يعرف أن البحر يبتلع آلاف الشباب الذين يبحثون عمَّا وراءه من أحلام، يتعاطف مع الفلسطينيين ولا تنطلي عليه حيل ولغة وأكاذيب البرلمانين.
لعبة الاسترجاع هذه فكّت طلاسم اللعبة، وجعلت حمودة الحاضر امتداد للحمودة الماضي، كلاهما الرجل والطفل يندمجان معا ليشلا صورة عن المواطن المغربي بين الأمس واليوم، والأمس البسيط والحاضر المعقد، الأمس المثخن بالأسئلة، والحاضر الذي يحمل ألف جواب.
لعبة الاسترجاع هذه فكّت طلاسم اللعبة، وجعلت حمودة الحاضر امتداد للحمودة الماضي، كلاهما الرجل والطفل يندمجان معا ليشلا صورة عن المواطن المغربي بين الأمس واليوم، والأمس البسيط والحاضر المعقد، الأمس المثخن بالأسئلة، والحاضر الذي يحمل ألف جواب.
"حمودة" لم يكبر، وإنما نضج فكريا وثقافيا وإنسانيا وأصبح اليوم قادرا على قراءة الماضي قراءة صحيحة لا تحمل أي عقدة أو حقد أو كآبة أو شعور بالخوف من الذكريات والتذكر، وتلك قمة التصالح مع الذات التي يسعى الإبداع إلى تحقيقها لدى المبدع بصفة عامة.
هذا بالنسبة لقصص الطفولة، أما قصص الواقع فهي المرآة التي تنعكس فيها نظرة متقف إلى الأحداث-ما ضهر منها وما بطن-حوله، وطريقته في الاحتجاج عليها ومساءلتها لعل إثارتها تحدث ضجة البحث عن الحلول المثلى لمعضلات العصر.
- قال تعالى: ﴿وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءٗ يَبْكُونَ 16 قَالُواْ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَٰعِنَا فَأَكَلَهُ اُ۬لذِّيبُۖ وَمَآ أَنتَ بِمُومِنٖ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَٰدِقِينَۖ 17 وَجَآءُو عَلَيٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٖ كَذِبٖۖ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُۥٓ أَنفُسُكُمُۥٓ أَمْراٗۖ فَصَبْرٞ جَمِيلٞۖ وَاللَّهُ اُ۬لْمُسْتَعَانُ عَلَيٰ مَا تَصِفُونَۖ 18﴾