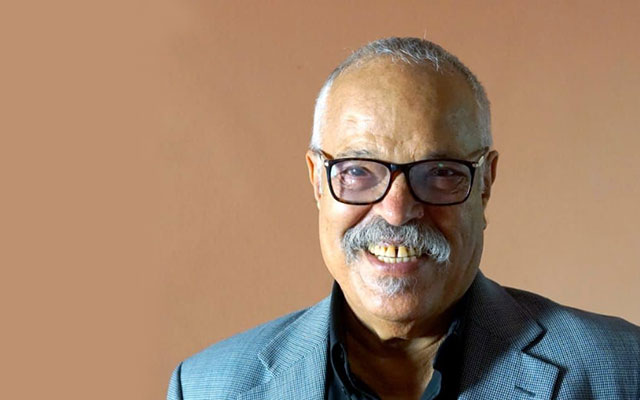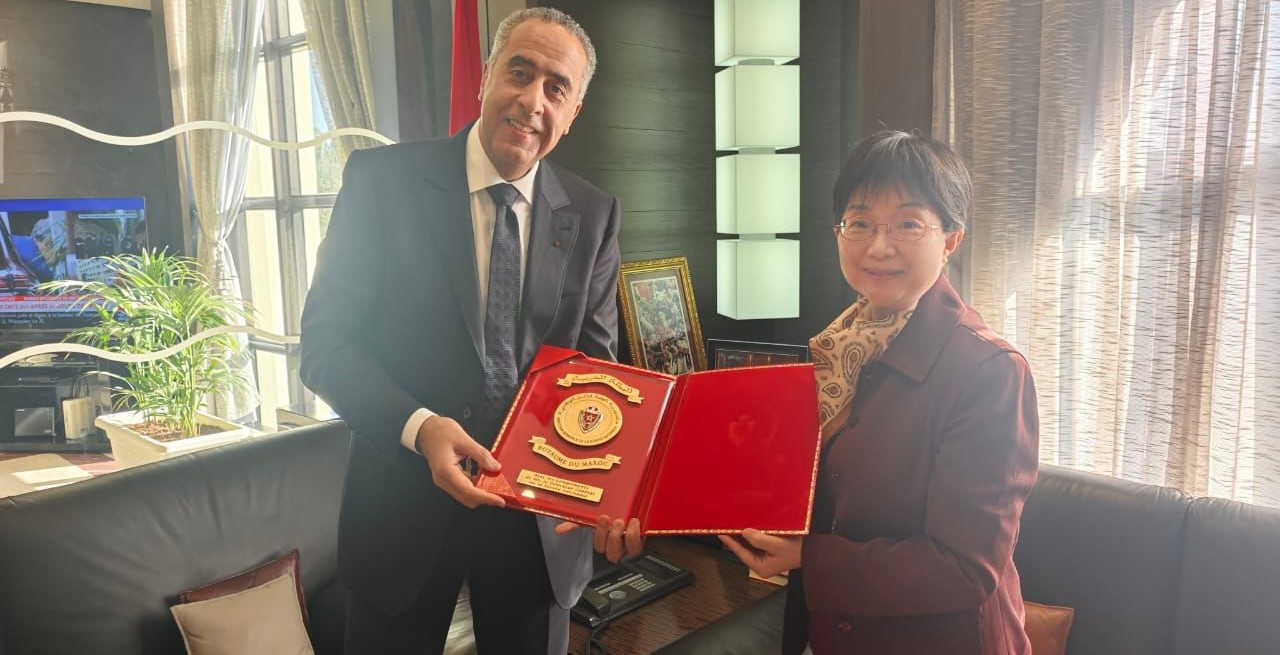يقول الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، من الولاية التشريعية العاشرة، بتاريخ 13 أكتوبر2017: "إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذا الصدد، ندعو الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد. إننا نتطلع لبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات التي أبانت عنها التجربة".
يبدو أن "نموذجنا التنموي" الحالي قد استنفذ كل طاقته، وبلغ مداه، ويجب إعطاؤه نفسا جديدا، وبالتالي تجاوز العراقيل التي تحول دون تطوره، من خلال إعادة النظر في ترتيب أولوياته، الاقتصادية والاجتماعية، بما يمكن من الحد من الفوارق، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية. لكن في المقابل، هذا لا ينفي أن بلادنا حققت من خلال هذا النموذج، مكتسبات عديدة، على مستوى التوازنات المالية، والبنيات الأساسية، والإستراتيجيات القطاعية.
يعاني "النموذج التنموي المغربي" الحالي، كما أصبح معلوما، من تحديات كثيرة، وعوائق ومتنوعة؛ ناتجة عن الجوانب السلبية لمدخلاته، بمختلف أنواعها؛ مثل ضعف حجم الاستثمارات المخصصة للتنمية، وســـــوء استغلال الموارد، وغياب الحكامة الجيدة في إدارة المشاريع التنموية، وانخفاض مستويات الإنتاجية، وضعف الكفاءة الاقتصادية لكافة القطاعات، وغياب الأمن الغذائي، وضعف الأمن الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتفاع نسب البطالة، وانتشار الفقر، والبطء في استيعاب العلم والتكنولوجيا الحديثة واستخدامها لأغراض التنمية. ويرجع القصور التنموي في المغرب بالأساس، إلى فشل التحكم في علاقاته الاقتصادية بالسوق العالمية، وخضوعه المستمر لتبعية تجارية ومالية وثقافية وتكنولوجية، وتغييب الإنسان لسنوات طويلة، عن عملية التنمية؛ الأمر الذي يتجلى في ضعف أداء المنظومة التعليمية والتكوينية، وعدم ملاءمتها مع مستلزمات التنمية؛ إضافة إلى تهميش الطاقات الابتكارية، وقصور الأداء السياسي، وضعف تأهيل الدولة للانخراط في مشروع الديمقراطية، وتهميش المجتمع المدني، على مستوى اتخاذ القرار في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لقد تميزت السنوات الأخيرة في المغرب، بإكراهات عديدة، على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ وهو ما يحتم على الجميع، التحرك لتجاوزها، وخلق الظروف الملائمة لتأهيل الاقتصاد وتحقيق التنمية، وذلك بخلق مناخ ماكرو اقتصادي نظيف، مبني على المنافسة الحرة، وإلغاء نظام الاحتكارات، وترشيد النفقات العامة، عن طريق تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وإنعاش المقاولات الخاصة، الصغرى منها والمتوسطة والمتناهية الصغر، وإصلاح النظام القضائي، والتخفيف من العبء الإداري، وعقلنه عملية احتساب الضرائب، وتوسيع الوعاء الضريبي، والحد من العشوائية في قرارات الإدارة الجبائية، وتبسيط المساطر، وإتباع نظام صارم للمراقبة؛ إضافة إلى توسيع وتشجيع المبادرات الاستثمارية المنتجة، العمومية منها والخاصة، واتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع الاجتماعية، من خلال التفكير في وسائل وآليات للعمل على تصحيح الاختلالات والفوارق، وتحسين ظروف عيش المواطن، ومحاربة الفقر ومختلف أشكال الحرمان، عبر تعميق البعد الاجتماعي، والحرص على بلورة روح التضامن بين أفراد الأمة؛ الأمر الذي يتطلب مواصلة الإصلاحات البنيوية والقطاعية، وذلك من خلال التدبير الجيد للإدارة العمومية، وتمكين المرأة، وخلق مجتمع المعرفة، وإصلاح التعليم، وخاصة النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي، حتى يكون رافعة للتنمية؛ كذلك ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتوطيد دعائم الديمقراطية، وسيادة القانون، وتقوية المجتمع المدني؛ أي بمعنى آخر، خلق شروط نمو اقتصادي قوى ودائم، يفضي إلى تنمية حقيقية، شاملة ومستدامة.
إن النموذج التنموي الذي نطمح إليه، هو الذي يحقق ثلاث أهداف جوهرية؛ يمكن تلخيصها في ما يلي: توفير الحاجات الأساسية، حيث يحتاجها الإنسان لاستمرار حياته، وتتمثل في الغذاء والمسكن والصحة والحماية من مختلف الأخطار؛ ويحتاج إلى رفع مستوى معيشته، ويتحقق ذلك بزيادة دخله، وتوفير فرص العمل أمامه، ورفع مستوى التعليم والصحـــــــــة، والارتقاء بالقيم الإنسانية والثقافية في المجتمع؛ ويحتاج كذلك احترام الحريات والحقوق الأساسية، وسيادة القانون. ويرتبط تطور أهداف التنمية في السنوات الأخيرة، بتطور مفهوم التنمية نفسه. لذلك، يمكن إضافة هدف آخر بالغ الأهمية؛ وهو الحفاظ على البيئة، حيث إن تحقيق رفاهية الأجيال الحالية، يجب أن لا تكون على حساب استنزاف الخيرات والموارد الطبيعية، لأن في ذلك إجحاف بحقوق الأجيال المستقبلية.
تتحقق التنمية في ظل نظام حكم مستقر، يسوده القانون، وتحكمه مبادئ الدولة الاجتماعية والتضامنية، التي يجب أن تسعى جاهدة، وفق آليات الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، وفي ظل جهوية متقدمة، قائمة على اللامركزية، وعلى الحكامة الترابية، إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتسريع التنمية الصناعية، وتأهيل المقاولة وتنظيم القطاع غير المهيكل وإدماجه في النسيج الاقتصادي المنظم، وذلك بهدف الرفع من وتيرة التشغيل وإدماج الشباب؛ وهو ما لا يتم إلا من خلال النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعبر سياسات عمومية مستدامة.
إن أي نموذج تنموي، مهما بلغ من النضج ومن الطموح، لن يكون ناجعا ويحقق أهدافه، إلا من خلال تخطيط دقيق ومحكم، ومن خلال نظرة إستراتيجية وبعيدة المدى، وعبر توافر عوامل متعددة وذات أهمية بالغة، اقتصادية وسياسية وقانونية ومؤسساتية واجتماعية، وثقافية... كالمناخ السياسي الملائم، والديمقراطية الحقيقية، والمسؤولين الوطنيين الذين يؤمنون إيمانا قويا، بجدوى الإصلاح وضرورة التغيير، وذلك بالاعتماد على الذات، لضمان نمو مستقر ومستدام، وعلى الموارد المحلية، وعلى الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار في مشروعات البنية التحتية الأساسية، والتنوع في البنية الصناعية، وتغطيتها لمعظم فروع النشاط الصناعي، والاهتمام بالبيئة والثقافة وبرأس المال البشري، لتحسين المؤشرات الاجتماعية، وتحسين الأحوال المعيشية والتعليمية والصحية لعموم المواطنين، والقضاء على الفقر أو على الأقل تقليصه، وتمكين المرأة، وحماية المستهلك؛ إذ التفاوت الكبير في المداخيل وفي توزيع الثروة، يعتبر في الكثير من الأحيان، من الأسباب المباشرة لفقدان الاستقرار الاجتماعي، وربما حتى السياسي، وفي وقوع العديد من المشاكل والاضطرابات.
وعليه، فإن مكاسب التطور الاقتصادي، يجب أن تنعكس إيجابا على جميع المواطنين، في تحسين حياتهم المعيشية، وتعميم، بل تجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهو ما يفرض من جهة، مفهوما جديدا للدولة، ودورا أكبر للفئات الميسورة من دوي المال والأعمال، لتساهم بدورها من خلال الاستثمار المنتج، في خلق فرص شغل حقيقية؛ ومن جهة أخرى، تأهيلا سياسيا، وتعبئة للموارد وتطويرا للإنتاج؛ وآليات جديدة لخلق الثروة، وتنظيما لسوق الشغل، ودعما عموميا حقيقيا وشفافا، وقروضا تضامنية، بدون فوائد أو على الأقل، بمعدلات فائدة رمزية، بهدف خلق نشاطات مدرة للدخل، تستفيد منها الفئات الأكثر فقرا؛ بالإضافة إلى العمل على خلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي، وذلك بتسهيل ولوج المستثمرين للعقار الفلاحي، عبر تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية، وفق مقاربة تجمع بين الإنجاز الفعلي للمشاريع الاستثمارية، والحد من التجزئة المفرطة للاستغلاليات الفلاحية، وتوفير المواكبة التقنية والمالية المطلوبة؛ كذلك تثمين المنتوجات الفلاحية وتطوير آليات تسويقها، داخليا وخارجيا، خاصة بالنسبة لصغار الفلاحين.
لكن نحتاج قبل كل ذلك، إلى إرادة سياسية قوية، تجعل من ثقافة التضامن وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة والكاملة، أولى أولوياتها، وتعمل على تحسين المستوى المادي والمعنوي للفئات المحرومة، وتوفير الخدمات الاجتماعية بالمجان وبالجودة المطلوبة، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وذلك بالإجراءات الملموسة التي تفضي إلى خلق حيوية اقتصادية واجتماعية، وتحقيق السلم الاجتماعي، وذلك اعتبارا للموقع الإستراتيجي الذي تحتله هذه الطبقة داخل البنية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
إن الحديث اليوم عن نموذج تنموي جديد بالنسبة لبلادنا، يعني فيما يعنيه، أن نرى المغرب، بكل قيمه التقليدية وتاريخه العريق وخصوصيته الاستثنائية وتجاربه السياسية، يجعل من الإنسان محورا أساسيا لكل برامجه وسياساته؛ الأمر الذي لن يتحقق إلا بتجاوز جميع العوائق المرتبطة بالمصالح الضيقة أو بالانشغالات الانتخابية، وقيادة المجتمع بكل فئاته وثقافاته، نحو مستقبل أفضل؛ تكون من أبرز معالمه: تثبيت مقومات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتوزيع عادل للثروة، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، والسهر على احترام القانون، وتحقيق الإمكان البشري، والقضاء التدريجي على الفقر والأمية، وتأهيل العنصر البشري، وولوج عالم المعرفة، وتقوية المجتمع المدني، وإتباع أساليب الحكم الصالح كمطلب تدبيري وتنموي، يساعد الأشخاص والمؤسسات على اتخاذ قرارات ناجعة وبلوغ أهداف مشتركة، على أساس من المشاركة والمراقبة والمحاسبة والشفافية.
إننا لا زلنا نتردد في اتخاذ قرارات جدية لمواجهة المستقبل؛ وهذا هو موضوع الأزمة حيث نلاحظ إلى يومنا هذا، قصورا في التنمية، وترددا في مقاربتها ككل شامل، لا يقبل التجزئة؛ كما نلاحظ كذلك قصورا في الأداء السياسي، وضعفا في تأهيل الإدارة، للانخراط في مشروع مجتمعي حقيقي ومتكامل؛ يضاف إلى ذلك، الضعف الكبير في البحث العلمي، وفي أداء المنظومة التعليمية، وعدم ملاءمتها مع مستلزمات التنمية، وأيضا التهميش الذي يطال العديد من الطاقات الابتكارية، العلمية والثقافية والفنية والرياضية…
لقد خطا المغــــــــــرب بالفعل، خطوات مهمة نحو توطيد النهج الديمقراطي كخيار استراتيجي، في اتجاه تحقيق التنمية، وتكريس دولــــــــــة القانون، وتثبيت قيم الحرية والديمقراطية؛ وهي مكتسبات مهمة، تحققت في إطار النموذج التنموي المغربي الحالي، والتي يجب تثمينها؛ لكن رغم ذلك، مجهودات كبرى يجب أن تبذل، في اتجاه تثبيت استقرار الإطار الماكرواقتصادي، كشرط أساسي لتأهيل الاقتصاد، وجعله قادرا على خوض المنافسة العالمية، وتأمين نمو اقتصادي متين ودائم؛ كذلك تحقيق التوازنات الاجتماعية الكبرى لضمان سلم اجتماعي حقيقي، والعمل على تجديد الثقة في العمل السياسي، وذلك بتخليق الحياة العامة وتنقيتها من كافة أشكال الفساد المالي والإداري والسياسي، وتحسين الإطار المؤسساتي، وتحسين ظروف العمل بالنسبة للمقاولات: وذلك بـتبسيط الإجراءات الضريبية والإدارية، وتحمل الدولة لبعض النفقات التي تتعلق بالبنيات التحتية، وتحديد معايير انتقاء المناطق التي يمكن أن تستفيد من الدعم الذي تقدمه الدولة، والعمل على تخفيف تكلفة العوامل الإنتاجية، من خلال تخفيض تكلفة الأراضي، وذلك بخلق مناطق صناعية مندمجة، وتخفيض تكلفة المال (معدلات الفائدة) وتخفيض الفاتورة الطاقية؛ كذلك إقرار حوافز مهمة، تتعلق بجلب الرساميل الأجنبية، بالنظر إلى ضعف الموارد المحلية التي يمكن أن توجه إلى الاستثمار؛ فالادخار الداخلي الخام يمثل اليوم فقط %13 من الناتج الداخلي الإجمالي؛ إضافة إلى تطوير التكنولوجيا والبحث العلمي الذي يفضي إلى حماية البيئة واقتصاد الطاقة، وتشجيع المنعشين والمقاولين الجدد والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكذا الحرف المهنية.
إن السياسات التي تحمل في طياتها أساليب دعم التنمية، تبنى أساسا على القضاء على الفساد بمختلف أنواعه؛ وتصحيح الخلل الكبير في توزيع الثروة الوطنية؛ والانتقال من مجتمع مستهلك إلى آخر منتج، من خلال العمل بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي لا تحتاج إلى أموال ضخمة للاستثمار؛ كذلك إعطاء أهمية قصوى للتنمية البشرية، ومنح قروض بدون فوائد لبناء المشروعات الصناعية والزراعية، والاهتمام بالتنمية القروية؛ كذلك الاهتمام أكثر بالاستثمار المسؤول اجتماعيا، والعمل على تعميق مفهوم التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لرجال الأعمال، وتوظيف التعليم العالي لخدمة الاقتصاد، وربطه بأنشطة البحث العلمي، وتوفير الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والسكن، وباقي الخدمات التي يحتاجها المواطن، والاستمرار بالموازاة مع كل ذلك، في سياسة الأوراش الكبرى، وإنشاء البنيات التحتية الأساسية.
إن بنـاء نموذج تنموي جديـد، وما يواكبه من تصحيح للاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، لا يمكن أن يتم إلا في ظل نظام اقتصادي عالمي جديد في بنياته ومؤسساته، حتى تصبح العولمة بحق رافعة أساسية للتنمية، خاصة بالنسبة للدول النامية؛ هذه العولمة التي أصبحت اليوم، واقعا حقيقيا، يفرض نفسه على الجميع، وأصبح الاقتصاد العالمي والسوق العالمية، تتقوى يوما بعد يوم، لتخلق فضاء عالميا، يتجاوز الدول وإمكاناتها الوطنية، ولا نستطيع اليوم السيطرة عليه أو التحكم فيه، إلا بقدر ما نستطيع أن نشارك في الإبداع في إطاره. وانطلاقا من كل هذا، يبقى تحكم المغرب في سياساته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوجيه اقتصاده، واعتماده على نفسه، وتطوير الوسائل الذاتية لنموه، ضمانة هامة وأساسية من الضمانات الأخرى التي ستمكننا من تجنب الآثار السلبية للعولمة، وتحقيق التوازن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي