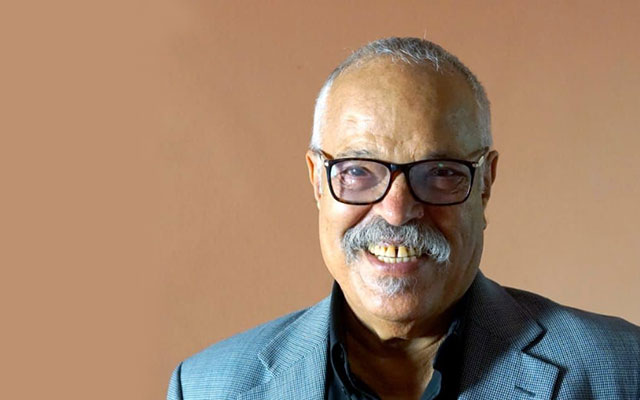إن مشاركة هذا العدد الهائل من وسائل الإعلام الدولية، والعدد الكبير من الصحفيين في عملية التحقق من صحة معلومات وثائق بنما قبل نشرها يعني أن تسريبها تدارك أخطاء المغامرة التي نسبت إلى جوليان أسانج وموقع ويكيليكس، كما استفاد من ارتباكات ما تم تصويره كصحوة ضمير قيل إنها انتابت إدوارد سنودن.
على العكس من ذلك تماما نحن أمام عمل منظم لا تتقنه سوى جهات استخباراتية نافذة وقوية تعرف جيدا الأهداف المتوخاة منه، ولا تأمر به سوى قيادة سياسية في كيانات عظمى، حيث الارتجال والمزاج والتفرد بالقرار في القضايا الكبرى ممنوع على الساسة، الذين عليهم الوفاء بوعودهم الانتخابية قدر المستطاع، وإلا كان عقاب صناديق الاقتراع شديدا.
إن نوعية الشخصيات السياسية والنجوم المجتمعية والرياضية والفنية المثارة أسماؤها في الوثائق تؤكد أن واشنطن ألقت بهذه القنبلة ذات الانفجار الكوني الواسع لأكثر من سبب في هذه المنطقة أو تلك من العالم، قاصدة استعمال بعض الأسماء لمجرد ادعاء الموضوعية وتحاشي تهمة الانتقائية، خاصة وأنه لحد الآن لم يظهر تورط أي شخصية سياسية أمريكية من العيار الثقيل رغم أنه زمن الانتخابات الرئاسية وما يرافقها من انتخابات جزئية تشريعية وولائية، حيث الضرب تحت الحزام وفوقه مباح وجائز.
انطلاقا من هذه المعطيات الأولية يتوجب النظر إلى موضوع تسريب وثائق بنما في سياق مخططات السياسة الخارجية الأمريكية على الأقل وفق ما رسمتها عقيدة أوباما، التي عمل على تطبيقها خلال ولايتيه الرئاسيتين، وكما سردها جيفري غولدبيرغ في مقاله بنفس العنوان في مجلة ذي أتلانتيك. والأوجب الاهتمام بما قد تحدثه من انعكاسات في الساحات العربية التي وردت أسماء شخصيات وازنة فيها ضمن الوثائق، خاصة وأن من المحتمل جدا أن تواصل الإدارة الأمريكية المقبلة تنفيذ مخططات أوباما أو الجزء الأكبر منها على الأقل.
كان الرئيس أوباما يدرك جيدا وهو يستهل ولايته الأولى أنه سيكون رئيس أقوى دولة في العالم، ولكنه كان على دراية بأن القوة الأمريكية ليست لا متناهية، ومؤمنا بأنه لا يجب تحت أي ظرف من الظروف المغامرة بالجنود الأمريكيين وتعريضهم للخطر لمنع كوارث إنسانية عبر العالم ما لم تكن تلك الكوارث تشكل تهديدا أمنيا جديا ومباشرا للولايات المتحدة الأمريكية، سيما في مناطق يطلب إلى الأمريكيين الهرولة للدفاع فيها عن قيم الحداثة والديمقراطية بينما أهلها وقادتهم يرفضون تبني تلك القيم، التي حين تفرض عليهم يتبنونها بشكل صوري فارغة من أي محتوى، ويتحججون للتهرب مما يطلب منهم بالخصوصية أو بالاستثناء.
بهذه القناعة، واحتراما لتوجهات الرأي العام الأمريكي دخل الرئيس أوباما البيت الأبيض عازما على الانسحاب من العراق وأفغانستان، متسلحا بحالة من الحرص وعدم الاندفاع بانفعال في ساحة دولية ".. أصبحت أكثر غموضا وتعقيدا"، وحذرا تجاه التورط عسكريا حيثما لا يكون الأمن القومي الأمريكي في خطر.
وعلى خلاف ما كان يعتقده العديد من المراقبين بمن فيهم مسؤولون في الإدارة الأمريكية، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكل ما تعيشه بعض أقطارها من مآسي وما تشهده من حروب وصراعات، ونمو في الحركات والجماعات الإرهابية المتطرفة لم تعد تمثل خطرا حقيقيا على أمن الأمريكيين. فالإرهاب كما نقل جيفري غولدبيرغ عن أوباما "يحصد أرواحا في أمريكا أقل بكثير من المسدسات وحوداث السيارات والسقوط في أحواض الاستحمام".
من هذا المنطلق لم يكن مستغربا، كما كتب جيفري غولدبيرغ، أن يقول الرئيس الأمريكي " إن داعش لا تمثل تهديدا وجوديا للولايات المتحدة، فيما يشكل تغير المناخ تهديدا وجوديا على العالم بأسره إذا لم نقم بشيء حياله" ؛ بل مع صعود داعش تضاعفت قناعة أوباما بأن الشرق الأوسط لا يمكن إصلاحه ليس فقط في عهده، وإنما لجيل قادم بأكمله.
هكذا توصل الرئيس الأمريكي إلى أن الشرق الأوسط ينبغي تفاديه، وبفضل ثورة الطاقة في أمريكا لن يكون لهذه المنطقة أي أهمية تذكر بالنسبة للاقتصاد الأمريكي عكس آسيا التي تمثل في رأيه المستقبل، وكل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية اللتين يستحقان اهتماما أمريكيا أكثر بكثير مما يحصلان عليه. كيف لا والقارة الأمريكية على سبيل المثال تستحوذ على ما يناهز 40% من حجم التجارة الأمريكية مع العالم، وظلت دائما بمثابة حديقة خلفية لواشنطن.
فالإنسان في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ورغم مشاكل الفقر والعوز والفساد طموح ونشط، ويتطلع إلى المستقبل مكافحا بشراسة ولهفة للتعلم ولتحسين مستواه وولوج عالم الحداثة والثروة المادية. إنه كما يقول أوباما يفكر كيف يحصل على تعليم أفضل وكيف يصنع شيئا ذا قيمة، ولا يفكر في قتل الأمريكيين، مثلما يفكر بعض شباب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحاقد على قيم الحضارة الغربية وثقافتها.
وقد ازداد إيمان الرئيس أوباما بتجنب الانغماس الكلي في شؤون المنطقة من خلال تطورات الوضع في ليبيا، التي قال إن بلاده خططت بعناية فائقة لعملية الإطاحة بالعقيد القذافي، ومع ذلك ما تزال هذه البلاد في وضع كارثي، معترفا بأن مستوى الانقسام القبلي فيها أكبر مما توقعه المحللون الأمريكيون، وأن البنية المدنية والعسكرية التي كونتها المخابرات الأمريكية هناك بغية التفاعل معها لأجل المستقبل انهارت بسرعة.
والأكيد أن توالي الخيبات وانتكاسة العديد من المشاريع هو الذي جعل الرئيس أوباما يستنتج بأن الشرق الأوسط يستنزف أمريكا فقط، خاصة بعد أن تزامنت تلك الخيبات والانتكاسات مع الإحباط الذي أصابه من جراء تصرفات قادة دول المنطقة بمن فيهم رئيس وزراء إسرائيل الذي وصفه بالخائف والعاجز سياسيا، والرئيس التركي المستبد والفاشل في نظره. فقد كان يأمل من أولئك القادة أن يفتشوا فعلا، وعن كثب عن جذور تعاسة شعوبهم، ولم يفعلوا حسب رأيه.
يعتقد أوباما أن هذه التعاسة تتجسد في أنظمة حكم فشلت في توفير الازدهار وفرص الترقي لشعوبها، لأنها لم تعمل على تأسيس تقاليد مدنية أكثر من بناء منظومة استبدادية، وأن قادة دول المنطقة لم يتجاوبوا مع متطلباته التي استهلها في خطاب القاهرة سنة 2009 بالدعوة إلى حوارات مجتمعية شاملة لمعالجة المشاكل الحقيقية، وتابعها في اتصالاته الدبلوماسية بالتشديد على بذل المزيد للقضاء على تهديد "الأصولية العنيفة" من خلال إيجاد صيغة تساعد الناس على تكييف أمثل لعقائدهم الدينية مع قيم الحداثة.
إن الاعتداد بالنفس لدى الأمريكيين الذي يصل بسبب فائض القوة العسكرية والاقتصادية إلى حدود الغطرسة يجعلهم لا يستسيغون كيف تستعصي عليهم عملية التغيير التي أرادوها في الشرق الأوسط، ويرفضون أن يستهزئ بهم من فشلوا في بناء دول، ليسمحوا للمنطقة بالارتداد إلى ما يسميه أوباما "القبلية Tribalism «(القبلية بمعنى الجماعة الصغيرة المتقاربة فكريا وطائفيا وعرقيا)، التي يعتبرها أكثر القوى المدمرة في الشرق الأوسط.
ما العمل إذن؟
رغم أن القضايا الدولية أصبحت أكثر تعقيدا، فإن الرئيس أوباما يرفض أسلوب تضخيمها، كما يرفض تبسيطها في ذات الوقت، ويرى أن من مصلحة أمريكا أن يكون شعارها في الشرق الأوسط منسجما مع مقولة الفيلسوف طوماس هوبز "حرب الكل ضد الكل". وبدون تأجيج صراعات تستنزف الجميع لن يكون بالإمكان لجم النزعات المذهبية المتطرفة. فبالنسبة له "لا يوجد حل شامل لـ "لإرهاب الإسلامي" حتى يوفق الإسلام نفسه مع الحداثة، ويتبنى بعضا من الإصلاحات التي غيرت المسيحية".
يعني هذا أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في وارد الانسحاب التدريجي من المنطقة، ولكنها استوعبت تناقضاتها وتشابكات العلاقات داخلها فيما بين مكوناتها، ما جعلها تفضل أسلوب القيادة من الخلف، الذي لا يكلفها ماديا وبشريا وسياسيا الكثير كما هو الشأن عند التدخل المباشر، ودفعها إلى سعي محموم نحو تلغيم الأوضاع في كل مكونات المنطقة على قاعدة "اشتدي أزمة تنفرجي"، مستفيدة من انعدام ثقة واسع بين الشعوب وقادتها، وبين الدول أيضا فيما بينها.
بهذا الأسلوب يبدو صانع القرار الأمريكي وقد استوعب جيدا من التراث العربي دهاء معاوية بن أبي سفيان تاركا نموذج استبداده لورثته الشرعيين. لقد تعلم ألا يضع سيفه (ترسانته العسكرية الضخمة والمدمرة) حيث يكفيه سوطه (العقوبات المتنوعة والمقاطعة وتجميد الأموال..)، ولا يضع سوطه حيث يكفيه لسانه ( وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وما يجري تسريبه لها من فضائح ووثائق من ضمنها الآن وثائق بنما..).
يفتخر الرئيس أوباما في عقيدته بأنه أممي ومثالي أيضا، يؤمن بشدة بضرورة تعزيز الديمقراطية والحقوق والمعايير والقيم الإنسانية عبر العالم، لأنها تساعد في تحويله إلى مكان للعيش أفضل، وفي ذلك كما يقول مصلحة أمريكية مؤكدة؛ الأمر الذي يفيد بأن واشنطن لن تتخلى عن الأهداف التي ترومها، ويرجح أن وثائق بنما تصب في هذا الإطار، خاصة وهي كشفت قيادات سياسية تحدت بشكل أو آخر الإرادة الأمريكية ولو مؤقتا.
لقد جاءت الوثائق لتشويه مصداقية بعض هذه القيادات السياسية أمام شعوبها، وتمريغ هيبتها في وحل الفساد بعد أن ظلت واشنطن تصمها بتهمة الاستبداد. وهي بهذا تكملة لما تحقق من فوضى خلاقة مع نشر وثائق ويكيليكس، وخطوة لتجاوز إخفاقات إطار منتدى المستقبل، ولكنها مع ذلك كشفت سذاجة من ظنوا أن بنما تشكل ملاذا آمنا، متناسين أنها بفضل المكانة الاستراتيجية لقناتها الرابطة بين المحيطين الهادي والأطلسي تعتبر أجمل وردة في الحديقة الخلفية لواشنطن، وبالتالي ترصد فيها عيون المخابرات الأمريكية دبيب النمل فأحرى صبيب الأموال.
إنها بداية العاصفة، هكذا علق إدوارد سنودن عندما سمع بالوثائق. فاللهم لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه.