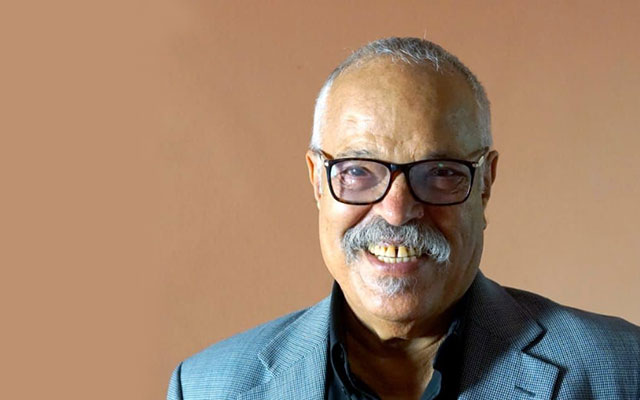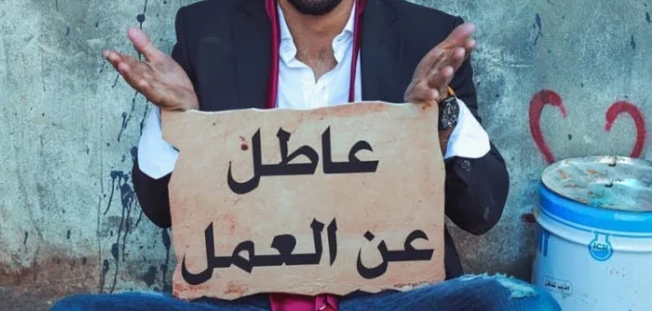هذه الجملة محبوبةٌ عند كثير من علماء وفقهاء الدين. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يسمعَ الناسُ كلامَهم (فقهَهم)، وبعد هذا السماع، أن يدينوا لهم بالطاعة. والطاعة واجبة، فقط وحصرياً، لله وحده.
جملة محبوبة، بل مُقدَّسة، عند علماء وفقهاء الدين الذين يُفهِمون الناسَ أنهم (أي العلماء والفقهاء) يتصرَّفون في الأمور الدينية بوِصايةٍ من اللهِ، سبحانه وتعالى. بل يعتقدون، اعتقاداً راسِخاً، بأن السّنةَ تفصِّل القرآن، بل تُفسِّره وتُكمِّله. فإذا كان هذا هو اعتقادُهم، فمعناه أن القرآنَ ناقصٌ علما أن اللهَ، عزَّ وجلَّ، يقول في كتابه الكريم : "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ" (هود، 1).
فكيف للقرآن الكريم أن يكونَ ناقصاً ومَن أنزله، سبحانه وتعالى، على آخِرِ الرسل والأنبياء يقول لنا وللبشرية جمعاء إنه كتابُ "أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ"، أي أن مَن أبدعها أبدعها بحكمة وتبصُّرٍ ورشاد وخبرة…بحيث لا تتنافى مضامينُها مع العقل ومع ما رسمه، عزَّ وجلَّ، للناس من طريقٍ مشتقيمٍ؟ بل كيف لقرآنٍ كريمٍ موجَّهٍ للبشرية جمعاء ولآخِرِ الرسل والأنبياء، أي بعده تتوقَّف الرسالات السماوية، أن يكونَ ناقصاً؟
انطلاقا من هذه الاعتبارات، لا يمكن أن يكونَ القرآنُ الكريمُ ناقصا. لماذا؟ لأنه إذا كان ناقصا، فما هي الغاية من تنزيلِ رسالةٍ سماويةٍٍ ناقصة على مَن كان آخرَ الرسل؟ بل إذا كان ناقصاً، فلماذا يقول، سبحانه وتعالى:
1."ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ" (البقرة، 2). "لَا رَيْبَ فِيهِ"، أي لا يوجد شكٌّ في معاني آياته، سورةً سورة.
2."كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ" (ص، 29). فهل يُعقلُ أن يتدبَّرَ الناسُ قرآنا يشوبُه النُّقصان؟
3."أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا" (النساء، 82). "لو" حرفُ شرطٍ. فما هو الشرطُ وما هو جوابُه؟ الشرط هو "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ". في هذه الآية، الشرط لم يتحقَّقْ وجوابُ الشرط هو "لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا". وبما أن الشرطَ لم يتحقَّق، فجوابه، هو الآخر، لم يتحقَّق. إذن، القرآن الكريم ليس ناقصا كما يدَّعي جلُّ علماء وفقهاء الدين الذين يزعمون أن السنةَ تكمِّل القرآنَ. وإذا كان الأمرُ هكذا، أي إذا افترضنا أن القرآن، فعلاً، ناقصٌ، فهل يعقل أن تكونَ أقوالُ (أحاديث) الرسولِ (ص) هي المكمِّلة للقرآن الكريم، علما أن السماعَ ليس كالفعل؟
لا، لا يجوز أن تكونَ أقوال الرسول(ص) مفصِّلة أو مُكمِّلة للقرآن الكريم. لماذا؟ لأن الأقوالَ تُسمَع، وكل شخصٍ يُدرك محتواها حسب مستواه الفكري، أو إن شئنا، حسب خلفياتِه الفكرية، الاجتماعية والثقافية. أو بعبارة أخرى، حسب الخلفيات الفكرية، الاجتماعية والثقافية التي كانت سائدةً في عهد الرسول (ص). ولهذا السبب، الرسول (ص) أوصى الصحابةَ قائلا لهم : "لا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ". فهل الرسول (ص) كان غير مُدركٍ أن أقوالَه قد تُفسَّر حسب ما تمليه على الصحابة خلفياتُهم الفكرية، الاجتماعية والثقافية؟
قد يقول قائلٌ إن آخرَ الرسل والأنبياء "لا ينطق عن الهوى"، أي يقول فقط ما يُوحى إليه، أو بعبارةٍ أخرى، لا تكون أقوالُه مُطابِقةً لأَهْوَائِه. نعم، لا ينطق عن الهوى، لكن كرسول وليس كنبيٍّ، مصداقا لقولِه، سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ" (المائدة، 67).
المُلاحظ، في هذه الآية، أن اللهَ، سبحانه وتعالى، يخاطِب الرسول (ص) وليس النَّبي. والدليل على ذلك أنه، عزَّ وجلَّ، قال له "بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ" ولا تكترث بحقد الناس وعداوتِهم ومعارضتِهم لك، أي قُم بواجب التبليغ، "وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ" أي يحميك من شرور هؤلاء الناس، أي يحفظُك من هذه الشرور.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ما هو المقصود من قولِه، سبحانه وتعالى، في الآيتين المواليتين؟
1."بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" (الأحزاب، 1).
2."بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (التحريم، 1).
في الآيتين، الله، سبحانه وتعالى، يُخاطب النبي وليس الرسول (ص). في الآية الأولى، يأمُره بمزيد من التقوى ويأمُره، كذلك، بعدم طاعة الكافرين والمنافقين. بينما في الآية الثانية، يوجِّه، سبحانه وتعالى، اللومَ للنبي وليس للرسول لأنه حرَّم على نفسِه ما أحلَّه له اللهُ، عزَّ وجلَّ. فماذا، بإمكاننا، أن نَسْتنتِجَه من هاتين الآيتين؟
يُستَنتَج منهما أن النبيَّ يخطئ والرسول، بحٌكم تبليغِه لرسالة سماوية، معصومٌ من الخطأ. إذن، النبي يخطئ، وهو الذي قال "كل ابن آدم خطاءٌ وخير الخطَّائبن التوابون". والنبي، كفردٍ من ابن آدم، فهو مُعرَّصٌ للخطأ. إذن، هناك فرقٌ بين النبي والرسول. الرسولُ نبيٌّ والنبي ليس بالضرورة رسول. فحينما يتحوَّل النبي من النبوَّة إلى تبليغ رسالة إلهية، فالله، سبحانه وتعالى، يعصِِمه من الخطأ. وحينما تنحصر مٌهمَّة الشخص الذي اختاره الله أن يكونَ نبيًّا، فإنه يُصيب ويخطئ.
بينما الأفعال هي شيءٌ ملموس على أرض الواقع. والدليل على ذلك أن الرسولَ (ص) كان عليه أن يَكْتَفِ بوصف الصلوات الخمس في أقواله (أحاديثه). لكنه لم يفعل. بل قال للناس : "صلوا كما رأيتموني أصلي" لماذا؟
لأنه لو اكتفى الرسول (ص) بوصف الصلوات الخمس، عن طريق الأحاديث فقط، لاختلف الناسُ في أدائها. والدليل على ذلك، اختلاف علماء وفقهاء الدين في تصحيح وتضعيف الأحاديث. بل الحديث الواحد يُعدُّ صحيح عند فئة من علماء وفقهاء الدين وفي نفس الوقت، تُضعِّفه فئةٌ أخرى.
إذن، السُّنة، منطقيا وعقليا، لا يمكن أن تتجسَّدَ في أقوال (أحاديث) الرسول (ص). وإن كانت هناك سُنَّة، فمن المنطقي أن تتجسَّدَ في أفعال الرسول (ص) وليس في أقواله. لماذا؟
لأن كل أفعال البشر هي تجسيدٌ لنطربات، بسيطة أو مُعقَّدة، صاغها العقلُ البشري وقرَّر إخراجَها إلى حيز الوجود على شكل أفعال. وهناك مَن آمن بهذه الأفعال وعمِل بها، وهناك من رفضها ولم يعمل بها. لماذاّ؟
لأن هناك اختلاف في إدراك النظريات، البسيطة أو المعقَّدة، التي، عادةً، تسبق الأفعال على مستوى العقل البشري.
وما لا يجب إغفالُه هو أن آخرَ الرسل والأنبياء بشرٌ مثل جميع البشر، مصداقا لقولِه، سبحانه وتعالى : "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ" (فصلت، 6).
والشيء الآخر الذي لا يجب إغفالُه هو أن علماء وفقهاء الدين القدامى فسروا الأمورَ الدينية في عصر كانت فيه العلوم الدنيوية بسيطة جدا إن لم نقل منعدِمة. خلافا لنا نحن البشر المعاصرون حيث أتِيحت وتُتاحُ لنا فُرَصٌ كثيرة لتطوير مستوانا الفكري والثقافي بكل سهولة.
ومع ذلك، يستمر علماء وفقهاء الدين الحاليون في التشبُّث بمقولة "سمعنا واطعنا"، أي أن نسمعَ لاقولِهم وندين لهم بالطاعة دون أن نشغِّلَ عقولَنا. وهذا شيءٌ مستحيلٌ. لماذا؟
لأن اللهَ، سبحانه وتعالى، عندما نفخ جزأً من روحه في جسم آدم وفي ذريتِه، أراده أن يكونَ واعِياً بوجوده وبالأشياء المحيطة به. والوعي لا معنى له إن لم يكن لبني آدم إرادة. والإرادة تعني حريةَ التَّصرُّف. وحرية التَّصرُّف هي التي جعلت من البشر أصنافاً مختلفةً. فمنهم المؤمِنون ومنهم الكافرون والمشركون والمُلحِدون والبوذيون والهندوسيون والعَلمانبون والكاثوليكيون والشيعيون والوهابيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون والحنفيون والخوارج والمعتزلة وأهل السنة والجماعة والإباضيون… كل صنف من هذه الأصناف اختار ما يتناسب مع خلفياتِه الفكرية، الاجتماعية والثقافية.
سنسمع ما تُمليه علينا عقولُنا. وبعد السماع، قد نُطيع وقد لا نُطيعُ.