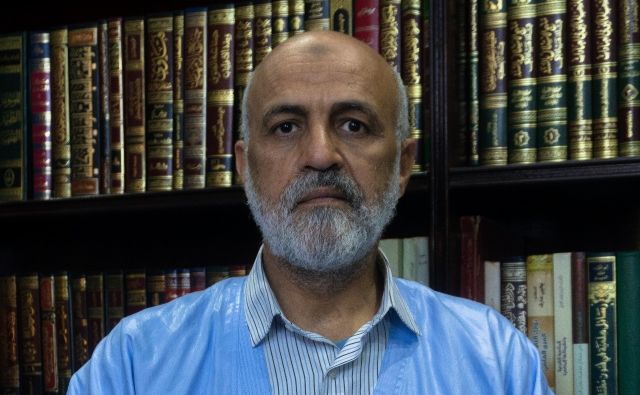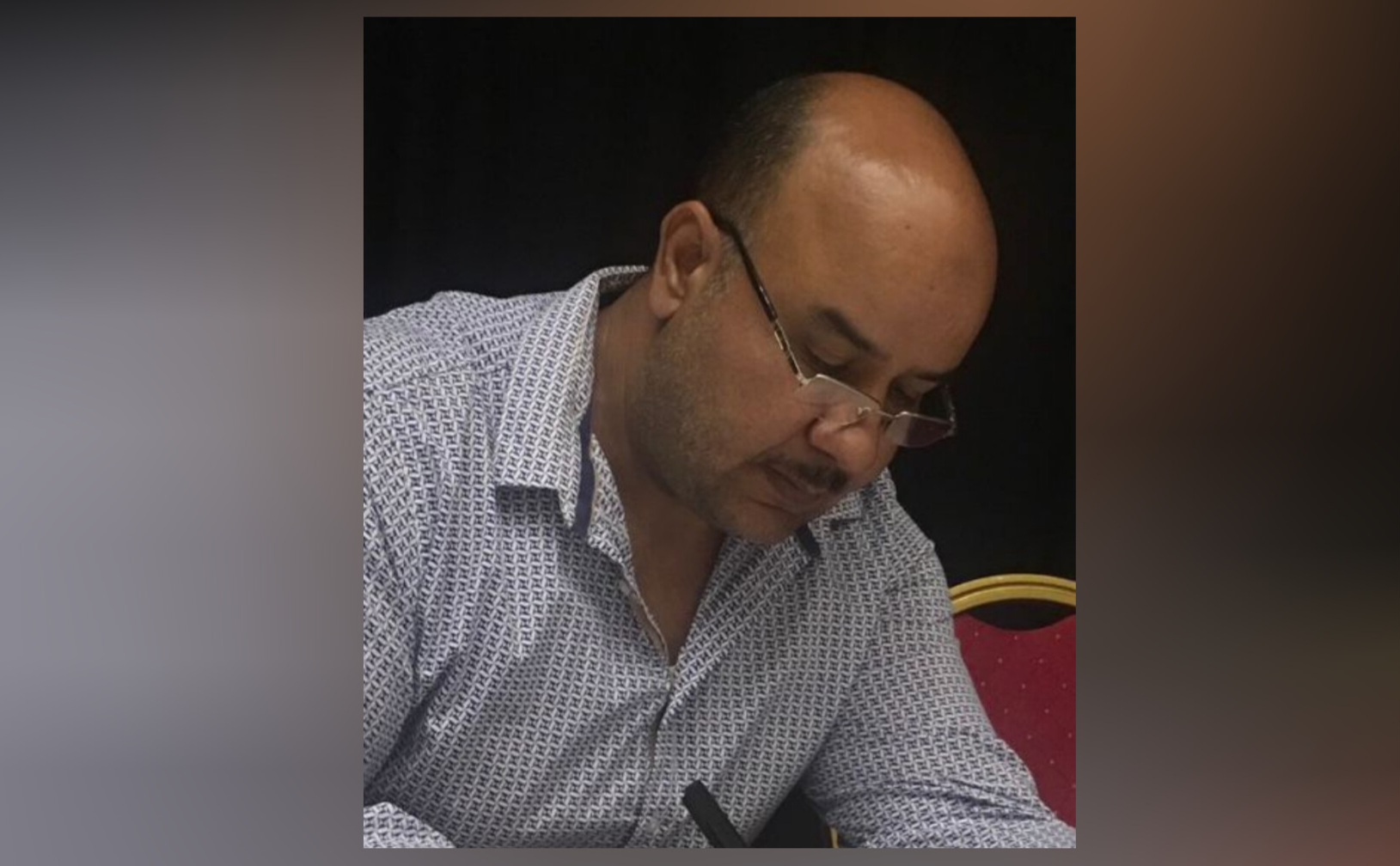علال الفاسي· شخصية متعددة الأبعاد، جمع بين مواكبة اليومي سياسيا وبعد النظر فكرا وتنظيرا والإبداع الخلاق أدبا وشعرا. لذلك فإن الوقوف على جانب من جوانب تراثه الغني اليوم، إنما هو وقفة تأمل فيما يمكن أن نستخلصه من دروس خدمة للحاضر واستشرافا للمستقبل.
بهذا المعنى فإن الأستاذ علال الفاسي سيبقى حيا بيننا وفينا بأشكال مختلفة، من خلال ما خطته يداه من كتب تفوق الثلاثين كتابا وعدد يكاد لا يحصى من المقالات والدراسات المبثوثة في الصحف السيارة والمجلات الدورية، بعضها أصبح متاحا للدارسين، وبعضها ما زال بحاجة إلى من ينفض عنه الغبار.
ولعل المتأمل في شعر الأستاذ علال الفاسي يقف أول ما يقف عند ظاهرة تسترعي الانتباه، ذلك أن شعره يعكس شخصيته بأبعادها المختلفة. ومن هنا يمكن قراءة شعره على ضوء فكره وممارسته السياسية، كما يمكن قراءة فكره وممارسته السياسية من خلال شعره. إن هناك علاقة جدلية بين إبداعه الشعري وبين اهتماماته السياسية وهواجسه الفكرية.
لم يكن الشعر عند علال الفاسي ملاذا يلجأ إليه متى ضاقت النفس باللواعج والعواطف الجياشة فحسب، بل هو أيضا وأساسا رسالة ذات أهداف واضحة ينتظر منها أن تؤتي أكلها في الزمان والمكان.
وكما كان علال الفاسي ملتزما سياسيا وفكريا تجاه وطنه ومجتمعه وأمته العربية والإسلامية، فإن شعره لا يقل التزاما بنفس القضايا والمواقف التي تفصح عنها كتبه ومقالاته وخطبه. ولهذا فإنه ظل في شعره على مسافة من النزعة الرومانسية التي كانت تشكل عند أغلب مجايليه من الشعراء العرب، نموذجا لتجديد القصيدة العربية المعاصرة..
هذا يعني أنه لا يمكن الفصل بين علال الفاسي السياسي وعلال الفاسي المفكر وعلال الفاسي الشاعر، لأن كل هذه المجالات تصب في هدف واحد هو تحرير الإنسان من قيود العبودية والاستغلال بكل ما تحمله الكلمتان من معاني وطنية وإنسانية.
إن الإيمان بقيم الحرية والعدالة والمساواة شكل القاعدة الأساس التي انطلق منها علال الفاسي، كي يبني رؤيته إلى العالم، وهي رؤية بدأت ملامحها الأولى واضحة منذ صغر سنه، حين فتح عينيه على الاستعمار الفرنسي، وما كان يعامل به المغاربة من استغلال ودونية، الشيء الذي جعل علال/الطفل يحرم على نفسه اللعب مع بلوغه السنة الخامس عشرة، ويصبح رجلا، يمتلك إحساس الكبار بالمسؤولية تجاه وطنه ومجتمعه: (1/43)[1]
أبعد مرور الخمس عشرة ألعب وألهو بلذات الحياة وأطــــــرب
ولي نظر عال ونفس أبيـــــــــة مقاما على هام المجرة تطلــــب
وعندي آمال أريد بلوغهـــــــــأ تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب
ولي أمة منكودة الحظ لم تجـــد سبيلا إلى العيش الذي تتطلــــب
لقد امتلك علال الفاسي في سن مبكرة مقومات المناضل المشبع بروح المقاومة، ويرجع هذا بالدرجة الأولى إلى الوسط الاجتماعي الذي ترعرع فيه، والذي جعله يتلقى تربية مبنية على أسس قومية/عربية ودينية/إسلامية.
وستتعمق هذه الرؤية المبكرة للواقع لديه، عندما يلتحق بالقرويين التي كانت تمثل آنذاك قلعة حقيقية للتحرر من الاستعمار، ومنارة للذود على القيم العربية والإسلامية. وهي قيم ستكتسي في مرحلة لاحقة بعدا إنسانيا لدى الأستاذ علال الفاسي، وخاصة بعد تجربة المنفى بالغابون ومصر. ومن هنا فإن شعره سيطبع بثلاثة أبعاد مشدودة إلى بعضها البعض بشكل عضوي يجعلها غير قابلة للتجزيء.
ـ البعد الوطني الذي عرف به شعر علال الفاسي والذي يتجلى في القصائد الملحمية التي صاغها لتخليد المناسبات الوطنية، وفي الأناشيد الحماسية التي ما يزال صداها يتردد على الألسن إلى يومنا هذا. وهو البعد الذي يهيمن على ديوانه الشعري، ولا نحتاج للتمثيل له، فمن منا لم يردد منذ الصغر نشيد: (1/316)
مغربنا وطننا روحي فداه ومن يمس حقوقه يذق رداه
ـ البعد العربي والإسلامي، الذي يحضر في الديوان في صورة تحريض ضد الاستعمار والظلم بجميع أشكاله تارة، أو في صيغة نداء إلى تحقيق الوحدة من أجل الوقوف أمام التحديات التي وضعها الاستعمار أمام تقدم البلدان العربية والإسلامية تارة أخرى. يقول في قصيدة "الوحدة العربية"(2/477)
أرى أمم العرب استعدت بروحها لتجمع من أقطارها ما تفرقا
ومن كبني العرب الكرام أحق أن يشيد هدما أو يفتح مغلــــــقا
ـ البعد الإنساني الذي يظهر تعاطف الشاعر مع كل الشعوب المقهورة بغض النظر عن انتمائها القومي أو الديني.(3/104)
من المدافع عن شعب المساكين من السيام إلى أقصى فلبيني
إن هذه الأبعاد الثلاثة قد اجتمعت عند علال الفاسي في كتاباته الشعرية عن قضية واحدة هي القضية الفلسطينية.
من الصعب أن نتتبع أثر القضية الفلسطينية في شعر الأستاذ علال الفاسي كله في هذه العجالة، ذلك أن فلسطين تقع في مركز اهتمامه منذ بدأ قرض الشعر. ولا عجب في ذلك لأن وعي الرجل تفتح مع وجودها وصاحب مراحل تطورها إلى حين وفاته.
من أجل ذلك فإن القضية الفلسطينية شكلت وجها من وجوه النضال الوطني الذي لا زمه طيلة حياته. وليس صدفة أن المنية وافته وهو يترافع عن تلك القضية في المحافل الدولية.
يروي امحمد بوستة الذي رافق الفاسي في رحلته الأخيرة إلى رومانيا، في مذكراته التي تحمل عنوان: "الوطن أولا" أن اللقاء الذي جمع بين وفد حزب الاستقلال وبين المستشار الروماني قبل قليل من وفاة علال الفاسي، عقد من أجل إقناع المستشار بفتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية ببوخاريست، وحث القيادة الرومانية على الوقوف إلى جانب المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية.
إن حادثة وفاة علال الفاسي المؤلمة، وهو يدافع عن الوحدة الترابية ويرافع عن القضية الفلسطينية في العواصم الدولية لها عمق رمزي لا تخطئه العين، ذلك أنها تنم عن أن القضية الفلسطينية كانت تحظى عنده بنفس الدرجة من الاهتمام الذي كان يوليه لقضية وحدة المغرب الترابية.
وبهذا يمكن القول إن فلسطين كانت تشكل بالنسبة إليه قضية وطنية، وهو ما تعبر عنه كتاباته السياسية، التي أبانت عن رؤية متقدمة تنادي بحل "يضمن للفلسطينيين كيانهم الموحد في دولة ديمقراطية لا دينية تتعايش فيها العناصر الموجودة والديانات السماوية الثلاث، إذ لم يعد في هذا العصر مكان لدولة تبنى على أساس السلالة والتفوق الديني"[1].
إن هذه الرؤية المتقدمة إلى القضية الفلسطينية تنبع من إيمان علال الفاسي العميق بأن إسرائيل هي قبل كل شيء ظاهرة استعمارية. ومن هذه الزاوية سينظر إليها في شعره...
ولا شك في أن موقفه تطور شعريا على الأقل مع تطور مسار تلك القضية. فقد كتب علال الفاسي عن فلسطين منذ 1934 يحيي النساء الفلسطينيات اللائي خرجن في تظاهرة ضد الحركة الصهيونية ويدعو المرأة العربية إلى أن تحذو حذوهن (1/123)
الآن قد خطت فلسطين لنا سبل الــسداد
حيا الإله فتاتــها وحمى مواقفها الجياد
كونــــي فتاة العرب رائدة لنا يوم الجلاد
كونـــي لنا كمثالها وتقدمي في كل ناد
ينبغي أن أذكر بأن هذه القصيدة قد كتبها علال الفاسي وعمره لا يتجاوز الرابعة والعشرين، مما يدل على امتلاكه لوعي مبكر بأبعاد القضية الفلسطينية وتشعبها.
ومع السنين ستنضج تجربته السياسية وستنضج معها تجربته الشعرية وتتبلور رؤيته الواضحة إلى القضية الفلسطينية.
وعلى الرغم من أن الشعر ليس تاريخا، إلا أن الشاعر علال الفاسي ظل يكتب عن القضية الفلسطينية بمناسبة أو بدونها، لأنها كانت حاضرة في وعيه بشكل دائم. ومن هذه الناحية فإن شعره حول القضية تطور معنى ومبنى مع تطور القضية الفلسطينية نفسها. ويمكن أن نمثل لهذا الارتباط الذي يكاد يكون عضويا، بأنه يحرص على إعلان موقفه في كل لحظة من لحظات التحول التي كانت تمر بها القضية.
ـ والبداية من "وعد بلفور" المشؤوم الذي منح ما لا يملك لغير من يملك:(3/118)
ما وعد بلفور بمعط عصبة مجلوبة، حقا لـــها لم يثبت
هل كان يملك أرضا بلفور حتى يستبيح مقايضات الصفقة؟
أمنت بالوعد الإلهي، إنـــــه أعطى لإسرائيل وعد الذلــة
ويتحدث الشاعر علال الفاسي في نفس القصيدة عن نكبة فلسطين 1948 بتفاؤل كبير، معلنا أن وضع الاحتلال وضع مؤقت، ولا بد من استرجاع الأرض وتحرير الإنسان: (3/1117)
لا النكبة العظمى ولا ما جرت بمبيدة أمــــل الحيـــاة الــــحرة
عهد علينا أن نصون كيــــــاننا ونرد عنا عار تــــلك النـــــكبة
ولئن بدا العادون في حلفائـــهم أقوى، فأقوى من عراهم همتي
ويقف في قصيدة أخرى عند هزيمة 1967 وما خلفته من جروح في نفس الإنسان العربي، ويعدد أسباب الهزيمة التي لا تعود كما يقول إلى الشعوب العربية، وإنما ترجع إلى القادة العرب الذين لم يدبروا الحرب اعتمادا على شعوبهم، وإنما قادوها اعتمادا على ولاءات أجنبية: يكتب في قصيدة تحمل عنوان: "الصفحة الأخيرة من مذكرات شهيد عند النكسة" (3/158)
من هاهنا وهاهنا يلتقطون
من أمريكا، من روسيا، من الصين
من كل صوب ما عدا من قلبنا
من عقلنا من قومنا من حاجنا
لم ننهزم نحن، لقد متنا وقد قتلنا
وإنما قوادنا، ثوارنا المنهزمون
ومع كل هذا يختم القصيدة بروح متفائلة، تؤمن بالنصر لأصحاب الحق:
من هاهنا ننطلق
ومن هزيمة الكبار نبتدئ
إلى المصير الحتم
للزحف للنصر، وها أنا المثل
ويؤرخ الأستاذ علال الفاسي بطريقته الخاصة شعريا لحرب رمضان 1973 في قصيدة "تحية تجريدة الجولان" (3/187) التي يشير عنوانها إلى مشاركة الجيش المغربي في تلك الحرب.
سيروا إلى النصر إن النصر ينتظر وكافحوا دولة الأعداء وابتدروا
وتغنى ببطولات الجيش المغربي في الجولان:
من عهد طارق والأيام شــــــــاهدة بكل فتح به الأقطار تزدهــــــــر
إن سار للشام تحدوه عـــــــــــقيدته فحسبه أنه بالله ينـــــــــــــتصر
وحسبه أنه لبى الـنداء وقــــــــــــــد دعاه صوت من الأعماق ينفجر
من مقدس الله من مسرى النبي ومن قبر المسيح وما قد بثه عـــمر
لا تخلو أية مرحلة من مراحل كفاح علال الفاسي من الخوض في القضية الفلسطينية، نثرا وشعرا. ومع ذلك يلاحظ قارئ أعماله الشعرية أن هناك تفاوتا كميا وكيفية من حيث حضور القصيدة المكرسة للقضية الفلسطينية عنده بين فترة وأخرى. والسبب في ذلك راجع إلى أحد سببين أو إلى كليهما فيما أرجح
يكمن السبب الأول في أن الشاعر ظل في مراحله الأولى من تعاطيه للكتابة الشعرية مشغولا بقضية تحرير بلاده المغرب من الاستعمار الأجنبي. ويبدو أن هذا الانشغال لم يسعفه على التركيز على القضية الفلسطينية. كما أن نفيه واعتقاله المتكررين بفعل مواقفه الوطنية من طرف المستعمر الفرنسي، حال دون تركيزه عن فلسطين، هذا على الرغم من أننا لا نعدم إشارات هنا وهناك في طيات قصائده الوطنية، تشيد بجهاد الفلسطينيين، وتنتقد مواقف القادة المتخاذلين تجاهها.
أما السبب الثاني فيتجلى في أن مفهوم القضية الفلسطينية نفسه لم يتبلور باعتباره ظاهرة استعمارية إلا بالتدريج، والشعر يحتاج إلى وقت كي تختمر الفكرة وتتحول إلى دفقة شعرية نابعة من أعماق التجربة. وهو ما يذكر بما سبق أن أشرت إليه من أن الوعي بالقضية الفلسطينية وبأبعادها، تطور مع نضج وتطور التجربة الشعرية لدى علال الفاسي.
إن هذا يفسر الزخم الكبير الذي كان يكتب به الأستاذ علال الفاسي عن القضية الفلسطينية مع بداية الستينيات إلى حين وفاته. في هذه المرحلة أصبح يخصص قصائد طوالا لفلسطين. ومن هذه القصائد نذكر على سبيل المثال لا الحصر: "مسيرة القدس" و"لبيك يا سر الخلود" و"شعارات" وغيرها من القصائد التي تضمنها المجلد الثالث من أعماله الشعرية على وجه الخصوص.
وتمثل قصيدة "مسيرة القدس" نموذجا دالا على هذه المرحلة التي اكتملت فيها رؤية الأستاذ علال الفاسي شعريا إلى القضية الفلسطينية.
من الوهلة الأولى تبدو قصيدة "مسيرة القدس" مختلفة عن أغلب ما كتبه علال الفاسي عن القضية الفلسطينية من شعر. ذلك أنه كتب القصيدة على نمط شعر التفعيلة وليس على الطريقة المعروفة في الشعر العمودي. ولهذا الانتقال الذي يبدو فنيا صرفا دلالة كبيرة على مستوى تطور القول الشعري عنده، وعلى مستوى تطور القضية الفلسطينية نفسها. ذلك أننا ألفنا في القصائد السابقة موسيقى ملحمية بارزة وفرها الوزن والقافية الذي يقوم على استقلالية البيت الشعري نسبيا بمعناه ومبناه، لأن الأمر كان يتعلق برغبة جامحة في استنهاض الهمم من أجل تحرير فلسطين.
أما في "مسيرة القدس" فإن الأمر يختلف، وذلك بالانتقال من القصيدة/النشيد، إلى القصيدة المهموسة، التي لا تتخلى عن الوزن ولكنها تستعمله بطريقة تمنح الشاعر إمكانية إطالة البيت الشعري أو تقصيره حسب الدفقة الشعورية التي يريد أن يعبر عنها. هذا يعني أن لا مجال للحديث عن الاستشهاد بالبيت الواحد، لأن الأبيات متصلة فيما بينها تركيبا ودلالة. وقد لا يكتمل المعنى الذي يظل، مع ذلك، جزئيا، إلا بقراءة المقطع كاملا. أما المعنى العام للقصيدة فلا يمكن القبض عليه إلا عندما ننتهي من قراءة القصيدة كاملة.
إن لهذه الطريقة في الكتابة الشعرية ضريبة يدفعها القارئ، إذ عليه أن يبذل جهدا أكبر لفهم القصيدة، التي أصبحت تتسع لقراءات متعددة لأن مستوى اللغة التي كتبت بها يتداخل فيه ما هو تواصلي إخباري بما هو إشاري رمزي.
تتوزع القصيدة على ستة مقاطع شعرية تتفاوت من حيث الطول، وتشترك في وزن واحد هو وزن الرجز، وتعتمد التدوير العروضي للربط بين الأبيات الشيء الذي لا يسمح بالوقوف عند آخر كل بيت كما هو الشأن في القصيدة العمودية.
ومع ذلك فإن استعمال وزن يتكون من تفعيلة واحدة أبقى على إذكاء الإيقاع في القصيدة. إذا أضفنا إلى هذا ظاهرة التكرار عبر استخدام اللازمة أدركنا أن الشاعر ما زال يراهن على الوزن بوصفه أحد العناصر الضرورية لتحقيق شعرية القصيدة، وذلك عبر شد القارئ أو السامع إليها عن طريق حاسة السمع.
المقطع في قصيدة "مسيرة القدس" هو الوحدة الأساسية في ظل فقدان البيت لدوره كبنية مستقلة. ويساهم كل مقطع بدوره في تشييد بناء القصيدة الذي لا يخضع لخط تصاعدي، بل يتبنى شكلا دائريا يستوعب التداخل بين الأزمنة والأمكنة، حيث يتم اختراق المسافة المكانية بين بني مسكين وماسة وبني ملال وغيرها من الأمكنة المغربية وبين غزة وقليقلة ونابلس والقدس وغيرها من الأمكنة الفلسطينية. هذا على صعيد المكان أما على صعيد الزمن فإن المسافة تنمحي بين زمن الهجرة النبوية ومعركة وادي المخازن من جهة وبين زمن فلسطين الآني، حيث العمليات الفدائية من أجل تحرير الإنسان، من جهة ثانية.
إن وظيفة التداخل بين الأمكنة والأزمنة تجعل الفضاء العام للقصيدة يتأطر بفكرة واحدة هي أن الحرية لا تمنح وإنما تنتزع. وانتزاعها يقتضي التضحية كما فعل الرسول عندما هاجر من مكة إلى المدينة، وكما حرر صلاح الدين الأيوبي القدس من الصلبيين، وكما انتصر المغاربة في معركة وادي المخازن على الغزاة الأجانب.
في قصيدة "مسيرة القدس" تصبح الأمكنة والأزمنة شاهدة على وجوب الكفاح من أجل التحرير، ومن أجل هذا فإن القصيدة خضعت لنزعة سردية تجمع بين مشاهد تبدو متفرقة، ولكنها مرتبطة في معناها ومغزاها:
ـ مشهد طبيعي تبدأ به القصيدة، يتمثل في الربيع الذي يرمز للخصب والانبعاث ويشرح النفس ويملأها تفاؤلا.
ـ مشهد الهجرة المحمدية وما ترمز إليه من تضحية وفداء من أجل تحرير الإنسان والأكوان.
ـ مشهد الحبيبة/القدس الذي يجمع بين الذات الشاعرة وحلول الربيع وبين الهجرة النبوية، بوصف هذه المدينة مسرى النبي وأولى القبلتين، وباعتبارها فضاء لبعث أمة.
ثلاثة مشاهد متداخلة فيما بينها زمانيا ومكانيا، تجمع بينها النفس التواقة الى القدس المحررة، التي يعبر عنها ضمير المتكلم، حيث يخاطب الشاعر القدس مناديا "حبيبتي..."
إن هذه القصيدة تعكس تجربة الشاعر في علاقتها بالقدس، وهي تجربة تصدر عن نزعة صوفية واضحة المعالم، ولكنها تجربة تستمد عمقها من التاريخ، الهجرة النبوية، وانتصار صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين ومعركة وادي المخازن. كما أن لها امتدادا جغرافيا بأرض المغرب في ماسة وسوس وزيان بني مسكين وبني ملال وغيرها من الأمكنة ذات الحمولة التحررية لأن هذه الأمكنة شكلت بؤرا لمقاومة الاستعمار الفرنسي للمغرب.
إن تكثيف كل هذه الأحداث التي ترمز إليها الأزمنة والأمكنة المتباعدة، يرمي بالإضافة إلى ما سبق ذكره، إلى أن حب الشاعر وشوقه إلى القدس الذي يرمز إليه ضمير المتكلم هو حب جماعي له جذور في التربة الأصيلة للمجتمع المغربي، وكأني بالشاعر يتحدث عن القدس بلسان المغاربة قاطبة.
كما أنه يجسد الأبعاد التي سبقت الإشارة إليها والتي ينظر بها المرحوم علال الفاسي إلى القضية الفلسطينية وهي البعد الوطني والبعد العربي الإسلامي والبعد الإنساني.
[1] علال الفاسي. القضية الفلسطينية والقدس في الفكر والوجدان. إعداد المختار باقة. مؤسسة علال الفاسي. الطبعة الأولى. الرباط 2018. ص 36.
· علال الفاسي (1910ـ 1974) زعيم سياسي ومثقف مغربي وشاعر. تزعم حركة التحرير الوطنية المغربية ضد الاستعمار الفرنسي، إلى جانب قادة أخرين من أمثال المهدي بنبركة وعبد الرحمان اليوسفي والفقيه البصري وغيرهم. كان من المؤسسين لحزب الاستقلال المغربي الذي ظل على رأسه إلى أن توفي ببوخاريست إثر وعكة صحية ألمت به. جمع بين الممارسة السياسية والفكرية وبين قرض الشعر.
[1] اعتمدت هذه القراءة على ديوان علال الفاسي الذي جمعه وحققه وقدمه المختارة باقة وعبد العلي الودغيري، ونشرته مؤسسة علال الفاسي في ثلاثة أجزاء. يشير الرقم الأول إلى الجزء ويشير الرقم الثاني إلى الصفحة.
2علال الفاسي. القضية الفلسطينية والقدس في الفكر والوجدان. إعداد المختار باقة. مؤسسة علال الفاسي. الطبعة الأولى. الرباط 2018. ص 36.