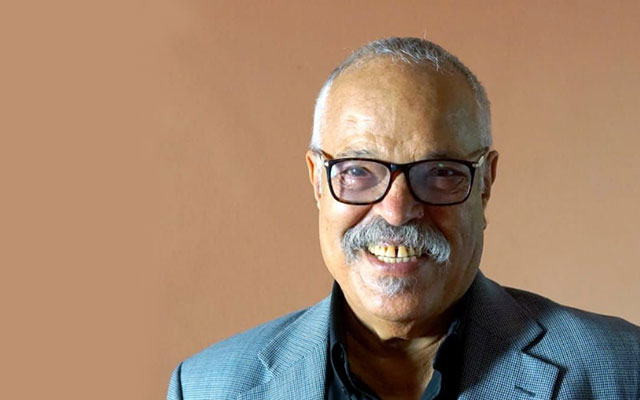أولا، أريد أن أوضِّحَ أني لستُ فقيها ولا عالِما متبحِّرا في علوم الدين، كما أرادها فقهاء وعلماء الدين أن تكونَ. لكن كلما سمعتُ خبرا أو قرأتُ نصا أو تصفَّحتُ كتابا، أحاول أن أمرِّرَ مضمونَ هذه الوسائل المقروءة والمسموعة من مصفاة filtre العقل والمنطق.
وهنا، لا بدَّ أن أذكِّرَ أن كل ما يُنتَجُه البشرُ من معارف قابل للنقاش. لأن المُنتِجَ بشرٌ والبشر ابن بيئته. "بيئته" تعني الوسط الذي يعيش فيه الإنسان. وفي هذا الوسط، تتم التنشئة الاجتماعية لهذا الإنسان، أي اندماجه في المجتمع. والإنسان، طول حياته، يتشبَّع بثقافة مجتمعه وتقاليده وعاداته ومعتقداته…
وهذا يعني أن الإنسانَ يتأثَّر ب"بيئته" ويؤثِّر عليها. والبيئة، أي الوسط، تتغيَّر زمانا ومكانا. والتأثيرُ والتَّأثُّرُ يؤديان إلى تكوين خلفيات فكرية، ثقافية ومعرفية عند الإنسان. وهذه الخلفيات هي التي تمكِّن الإنسانَ من العيش والتعايش في بيئته والتواصل مع أنداده في المجتمع. وهذا يعني أن هناك تفاعلا دائما ومتبادلا بين الإنسان وبيئته.
وهذا التذكير ينطبق على جميع مجالات المعرفة بما فيها ما أنتجه البشر في المجال الديني. أُلحُّ وأقول : ما أنتجه البشر في المجال الديني. لماذا هذا الإلحاح؟
وهذا يعني أن الإنسانَ يتأثَّر ب"بيئته" ويؤثِّر عليها. والبيئة، أي الوسط، تتغيَّر زمانا ومكانا. والتأثيرُ والتَّأثُّرُ يؤديان إلى تكوين خلفيات فكرية، ثقافية ومعرفية عند الإنسان. وهذه الخلفيات هي التي تمكِّن الإنسانَ من العيش والتعايش في بيئته والتواصل مع أنداده في المجتمع. وهذا يعني أن هناك تفاعلا دائما ومتبادلا بين الإنسان وبيئته.
وهذا التذكير ينطبق على جميع مجالات المعرفة بما فيها ما أنتجه البشر في المجال الديني. أُلحُّ وأقول : ما أنتجه البشر في المجال الديني. لماذا هذا الإلحاح؟
لأن الدينَ له توابثه وهي غير قابلة للنقاش لمن هو مؤمن إيمانا راسخا، وبالتالي، هذه التَّوابث تحتاج فقط إلى الإيمان. أما ما أنتجه ويُنتِجه العقل البشري في مجال الدين، فهو قابل للنَّقاش. والإنتاج البشري في مجال الدين يتمُّ في ظروف زمانٍ ومكانٍ معيَّنة. فكلما طرأ تغيير على هذه الظروف، كلما تغيَّرت الخلفيات، المشار إليها أعلاه، بكل أبعادها. وهذا هو ما يجعل مجتمعات العالم مختلفةً بعضُها عن البعض الآخر. لماذا؟
لأن هذه المجتمعات، بحكم اختلاف خلفياتِها الفكرية، الثقافية والمعرفية، لا ترى الأشياء بنفس النظرة. كل مجتمعٍ له نظرةٌ خاصة به لهذه الأشياء.
لأن هذه المجتمعات، بحكم اختلاف خلفياتِها الفكرية، الثقافية والمعرفية، لا ترى الأشياء بنفس النظرة. كل مجتمعٍ له نظرةٌ خاصة به لهذه الأشياء.
فمن هذا المنطلق، يمكن القولُ بأن وجودَ العالم مبنيٌّ على الاختلاف. وهذا شيءٌ أقرَّه اللهُ سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فكم هي كثيرةٌ الآيات التي يحدِّثنا فيها، جلَّ علاه، عن هذا الاختلاف، كاختلاق الليل والنهار واختلاف الألسن (اللغات) ولون البشرة… مصداقا لقوله سبحانه وتعالى:
1-"إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فيِ البَحرِ …" (البقرة، 164). الليل يطول أو يقصر. والنهار، هو الآخر، يطول أو يقصر. الليل يكون مُضاءً بنور القمر أو شديد الظلمة. النهار والليل يكونان باردين أو شديدَي الحرارة… أليس هذا اختلاف؟
2-وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (الشورى، 10). "مِن شَيْءٍ"، أي كلَّ الأشياء. وهذا دليل على أن الاختلافَ هو العادة أو المألوف، والتَّشابُه استثناء. فهل كل النساء يلِدنَ توأمين؟
3-وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ (الروم، 22). دليل آخر على أن العالمَ قائمٌ على الاختلاف.
4-"…وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (البقرة، 251)، أي أن فئةً من الناس قد تدفع، بطريقة أو أخرى، الشرَّ الذي تكنَّه لها أولغيرها فئةٌ أخرى من الناس. وهذا هو ما يحدث فعلا في المجتمعات حيث هناك صراعٌ دائم بين الخير والشرِّ. ولولا دفعُ الناس بعضُهم البعضَ الآخرَ لتَغَلَّبَ أو لانتصر الشَّرُّ على الخيرِ وفسد كل شيءٍ.
أليست هذه الآياتُ أدلة واضخة تُبيِّن أن العالم (الكرة الأرضية التي يعيش فوقها الإتسانُ) مبني على الاختلاف. وهو ما بيَّنه بوضوح العلمُ الحديث، على الأقل، فيما يخص عالمَ الأحياء.
ما بيَّنه العلمُ الحديث، بالنسبة لعالم الأحياء، هو أن الحياةَ، بمفهومها البيولوجي، ما كان لها أن تستمرَّ فوق سطح الأرض، لولا ما سماه ويسميه العلماء المتخصِّصون في البيولوجيا والبيئة، التَّنوُّع البيولوجي biodiversité ou diversité biologique. فكلما تنوَّعت الحيوانات والنباتات، كلما كانت لها القُدرة على الصمود أمامَ التَّقلُّبات والتَّغييرات التي تحدث داخلَ المنظومات البيئية écosystèmes. هنا، الاختلاف هو الضامن لاستمرار الحياة.
وقد أشار اللهُ سبحانه وتعالى في عدَّة آياتٍ من القرآن الكريم للتَّنوُّع البيولوجي (أقول أشارَ وليس بيَّن ما هو النَّنوُّع البيولوجي)، أذكر من بينها :
1-"وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (النور، 45)
وقد أشار اللهُ سبحانه وتعالى في عدَّة آياتٍ من القرآن الكريم للتَّنوُّع البيولوجي (أقول أشارَ وليس بيَّن ما هو النَّنوُّع البيولوجي)، أذكر من بينها :
1-"وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (النور، 45)
2-"... مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا …" (الأنعام، 99).
والتَّوُّع البيولوجي مُشارٌ إليه في الآية الأولى باختلاف طريقة المشيِ وبقوله "... يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ…".
أما في الآية الثانية، فالإشارةُ إلى التَّنوُّع البيولوجي أتت في "...فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ…".
ما يُستنتجُ من هاتين الآيتين، هو أن وجودَ عالم الأحياء مبنيٌّ على الاختلاف. وبما أن عالم الأحياء جزءٌ لا يتجزَّاُ من العالم ككل، الذي بيَّنتُ أعلاه أنه قائمٌ على الاختلاف، فهذا الاختلافُ ظاهرةٌ أرادها اللهُ أن تكونَ خاصيةً من خاصيات ما أوجده الله سبحانه وتعالى من مخلوقات حية وغير حية.
بعد هذه التوضيحات، أدخلُ في صُلب الموضوع و أقول : كثيرا ما نسمع عبارَتَي "أجْمعَت الأمة على..." أو "أجمعَ العلماء على...".
وحتى يسهلَ إدراكُ ما تحتوي عليه هاتان العبارتان من معنى، فيما يلي تفسير لفعل "أجمَعَ" ولمُفردة "أمة".
أما في الآية الثانية، فالإشارةُ إلى التَّنوُّع البيولوجي أتت في "...فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ…".
ما يُستنتجُ من هاتين الآيتين، هو أن وجودَ عالم الأحياء مبنيٌّ على الاختلاف. وبما أن عالم الأحياء جزءٌ لا يتجزَّاُ من العالم ككل، الذي بيَّنتُ أعلاه أنه قائمٌ على الاختلاف، فهذا الاختلافُ ظاهرةٌ أرادها اللهُ أن تكونَ خاصيةً من خاصيات ما أوجده الله سبحانه وتعالى من مخلوقات حية وغير حية.
بعد هذه التوضيحات، أدخلُ في صُلب الموضوع و أقول : كثيرا ما نسمع عبارَتَي "أجْمعَت الأمة على..." أو "أجمعَ العلماء على...".
وحتى يسهلَ إدراكُ ما تحتوي عليه هاتان العبارتان من معنى، فيما يلي تفسير لفعل "أجمَعَ" ولمُفردة "أمة".
فعل "أَجْمعَ" يعني الاتفاق على أمر من الأمور بالإجماع؟ أي بموافقة الجميع. وهذا الفعلُ، أي "أَجْمعَ" متداولٌ في السياسة إذ غالبا ما نسمع أن البرلمان صوَّت بالإجماع على قانون ما. كما نسمع كذلك أن فلانا تمَّ انتخابُه بالإجماع. وهذا يعني أن جميع أعضاء البرلمان أعطوا موافَقَتهم على هذا القانون. كما يعني أن كل الناخبين أعطوا أصواتَهم لفلان.
أما أمَّةٌ، فتعني : "جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ (البشر) تَجْمَعُهُمْ رَوَابِطُ تَارِيخِيَّةٌ مُشْتَرَكَةٌ، قَدْ يَكُونُ فِيهَا مَا هُوَ لُغَوِيٌّ أوْ دِينِيٌّ أوِ اقْتِصَادِيٌّ أو ثقافي… وَلَهُمْ أهْدَافٌ مُشْتَرَكَةٌ فِي العَقِيدَةِ أَوِ السِّيَاسَةِ أَوِ الاقْتِصاد... (منقول عن معجم المعاني).
فعندما نقول : "أجمعت الأمَّة على أمر له علاقة بالدِّين"، وهنا يتعلَّق الأمر بالأمة الإسلامية، فهذا يعني أن جميعَ الناس المسلمين (ذكور وإناث)، بدون استتثناء، وافقوا واتفقوا على هذا الأمر! أو بعبارة أخرى، إن جميعَ أفراد الأمة متَّفقون على هذا الأمر.
أول ردِّ فعلٍ على عبارة "أجمعت الأمَّة على أمر له علاقة بالدِّين"، هو أن هذه العبارة مخالِفةٌ لما أراده اللهُ من اختلافٍ في العالم (الأرض)، كما وضَّحتُ ذلك أعلاه. فإذا كان الاختلافُ خاصيةً أرادها الله سبحانه وتعالى للبلاد ةالعباد، فأي عاقل سيقبل هذا الادِّعاء وهذا الاستخفافَ بعقول الناس؟
فكيف لأمَّةٍ أكثر من نصف أعضائها أمِّيون، ولا يُدركُون أمورَ الدين إلا عبر القيل والقال والتقليد الأعمى، أن تتَّفق بالإجماع على أمر ما له علاقة بالدين؟ وبعبارة أخرى، كيف لِما يُناهز مليارَي مسلم (سنة وشيعة، مع أغلبية ساحقة سنِّية) أن يُجمِعوا على أمرٍ من أمور الدين؟
فكيف لأمَّةٍ أكثر من نصف أعضائها أمِّيون، ولا يُدركُون أمورَ الدين إلا عبر القيل والقال والتقليد الأعمى، أن تتَّفق بالإجماع على أمر ما له علاقة بالدين؟ وبعبارة أخرى، كيف لِما يُناهز مليارَي مسلم (سنة وشيعة، مع أغلبية ساحقة سنِّية) أن يُجمِعوا على أمرٍ من أمور الدين؟
ما يمكن استنتاجُه من هذا الوضع، هو أن مَن يقول : "أجمعت الأمَّة على..."، نصَّبَ نفسَه للتَّحَدُّث باسم الآخرين ودون استشارتهم. وهذا فيه شيء من الاستصغار للآخرين سواءً كانوا أميين أو على دراية بالأمور. ثمَّ هل فكَّرَ المنادي ب"أجمعت الأمَّة" أن النصفَ الآخر، غير الأمِّي، أو بعضَه، يمكن أن يكونَ له رأي آخر أو رأيٌ مُخالفٌ لما جاء به الإجماع. فهل كانت هناك استشارةٌ لأفراد الأمة واحدا واحدا للتعرُّف على موقفهم من هذا الإجماع؟ وهل يكفي أن يكونَ الفقيه فقيها والعالِم عالما ليتجاهلَ الناسَ وينطق باسمهم؟ هل نسي مَن يقول"أجمعت الأمَّة" أن اللهَ سبحانه وتعالى قال:
"لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ..." (البقرة، 256)، وقال : "...وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ…" (الشورى، 38)، وقال كذلك : "...فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران، 159).
وهل نسي مَن ينادي ب"أجمعت الأمة"، أن الاختلافَ بين البشر موجودٌ منذ القِدم؟ و وجود هذا الاختلاف هو الذي جعل اللهَ، سبحانه وتعالى، يبعث رُسلا للأقوام الغابرة.
وهل نسي مَن ينادي ب"أجمعت الأمة" بأن إرادةَ الله فوق كل شيءٍ مصداقا لقوله سبحانه وتعالى : "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (هود، 118).
ما دام الله سبحانه وتعالى ترك الاختيارَ لعباده في أن يتديَّنَوا أو أن لا يتديَّنَوا، فكيف لمَن ينادي بالإجماع أن يُخالفوا أمرَ الله؟ وما دام سبحانه وتعالى لا يفرض التَّديُّنَ على عباده، فهذا معناه أنه من بين هؤلاء العباد مَن هم مقتنعون بما تم عليه الإجماعُ كما أن هناك من بين هؤلاء العباد مَن هم غير مقتنعين بما تم عليه الإجماع. وهذا يعني أن المقتنعين وغير المقتنعين ليس لهم نفس الرؤية إزاء الأمور التي يُزْعَمُ أنها حظِيت بالإجماع. فأين نحن من مقولة "أجمعت الأمة"؟
ومن جهة أخرى، لماذا حبا الله بني آدم العقلَ؟ بالطبع، لِيُفكِّروا به. و في نفس الوقت، إنه، جلَّ جلالُه، رسم لهم الطريقَ الذي، إذا اتبعوه، يجدون فيه خلاصَهم. غير أن اللهَ سبحانه وتعالى، إذا متَّعَ البشرَ بالعقلَ، فليس لمَنعهم من استعماله.
فمنهم مَن يستعملُه تماشياً مع ما رسمه الله من سبيل، وهناك، في نفس الوقت، مَن له رأي مخالف. ولهذا، فإن الله سبحانه وتعالى رسم لعباده الطريقَ الصحيحَ وحباهم العقلَ ليُرشدَهم إلى اتِّباع هذا الطريقَ أو ليسيروا في طريق آخر اختاروه بمحضر إرادتهم وبعقولهم.
وهذا هو ما بيَّنه ويُبيِّنه التاريخُ عبر العصور بل ومنذ ظهور بني آدم على وجه الأرض. فالله سبحانه وتعالى أعطى العقلَ للبشر ورسم لهم الطريقَ المستقيم وترك لهم الاختيار. والاختيار يُسفِر دائما عن تفضيل طريق عن غيره لأن الآراءَ والرُّؤى تختلف اختلافا يتماشى مع اختلاف الزمان و المكان. فأين نحن من "أجمعت الأمة…"؟
وهذا هو ما بيَّنه ويُبيِّنه التاريخُ عبر العصور بل ومنذ ظهور بني آدم على وجه الأرض. فالله سبحانه وتعالى أعطى العقلَ للبشر ورسم لهم الطريقَ المستقيم وترك لهم الاختيار. والاختيار يُسفِر دائما عن تفضيل طريق عن غيره لأن الآراءَ والرُّؤى تختلف اختلافا يتماشى مع اختلاف الزمان و المكان. فأين نحن من "أجمعت الأمة…"؟
أما عبارة "أجمعَ العُلماء على..."، فتبقى غامضةً ما دُمنا لا نعرف هل هذا الإجماعَ نادى به علماءُ بلد واحدٍ أم عدَّة بلدان أم علماء العالم الإسلامي برُمَّتِه.
وكيفما كان الحال وفي نظري، الإجماع لا يمكن أن يكونَ قائما إلا بين جماعة محدودة من العلماء الذين يقتسمون نفسَ الخلفيات الفكرية ونفسَ التَّوَجُّهات الدينية سواءً كانوا منتمين لبلد واحد أو لعِدَّة بلدان.
وحتى في هذه الحالة، يبدو لي أنه من المنطقي أن لا يكون ما تمَّ الإجماعُ عليه مخالفا لما قاله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، الآية 256 : "لا إكراهَ في الدين...". والمنطق والعقل يقولان إنه من المستحيل أن يتمَّ الاجماعُ بين علماء بلد واحد، فما بالك بعلماء الأمة الإسلامية التي تبنَّت وتتبنى على الأقل أربعةَ مذاهب.
وكيفما كان الحال وفي نظري، الإجماع لا يمكن أن يكونَ قائما إلا بين جماعة محدودة من العلماء الذين يقتسمون نفسَ الخلفيات الفكرية ونفسَ التَّوَجُّهات الدينية سواءً كانوا منتمين لبلد واحد أو لعِدَّة بلدان.
وحتى في هذه الحالة، يبدو لي أنه من المنطقي أن لا يكون ما تمَّ الإجماعُ عليه مخالفا لما قاله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، الآية 256 : "لا إكراهَ في الدين...". والمنطق والعقل يقولان إنه من المستحيل أن يتمَّ الاجماعُ بين علماء بلد واحد، فما بالك بعلماء الأمة الإسلامية التي تبنَّت وتتبنى على الأقل أربعةَ مذاهب.
أما إجماع علماء العالم الإسلامي برُمَّته، فيبدو لي غير منطقي ما دامت هناك عدَّة مذاهب وعدَّة مدارس لتفسير القرآن الكريم وعدَّة مدارس لتفسير السنة النبوية. وما تعدُّد هذه المذاهب والمدارس إلا تعبير عن الاختلاف في الرأي وفي الرؤى. فكيف يحدثُ الإجماعُ بين فئات من العلماء ليس لهم نفس الآراء ونفس الرُّؤى؟
وهل يُعقل أن نتحدثَ عن الإجماع وكل مذهب يحاول أن يفرضَ نفسَه على المذاهب الأخرى. بل إن كل مذهب يعتبر نفسَه أحسن من المذاهب الأخرى. ناهيك عن أن لكل مذهب عدَّة طوائف. و وجود طوائف داخلَ المذهب الواحد هو تعبير عن اختلافات داخل نفس المذهب. فأين هو الإجماعُ؟
ثم إن هناك سؤالا لا بدَّ من طرحَه : "فهل علماء المسلمين معصومون من الخطأ"؟
بالطبع لا، ولسبب بسيط هو أنهم بشرٌ. ولهذا، فكل ما يصدر عنهم، كبَشَر، من فتاوي وآراء وتوجهات… يحتمل الصوابَ وفي نفس الوقت، يحتمل الخطأ تمشيا مع ما جاء في الحديث النبوي الشريف : "كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التَّوابون". ولاحِظوا معي أن الرسولَ (ص) قال "بني آدم"، أي الناس جميعا بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية، الفكرية، العقائدية، العِرقية… و هذا يعني أن الرسولَ (ص) لم يستثنِ أحدا من الخطأ. بل إن الخطأ كان ملازما لأول بشرٍ خلقه الله ألا وهو سيدنا آدم عليه السلام.
بالطبع لا، ولسبب بسيط هو أنهم بشرٌ. ولهذا، فكل ما يصدر عنهم، كبَشَر، من فتاوي وآراء وتوجهات… يحتمل الصوابَ وفي نفس الوقت، يحتمل الخطأ تمشيا مع ما جاء في الحديث النبوي الشريف : "كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التَّوابون". ولاحِظوا معي أن الرسولَ (ص) قال "بني آدم"، أي الناس جميعا بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية، الفكرية، العقائدية، العِرقية… و هذا يعني أن الرسولَ (ص) لم يستثنِ أحدا من الخطأ. بل إن الخطأ كان ملازما لأول بشرٍ خلقه الله ألا وهو سيدنا آدم عليه السلام.
فإذا كان علماء المسلمين غير معصومين من الخطأ، فكل ما يتفوَّهون به نسبي. وما هو نسبي قابل للتغيير بفعل الزمان والمكان إن عاجلا أو آجلا. فأين هو الإجماع في هذه الحالة؟
أما ما أومِن به أنا شخصيا كإجماع، هو الإجماعُ حول القرآن الكريم و العبادات و السنة النبوية كما نطق بها الرسول (ص)، أي السنة التي لم تتعرَّض للتَّحريف.
ثم هل تمَّ التفكيرُ بإمعانٍ وتبصُّرٍ فيما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، الآية 48 : "...وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ…"
أليس هذا دليل على أن الله جعل الناسَ أمَماً، أي جعل الناسَ يشكِّلون عدَّة أمم تختلف فكريا واجتماعيا وثقافيا. ثم قال سبحانه وتعالى : "لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ…". أي ليرى كيف تتعاملون مع "ما أتاكم"، أي مع ما أنزل من شرائع وكتاب. وحين قال سبحانه وتعالى : "ليبلوكم"، فهذا معناه أنه، جل جلالُه، ترك الاختيارَ لعباده ليؤمنوا أو لا يؤمنوا. وحينما نتحدَّث عن الاختبار، فهناك حتما اختلاف. والاختلاف ازداد مع الإنسان وسيبقى ملازما له إلى أن يرثَ الله الأرضَ ومَن عليها.
وإذا كان الاختلافُ بين الأمم واضحا ويثقب العينين، فهو كذلك واضح ويثقب العينين داخل أمة واحدة وداخل دين واحد وداخل جماعة واحدة وحتى بالنسبة للفرد الواحد. لأن هذا الأخير ابن بيئته. و بحُكم انتمائه لهذه البيئة، فإنها تؤثِّر فيه ويؤثِّر فيها. اللهم إذا وضع هذا الفردُ قُفلاً مُحكمَ الإغلاق حول عقله كي لا ينفذ إليه التَّغيير! فأين نحن من "أجمعت الأمة" ومن "أجمع العلماء"؟
وإذا كان الاختلافُ بين الأمم واضحا ويثقب العينين، فهو كذلك واضح ويثقب العينين داخل أمة واحدة وداخل دين واحد وداخل جماعة واحدة وحتى بالنسبة للفرد الواحد. لأن هذا الأخير ابن بيئته. و بحُكم انتمائه لهذه البيئة، فإنها تؤثِّر فيه ويؤثِّر فيها. اللهم إذا وضع هذا الفردُ قُفلاً مُحكمَ الإغلاق حول عقله كي لا ينفذ إليه التَّغيير! فأين نحن من "أجمعت الأمة" ومن "أجمع العلماء"؟
يقول سبحانه وتعالى : "اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ" (الشورى، 19)، ويقول كذلك : "إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ" (الحج، 65)، أي أن اللهَ أراد للناس اليُسرَ وليس العسرَ.