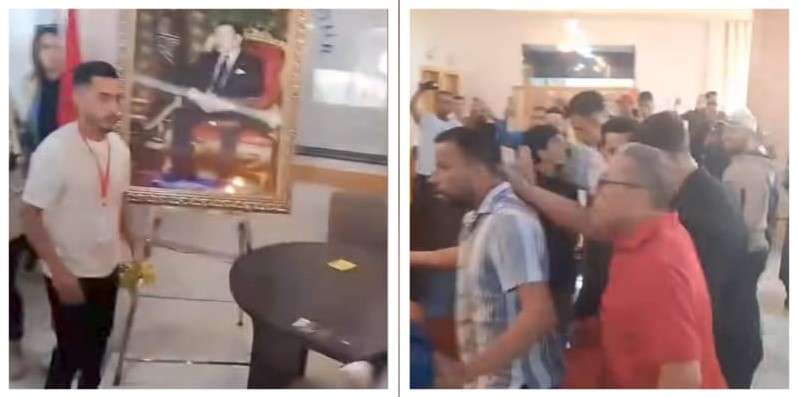شكرا للأستاذ حسام الدين درويش، مؤلّف هذا الكتاب المعرفي القيّم الذي أعتبره، بعيدا عن كلّ مجاملة، إضافة علمية ومعرفية حقيقية في موضوع لا يزال منذ عقود مثيرا للأسئلة، ولكثير من السجال الإيديولوجي، إن لم أقل الصراع السياسي والاجتماعي. هو إضافة بتحليلاته الرصينة، واستئناسه بمناهج حديثة، واستناده على مصادر ومراجع رئيسة، في لغة سلسة، وحفاظ، ما أمكن ذلك، على مسافة تبعده أكثر ما يمكن عن كلّ غلط إيديولوجي.
من الصعب أن أناقش هذا الكتاب في كلّ تفاصيله، ليس بسبب تعدّد صفحاته (ما يفوق 300 صفحة)، ولكن نتيجة تعدّد مواضيعه وتداخلها، ناهيك عن مناقشاته المتعدّدة لتصورات بعض المفكرين المتميزين داخل الساحة العربية وخارجها.
وعموما، يتضمّن الكتاب، وحتى يُكوّن القارئ صورة عامة عنه، سبعة فصول، إضافة لمقدمتيه وخاتمته ولائحة مصادره ومراجعه. هناك فصل أوّل، يمكن اعتباره بمثابة توضيح منهجي لكل أبعاد "المفاهيم المعيارية الكثيفة" التي توجد في صلب الكتاب. وفصل ثاني يتعلق بموضوع العلمانية، وتعدّد صيغها، وتماوجها بين الواقع والأدلجة، ناهيك عن علاقتها بمفهوم الإسلام الذي لا يخلو بدوره من لُبس وتعدّد الصيغ. وفصل ثالث خصّه المؤلف لمفكّر لم ينل حظه من الاهتمام، هو بطرس البستاني وتصوراته حول العلمانية. وفصل رابع ناقش فيه الأستاذ حسام الدين مدى إمكانية التوفيق بين الإسلام ومواضيع العلمانية والتنوير، طارحا مختلف الآراء لمفكرين متميّزين طبعوا الساحة الفكرية العربية. ثمّ فصل خامس عرض فيه المؤلف لحركات الإسلام السياسي، محللا لهذا المفهوم، ومناقشا لعلاقات الإسلام السياسي بمختلف الأطراف السياسية، وبالدولة نفسها. وفصل سادس ناقش فيه الكاتب وقائع المؤتمر العلمي لمركز الدراسات المتقدمة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة لايبزيغ بألمانيا بتاريخ 9 – 10 ديسمبر 2020 حول "العلاقة بين الدولة والدين في السياقات العربية والإسلاماتية: الدولة المدنية والدولة العلمانية والدولة الدينية - الإسلامية". وأخيرا فصل سابع تضمّن موضوعا بالغ الأهمية، وهو تجديد الخطاب الديني، محللا لمفاهيمه، وشارحا لما أسماه بالضوابط الداخلية والخارجية لهذا التجديد.
انطلاقا من هذه المعطيات، يبدو فعلا كم هو صعب مناقشة مجمل محتويات الكتاب في صفحات معدودة. لذا، أقترح مناقشة الأستاذ حسام الدين في محاور محدّدة كما يلي:
أوّلا: مثنوية الواقعة والقيمة
تحدّث الأستاذ حسام الدين طيلة صفحات كتابه عن هذه الثنائية. والواقع أنّ من يستقصي التجربة العربية - الإسلامية، فكرا وواقعا، يلاحظ، بعيدا عن فيض التفاصيل، أنّ ثنائية "الواقع" و"القيمة" تخترق التجربة العربية – الإسلامية منذ زمان، ولاتزال. يتجلى ذلك في تقابل العديد من الثنائيات المتعارضة (والمتساكنة في آن واحد): الخلافة والمُلك، القرآن والسلطان، الصحابة والحاشية، الشرع والدولة، الدين والدنيا، الجهاد والحرب...
أغلب من يتحدّث باسم الإسلام، قديما وحديثا، معتدلا كان أو متطرّفا، يتوق لتحقيق الطرف الأول من هذه المعادلة: يحلم بالخلافة، وأولوية القرآن، وتطبيق الشريعة، وإعلان الجهاد... ومع ذلك، ينبئنا التاريخ كيف انقلبت الخلافة (إن وُجدت أصلا) إلى مُلك، وتساكن الطرفان. وكيف تكامل الحكم السلطاني مع مبادئ الشرع الإسلامي، فتعايش الاثنان، وكيف تجاورت، بل وتكاملت الوظائف السلطانية – الدنيوية (من وزارة وكتابة وحجابة وشرطة...) مع الخطط الخلافية – الدينية (من قضاء وإفتاء وحسبة...) داخل جهاز ما سُمي بالدولة الإسلامية، وكيف أضفت كل الدول التي تعاقبت على الرقعة العربية الإسلامية، مشرقها ومغربها، طابع الجهاد على كلّ حروبها، حتى ولو كانت اقتتالا بين المسلمين أنفسهم.
هل يمكن الفصل بين الواقع والقيمة، بين الوصف والتقييم؟ في حالة التجربة العربية - الإسلامية، هناك حروب جرت (هذا واقع)، تمّ تسميتها بالجهاد (هذا تقييم). هناك استبداد سلطاني (هذا واقع)، تمّ تسميته بالخلافة (هذا تقييم)، هناك ضرائب تقرّرت، (هذا واقع) تمّ تسميتها زكاة وجزية (هذا تقييم) ...
هل بالمفاهيم المعيارية الكثيفة التي تجمع بين الوصف والوقائع وبين التقييم والأحكام المعيارية يمكن فهم طبيعة التجربة الإسلامية؟ نعم ولا. نعم، لأنّ الطرفين ظلا متساكنين، ولا، لأنّ الأول واقع والثاني مجرد تقييم ومثال.
ثانيا: قضية الفصل (أو التمييز) بين الدين والدولة، بين الدين والسياسة
يقترح الأستاذ ساري حنفي في تقديمه للكتاب فكرة التمايز بين الدين والسياسة بدلا عن كلمة الفصل بين الاثنين. ويبدو أنّ المؤلف، حسام الدين، لا يعارض هذا الطرح على أساس أنّ الفصل المطلق بين الطرفين غير وارد. طيب، أليس التمايز بين الدين والسياسة هو الذي كان سائدا طيلة مجريات التاريخ العربي – الإسلامي؟ ألم يميّز الفقيه الماوردي بين أدب الدين وأدب الدنيا على أساس أنّ الأوّل يهمّ قضاء الفرض من صلاة وزكاة وأنّ الثاني يهمّ عمارة الأرض، وألم يؤكّد أيضا أولوية "العمارة" على "الفرض" على أساس أنّ أيّ خرق للفرض الديني إنّما يضرّ صاحبه، كتارك الصلاة مثلا، وأنّ خرق قواعد "العمارة" يضرّ الغير، وهذا لا يجوز. وألم يؤكّد ذلك ابن الحداد، الفقيه المشرقي في كتابه "الجوهر النفيس في سياسة الرئيس" وابن الأزرق، الفقيه المغربي – الأندلسي في كتابه "بدائع السلك في طبائع الملك" بتمييزهما بين سياسة الدين وسياسة الدنيا، بل وأقر به الفقيه المغربي – الأندلسي أبو بكر الطرطوشي في مقدمة كتابه "سراج الملوك" حين ميّز بين الأحكام والسياسات على أساس أنّ الأولى تهمّ الحلال والحرام، وأنّ الثانية تهمّ ما اصطلح عليه باقي الأمم في تدبير شؤونها السياسية. ولا يتوقّف الأمر عند هذه الجوانب النظرية التي تكاد تكون عامة بين فقهاء الإسلام، بل إنّنا نجد هذا التمييز حاضرا في قلب جهاز الدولة الإسلامية (السلطانية) بين وظائف سلطانية دنيوية سياسية، وفي مقدّمتها الوزارة، وبين خطط دينية خلافية، وفي مقدّمتها القضاء.
وسؤالي هنا: ها هو ذا التمايز حاضر اسما وفعلا. ما ذا كانت النتيجة؟ لا شيء.
ثالثا: العلمانية والإسلام
خصص الكاتب حوالي مائة صفحة لموضوع العلمانية والإسلام (الفصل الثاني، حوالي 40 ص، الفصل الثالث: العلمانية في تصور بطرس البستاني، حوالي 30 ص، الفصل الرابع: عدم التوافق بين الإسلام والتنوير – العلمانية، حوالي 30 ص). بعيدا عن التفاصيل مرّة أخرى، أشير إلى أنّ هناك أولا من يؤكّد أنّ الدين إلى زوال بسبب حداثة عارمة لن تبق ولن تذر، وهناك من يؤكّد ثانيا عودة الدين من جديد واستماتته أمام كلّ المستجدّات، وهناك ثالثا من يؤكّد أن الدين كان دائم الحضور وإن اختلفت صيغ هذا الحضور.
تذهب أطروحات التحديث التقليدية إلى أنّ العلمانية لصيقة بالحداثة، وبالتالي فمصير الدين أن يلزم مكانه الخاص. أمّا أطروحات "حداثات متعدّدة" فترى أنّ هناك طرق متعدّدة لدخول عالم الحداثة. وواضح هنا أنّ الخلاف هو بين من يضفي على التجربة الأوربية طابعا كونيا، وبين من يرى في ذلك مركزية أوربية لا تصمد أمام وقائع التاريخ (الولايات المتحدة في مقابل أوربا، مثلا، بل وحتى التباين بين تجربتي ألمانيا وفرنسا).
والواقع أنّ مشروع "علمانيات متعدّدة" يأخذ العصا من الوسط وهو أمر صعب فيه توفيق بين الكثير من المتعارضات (أنظر ص 113)
هناك طبعا من يقول بالتنافر بين الإسلام والعلمانية. أطروحاتهم معروفة. وحينما يقول "دان دينر"، وغيره من المستشرقين أيضا أنّ "الإسلام دين سياسي في جوهره" (ص 123)، دين ودولة في نفس الآن مقابل مسيحية باعتبارها دينا وكفى، أقول له مستندا على المفكر المغربي عبد الله العروي، أنّ مقارنتكم معيبة في الأساس. وأنكم حينما تعتبرون المسيحية دينا وكفى، تتحدّثون عن العقيدة، عن المعتقد، وحينما تعتبرون الإسلام دينا ودولة، فإنكم تتحدثون عن التاريخ ووقائعه. ولو عنيتم بالإسلام المعتقد، فهو دين بلا دولة، ولو عنيتم بالمسيحة التاريخ والوقائع فإنها دين ودولة، بابوية وامبراطورية...
ويبدو أنّ مركز الدراسات بجامعة لايبزيغ محق في أطروحاته حينما يرى أنّ الرجوع إلى السياقات التاريخية أمر مفيد في هذه الحالة. ففي دراسة صدرت لي مؤخّرا تحت عنوان "النصيحة السياسية، دراسة مقارنة بين نصائح الملوك الإسلامية ومرايا الأمراء المسيحية" تبين لي العديد من أوجه التشابه بين فقهاء المسيحية والإسلام فيما يخصّ العلاقة بين الدين والسياسة، وأن المسيحية دين سياسي تماما كما هو حال التجربة الإسلامية. والتاريخ فعلا هو الذي يبين كيف تمكنت أدبيات الغرب المسيحي من تصور الدولة ككائن طبيعي، مقابل الخلط الذي ظلّ سائدا عندنا بين دائرتي الأخلاق والدين من جهة والدولة والسياسة من جهة أخرى.
وهنا أطرح سؤالا واحدا للتفكير فيه: لدينا في تراثنا الإسلامي فقيه كبير ومفكّر موسوعي هو قاضي القضاة أبو الحسن الماوردي، ولديهم في العصر الوسيط المسيحي ثيولوجي كبير ومفكّر موسوعي هو "جيل دو روم" Giles de Rome. كتب الماوردي كما كتب نظيره "جيل دو روم" في الدين وعلومه، وفي السياسة وآدابها. وكتب الأوّل كما كتب الثاني في مرايا الأمراء والنّصح السياسي. ألّف "جيل دو روم" كتابا ضخما عنوانه "حُكم الأمراء" لا يستند فيه، وهو رجل دين، على أي مرجع ديني. سؤالي هو: هل يمكن أن نتصوّر الماوردي يؤلّف "نصيحة الملوك" دون أن يحيل على الآية القرآنية والحديث النبوي؟
ومن جهة ثانية، يرى المؤلف في مناقشته للعلاقة بين العلمانية والدمقراطية، أنّ هذه الأخيرة لا تستدعي بالضرورة الفصل بين الدين والدولة، مستندا في ذلك على مثال بريطانيا (الملك رئيس الكنيسة)، وعلى التجربة الألمانية (عدم الفصل بين الدين والدولة), والسؤال: هل هذا يعني أنّ المجال العام في هذين البلدين يعيش تداخلا بين الدين والسياسة؟ طبعا الجواب بالنفي.
والواقع أنّ ما لاحظته في مبحث الأستاذ حسام الدين حول تفكيك ثنائية علماني / ديني، تواجد رغبة مستترة لإيجاد توافقات بين الطرفين. ويبدو أنّه وجد هذا التوافق، كما وجده سابقا آخرون، من خلال مفهوم الدولة "المدنية"، وإن أكّد عمومية هذا المفهوم باعتباره "دالا عائما" يشير إلى مدلولات مختلفة. وملاحظتي أنّ هذا الطرح، يبدو كما لو أنّه يتضمن فكرة أنّ العلمانية مناهضة للدين بشكل من الأشكال، وهذا غير صحيح تاريخيا ونظريا.
رابعا: حول الإسلام السياسي
جاء الربيع العربي، وفاز الإسلاميون في تونس ومصر والمغرب. وتلا ذلك هبوط، أحيانا مدوّي، لهذه الأحزاب. وهذا يعني، كما يقول الكاتب عن حق، أنّ هناك إسلام آخر لم يصوّت عليهم، ناهيك أنهم لم يحصلوا على الأغلبية في أي انتخابات. فلملذا التخوف منهم؟ وعن علاقة الإسلاميين بالدولة، يرى صاحب الكتاب أن الربيع العربي كان فعلا فرصة ذهبية أضاعها الإسلاميون لنقص خبرتهم ممّا حال دون تطبيق شعاراتهم. أمّا عن الفصل بين الديني والدعوي، فيذهب المؤلف إلى أنّه "لا يعني ولا يتطلب الفصل الكامل بين الديني والسياسي. فمن غير الواقعي ولا الضروري أن يتخلى الإسلام السياسي عن كلّ صلة له بالدين في تنظيره وممارساته، وليس واضحا كيف يمكن له أن يحقق ذلك التخلي ويبقى إسلاما سياسيا" (ص 228). ومرة أخرى، بعيدا عن التفاصيل أشير إلى ملاحظات بسيطة:
- هل القول باستغلال الدين في السياسة لدى حركات الإسلام السياسي، حكم إيديولوجي معياري، أم واقع عيني؟
- الحديث عن إسلام سياسي معتدل مفاوض مقابل إسلام عنيد، أو جهادي متطرف فيه نظر. الاختلاف في الدرجة وليس في النوع.
- أشار الكاتب في معرض حديثه عن الإسلام السياسي إلى أنّ الأمر لا يتعلق بمعايير (حاسمة) بل ب"قيم" عامة حول العدالة والمساواة والأخلاق الحميدة. وطبعا هي مبادئ عامة تتقاسمها، أو تكاد، مجموع الديانات البشرية. وهنا ألاحظ: اليس من المفيد تربية الناس، وخاصة الأجيال الصاعدة، في الأسرة والمدرسة، على أخلاق مدنية بدل أخلاق دينية مبنية على الترغيب في الجنة والترهيب من النار؟
- يبدو كما لو أنّ الكاتب يبحث عن موطئ قدم للحركات الإسلامية. فها هي أحزاب إسلامية في المغرب وتونس مندمجة وراضية باللعبة، فلماذا التخوف؟ سؤالي: إن كان الأمر كذلك فلم تلجأ إلى الآية القرآنية والحديث النبوي في برامجها السياسية ومنابرها الإعلامية؟ الواقع أنها عمليا مثل باقي الأحزاب، ونظريا تركّب جملا أخلاقية في سبيل نتائج انتخابية.
خامسا: بين خطاب الدين والخطاب الديني (تجديد أم نقد)
يميز الكاتب عن حقّ بين الدين والتدين وبين الخطاب الديني وخطاب الدين. ومع ذلك يعترف بصعوبة التمييز بين الطرفين. الأول مقدس والثاني تأويل. وبهذا الصدد أتساءل: ما العمل مع آيات قرآنية لا تحتمل التأويل علما أنّ وقائع اليوم تبيّن بما لا يدع مجالا للشكّ انتهاء صلاحيتها؟ طبعا، يحتجّ الكثير اليوم، كما هو معروف، بما يسمونه النصوص القطعية. فليكن، ألا يوجد الكثير من الأحكام القطعية التي تمّ إهمالها في صمت ودونما ضجيج؟ من منّا يتحدّث اليوم عن حدود قطع يد السارق أو جلد الزّاني التي تعجّ بها كتب السياسات الشرعية؟ من منّا يتحدّث اليوم عن أحكام الرّق التي لا نزال نردّد الآيات المتعلّقة به؟ لماذا إذن لا نقول، كما قال الأستاذ عبد الله العروي "إنّ أحكاما شرعية أخرى يجوز إهمالها إذا لم تعد فائدتها واضحة (...) تعليق حكم شرعي من طرف البرلمان، لا يعني الحكم ببطلانه مطلقا، لا ماضيا ولا مستقبلا، فليس فيه ما يدلّ على تكذيب أو تسفيه أو مروق أو عقوق."
وحيث أنّ الكاتب يرى أن تجديد الخطاب الديني لا يمكنه أن يخرج عن دائرة الدين بوصفه ثابتا، فالأحرى استعمال عبارة نقد الفكر الديني، خاصة وأنّ الكاتب يرى أنّ التجديد قد ينزلق إلى ما هو غير ديني. والواقع أنّ الحديث عن ضوابط داخلية تحكم تجديد الخطاب الديني، بدت لي أحيانا وكأنها نوع من ممارسة الرقابة على حرية التفكير.
ومع ذلك، فإنّ ما يقترحه الأستاذ حسام الدين بغاية تحقيق التجديد الديني من إصلاح سياسي واقتصادي، وتوجه ديمقراطي، ومراعاة أوضاع المجتمعات العربية والإسلامية، وأصالة دون أصولية، ومصالحة الذات في علاقتها بالآخر (رجل – امرأة، يميني – يساري، مؤمن – ملحد...) ناهيك عن الدور الرئيس الموكول للمؤسسة السياسية... كلها أمور لا يمكن أن نختلف بشأنها.
وأخيرا، دونما ادّعاء بمناقشة الكتاب في شموليته، أكرّر أهمية هذا التأليف، وطرحه لقضايا راهنة لم تجد بعد طريقها إلى الحل.