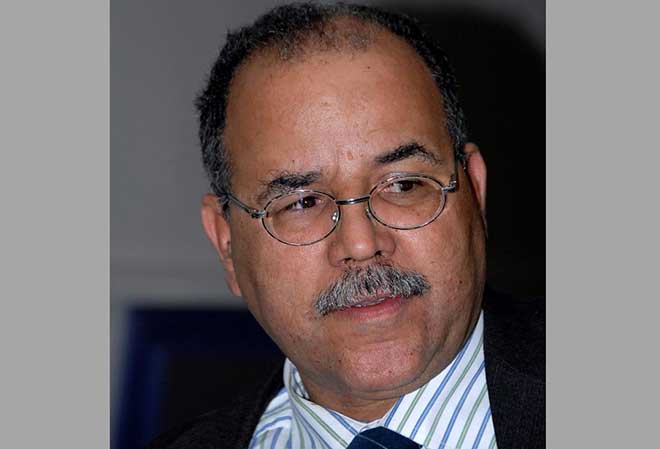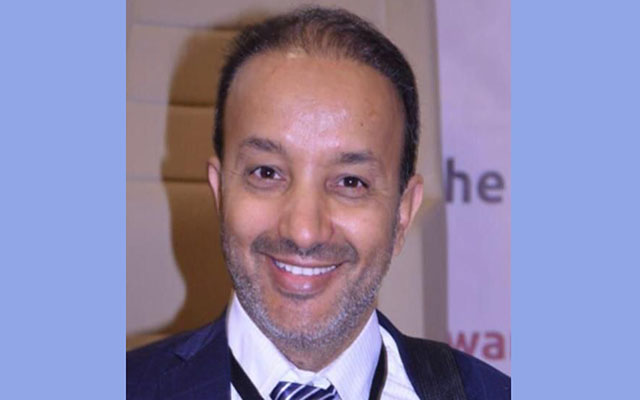من النتائج البارزة التي أسفر عنها مناخ الانفتاح الذي عرفه المغرب منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، ذلك التحول في وعي المواطن الذي أدى شيئا فشيئا إلى تغيير رأيه في السلطة بكل أنواعها، وهي التي ظلت تجسد لعقود طويلة مصدرا للخوف وأداة للقهر والضبط.
لقد كان المواطن يعي بأن رجال السلطة هم في نهاية المطاف أناس يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق مثل باقي أفراد المجتمع، وأن لهم نزواتهم الخاصة، وأنهم يخطئون ويصيبون، ويعدلون ويتعسفون ويظلمون... ومع ذلك فإنه كان يبتلع كل المحن في صمت وصبر دون أن يجرأ على مجرد التعبير عما يلحقه من أذى.
وكانت الأحزاب والهيئات النقابية وحدها تمتلك امتياز تنظيم مسيرات وتظاهرات في مناسبات محدودة في الزمان والمكان، باتت تشكل فرصا نادرة تمنح للمواطنين الحق في الصراخ وتبيح التظاهر للعامل والفلاح والتاجر كل فاتح ماي في وجه الظلم والتفقير الذي يطاله بشكل يومي.
أما في أيامنا هذه فقد أصبح المواطن بفعل هذا المناخ الذي لعب فيه السياق العالمي وأدوات الاتصال الحديثة دورا حاسما، لا يقنع بأن ترفع السلطة يدها عنه فحسب، بل يطالبها بأن توفر له حاجياته الأساسية من شغل وسكن وتعليم وتطبيب...
هذا التغيير الذي طال مفهوم المواطن للسلطة خلال السنين الأخيرة رافقته مظاهر الاحتجاج التي أصبحت تنتشر في كل مكان، في الشوارع وامام البرلمان ومقرات الولايات والعمالات، وفي غيرها من الأماكن التي ترمز لوجود السلطة.
وإذا كان من الطبيعي أن يعرف المجتمع المغربي لفترة محدودة هذا الكم الهائل من أشكال الاحتجاج، فإنه بعد مضي أكثر من عقدين على تدشين هذه المرحلة التي تمنح الانطباع بأن "مفهوما جديدا" للسلطة هو في طور التشكل، فإن ما ليس طبيعيا في السياق الوطني الحالي هو محاولات "تقنين" ظاهرة الاحتجاج عن طريق العمل بسياسة المنع والقمع التي تذكرنا بمغرب النصف الثاني من القرن الماضي، والتي أدت من بين ما أدت إليه إلى شروخ اجتماعية وسياسية ما زال البلد يؤدي ضريبتها إلى الآن. كما أن سن مزيد من القوانين الزجرية التي تحد من طموح المواطن إلى العيش الكريم وحقه في التعبير عن رأيه، لن يجدي نفعا، في ظل التحولات الكبرى التي تجري من حولنا.
إن نشر ثقافة الاحتجاج التي تنطلق من وعي المواطن بحقوقه وواجباته، ومن تأطير حقيقي تسهم فيه مؤسسات المجتمع المدني من شأنه أن يمأسس الاحتجاج وينظمه. ولكن مثل هذه الثقافة تقتضي تشبع المسؤولين بثقافة الحوار التي بدونها لن تكتمل حلقة الدينامية الاجتماعية، لآن من المفارقات أن يتطور وعي المواطن، وأن تسود رجال السلطة نفس العقلية المتحجرة التي تدعي احتكار الحقيقة بدافع الغيرة على الوطن.
إن ما نشاهده اليوم هو غياب هذه العلاقة بين ثقافة الاحتجاج وثقافة الحوار. فلا النقابات ولا الأحزاب ولا جمعيات المجتمع المدني، قادرة على تأطير المواطن بشكل يجعله يعرف ما له وما عليه، ولا المسؤولون مقتنعون بأهمية ثقافة الحوار من أجل الوصول إلى حلول للمشاكل الملحة التي لا تقبل التأجيل.
لا يكفي عندما نتحدث عن ثقافة الحوار، أن تجتمع الحكومة بالنقابات وتنشر صورا للمجتمعين، ويتصدر خبر الاجتماع وكالة المغرب العربي للأنباء. إن ثقافة الحوار تقتضي أولا وقبل كل شيء الإنصات إلى الآخر دون أفكار مسبقة، كما تتطلب الاستعداد إلى تعديل موقف أحد الطرفين، إذا كان موقف المحاور مقنعا. كما تتطلب إشراك جميع أطراف الحوار في التعرف على الأوضاع وحقهم في الوصول إلى المعلومة. كل حوار لا ينبني على الندية والاقرار بأن لا أحد يمتلك الحقيقة ولا يقبل بأن كل القضايا قابلة للأخذ والرد، ليس حوارا بقدر ما هو سجال عقيم يستهلك الجهد والوقت دون جدوى.
إن أهمية الحوار تقاس بالنتائج التي يتوصل إليها، وليس بعدد الساعات والأيام التي استغرقها. ويبدو أن حوار الحكومة الحالية مع الهيئات النقابية يشكو من خلل ما. مما يعني أن ثقافة الاحتجاج التي اكتسبها المغاربة مع مطلع القرن الواحد والعشرين لم يرافقها تطور في ثقافة الحوار التي يبدو أنها تعاني تخلفا كبيرا. ذلك أن مشاكل مصيرية تراهن عليها فئة واسعة من المجتمع المغربي تحتاج إلى حوار حقيقي يتسم بالشجاعة الأدبية والمسؤولية والشفافية.
الحوار بهذا المعنى لا يفرز منتصرا ومنهزما، لأن نجاحه هو نجاح لكل الأطراف المشاركة فيه، وفشله هو فشل لها.
وعندما يخرج المسؤولون الحكوميون بتصريحات في وسائل الإعلام، يعلنون فيها أن لا زيادة في الأجور، وأن الحكومة لظروف تمر بها البلاد، ليس لديها ما يسمح بالاستجابة للمطالب النقابية والاجتماعية، ثم يبادر هؤلاء المسؤولون أنفسهم إلى دعوة النقابات إلى الحوار الاجتماعي، فإن النتيجة معروفة مسبقا، وإن الحوار لم يعد سبيلا إلى التوافق، بل أصبح في هذه الحالة وسيلة للاستهلاك الإعلامي. بل إنه يتحول إلى وسيلة للتضليل، وهذا ما يفسر طول المدة التي يستغرقها، والتي تهدر فيها الساعات والأيام والشهور، ثم تتمخض في نهاية الأمر عن نتائج هزيلة لا يعتد بها.
إن ما يلحق الضرر بالحوار الاجتماعي بالإضافة إلى ما سبق، أن اللقاءات التي تعقد بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين تبدأ في الصفر عندما يتعلق الأمر بوزراء جدد. ذلك أن كل مسؤول حديث العهد بالقطاع الذي أسند إليه تدبيره يصر على شطب إرث من سبقه، والبدء من السطر الأول، وكأنه أول وزير على القطاع. وهذا بالضبط هو ما يجعل الملفات تتراكم على بعضها والمشاكل تزداد تعقيدا، مما يطيل أمد الملفات المطروحة التي قد يستغرق حلها سنوات وليس شهورا.
كل حوار لا ينبني على نتائج الحوار الذي سبقه يتحول إلى مناورة لربح الوقت، وهو ما يفاقم العلاقة بين المتحاورين ويقضي على الثقة التي من المفروض أن تشكل عنصرا أساسيا ومشتركا فيما بينهم. وما نشاهده اليوم في جلسات الحوار بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين لا يخرج عن هذا النطاق الذي يحول الحوار إلى مبارزات كلامية لا تنفع معها البيانات البلاغية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.