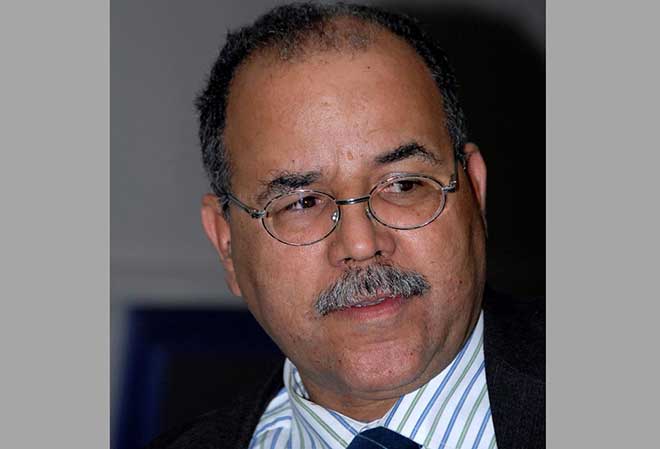من يستمع إلى الماسكين بزمام التعليم العمومي ببلادنا هذه الأيام، لا يملك أن يشفق عليهم، فهم يبدون حماسا ووعيا بما يتخبط فيه التعليم العمومي من مشاكل، ويعلنون عن برامج ومخططات لإصلاح ما أفسدته "الإصلاحات" السابقة، ويجتهدون في حشد الدعم لما يبيتونه من مشاريع، ولكنهم لا يملكون الإرادة الحقيقية التي تجعل من كل هذا واقعا ملموسا. إن أقسى محنة يمكن يتعرض إليها كل مسؤول حقيقي، أن "يعرف" مكمن الخلل في المجال الذي يشرف عليه دون أن يمتلك القدرة على تصحيحه.
والمتتبع لما يروج في دهاليز الوزارتين الوصيتين عن التربية الوطنية والتعليم العالي، وما يصدر عن مسؤولي هذا القطاع الحيوي من تصريحات، وما يعد من لقاءات ومناظرات، لابد أن يدرك أن هذه المحاولات ستخرج كسابقاتها "من الخيمة مائلة"، كما يقول المثل المغربي، لأن النقاش لحد الآن يصب فيما هو تقني، في حين أن مشكلة التعليم في بلادنا أكبر وأعمق من أن ينظر إليها من هذه الزاوية.
فقد سبق أن صرفت ملايين الدراهم من المال العام من أجل تثبيت نظام الباشلور في الجامعة المغربية على سبيل المثال، وعقدت من أجله ندوات ومناظرات محلية ووطنية، وخصصت ميزانية ضخمة للترويج له وتسويقه، ثم جاء وزير جديد ليلغي المشروع برمته ويقبره في المهد، وشرع في الترويج لـ"مشروع إصلاح" جديد لا تعرف له ملامح لحد الآن.
وكأن مسألة التعليم ببلادنا تخضع لأمزجة المسؤولين وهواهم أكثر مما تنبع من إرادة وطنية تراعي مصلحة البلاد والعباد. إن هذا المثال الذي لا نعدم أشباها له على مر السنين، يبين إلى حد تفتقر الدولة لاستراتيجية حقيقية تضع حدا للنزوع نحو التجريب في مجال لا يقبل التجريب.
لا شك في أن الإمكانات المرصودة للوزارتين عاجزة عن توفير احتياجات قطاع التعليم العمومي، وهي مشكلة عاناها القطاع منذ الاستقلال وما زال يعانيها إلى اليوم. ولكن ما يعرفه التعليم ببلادنا من تعثر ليس راجعا إلى قلة الإمكانيات فحسب، فالتعليم يعكس أزمة مجتمعية لم يجد المغاربة بعد طريقا إلى التخلص منها.
إن المشكلة ذات طابع بنيوي لا يحلها المال وحده ولا توفير الموارد البشرية الكافية، إنها تحتاج إلى تفكير جماعي وإرادة سياسية، أكثر مما تحتاج إلى ميزانية ضخمة. من هنا فإن ما يلاحظ على هؤلاء المسؤولين الذين يتباكون على حالة التعليم ببلادنا اليوم، هو أنهم يختزلون مشاكله في بعض المظاهر، هي في الواقع نتائج وليست أسبابا، مثل الاكتظاظ والهدر المدرسي والنقص في التأطير وغيرها. وعندما يكلفون أنفسهم عناء البحث عن حلول، يكتفون بإجراءات "تقنية" ترقيعية لبعض الأعطاب ذات الطابع الكمي، وكأن مشكلة التعليم ستجد طريقها إلى الحل عندما تنجح الدولة في توفير قسم لكل عشرين تلميذا، وعندما توقف نزيف المدرسة المغربية الذي يجعل نسبة من يصلون إلى التعليم العالي من تلامذتها نسبة مخجلة، ويجعل نسبة ضئيلة من تلك النسبة المخجلة تغادر الجامعة دون أن تحصل على شهادة جامعية.
إن الخلل في إصلاح التعليم يكمن في التشخيص الموضوعي الذي يمهد السبيل للبحث عن حلول ناجعة لمشاكل المدرسة المغربية. وعلى الرغم من "التخمة" التي يعرفها التعليم على هذا المستوى، على المستوى النظري (الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون الإطار...) وعلى الرغم من المناظرات والندوات والنقاشات التي عقدت وستعقد لحل هذه المعضلة، إلا أن هذا الركام من الأوراق الذي نتج عن هذه الاجتماعات والهيئات لا يعدو أن يكون اجتهادا نظريا صعب التطبيق، أو تشخيصا كميا يضع الإصبع على ظاهر الأشياء دون أن ينفذ إلى عمقها.
فما لم يبن إصلاح التعليم على دراسات رصينة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية للمتعلم والمعلم معا، وما لم تحدد الأهداف من عملية التعليم برمتها تحديدا دقيقا يراعي حاجة المجتمع المغربي وسياقه، وإمكانات الدولة المغربية المالية، فإن كل محاولة في هذا الاتجاه تبقى محدودة في الزمن والمكان.
إن تعليمنا ظل لسنين طويلة ضحية مزايدات سياسوية وإيديولوجية جعلت كل وزير ياتي بإصلاحه الخاص، حتى غدا التعليم مختبرا لتجارب أغلبها غريب عن سياق المجتمع المغربي.
ومن المؤسف أننا بعد ما يقرب من سبعين سنة من الاستقلال، ما زلنا نتساءل حول لغة التعليم، أهي العربية أم الفرنسية أم غيرهما. وما زال الوزراء الذين يتعاقبون على التعليم "يتنافسون" في البحث عن تعليم ينسجم مع "الهوية" المغربية ويكرسها، وما فتئوا يستهلكون الجهد والمال من أجل أن "تصنع" المدرسة والجامعة "مواطنا صالحا" بالمقاييس التي حددت للمواطن الصالح .
يحدث هذا في القرن الواحد والعشرين حيث يغادر التلميذ أو الطالب المدرسة أو الجامعة المثقلتين بالجدران والأوامر والنواهي، ليفتح لنفسه أفقا لامحدودا، غير مسيج بأية أيديولوجية أو نزعة سياسوية، وذلك بمجرد الضغط على هاتفه أو فتح حاسوبه.
يمكن أن يتخلص التعليم المغربي من أزمته عندما ينتهي الجدل العقيم حول "الهوية" التي تأخذ في كثير من كتبنا المدرسية شكلا شوفينيا يضيق به صدر الأستاذ والتلميذ معا، وعندما نخلص اللغة من تبعيتها الإيديولوجية وننظر إليها باعتبارها لغة فقط، تتطور بتطور المتكلمين بها، كي تقول ما نريد نحن وليس ما قاله أسلافنا.
وعندما نمتلك معرفة علمية بالمجتمع المغربي وسيكلوجية الطفل المغربي، معرفة موضوعية تكشف عن الحاجات الحقيقية للجماعة والفرد. مما يعني أنه لا يمكن أن نتحدث عن تعليم يواكب العصر إلا إذا كنا معاصرين حقا. وأن نكون معاصرين يعني أن نهيء الشباب المغربي كي يعيش العصر الحديث ولا يعيش على هامشه.
إصلاح التعليم بهذه المتطلبات لا يتحقق بقرار إداري بل بإرادة سياسية تصدر من قاعدة استشارية عريضة، وتنبع من فكر جرئ ينحاز إلى مجتمع المعرفة، دون التركيز على ما يمكن أن يكمن خلف ذلك. فقد أثبتت التجارب أن لا مكان للتوفيق بين المتناقضات، وعلينا أن نختار: هل نريد مدرسة للمستقبل تستوعب عصرها أم نريد "معملا" لتفريخ البلادة باسم الحفاظ على الهوية والأصالة. وهكذا فإن مقدمات أي إصلاح ينبغي أن تنطلق من مسألتين أساسيتين:
أولاهما تتجلى في أن حل مشكلة التعليم لا يمكن أن يناط بوزير أو حكومة، إنها مشكلة مجتمع بكامله. وبما أنها كذلك فإنها تحمل بعدا استراتيجيا لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون مرهونا بالمؤقت والطارئ، بل بمؤسسة من مؤسسات الدولة الدائمة. والمرشع لهذه المهمة هو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي شريطة إعادة النظر في تشكيلته وصلاحياته، بطريقة تجعله فضاء للتفكير وتراكم الخبرة.
ـ ثانيتهما تتمثل في أن الوقت قد حان كي يتخلص التعليم من الأثقال السياسوية والإيديولوجية التي ينوء بها، والتي تجعل تلاميذنا وطلابنا يعيشون لحظات انفصام يومي، وهم "يدرسون" مواد بعضها يحث على العقل ويعلي من قيمته، وبعضها يحط من شأنه ويسفهه. هذه المفارقة لا يمكن أن تنتج سوى مواطن متردد، يطبعه التذبذب في سلوكه وعلاقته بمحيطه، ولا يستطيع أن يبلور حلمه الخاص بالمستقبل، لأنه تعلم أن ينظر إلى الأمام وإلى الخلف في الآن ذاته، وهي بدون شك، مهمة مستحيلة، قد توصله إلى الهاوية.