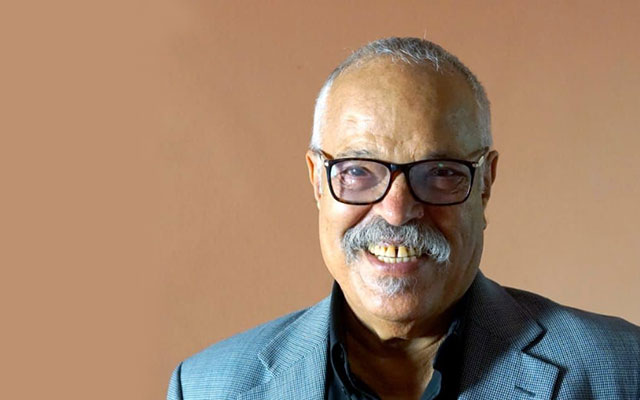ضرورة التحرر من المركزية التراثية
عندما ولج جيلنا، جيل الستينات، كلية الآداب بالرباط، كانت لا تزال كلية فتية تصارع في جبهات متعددة لتؤكد وجهها المغربي تأطيرا وبرمجة ودراسات. وقد عاش ذلك الجيل، لا أقول أشكالا من الانفصام، وإنما أشكالا من الازدواجيات، وضروبا من التشتت، وأنواعا من التقسيمات. لا أشير فحسب إلى توزعنا بين عدة مجالات، وتلقينا الدروس عن أساتذة تطوعوا لتدريس ما لا يهتمون به في تخصصاتهم، إن صح الحديث وقتها عن تخصصات، وترددنا نحن في ما بعد بين اهتمامات ومجالات شتى مشتتة، لا أشير إلى كل هذا فحسب، وإنما أساسا إلى ذلك التقسيم الذي ترسخ في قسم الفلسفة بين فكر فلسفي من جهة، و"فكر إسلامي"، ثم "فكر عربي معاصر".
قارات فكرية
لا يتعلق الأمر هنا بتخصصات يبررها توزيع مواد التدريس والدراسة، كأن يقسم تدريس الفلسفة إلى منطق وفلسفة عامة ثم فكر إسلامي وفكر عربي... بل بقارات فكرية متمايزة بعضها عن بعض، مماثلة إلى حد ما لما عرفه برنامج الدراسات في فرنسا من تمييز بين "تاريخ للفلسفة" وما كان يسمى "تاريخ الأفكار"، ذلك التاريخ الذي كان يشمل أولئك الكتاب الذين لم يكونوا وقتها يجدون لهم مكانا ملائما لا ضمن تاريخ الأدب ولا ضمن تاريخ الفلسفة، والذين ظلوا يعدون، حتى وقت قريب، في منزلة بين-بين، شأن مونتيني وباسكال وفولتير ومونتسكيو وروسو، الذين انتظروا مدة غير قصيرة كي يوليهم الفلاسفة عنايتهم، شأن مونتيسكيو مع ألتوسير، وروسو مع دريدا، وباسكال مع غولدمان وبورديو.
ربما لم نكن لنجد هذا التصالح نفسه عندنا بين الفلسفة وما يصنف "فكرا إسلاميا" أو "فكرا عربيا معاصرا". ويبدو أن ذلك الفصل الذي ترسخ بين تلك القارات الفكرية ظل قائما لمدة غير قصيرة، وعند معظم الدارسين والمدرسين. ربما يرجع ذلك إلى كون الانتقال من حقل فكري إلى آخر لم يكن يعني فحسب تغيير موضوع الاهتمام، وإنما الانتقال من طريقة في التفكير إلى أخرى، طريقة في طرح الأسئلة إلى أخرى، طريقة في التعامل مع التاريخ إلى أخرى. فبينما كان الباحث في حقل الفلسفة يسمح لنفسه بأن يحلل ويراجع وينتقد وينتج الأسئلة ويولد المفهومات، كان في الحقول الأخرى غالبا ما يتحول إلى مجرد مؤرخ يرصد التيارات، ويثبت الاتجاهات، بل ويتوقف أكثر مما ينبغي عند الوقائع التاريخية.
كانت نادرة تلك المحاولات التي سعت أن تعيد النظر في هذه التقسيمات وأن تحطم تلك الجدران الوهمية التي تفصل أطرافها، وتمد الجسور الواصلة بينها. أشير هنا إلى ما حاول بعض أساتذتنا أن يقوموا به، كعلي أومليل في كتابه في "السلطة الثقافية والسلطة السياسية"، وعبد الله العروي في بعض تآليفه وخصوصا "مفهوم العقل".
لا تهمنا هنا مناقشة هذا التمييز في حد ذاته، وإن كان يستدعي هو كذلك إخضاعه لمحك التساؤل، فقد يكون صيغة أخرى للتمييز الذي يقام بين "التراث والمعاصرة". إلا أن ما يعنينا هو محاولة الوقوف عند المضمون الذي كان الأساتذة وتلامذتهم وطلبتهم، يعطونه لمادتي الدراسة كلتيهما، وبصفة أخص، المنهج الذي يتبعونه في دراسة كل مادة، والروح التي يتحلون بها.
كانت مادة الفلسفة تحيل في الغالب عند الدارسين، طلبة وأساتذة، إلى قضايا نظرية لا يتوقف طرقها عند استعراض نصوص تاريخ الفلسفة الغربية، ولا بالأولى عند ذكر المدارس، وحصر التيارات، وتصنيف المذاهب، وإنما الذهاب إلى استنطاق تلك النصوص، واستثمارها في خدمة نمو جدلي لتحليل القضية المطروحة. فلم تكن النصوص المستعملة شاهدا على الحقيقة، وإنما كانت مادة خاما، يعيد الفكر إنتاجها، وسيقال في ما بعد، يفكك أواصرها، ويسعى الى وضعها في أزمة، بهدف فحص القضية، ومعرفة إلى أي حد يمكن الباحث، لا أن يقترب من رأي صاحب النص ويتبنى أطروحته، وإنما أساسا أن ينفصل عنه، ويقف عند ما قد يكون مواطن اختلاف معه.
حلبة الصراع
ههنا كان التشكك والنقد وإنتاج الأسئلة سادة الموقف. وحتى إن لم يتوصل الأستاذ مع طلابه، إلى نتيجة مرضية، فإنهم يخرجون غير نادمين عما انتهوا إليه، شاعرين أن النصوص التي تعاملوا معها هي، بالفعل، من أمهات النصوص التي يزخر بها تاريخ الفلسفة، وهي أمهات بقدر ما تلد وتولد من أسئلة، وتدفع إلى إعمال الفكر. والأهم من كل ذلك، أنهم يستشعرون أن درس الفلسفة ينقلهم إلى "حلبة الصراع" التي تحدث عنها كانط، وأنهم، حتى إن لم يغادروها منتصرين، فإنهم يكونون قد تخلصوا من مسبقاتهم، وتحرروا من أوهامهم، وتمردوا على سلطة النصوص.
عكس كل هذا، كان يتم عند تدريس الفكر العربي-الإسلامي. ها هنا كان الجميع يشعر أن عليه أن يدخل متحف التاريخ، فينفض عنه ما كان يتسلح به من روح نقدية وفكر تساؤلي. بل إن غالبية الدارسين، طلابا وأساتذة، لم يكونوا يشعرون أن عليهم أن يطرقوا قضايا فكرية، وإنما أن يستعرضوا مسائل لا يلمسون فيها حياة، ومعظمهم لا يشعر أنها تعنيه بالفعل.
النهج الذي كان يبدو مناسبا لهذه النظرة القاتلة للفكر، هو الاحتماء بمنهج تأريخي بارد يقتصر على عرض "الملل والنحل". فكان يكفي اجترار كتب الفرق، والاعتماد على الشهرستاني والأشعري والبغدادي وابن حزم لعرض الفرق وتشعباتها وأصنافها. قد يقال إن هناك قضايا كانت تطرح للدرس كمسألة العقل، ومسألة "القضاء والقدر"، إلا أن تدريسها ودراستها لم يكونا ليجعلا منها قضايا، بل سرعان ما يحولانها إلى عرض آراء، واستعراض مواقف. فلم يكن المدرس هنا يتعامل مع نصوصه على أنها حقل ينبغي استثماره، وحياة فكرية يلزم إحياؤها، وأسئلة ثاوية ينبغي إنعاشها، وإنما مجرد نصوص لا تستمد قيمتها إلا من قدمها الزمني وتناقلها عبر الأجيال. لقد كان المنهج الذي ينهجه هذا الدرس محاولة لا تكل لتحويل التراث إلى تقليد.
منهجان إذن وعقليتان ومفهومان عن الفكر وعن التاريخ كانا يطبعان مادتي الدراسة. وقد كان الأمر يتم في انفصال تام لإحداهما عن الأخرى. فإذا استثنينا "مقدمة" ابن خلدون، التي كان بعض المستشرقين قد نبهوا إلى أهميتها الفكرية، لم يكن يخطر ببال دارس الفلسفة، أن يسائل نصا لمفكر إسلامي وهو يدرس مسألة التاريخ ومعناه والقضايا التي يطرحانها. هذا مع العلم أن هناك مصنفات في غاية الأهمية في هذا الباب، كما كان قسطنطين زريق قد بيّن. لا أعني فحسب مقدمات بعض المؤرخين المسلمين لتواريخهم، وإنما مصنفات مهمة في هذا المضمار، ككتاب "البدء والتاريخ" على سبيل المثل.
لست أقصد، في طبيعة الحال، أن هذين المنهجين كانت تمليهما طبيعة الموضوعين قيد الدراسة والتدريس، وأن نصوص الفكر العربي-الإسلامي لم يكن لها إلا أن تخضع لهذا المنهج الذي يحولها إلى تقليد، بينما تسمح مادة الفلسفة باتباع منهج يبعث في نصوصها الحياة. لنقل، على العكس من ذلك، إن اتباع هذين المنهجين هو الذي كان يجعل من الموضوعين موضوعين مختلفين، فلو أن الدارس كان ينهج، عند دراسة الفكر العربي-الإسلامي، المنهج نفسه الذي يتبعه في مادة الفلسفة، لو كان، على الأقل، يتحلى بالروح نفسها التي يتحلى بها بالنسبة إلى الموضوع الآخر، لغدت نصوص ذلك الفكر أمهات مولدة، ولأصبح متحررا من المركزية التراثية، ولتحول إلى فكر متفحص، مولد لأسئلة، ولغدا درس الفكر العربي-الإسلامي درس فلسفة بلا منازع.
عن مجلة " المجلة ".