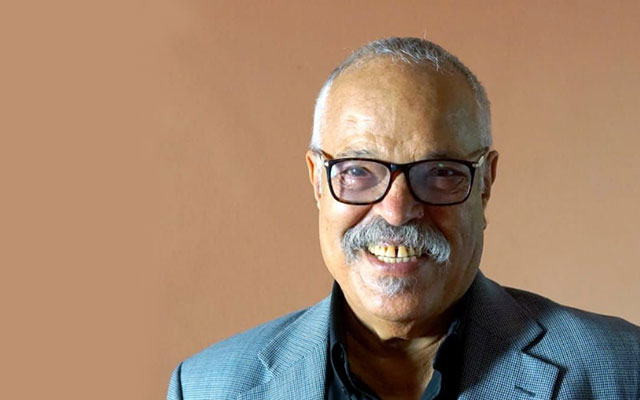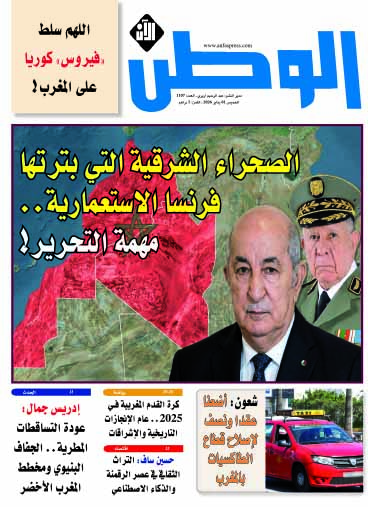الإسلام له دعاماتُه الأساسية وثوابته التي، من المفروض، أن تجعلَ منه ديناً معمولاً به في جميع بقاع الأرض المسلمة. وعندما أتحدِّثُ عن الإسلام، كدينٍ، فالأمرُ يتعلَّق بالإسلام الذي شرعه اللهُ، سبحانه وتعالى، للناس متذ نوح، عليه السلام، وأنزل، في شأنه، الوحيَ، أي القرآنَ الكريمَ، على آخِر الرسل والأنبياء، محمد (ص).
لكن واقعَ التَّديُّن يبيِّن لنا أن هذا التَّديُّن، أو ممارسة الشرائع الدينية، يختلف من بلدٍ إسلامي إلى آخر. بل قد يختلف من مسلمٍ إلى آخر. فما هو السبب في هذا الاختلاف، بينما عندما نقرأ القرآن الكريم، لا نجد له أثراً فيه؟
السبب الرئيسي يكمن في كيفية قراءة الإسلام أو في كيفية إدراكه. ولا داعيَ للقول أن مَن هم مؤهَّلون لقراءة الإسلام أو لإدراكه وتفسيره للناس، هم علماء وفقهاء الدين. غير أن هؤلاء العلماء والفقهاء، عوض أن يوحِّدوا الناسَ حول إسلام واحدٍ unifier les gens autour d'un islam unique وكوني universel، فإنهم جعلوا لهذا الإسلام نُسخا تختلف من جماعة من علماء وفقهاء الدين إلى جماعةٍ أخرى. بمعنى أن كل جماعة من علماء وفقهاء الدين تقرأ الإسلامَ وتُدرِكه حسب ما تتوفَّر عليه من خلفيات فكرية، ثقافية واجتماعية.
ولا داعيَ للتَّذكير أن إدراكَ الأشياء لا تمطره السماء. بمعنى أن شخصا ما استيقظ ذات صباح، فوجد نفسَه قادرا على إدراك كل ما يُحيط به من أشياء. هذا غير ممكن، بل مستحيل. لماذا؟
لأنه، من بين ما يتميَّز به الإنسان، هو أنه حيوانٌ ناطقٌ وعاقلُ. والنُّطقُ يكون بالكلام. والكلام لا يستقيم إلا إذا توفر الإنسانُ على رصيد معرفي يمكِّنه من التعبير عن أفكاره، عن طريق دماغه المربوط بالعالم الخارجي بواسطة الحواس الخمس. والدماغ، حيث يوجد مقر العقل، هو الذي يكون وراء اختلاف الخلفيات الفكرية، الثقافية والاجتماعية. كيف ذلك؟
لأن اختلافَ الخلفيات الفكرية، الثقافية والاجتماعية، من شخص إلى آخر أو من جماعة بشرية إلى أخرى، له علاقة وطيدة بالتَّجربة l'expérience التي يكتسبها الشخص أو الجماعة البشرية بعيشهم وتعايشهم داخلَ الوسط الذي يتحرَّكون فيه. والوسط هو مكان العيش والتَّعايش. غير أن هذا المكان لا يبقى جامدا على امتداد الوقت أو الزمان. بل يتغيَّر تحت تأثير العيش والتعايش. وهذا يعني أن التجربةَ التي يكتسبها الشخصُ أو الجماعةُ البشريةُ تتغير مع الزمان والمكان. وهذا هو ما دفع ابنَ خلدون، عالم الاجتماع المرموق إلى الإدلاء بقولتِه المشهورة : "الإنسان ابن بيئتِه"، أي أن البيئةَ (وسط العيش) هي التي تُشكِّل الإنسانَ بيولوجياً، فكريا، ثقافياً وجتماعيا.
فإذا وضعنا مثلاً طفلين حديثي الولادة، الأول في النرويج la Norvège والثاني في أفغانستان، فمن المؤكَّد أنهما سيختلفان فكرياً، ثقافياً واجتماعاً. الأول سيكون مُتفتِّخاً فكرياً، ثقافياً واجتماعياً. أما الثاني فسيكون جامدَ العقل لأنه نشأ في بيئةٍ (مكان أو وسط عيش وتعايش) لا تعطي أي اهتمام لتشغيل العقل.
ولهذا، فعلماءُ وفقهاء الدين، وخصوصا، أولئك الذين عاشوا في القرون التي أعقبت وفاةَ الرسول (ص)، وحتى الحاليون أو الجُدد منهم، لا يمكن، على الإطلاق، أن تكون لهم، نظريا théoriquement، نفس الرؤية حول الإسلام. وهذا يعني، نظرياً كذلك، أن الإسلام الذي قدَّمه للناس علماء وفقهاء الدين بعد وفاة الرسول (ص)، ليس هو الإسلام الذي ساد في عهد الامويين والعباسيين والعثمانيين. فما بالك، نظريا، بالإسلام الذي يقدِّمه لنا علماءُ وفقهاء الدين الحاليون. كان، من المفروض، أن يكونَ إسلاماً متفتِّحاً ومسايراً لما طرأ من تغييرات جذرية داخل المجتمعات الإسلامية. لكن هيهات، لقد بقي الإسلام على حاله، أي كما يراه علماء وفقهاء الدين الأولون. أي كأن المجتمعات، هي نفسُها بقيت جامدة، والحالُ أنها تغيَّرت تغييراً جذرياً. فماذا فعل هؤلاء العلماء والفقهاء؟
إنهم تنكَّروا للتَّغييرات التي حدثت في المجتمعات الإسلامية ورفضوا أن يُكيِّفوا نظرتَِهم للإسلام مع التَّطوُّر الحاصل داخل هذه المجتمعات الإسلامية. ولهذا، فإنهم فضلوا أن تبقى هذه النظرةُ على ما هي عليه بعد وفاة الرسول (ص) بقرون. فعوض أن يوحِّدوا الناسَ حول الدين الواحد المنصوص عليه في القرآن الكريم، والذي هو الإسلام منذ نوحٍ، عليه السلام، إلى آخر الرسل والأنبياء محمد (ص)، فإنهم بثُّوا ونشروا الفتنةَ بين الناس. كيف ذلك؟
فعوض أن يُوظِّفوا اختلافَ خلفياتِهم الفكرية، الثقافية والاجتماعية حول الدين الواحد المنصوص عليه في القرآن الكريم، فإنهم نجحوا في تقسيم الإسلام إلى عدَّة نُسَخٍ، وبالتالي، إلى ابتكار المذاهب والطوائف والفِرق كالمالِكية والشافعية والحنفية والحنبلية والسنة والجماعة والشيعة والإباضية والمعتزلة والخوارج…
كل مذهب له نظرة للإسلام خاصة به. وكل طائفة وكل فرقة لها نُسخة من الإسلام خاصة بهما. فهل هناك فتنةٌ أو تفرقة بثَّهما علماءُ وفقهاء الدين، القدامى، بين الناس أكثر من هاتين الفتنة والتَّفرقة؟
بالطبع، هناك فتنة وتفرقة واضحتان للعيان. لماذا؟ لأن اللهَ، سبحانه وتعالى، لا يمكن، على الإطلاق، أن يَبُثَّ الفتنةَ بين الناس، بسَنِّ عدَّةَ أديانٍ مختلفة عوض الدين الواحد، الذي هو الإسلام، والذي أوحى به، بالتَّدريج، لأنبيائه ورسله، منذ نوحٍ، عليه السلام، إلى آخِرِ الرسل والأنبياء، محمد (ص).
الدين الذي قال في حقه، سبحانه وتعالى : "...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا…" (المائدة، 3). هذه الآية الكريمة تدفعني للإدلاءِ بملاحظةٍ أعتبرها، أنا شخصياً، من الأهمِّية بمكان. لماذا؟
لأن اللهَ، سبحانه وتعالى، يُخاطِب، في هذه الآية، الناسَ، ومن ضمنهم الصحابة وكل الذين آمنوا بالله وبرسالة الإسلام، مُخبِراً إياهم بأن الدين الواحد الذي هو الإسلام، قد اكتمل. والملاحظة المهمَّة، هي أن اللهَ، سبحانه وتعالى، وجَّه كلامَه للناس قبل ولادة جل علماء وفقهاء الدين القدامى كالأئمة الأربعة والبخاري وابن تيمية وابن ماجة ومسلم والترمذي والنووي وابن حزم وابن القيم وابن حجر العسقلاني والسيوطي… يعني أن الإسلامَ اكتمل في عهد الرسول (ص).
فكان، من المفروض، أن المهمة الأساسية لعلماءَ وفقهاءَ الدين القدامى، هي تقريبُ الإسلام من الناس وجعلهم يُدركونه كما ورد في القرآن الكريم. ما قام به جلُّ علماء وفقهاءُ الدين، هو بث الفتنة والتَّفرقة، كما سبق الذكرُ. فكيف يمكن تفسيرُ هذه الفتنة وهذه التَّفرقة؟
في نظري، تفسير هذه الفتنة والتَّفرقة له سببان.
السبب الأول هو أن هناك تواطأً، من جهة، بين علماء وفقهاء الدين وحكَّام العالم الإسلامي، من جهة أخرى، والذين كانوا خلفاء للرسول (ص). وهذا التواطؤ فيه مصلحةٌ للطَّرفين، أي أن كل جهة تجد ضالَّتَها فيه. الحكام يفرضون سيطرتَهم على الناس باسم الدين. وعلماء وفقهاء الدين يفرضون رؤيتَهم للإسلام على الناس، من خلال الحكام.
وإذا افترضنا أن التَّواطؤَ غير موجود، وهو، في الحقيقة، موجود، فالسبب الثاني يتمثَّل في يقين علماء وفقهاء الدين أن نظرتَهم للإسلام هي النظرة الصحيحة، وبالتالي، من واجبِهم فرضُها على الناس بكل الطرق الممكِنة والتي تعتمد، أساساً على التَّرهيب والتَّخويف والتَّرعيب والقهر والإِجبَار والتَّضييق والاقتصاص… هذه الأساليب التي يستعملها علماء وفقهاء الدين لفرض الإسلام، كما يرونه، على الناس، لهم فيها مصلحة. ومصلحتُهم تتمثَّل في سيطرتهم على عقول الناس لتجميدها ومنعِهم من التفكير والتنوير. والتفكير والتَّنوير قد يقودان الناسَ إلى اكتشاف النوايا الحقيقية لهؤلاء العلماء والفقهاء التي تتنافى وتتناقض مع التغييرات التي تعرفها المجتمعات الإسلامية.
لكن واقعَ التَّديُّن يبيِّن لنا أن هذا التَّديُّن، أو ممارسة الشرائع الدينية، يختلف من بلدٍ إسلامي إلى آخر. بل قد يختلف من مسلمٍ إلى آخر. فما هو السبب في هذا الاختلاف، بينما عندما نقرأ القرآن الكريم، لا نجد له أثراً فيه؟
السبب الرئيسي يكمن في كيفية قراءة الإسلام أو في كيفية إدراكه. ولا داعيَ للقول أن مَن هم مؤهَّلون لقراءة الإسلام أو لإدراكه وتفسيره للناس، هم علماء وفقهاء الدين. غير أن هؤلاء العلماء والفقهاء، عوض أن يوحِّدوا الناسَ حول إسلام واحدٍ unifier les gens autour d'un islam unique وكوني universel، فإنهم جعلوا لهذا الإسلام نُسخا تختلف من جماعة من علماء وفقهاء الدين إلى جماعةٍ أخرى. بمعنى أن كل جماعة من علماء وفقهاء الدين تقرأ الإسلامَ وتُدرِكه حسب ما تتوفَّر عليه من خلفيات فكرية، ثقافية واجتماعية.
ولا داعيَ للتَّذكير أن إدراكَ الأشياء لا تمطره السماء. بمعنى أن شخصا ما استيقظ ذات صباح، فوجد نفسَه قادرا على إدراك كل ما يُحيط به من أشياء. هذا غير ممكن، بل مستحيل. لماذا؟
لأنه، من بين ما يتميَّز به الإنسان، هو أنه حيوانٌ ناطقٌ وعاقلُ. والنُّطقُ يكون بالكلام. والكلام لا يستقيم إلا إذا توفر الإنسانُ على رصيد معرفي يمكِّنه من التعبير عن أفكاره، عن طريق دماغه المربوط بالعالم الخارجي بواسطة الحواس الخمس. والدماغ، حيث يوجد مقر العقل، هو الذي يكون وراء اختلاف الخلفيات الفكرية، الثقافية والاجتماعية. كيف ذلك؟
لأن اختلافَ الخلفيات الفكرية، الثقافية والاجتماعية، من شخص إلى آخر أو من جماعة بشرية إلى أخرى، له علاقة وطيدة بالتَّجربة l'expérience التي يكتسبها الشخص أو الجماعة البشرية بعيشهم وتعايشهم داخلَ الوسط الذي يتحرَّكون فيه. والوسط هو مكان العيش والتَّعايش. غير أن هذا المكان لا يبقى جامدا على امتداد الوقت أو الزمان. بل يتغيَّر تحت تأثير العيش والتعايش. وهذا يعني أن التجربةَ التي يكتسبها الشخصُ أو الجماعةُ البشريةُ تتغير مع الزمان والمكان. وهذا هو ما دفع ابنَ خلدون، عالم الاجتماع المرموق إلى الإدلاء بقولتِه المشهورة : "الإنسان ابن بيئتِه"، أي أن البيئةَ (وسط العيش) هي التي تُشكِّل الإنسانَ بيولوجياً، فكريا، ثقافياً وجتماعيا.
فإذا وضعنا مثلاً طفلين حديثي الولادة، الأول في النرويج la Norvège والثاني في أفغانستان، فمن المؤكَّد أنهما سيختلفان فكرياً، ثقافياً واجتماعاً. الأول سيكون مُتفتِّخاً فكرياً، ثقافياً واجتماعياً. أما الثاني فسيكون جامدَ العقل لأنه نشأ في بيئةٍ (مكان أو وسط عيش وتعايش) لا تعطي أي اهتمام لتشغيل العقل.
ولهذا، فعلماءُ وفقهاء الدين، وخصوصا، أولئك الذين عاشوا في القرون التي أعقبت وفاةَ الرسول (ص)، وحتى الحاليون أو الجُدد منهم، لا يمكن، على الإطلاق، أن تكون لهم، نظريا théoriquement، نفس الرؤية حول الإسلام. وهذا يعني، نظرياً كذلك، أن الإسلام الذي قدَّمه للناس علماء وفقهاء الدين بعد وفاة الرسول (ص)، ليس هو الإسلام الذي ساد في عهد الامويين والعباسيين والعثمانيين. فما بالك، نظريا، بالإسلام الذي يقدِّمه لنا علماءُ وفقهاء الدين الحاليون. كان، من المفروض، أن يكونَ إسلاماً متفتِّحاً ومسايراً لما طرأ من تغييرات جذرية داخل المجتمعات الإسلامية. لكن هيهات، لقد بقي الإسلام على حاله، أي كما يراه علماء وفقهاء الدين الأولون. أي كأن المجتمعات، هي نفسُها بقيت جامدة، والحالُ أنها تغيَّرت تغييراً جذرياً. فماذا فعل هؤلاء العلماء والفقهاء؟
إنهم تنكَّروا للتَّغييرات التي حدثت في المجتمعات الإسلامية ورفضوا أن يُكيِّفوا نظرتَِهم للإسلام مع التَّطوُّر الحاصل داخل هذه المجتمعات الإسلامية. ولهذا، فإنهم فضلوا أن تبقى هذه النظرةُ على ما هي عليه بعد وفاة الرسول (ص) بقرون. فعوض أن يوحِّدوا الناسَ حول الدين الواحد المنصوص عليه في القرآن الكريم، والذي هو الإسلام منذ نوحٍ، عليه السلام، إلى آخر الرسل والأنبياء محمد (ص)، فإنهم بثُّوا ونشروا الفتنةَ بين الناس. كيف ذلك؟
فعوض أن يُوظِّفوا اختلافَ خلفياتِهم الفكرية، الثقافية والاجتماعية حول الدين الواحد المنصوص عليه في القرآن الكريم، فإنهم نجحوا في تقسيم الإسلام إلى عدَّة نُسَخٍ، وبالتالي، إلى ابتكار المذاهب والطوائف والفِرق كالمالِكية والشافعية والحنفية والحنبلية والسنة والجماعة والشيعة والإباضية والمعتزلة والخوارج…
كل مذهب له نظرة للإسلام خاصة به. وكل طائفة وكل فرقة لها نُسخة من الإسلام خاصة بهما. فهل هناك فتنةٌ أو تفرقة بثَّهما علماءُ وفقهاء الدين، القدامى، بين الناس أكثر من هاتين الفتنة والتَّفرقة؟
بالطبع، هناك فتنة وتفرقة واضحتان للعيان. لماذا؟ لأن اللهَ، سبحانه وتعالى، لا يمكن، على الإطلاق، أن يَبُثَّ الفتنةَ بين الناس، بسَنِّ عدَّةَ أديانٍ مختلفة عوض الدين الواحد، الذي هو الإسلام، والذي أوحى به، بالتَّدريج، لأنبيائه ورسله، منذ نوحٍ، عليه السلام، إلى آخِرِ الرسل والأنبياء، محمد (ص).
الدين الذي قال في حقه، سبحانه وتعالى : "...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا…" (المائدة، 3). هذه الآية الكريمة تدفعني للإدلاءِ بملاحظةٍ أعتبرها، أنا شخصياً، من الأهمِّية بمكان. لماذا؟
لأن اللهَ، سبحانه وتعالى، يُخاطِب، في هذه الآية، الناسَ، ومن ضمنهم الصحابة وكل الذين آمنوا بالله وبرسالة الإسلام، مُخبِراً إياهم بأن الدين الواحد الذي هو الإسلام، قد اكتمل. والملاحظة المهمَّة، هي أن اللهَ، سبحانه وتعالى، وجَّه كلامَه للناس قبل ولادة جل علماء وفقهاء الدين القدامى كالأئمة الأربعة والبخاري وابن تيمية وابن ماجة ومسلم والترمذي والنووي وابن حزم وابن القيم وابن حجر العسقلاني والسيوطي… يعني أن الإسلامَ اكتمل في عهد الرسول (ص).
فكان، من المفروض، أن المهمة الأساسية لعلماءَ وفقهاءَ الدين القدامى، هي تقريبُ الإسلام من الناس وجعلهم يُدركونه كما ورد في القرآن الكريم. ما قام به جلُّ علماء وفقهاءُ الدين، هو بث الفتنة والتَّفرقة، كما سبق الذكرُ. فكيف يمكن تفسيرُ هذه الفتنة وهذه التَّفرقة؟
في نظري، تفسير هذه الفتنة والتَّفرقة له سببان.
السبب الأول هو أن هناك تواطأً، من جهة، بين علماء وفقهاء الدين وحكَّام العالم الإسلامي، من جهة أخرى، والذين كانوا خلفاء للرسول (ص). وهذا التواطؤ فيه مصلحةٌ للطَّرفين، أي أن كل جهة تجد ضالَّتَها فيه. الحكام يفرضون سيطرتَهم على الناس باسم الدين. وعلماء وفقهاء الدين يفرضون رؤيتَهم للإسلام على الناس، من خلال الحكام.
وإذا افترضنا أن التَّواطؤَ غير موجود، وهو، في الحقيقة، موجود، فالسبب الثاني يتمثَّل في يقين علماء وفقهاء الدين أن نظرتَهم للإسلام هي النظرة الصحيحة، وبالتالي، من واجبِهم فرضُها على الناس بكل الطرق الممكِنة والتي تعتمد، أساساً على التَّرهيب والتَّخويف والتَّرعيب والقهر والإِجبَار والتَّضييق والاقتصاص… هذه الأساليب التي يستعملها علماء وفقهاء الدين لفرض الإسلام، كما يرونه، على الناس، لهم فيها مصلحة. ومصلحتُهم تتمثَّل في سيطرتهم على عقول الناس لتجميدها ومنعِهم من التفكير والتنوير. والتفكير والتَّنوير قد يقودان الناسَ إلى اكتشاف النوايا الحقيقية لهؤلاء العلماء والفقهاء التي تتنافى وتتناقض مع التغييرات التي تعرفها المجتمعات الإسلامية.