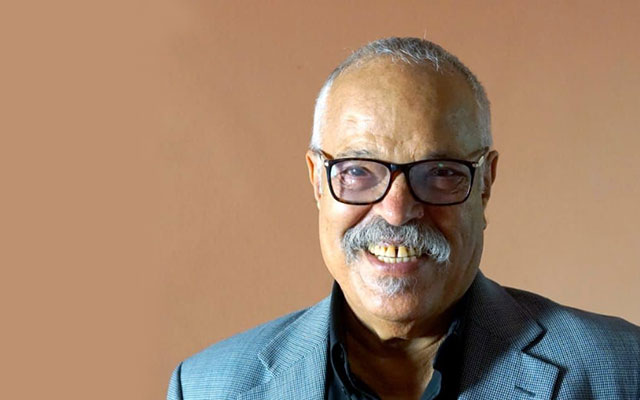هذا الصباح، هبت نسمات باردة خالية من الدفئ على حي القبيبات المتصدع. رحل الغمام وتسللت خيوط الشمس إلى أزقته الضيقة المشبعة برائحة التاريخ. تكاد جدرانه الرطبة والمشقوقة تنهار فوق رؤوس ساكنيها. بدا زقاق المصباحية المفضي إلى صحن السوق الصغير شبه مقفر من المارة، إلا من صبية وتلاميذ بأجساد نحيلة يحملون على ظهورهم حقائب ثقيلة، يحثون الخطى نحو مدارسهم في سكون يقطعه هدير البحر، ويبعثره تلاطم أمواج هائجة على صخور عنيدة. في الطرف القصي من الحي يقبع حصن الفتح المطل على بحر الظلمات، يئن تحت وطأة الإهمال والنسيان، وكأنه انتقام فظيع من تاريخ السعديين.
لكن حميد لم يعبأ بكل هذا، لا بالتاريخ ولا بالسياسة ولا حتى بحقوق المواطنة. لبث سنين طويلة يركض وراء حقه المعلوم في الحصول على وثيقة سفر، وفي الأخير لم يحصل عليها إلا بشق الأنفس.
وعلى الرغم من غرقه في وحل البطالة وبؤس العيش، إلا أنه لم يحنق يوما على المسؤولين، ولم يفكر أبدا في الاحتجاج أو الانخراط في عمل مناهض للدولة. همه الوحيد الذي يشغل باله هو الحصول على جواز السفر ومغادرة البلاد. ما فتئت والدته تصبره وتنصحه دائما: الحياة قسمة ونصيب يا ولدي، اقنع بما قسمه الله لك ولا تطمع في جنة الأرض. السياسة مآلها السجن ! هكذا كانت مي طامو تحذره منذ يفاعته. غير أن حميد كان يفكر في أمر آخر، كل تفكيره كان مصوبا نحو جنة الآخرين، جنة غناء بعيدة تقع في شمال القارة الباردة.
استيقظ حميد ثاني يوم وصوله في فراشه البارد. لبث ساهما برهة يحدق في سقف عطن ومقشر. وما هي سوى لحظات حتى هب واقفا وجعل ينظر عبر الشباك إلى مركب صيد يمخر عباب البحر قرب باب "شبيطو" الخطير، وهو نقطة المصب والتقاء وادي لوكوس بمياه المحيط الأطلسي. كان المركب يهتز ويترجرج وكأنه يؤدي رقصة السامبا. يصعد ويهبط مثل بالون مطاطي يرمى به على الأرض فيقفز، محاولا اقتحام أمواج شاهقة ليشق طريقه نحو المرسى. سرعان ما انتابه الهلع، وانتفضت ذاكرته لتعيده إلى أيام خوالي قضاها يشتغل بحارا في ميناء العرائش رفقة زميله الهواري. هذا الأخير قضى غرقا في مركب "هميوط" لما هاجمته أمواج عاتية وابتلعه البحر، ليختفي سريعا من سطح الماء عند باب "شبيطو" سيء الذكر. ولا تزال ألسنة الناس تلوك هذا الخبر المفجع إلى يومنا هذا، وتتحدث عنه كأكبر تراجيديا مروعة حلت بمدينة البحارة، حيث عم الحزن في كل أرجاء المدينة، وانطلقت الجنائز من أحياء عدة خلال اليوم الواحد. تلك ذكرى خلفت وقعا مؤلما على قلب حميد، وظلت عالقة في مخيلته إلى ما لا نهاية. فكان مؤداها أن شكلت منعطفا مفصليا في حياته، حتى أنه غادر مهنة البحارة إلى الأبد، وشرع في البحث عن شغل آخر يسد به رمقه.
تناهى إلى سمع حميد صوت أمه تناديه لوجبة الإفطار. هبط الدرج في تثاقل، ودخل بهوا ضيقا مخصصا للجلوس والأكل. كانت مي طامو للتو فرغت من صلاتها وأورادها ثم دلفت إلى المطبخ لتحضير الفطور. أما حميد فبسط ساقيه، وشبك رجليه على هيدورة خروف مسندا يديه على طيفور خشبي مزوق، ومضى يشاهد التلفاز في خشوع.
وجاءت مي طمو تحمل صينية شاي مع خبز قمح وزيت زيتون وجبن عربي لذيذ. أشارت على إبنها كي يأكل، لكنه أمسك بكوب شاي وشرع يتناول الطعام بتأفف، وكأنه يعاني من فقدان الشهية. الشيء الذي أثار دهشة مي طامو إلى حد الانزعاج. سلوك غامض لم تستوعبه امرأة بسيطة غارقة في التقاليد. كان من الطبيعي أن تتبدل شخصية حميد، وتتغير هيئة لباسه وحاسة تذوقه للأطعمة بعد سنين طويلة أمضاها في أوروبا، لا سيما وأنه كان متزوجا من ألمانية، واندمج بشكل شبه كلي في ثقافة مغايرة. وأقل ما يثبت ذلك هو عودته مطرودا بضفائر شعر طويلة تتدلى على أسفل ظهره.
وغدا سيكون على مي طامو أن تواجه أسئلة بفضول عارم من لدن جاراتها ونظراتهن الثقيلة، خاصة عندما تهم بجلب الماء في قوارير بلاستيكية، أو نشر غسيلها على حبال ممدودة بين أعمدة خشبية جنب السقاية. ذلك المكان المغري لتداول شائعات مغرضة والتقاط أخبار طازجة، الذي يعد مرتعا خصبا لجلسات الغيبة والنميمة و" قرقبة الناب" بين نسوة الحي المتهالك.