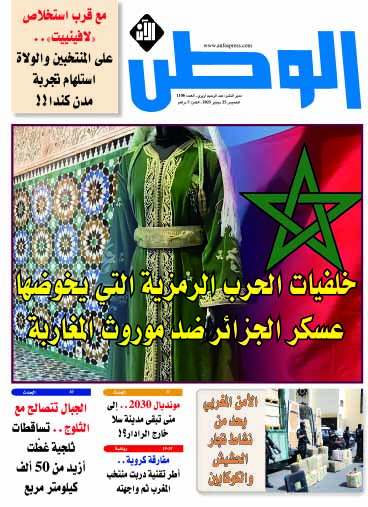بينما كانت الاقتصادات الغربية تتحدث عن نهاية عصر الصناعة وانتقالها إلى ما بعد الاقتصاد الإنتاجي، كانت الصين تبني بهدوء أعظم قوة تصنيعية في التاريخ المعاصر. لم يكن صعود بكين مجرد تطور طبيعي أو نتيجة لانفتاح السوق العالمي، بل كان ثمرة إستراتيجية عميقة ومدروسة جمعت بين الانفتاح الانتقائي، والتحكم الصارم، والاستفادة الذكية من تناقضات النظام الليبرالي العالمي.
منذ نهاية السبعينيات، أطلقت الصين مشروعها التنموي عبر تجربة المناطق الاقتصادية الخاصة، بدءاً بمنطقة شينزن، والتي تحولت من قرية صيد إلى واحدة من أكبر العواصم التكنولوجية في العالم. توسعت التجربة بسرعة ليصبح لدى الصين، بحلول العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، أكثر من 2,000 منطقة صناعية، منها 150 منطقة حرة أو خاصة معتمدة رسميًا، تغطي قطاعات متشعبة مثل التكنولوجيا، النسيج، الإلكترونيات، الطاقات المتجددة، والمعدات الطبية. هذه المناطق لم تكن فقط مراكز إنتاج، بل فضاءات استراتيجية صُمّمت لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال نظام ضريبي مخفف، امتيازات جمركية، وقوانين استثمار محفزة، مع غياب شبه تام للقيود النقابية أو الإجرائية.
العامل البشري كان في قلب هذه المعادلة. فبينما كانت تكاليف العمل في ألمانيا أو كندا أو الولايات المتحدة تصل إلى ما بين 3,500 و4,200 دولار شهريًا، كانت المصانع في الصين تدفع ما بين 200 و550 دولار للعامل في المتوسط، حسب القطاع والمقاطعة. هذا الفارق المهول جعل من غير الممكن لأي شركة غربية أن تتجاهل ميزة “صنع في الصين”، لا سيما مع وجود قدرة تنظيمية صينية هائلة تتيح تسريع عملية الإنتاج على مدار الساعة، بلا إضرابات أو قيود بيروقراطية.
العنصر الآخر في وصفة التفوق الصيني كان سعر الصرف. حافظت بكين، بصرامة، على بقاء اليوان في مستويات منخفضة ومتحكم فيها عبر نظام “سعر صرف مدار”، حيث تم تثبيت العملة عند 8.28 مقابل الدولار حتى 2005، قبل أن تبدأ في تحرير تدريجي مقيد. هذه السياسة جعلت السلع الصينية أرخص في الأسواق العالمية، وساهمت في تفاقم العجز التجاري للدول المستوردة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي بلغ عجزها مع الصين أكثر من 419 مليار دولار عام 2018 وحده، وهو رقم يعكس حجم الاختلال البنيوي الذي صنعته هذه المعادلة.
في حين فرض الاتحاد الأوروبي قوانين بيئية صارمة رفعت من تكاليف الإنتاج، وفرضت قيودًا مشددة على الصناعات الثقيلة، اختارت الصين تأجيل هذه المعايير، وسمحت بمستوى من التلوث البيئي بوصفه “تكلفة ضرورية للنمو”. وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، فإن الصين مسؤولة عن حوالي 30% من الانبعاثات العالمية، لكنها بالمقابل أصبحت المنتج الأول للفولاذ، الألمنيوم، والإسمنت، إضافة إلى كونها المصدّر الأكبر للمعدات الصناعية والإلكترونية. فبينما كان الغرب يربط التنمية بالاستدامة، كانت الصين تربطها بالتصنيع الشامل مهما كانت آثاره.
الخطأ الاستراتيجي للغرب كان اعتقاده أن الانتقال إلى اقتصاد المعرفة والخدمات سيعفيه من الحاجة إلى الصناعة. أكثر من 65,000 شركة غربية، بما فيها عمالقة مثل Apple، Nike، General Motors، Siemens، نقلت مصانعها أو أجزاء من سلاسل إنتاجها إلى الصين بين 2001 و2015. هذه الهجرة الإنتاجية لم تكن فقط انتقالًا في الجغرافيا، بل كانت تخليًا عن أدوات السيادة الاقتصادية لصالح خصمٍ جيو-استراتيجي يتبنى الرؤية الماركسية للدولة ويستخدم أدوات السوق بحرية محكومة.
لقد استغلت الصين نظام التجارة الحرة العالمي لصالحها، فجمعت بين الانفتاح المرحلي والانغلاق الانتقائي، بين الاستثمارات الأجنبية والتوطين التكنولوجي القسري، وبين الرأسمالية في الأسواق والتخطيط المركزي في القرار. واليوم، أصبحت الصين أول مصدر في العالم، بنحو 3.7 تريليون دولار من الصادرات في 2022، وتُعد المورد الأول لأكثر من 120 دولة، وتتحكم في أكثر من 60% من سلاسل التوريد العالمية في قطاعات التكنولوجيا، الأدوية، والطاقة.
لقد وقعت النخب الغربية في وهم أن “ما بعد الصناعة” هو التقدم. لكنها اكتشفت متأخرة أن امتلاك المعرفة لا يكفي إذا كنت لا تملك وسائل الإنتاج. جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية أظهرتا هشاشة الاعتماد على الصين. الدول الغربية التي اعتقدت أن بإمكانها أن تشتري كل شيء من الخارج وجدت نفسها عاجزة عن تأمين الكمامات والأدوية، ناهيك عن الشرائح الإلكترونية والتجهيزات الصناعية.
الصين لم تنتصر فقط في معركة الإنتاج. لقد أعدّت، على مدى عقود، بنية استراتيجية تجعل منها القوة الاقتصادية الأكثر قدرة على الاستمرار، والأكثر تأثيرًا على مستقبل النظام العالمي. هذا الانتصار لم يكن نتيجة تفوق تقني فحسب، بل نتيجة غفلة غربية استمرت طويلاً. وإذا لم تعد الاقتصادات الغربية إلى بناء صناعة وطنية محمية وذات سيادة، فإن القرن الحادي والعشرين سيكون قرناً صينيًا بلا منازع.