إحياءا للذكرى 11 لرحيل المفكر المغربي المرحوم محمد عابد الجابري أقدم موجزا للجزأ الأول من رباعيته " نقد العقل العربي" الموسم ب " تكوين العقل العربي" تحت عنوان :
* نقد العقل أساس النهضة *
يقول المؤلف: " يتناول هذا الكتاب موضوعا كان يجب أن ينطلق القول فيه منذ مائة سنة. إن نقد العقل جزء أساسي وأولي من كل مشروع النهضة. ولكن نهضتنا العربية الحديثة جرت فيها الأمور على غير هذا المجرى، ولعل ذلك أهم عوامل تعثرها المستمر إلى الآن. وهل يمكن بناء نهضة بعقل غير ناهض، عقل لم يقم بمراجعة شاملة لآلياته ومفاهيمه وتصوراته ورؤاه؟".
ولمعالجة هذا الإشكال ضمن الكتاب قسمين : هما، العقل العربي.. بأي معنى؟، وتكوين العقل العربي، المعرفي والأيديولوجي في التقافة العربية، وفصلاهما في إثنى عشر (12) فصلا، تحدث فيها عن العقل والثقافة، والزمن الثقافي العربي ومشكلة التقدم، وعصر التدوين كإطار مرجعي للفكر العربي، الأعرابي صانع "العالم" العربي، والتشريع للمشرع: تقنين الرأي والتشريع للماضي، والقياس على مثال سابق، بعدها تحدث عن "المعقول" البياني واللامعقول "العقلي"، ثم العقل المستقل في كل من الموروث القديم، وفي الثقافة العربية الإسلامية، بعدها عرج على تنصيب العقل في الإسلام، وخصص الفصلين الأخيرين لكل من أزمة الأسس.. وتأسيس الأزمة، مع بداية جديدة.. ولكن ! ، خاتما مؤلفه بموضوع العلم والسياسة في الثقافة العربية.
بعد هذه التوطئة، سؤوجز ماقاله جوابا على سؤاله أعلاه، بالقول، فقد انطلق الجابري في تكوين العقل العربي من تحديد انطلاقة مشروعه من قضية أساسية، هي أن الثقافة العربية قد ظلت، وإلى اليوم، ذات زمن ثقافي واحد يشمل ما بعد عصر التدوين وما قبله. حيث يقول:(هذا بالنسبة للتاريخ الثقاقي، أما التاريخ السياسي فإن التصنيف المشار إليه لا يعكس فعلا" لحظات" تاريخية إلا إذا نظرنا إلى الأمور من زاوية ما كان يتمتع به الخليفة العباسي من سلطة.. أما إذا نظرنا إلى الخلافة العباسية كدولة، أي كمؤسسة تمارس السلطة على المجتمع باسم "الدين" و"التاريخ" ،أي تحت غطاء أيديولوجي معين، وتعمل على الحفاظ على كيانها وسلطتها، واقفة بعنف، أو على الأقل صامدة، أمام كل مطالب أو ثائر أو معارض، فإننا سنجد "العصور" المشار إليها عبارة عن "زمن سياسي وأيديولوحي" واحد). معتبرا هذه المقولة "جديدة" تنضاف لمجموعة المفاهيم الإجرائية التي وظفها في دراسته، حيث ستمكنه من اكتساب رؤية أوضح لما سيعرض له في الزمن الثقافي العربي الواحد المتموج، لأنها ساعدته على السيطرة على الظاهرتين، المتناقضتين اللغتين تحكمان التاريخ الثقافي العربي، ظاهرة تداخل العصور الثقافية في الفكر العربي، وظاهرة انفصال بين الزمان والمكان والتاريخ الثقافي العربي، والسيطرة على هذه الظاهرة معناها تجنب السقوط في التعددية التي تطبع التاريخ الثقافي العربي الراهن.
يعتبر الجابري:( أن الدولة العباسية ككل قد عاشت زمنا سياسيا إيديولوجية واحدا بسبب أن "الآخر" الذي كانت تتحدد بالعلاقة معه تحركاته السياسية قد بقي هو هو "لا متغيرا"، خلال جميع التحولات التي عرفتها، وأن هذا الآخر هو الشيعة الباطنية...فلقد قامت في الغرب الإسلامي،.. دولة مستقلة.. دولة الأدارسة، التي كانت أول دولة انشقت عن الخلافة العباسية.. - كما- فر إلى الأندلس بعد سقوط الدولة الأموية... عبد الرحمن الداخل فأسس هناك الدولة الأموية).
إذن أصبح، (المغرب والأندلس "زمن سياسي" آخر مستقل عن الزمن السياسي العباسي في المشرق..)، وهكذا أصبح للدولتين الجديدتين في الغرب الإسلامي زمنهما السياسي زمنا واحدا مستقلا عن الزمن السياسي العباسي والزمن السياسي الفاطمي.
ويعتبر أن الموضوع الذي تعامل معه العقل البياني العربي وما يزال، هو النصوص، والتعامل معها غير التعامل مع الطبيعة وظواهرها. حيث يقول:(ذلك لأنه إذا كان العقل البشري يجد، كما قلنا، في مجال الطبيعة من إمكانيات التقدم واطراد ما لا حد له، وبالتالي ما يسمح له بخلق أزمنة ثقافية جديدة كلما استطاع أن "يقطع" مع مفاهيم وأجهزته النظرية السابقة). بناء عليه يرى أن ما يمكن استخراجه واستنباطنه من قواعد تحكم النص اللغوي أو من تشريعات تستقى من نفس النص الديني محدودا تماما، وبالتالي فلابد أن يأتي يوم يستنفد فيه البحث كل إمكانية للتقدم ولا يعود ثمة من إمكانية للعمل سوى المراجعة وإعادة التنظيم. وهذا ما حصل بالفعل في مجال العلوم العربية الإسلامية التي انتهى كل شيء فيها في مرحلة تأسيس، أي مرحلة عصر التدوين التي كانت في نفس الوقت مرحلة إنتاج ومراجعة وتبويب وتنظيم.
تعليقا على هذا يضيف الجالري"أكيد أنه كانت هناك بعض التفريعات التي لم تكن تخلو من إبداع. وأكيد كذلك أن الاهتمام قد انتقل بعد أن استفدت إمكانيات الموضوع (=النصوص) إلى النظر في <<طرق النظر>>(=المناهج) و<<آداب>> المناظرة والجدل.. الخ. ولكن ذلك كان يتم داخل دائرة انغلقت إلى الأبد،.. فصار الزمن فيها زمنا مكرورا معادا.. زمنا ميتا، أو هو بالحي_الميت أشبه. لكنه يخلص إلى القول بأنه"لم يكن ولا من طبيعة علوم <<البيان>> أن تضمن للفكر العربي وبالتالي للثقافة العربية كلها، اطراد التقدم. أما علوم <<العرفان>> فهي <<العقل المستقيل>> ذاته. وسيكون من التناقض أن نبحث فيها عن مدى ما كان يمكن أن توفره من أسباب التقدم أو اطراد النهضة.
خلص الجابري إلى أن علوم <<العرفان>> بمنهجها وغاياتها، من أجل الآخرة وليس من أجل الدنيا. أما ما ارتبط بها من <<علوم سرية>> دنيوية كالكيمياء والتنجيم.. فلقد كانت تصدر عن نظرة سحرية للعالم.. وبالتالي فهي لم تكن علوما.. وهل يمكن إنجاز نهضة بالسحر؟
ويختم تصنيفه للنظم المعرفية بعلوم <<البرهان>> وهي المقصودة بالذات من السؤال، أين كان يقع <<العلم العربي>> من حركة الثقافة العربية... ولكن لما كانت علوم <<البيان>> هي التي احتلت أوسع رقعة في الثقافة العربية.. فلقد كان لابد من من مناقشة إمكانياتها بالنسبة المسألة التي تهمنا هنا يقصد التعريف بعلوم البرهان مضيفا كما كان لابد من كلمة حول إمكانيات علوم <<العرفان>> حتى يتأتى له حسب رأيه مناقشة إمكانيات علوم <<البرهان>> وهو على بينة من أمره.
اعتبر الجابري أنه في التجربة الثقافية العربية يجب أن نضع السياسة مكان العلم في التجربتين اليونانية و الأوروبية الحديثة، وعبارة أخرى إن الدور الذي قام به العلم عند اليونان وفي أوروبا الحديثة في مساءلة الفكر الفلسفي(والديني) ومخاصمته وفك بناءاته وإعادة تركيبها.. الخ قد قامت به السياسة في الثقافة العربية الإسلامية.
معتبرا أن أي تحليل للفكر العربي الإسلامي، سواء كان من منظور بنيوي أو من منظور تاريخاني، سيظل ناقصا وستكون نتائجه مضللة إذا لم يأخذ في حسابه دور السياسة في توجيه هذا الفكر وتحديد مساره ومنعرجاته. مؤكدا في هذا الإطار، العلاقة بين الفكر والسياسة في <<دولة الإسلام >> لم تكن تتحدد بسياسة الحاضر وحده، كما كان الشأن في المجتمعات المعاصرة، بل كانت تتحدد أيضا بسياسة الماضي. ذلك لأن سياسة <<الحاضر>>، سواء بالنسبة للدولة أو المعارضة، كانت استمرار لسياسة <<الماضي>>.
كانت المواقف السياسية ، يبحث لها، كما يقول الجابري، عن سند من الدين، مما أسس ل<<علم الكلام>> وبذلك كان في حقيقته التاريخية ممارسة لسياسة في الدين وليس مجرد كلام في العقيدة. وهو ما قامت به المعارضة، وحتى الدولة بعدها، حيث تم توظيف الموروث القديم في الممارسة السياسية في الدين، واتسعت إلى ممارستها في الفلسفة. أما ممارسة العلم فظل على الهامش، وخارج مسرح الحركة في الثقافة العربية، ولم يغدي العقل العربي ولم يجدد قوالبه، فظل الزمن الثقافي العربي هو هو من عصر التدوين إلى زمن ابن خلدون، بعدها تخشبت موجاته، وحتى <<النهضة>> العربية الحديثة التي لم تتحقق بعد.
وبناء عليه، يتساءل الجابري، قائلا، لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ إلا أنه يعتبره تساؤلا ناقصا، إذا لم يطرح على الصعيد الإيبيستيمولوجي، ما لم يتجه مباشرة إلى العقل العربي، معتبرا أن <<المسلمين>> إنما بدأوا يتأخرون حينما بدأ العقل العربي يقدم استقالته، ملتمسين شرعية دينية لذلك، على عكس الأوروبين الذين تقدموا عندما استيقض العقل وأصبح يسائل نفسه، وبذلك كانت الرأسمالية بنت العقلانية الأوروبية.
مضيفا، إن هذه الاستقالة مرتبطة بالموروث القديم السابق للإسلام، وبعضها يعود للموروث الإسلامي الخالص. ذلك أن العرب ورثوا مركبا جيولوجيا من الآراء و المعتقدات والفلسفات تعتليها، كما يقول الجابري، قشرة سميكة من منتجات <<العقل المستقيل>> الهرمسي، فكان دورهم تجاوز هذه القشرة إلى <<معادن>> العلم والعقل، إلى العقلانية.
من هنا يعتبر أن أزمة <<الإمامة والسياسة>> كانت أزمة بنيوية مزمنة، ذات جدور ثقافية واجتماعية وإثنية، غذت ولعصور طويلة الصراع الإيديولوجي، مما أفرز تناقضا بين المضمون الإيديولوجي والإيبيستيمولوجي، بين المعارضة الشيعية والخلاف السنية.
لتوضيح التناقض الإديولوحي والإيبيستيمولوجي بين المعارضة، ودولة الخلافة، يقول الجابري: (بينما استطاعت المعارضة الشيعية أن تستقطب، على مدى التاريخ العربي الإسلامي، الفئات الاجتماعية المضطهدة.. وتبني قضيتها السياسية الاجتماعية مما أكسبها مظهرا تقدميا ثوريا.). حيث عملت على توظيف منتجات <<العقل المستقيل>> كأساس ابيستيمولوجي لايديولوجيتها، واستقت منه فلسفتها الدينية والسياسية، فظلت تعاني من التناقض بين الثورة واللاعقلانية. بينما يرى الجابري أن الدولة السنية تبنت موقفا معاكسا، إذ كانت محافظة اجتماعيا<<ثورية>> (=عقلانية) في معظم الحالات على المستوى الأيدي لوجي.
وإبان الحروب الصليبية انتهى التناقض بينهما، وتراجع الطابع الثوري التقديمي للمعارضة، واستفحال الطابع العقلاني الأساس المعرفي في إيديولوجيتها الدينية، في نفس الوقت تراجع الطابع العقلاني لايديولوجيا الدولة، واستفحال الطابع المحافظ لأهدافها الاجتماعية.
ويخلص إلى القول:(النتيجة: تعميم الرؤية اللاعقلانية على الصعيد المعرفي والايديولوجي وتكريس الأوضاع المتخلفة.. وبذلك تحقق الانسجام والتكامل بين الأساس ابيستيمولوجي والمضمون الإديولوحي لأول مرة...في عصر <<الانحطاط>>).
هذا عن <<أسباب تخلف المسلمين>>، أما تقدم أوروبا، فهذه الأخيرة اعتمدت نوعين من الموروث القديم، اليوناني المسيحي، والعربي الفلسفي والعلمي. حيث ساعد ذلك الدولة على الفصل بين الدين والسياسة، واتخاد الدولة الحياد من الفكر الكنسي، فأصبح الصراع ضد الكنيسة وليس الدولة، ولم يكن صراعا من أجل الإمامة والسياسة بل من أجل الحقيقة الدينية و الكونية، بينما الموروث العربي الذي أسست عليه أوروبا نهضتها فيتجلى في الفلسفة الرشدية، حيث انتصر العقل واستقل العلم، إلى جانب تأثير الأعمال العلمية لكل من بن الهيثم والبطروجي.
صفوة القول، يرى الجابري أنه انتهى في كتابه "تكوين العقل العربي" داخل الثقافة العربية إلى التمييز بين ثلاث نظم معرفة البياني والعرفاني والبرهاني، ممهدا لخطوة ثانية، تتمثل في تحليل هذه النظم وفحص آلياتها ومفاهيمها ورؤاها، وعلاقة بعضها ببعض، مما يشكل في نظره البنية الداخلية للعقل العربي، الذي سيخصص له الجزء الثاني من رباعيته "نقد العقل العربي"، وهو ما عزمنا إيجازها فيما سيأتي من أيام، إذا كتب الله لنا في العمر بقية.
إنجاز/ نورالدين السعيدي حيون

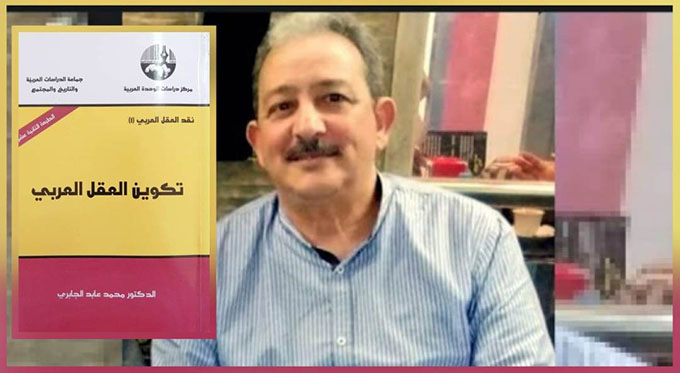 نورالدين السعيدي حيون
نورالدين السعيدي حيون 
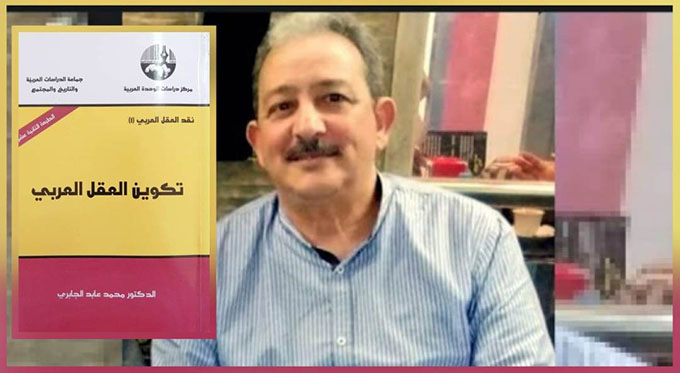 نورالدين السعيدي حيون
نورالدين السعيدي حيون