
عثمان بن شقرون: في ذكرى رحيله لماذا يتحول محمد شكري إلى "حطب للكتابة"؟
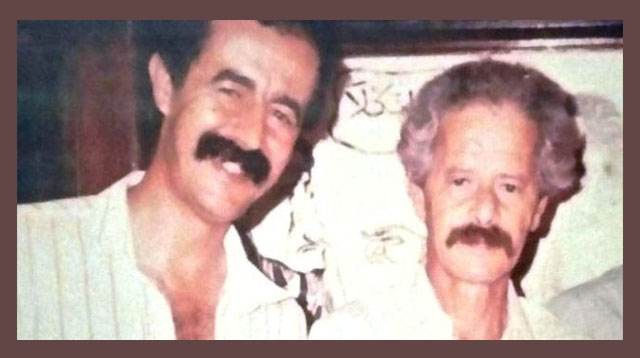 الكاتب المغربي الراحل محمد شكري (يمينا)
الكاتب المغربي الراحل محمد شكري (يمينا) 
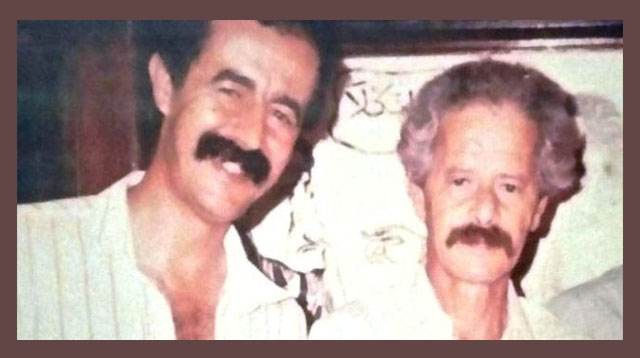 الكاتب المغربي الراحل محمد شكري (يمينا)
الكاتب المغربي الراحل محمد شكري (يمينا) لماذا يتحول محمد شكري إلى "حطب للكتابة"؟
تُظهر التجربة النقدية المحيطة بالكاتب المغربي الراحل محمد شكري، خلال العقود الأخيرة، مسارًا لافتًا يتحول فيه الكاتب من ذات إبداعية متمرّدة على النسيج الثقافي إلى موضوع جاهز يُستدعى كلما احتاج الخطاب الأدبي إلى شرعية سريعة أو إلى إعادة إنتاج أسطورة الهامش. لقد تحولت سيرة شكري –الطفولة القاسية، الأمية المتأخرة، اللغة المباشرة– إلى ما يشبه "عملة رمزية" في معنى بيير بورديو، والتي تُعرّف بأنها أي شكل من أشكال الرأسمال الاجتماعي أو الثقافي (مثل الشهرة أو السمعة) يتم الاعتراف به كقيمة شرعية داخل حقل محدد. وفي هذا السياق، تُصبح السيرة الذاتية لشكري هي الرصيد الرمزي الذي يستثمره الآخرون. لا تُستعاد بوصفها معطيات تتطلب قراءة، بل بوصفها علامة تداولية تضمن لصاحب الخطاب مكانة داخل المجال الثقافي.
هذا التحول يفرغ تجربة شكري من حدّتها ويُعيد إنتاجها كقالب مكتفٍ بذاته، ويجعل الهامش الذي كان يزعزع البنية الثقافية يتحول إلى جزء من آلية الاستهلاك الرمزي. هكذا تظهر الكتابة عن شكري اليوم باعتبارها ممارسة تُحيّد راديكاليته بدل أن تُفككها، وتعيد إنتاج سيرته كما لو كانت مادة صالحة للاستعمال اللغوي الفوري، جاهزة للضم في أي نص يحتاج إلى طابع التمرّد دون دفع ثمن القراءة المعرفية.
أزمة الإنشائية والقراءة المريحة
يكشف هذا المسار عن أزمة إنشائية أعمق في النقد العربي المعاصر، إذ تُستعاد عناصر السيرة دون مساءلة لغتها أو طرائق تمثلها أو بنيتها السردية. إن ما ينتجه الخطاب السائد ليس قراءة، بل تمجيدًا مموّهًا يتخفى وراء انطباعات عامة عن "الصدق" و"الجرأة" و"الشجاعة"، وهي قيم باتت بديهية في الحديث عن شكري، لكنها فقدت كل قوة تفسيرية.
من هنا تبدو الكثير من المقاربات أقرب إلى ما يسميه رولان بارت "القراءة المريحة": وهي قراءة تسعى إلى تثبيت المعنى وإراحة القارئ عبر تأكيد التوقعات والبديهيات السائدة عن النص (الأسطورة)، بدلاً من الدخول في التفكيك المربك لتعقيداته اللغوية والبنيوية. قراءة تستعيض عن النص بأسطورته، وعن التفكيك بإعادة إنتاج ما هو مستقر ومتوقع. وفي هذا الإطار لا يُطرح أي سؤال يتعلق ببنية الجملة عند محمد شكري، أو بالحدّ الذي يفصل التوثيق عن التمثيل، أو بعلاقة الجسد باللغة.
ولو تجاوزنا سحر الحكاية قليلاً، لوجدنا أن قوة شكري لا تكمن في "ما حدث له"، بل في "كيف كتبه". إن جملة شكري جملة "تشريحية" بامتياز؛ فهي تقتصد في النعت لصالح الفعل، وتتجنب المجازات الشعرية لصالح التسمية المباشرة للأشياء. إنه لا يصف القاع لكي يستدر عطف القارئ (وهو ما تفعله الواقعية الساذجة)، بل ينقل "فيزيولوجيا" الألم والجوع واللذة ببرودة لغوية جارحة. هذه المفارقة بين "حرارة الموضوع" و"برودة اللغة" هي ما يصنع أدبيته، وهي المنطقة التي يغفلها النقد "الكرنفالي" الذي يحتفي بالكاتب ويقتل الكِتابة.
هذه الأسئلة وغيرها كان ينبغي أن تشكل عصب المقاربة النقدية، خاصة إذا استحضرنا ما يقترحه موريس بلانشو من كون الكتابة منطقة تماس بين الحياة ولغتها، وهو مفهوم يؤكد أن العمل الأدبي ليس مجرد انعكاس لحياة سابقة، بل هو لحظة خلقية تُصاغ فيها الحياة وتُعاد تعريفها عبر فعل اللغة ذاته، مما يجعل النص كياناً مستقلاً يتطلب قراءة جمالية لا قراءة وثائقية. إن إقصاء هذه الأسئلة يؤدي إلى نتيجة خطيرة: تغييب النص الحقيقي لصالح صورته، وتحييد المساءلة الجمالية لصالح الصياغة الإنشائية، بحيث يصبح الكاتب موضوعًا لا نصًا، وإرثه مناسبة لاستعراض الكاتب الناقد لا لتطوير أدوات النقد.
تجاوز الإنشائية إلى المعرفة
هذا الوضع لا يؤثر فقط على قراءة شكري، بل يمتد إلى الحقل الأدبي برمته، إذ يتحول اسم الرجل إلى احتكار رمزي يحجب أصواتًا جديدة، ويبتلع إمكانات المقاربات المغايرة التي كان ينبغي أن تكمل أسئلته بدل أن تتغذى على أسطورته. إن استعادة شكري ضرورة، لكنها لا تتمّ عبر إعادة إنتاج سيرته، بل عبر مساءلة مشروعه بوصفه حدثًا كتابيًا، لا بوصفه مادة سردية جاهزة. والعودة الجادة إليه تقتضي وضع نصوصه – وليس حياته فقط– داخل شبكة الأشكال السردية الحديثة، وربط تجربته بسياقات عالمية قاربت الجسد واللغة والهامش بطرائق مركبة، مثل جان جينيه (Jean Genet) ولويس فرديناند سيلين (Louis-Ferdinand Céline) وهنري ميلر (Henry Miller).
وهذا الربط لا يجب أن يكون استعراضياً، بل لتوضيح كيف يلتقي شكري مع "جينيه" في تحويل القبح والشرط الإنساني الوضيع إلى جماليات متعالية، وكيف يتقاطع مع "سيلين" في تحطيم الجملة الأدبية المهذبة لصالح إيقاع الكلام المنفعل، وكيف يتماهى مع "ميلر" في جعل الجسد بؤرةً للرؤية لا مجرد موضوع للوصف.
فضلًا عن إعادة فتح نصوصه الأقل قراءة، تلك التي تتجاوز تأثير "الخبز الحافي" وحده. إن إعادة الاعتبار لشكري لا تحتاج إلى إحياء أسطورته، بل إلى تفكيكها، وإلى قراءة تمنح نصه مكانته في تاريخ الكتابة العربية، باعتباره تجربة تتطلب أدوات معرفية صلبة، لا خطابًا يعيد إنتاج ما صار بدهيًا. في هذا الأفق فحسب يمكن للنقد أن يتجاوز الإنشائية إلى بناء معرفة جديدة بتجربة استثنائية كُتب لها أن تكون عميقة، لا لأنها صادمة، بل لأنها أعادت تعريف ما يمكن أن تكونه الكتابة ذاتها.
حينها فقط، يتوقف محمد شكري عن كونه "حطباً" يحترق لتدفئة نصوص الآخرين، ويتحول إلى شجرة حية في غابة السرد العربي، شجرةٌ تحتاج أن نراها كما هي، لا كما نريدها أن تكون.