
عبد السلام بنعبد العالي: جيل "زد"
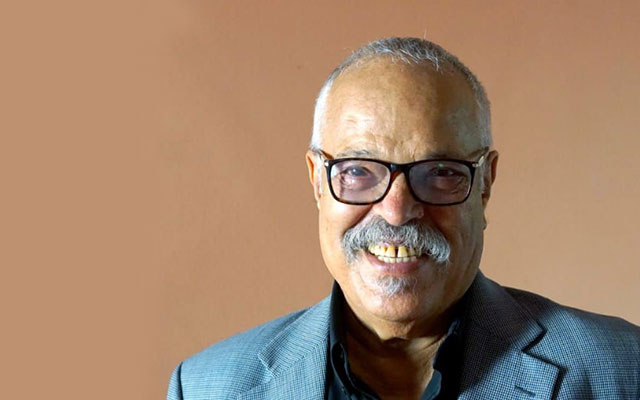 عبد السلام بنعبد العالي
عبد السلام بنعبد العالي 
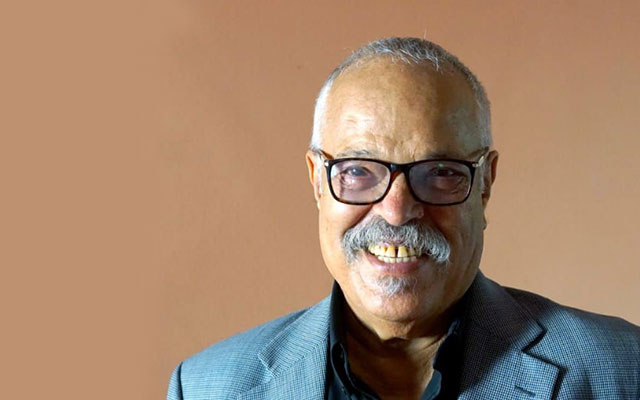 عبد السلام بنعبد العالي
عبد السلام بنعبد العالي بعد الحرب العالمية الثانية، أطلق على مواليد سنوات 1946–1964 في أميركا وكندا، اسم "جيل الطفرة السكانية" (Baby Boomers)، لما تميزت به الفترة من كثرة المواليد. بعد هؤلاء جاء مواليد السنوات 1965–1980 الذين أطلق عليهم جيل "إكس". تسمية "إكس" ظهرت في كتاب الصحافي البريطاني روبرت كابا سنة 1964 بعنوان "Generation X"، دلالة على أن هذا الجيل جيل غامض الملامح، "مجهول" الطباع، علما بأن المجهول الواحد في المعادلات الرياضية يرمز إليه بهذا الرمز.
حين كبر أبناء "جيل إكس" صاروا يسمون "جيل واي"، وفيما بعد، أطلق عليهم الكاتبان الأميركيان ويليام شتراوس ونيل هاو في كتابهما "جيل الألفية الصاعدة" (Millennials Rising) لأنهم بلغوا سن الرشد عند بداية الألفية الجديدة 2000.
بعد حرف (Y)، أصبح طبيعيا في الإعلام والشركات أن يطلق على المواليد الجدد حرف "زد" آخر حروف الأبجدية اللاتينية، فسمي الجيل اللاحق بـ"جيل زد". بدأ ظهور مصطلح "جيل زد" في الصحافة الأميركية حوالي 1994–1997، ثم رسخته دراسات سوسيولوجية وتسويقية في أواخر التسعينات وبداية الألفية.
كثرت تأويلات اختيار هذا الحرف بعينه، منهم من رده إلى الحرف الإغريقي "تزيتا" الذي يرمز إلى الحياة، ومنهم من جعله إحياء للدلالات السياسية التي ضمنها كوستا غافراس فيلمه "زد"، بل هناك حتى من ذهب إلى ربطه بمجموعة الأعداد النسبية، إلا أن الغالب أنه جاء فقط تسلسلا لحرفي الجيلين السابقين "X" و"Y" في الأبجدية اللاتينية.
صار البعض يتكلم اليوم عن "حركة زد". لا ينبغي أن ننسى أن ما يجمع هؤلاء هو أعمارهم، فالجيل ملتقى أعمار، وليس أيديولوجيا تعتنق، أو حزبا سياسيا يضم موالين. صحيح أن الجيل قد "يتحرك" اجتماعيا، لكن، ليس بوصفه "حركة اجتماعية" لها مرجعياتها الفكرية ودوافعها السياسية، وإنما بوصفه جيلا عاش الظروف نفسها، وربما عانى المعاناة ذاتها. إنه جيل يحمل المشاعر نفسها، لا الشعارات عينها.
ما يثير الانتباه في تمييز هذه الأجيال هو قصر المدة التي عمرتها. تعودنا في ثقافاتنا التقليدية أن يعمر الجيل أكثر من ثلاثة عقود، وها نحن نلاحظ أن جيل "X" وجيل "Y" لم يعمرا إلا عقدا ونصف العقد. ولعل "التسارع التاريخي" جعل الأجيال تتمايز عن بعضها جوهريا بعد مدة تزداد قصرا. كتبت إحدى الباحثات في هذا المجال: "اليوم، في العائلة الواحدة، لم يعد الطالب البالغ من العمر 22 عاما، والتلميذ البالغ من العمر 16 عاما، والتلميذ الذي سنه 8 أعوام، ينتمون إلى الجيل نفسه! وأولياء أمورهم يشهدون على ذلك: ففي غضون عشر سنوات، يلاحظون التطور المذهل في سلوكيات أطفالهم، وحتى في اختلاف طريقة تفكيرهم، وأسلوب عيشهم وتصورهم للمستقبل، وتمثلاتهم للحياة ذاتها، والأهم من ذلك، التغير في التفاعلات بينهم، إلى درجة الحديث عن هوة بين الأجيال".
عندما كنا نصنف أفراد المجتمع طبقات ونجزم أن لكل طبقة خصائصها، كنا نعتمد ملكية وسائل الإنتاج معيارا لذلك التصنيف. الظاهر أن التصنيف إلى أجيال لا يقتصر فحسب على الأعمار، فوراء اعتماد الأعمار نتبين العلاقة بالتقنية كمحدد أساسي. فكأن الجيل بهذا المعنى لا يتحدد بأعماره فحسب، وإنما بدرجة تطور الوسائط الإعلامية التي عايشها. لذا، فالأجيال أيضا أجيال لتكنولوجيا الإعلام: المذياع "جيل الطفرة السكانية"، التلفزيون "جيل إكس"، والإنترنت "جيل الألفية"، أما الهواتف الذكية فهي "جيل زد".
واكب جيل "الطفرة السكانية الكبرى" نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم الحرب الباردة، فصعود الاقتصاد الصناعي الغربي، وبروز حركات الحقوق المدنية في الستينات. أما "جيل إكس" فواكب أزمة النفط 1973، وحرب فيتنام وما بعدها، وانتشار الطلاق، وظهور الأسر الأحادية، كما واكب بدايات ثورة المعلومات (الكمبيوتر الشخصي). "جيل الألفية" عاش سقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة، وظهور العولمة، وانتشار الإنترنت منتصف التسعينات، وهجمات 11 سبتمبر/أيلول، وتوسع التعليم العالي. أما "جيل زد" فعرف الطفرة التكنولوجية (الهواتف الذكية، وسائل التواصل الاجتماعي)، والأزمة المالية في 2008 وما خلفته من آثار، وتحول مسألة تغير المناخ إلى انشغال يومي، وصعود ثقافة الهوية.
إذا كان ما طبع "جيل الطفرة السكانية" كثرة التوالد، والولاء للعمل، والإيمان بالمؤسسات، والميل نحو الاستهلاك، فإن ما طبع "جيل إكس" هو نوع من الاستقلالية، وعدم الثقة في السلطات، وبداية التأقلم مع التطورات التكنولوجية. أما "جيل الألفية" فهو جيل مواكب للتكنولوجيا الجديدة، ميال إلى العمل الجماعي. أما المنتسبون إلى "جيل زد" فهم، كما قيل، "رقميون بالفطرة" (Digital Natives)، مما جعلهم منفتحين على الثقافات جميعها.
تمثل فرادة "جيل زد" في كون أفراده يتشاركون ثقافة رقمية مشتركة تدفعهم إلى تبني سلوكيات استهلاكية جديدة. فهم أول جيل ولد في العالم الرقمي بالكامل، وكما قيل، هم "رقميون بالفطرة"، ولدوا منفتحين على العالم. لا ينبغي أن نفهم من هذا "الانفتاح" متابعة فعلية لما يجري في العالم، ولا بالأحرى وقوفا عند أصوله وتطوراته، وفهما عميقا لتحولاته، وإنما هي مجرد مسايرة لموضاته، والتقاط لصوره. مع ما تخلفه الصور من انبهار بما أصبح يروج في العالم، وبالتالي، من ميل إلى المقارنات. لذلك، فربما أمكننا أن نتحدث، في الوقت ذاته، عن "انفتاح" هذا الجيل وانفصاله عن الواقع الفعلي، ما دام يقضي في الشبكة من الوقت أكثر مما يقضيه واقعا. فهو خارج التغطية وتحتها في الوقت ذاته. وهو موصول دائما بأكثر من جهة، إنه جيل حائر مشتت الانتباه بين وجهات متعددة، لا يسمح لمعلومة من المعلومات، أو صورة من الصور، أن تفلت من إدراكه، لذا فهو "يتابع" مواضيع كثيرة، وينفتح على أكثر من مخاطب، وغالبا ما تجده يحمل أكثر من جهاز إلكتروني، فهو مفرط التواصل، مشبع بالمعلومات والصور، من غير أن يعني ذلك بالضرورة أنه غزير المعرفة، أو واسع الاطلاع.
يقال عن هذا الجيل إنه يتمتع بحس نقدي مفرط. إذا سلمنا بأن النقد موازنة متروية بين إمكان ونفيه، فإننا لا نستطيع أن نتكلم في هذا الصدد عن "الحس النقدي"، ربما كان لفظ "الرفض" أكثر ملاءمة، وهو رفض غالبا ما يكون متولدا عن حالة غضب، أكثر مما يترتب عن تحليل نقدي. وبالفعل فإن الاستجابات التلقائية المتسرعة لهذا الجيل تسمح لنا بأن ننعته بالجيل الرافض الذي لا يرضيه العالم بتفاوتاته وتناقضاته وإقصاءاته. لا أقول "فروقه الطبقية"، وإنما توزيعه غير المتكافئ للفرص. ربما لا يصح هنا أن نتكلم عن إعلاء لقيمة العدالة أمام الظلم، إذ إن هذين المفهومين يقتضيان أن يدخلا ضمن تحليل أيديولوجي يستند إلى دوغما وعقيدة، والحال أننا، مع هذا الجيل، أمام مشاعر لحظية لا تسمح لنا بأن نقول إن الرفض يستند إلى دوغما وينطلق من رؤية، أو يعتمد نظرية، ويعمل وفق برنامج، ويعبر عن نفسه في بيانات، وإنما هي ردود فعل متسرعة، وموجات غضب واحتجاج ترفض رفضا باتا أن تقاد وتملى عليها الأوامر، وتنم عن رغبة مستعجلة في التغيير، وتفضل في الغالب أن تعبر عن نفسها في "الهاشتاغات" وأغاني "الراب"، وتتخذ الصورة مطية، فتجعل الوسيط خالقا للحدث وليس مجرد ناقل له.
لا يعني ذلك بطبيعة الحال أن كل ذلك لا يلقى آذانا مصغية، وأنه ليس له مفعول. فمن يدري، لعله اليوم هو الأنسب للفعل في الواقع الجديد، وربما للمساهمة في تغييره.
عن مجلة " المجلة "