تفاعلاً مع ما تشهده الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة، ومع الحراك الذي ارتبط بما يُعرف بجيل "زيد 212"، أود التأكيد منذ البداية أن الغرض من هذا المقال ليس إعادة سرد الأحداث، فقد تناولتها القنوات الإعلامية بتفصيل مشكور، وإنما الغاية الوقوف عند بعض مظاهر الانفلات والعنف التي صدرت عن فئة من القاصرين والمراهقين، لا تمت في حقيقتها إلى جيل "زيد" الواعي بصلة، ذلك الجيل الذي قدّم نموذجاً راقياً في التعبير السلمي والمسؤول عن آرائه ومطالبه.
إن الوقوف عند هذه الظاهرة ضرورة ملحّة من أجل الفهم والتحليل، بغية تحويل ما جرى إلى فرصة لإعادة البناء والتوازن بين الحرية الفردية والنظام العام.
- أولاً: العنف بوصفه ظاهرة اجتماعية ونفسية
العنف ليس مجرد أحداث متفرقة أو تجاوزات أمنية ظرفية، بل هو في جوهره تعبير عن اختلال عميق في البنية النفسية والاجتماعية.
إنه انعكاس لجراح داخلية وتصدعات في العلاقة بين الفرد وذاته، وبين المواطن ومؤسسات وطنه، بل حتى في تصوره للمستقبل الذي يبدو له غامضاً ومفتقداً للمعنى واليقين. فالشعوب في طبيعتها تنشد الأمن والاستقرار، لأن الطمأنينة تمثل الأساس الذي تُبنى عليه القوة المجتمعية والتنمية المستدامة. ومتى غابت الطمأنينة، اختلّ التوازن النفسي والاجتماعي وفقد المجتمع قدرته على التماسك والإبداع.
يرى علماء النفس الاجتماعي أن العنف لا يظهر من فراغ، بل هو نتيجة تراكمات عميقة وأسباب موضوعية. إنه، في جوهره، صرخة مكبوتة وتنفيس عن وجع داخلي، وصيغة تعبير بديلة حين تُغلق أمام الإنسان سبل الحوار ويُحرم من حقه في الإصغاء.
وعندما يفقد الإنسان الإحساس بالانتماء أو المعنى، تصبح حياته خواءً، فيعوض ذلك الفراغ بالعدوانية والإيذاء، وكأنما العنف يصبح وسيلة بديلة للتعبير عن الذات المقهورة. بهذا المعنى، يمكن اعتبار العنف رسالة صامتة تكشف عجز المجتمع عن توفير فضاءات وآليات سلمية للتعبير والمشاركة. وحين تُغلق قنوات التواصل وتغيب المشاركة الفعلية، يتحول الجسد ذاته إلى أداة احتجاج، غير أن هذا الاحتجاج – عندما يتجاوز حدوده – يفقد معناه ويتحول إلى تخريب وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة، أي من الاحتجاج إلى الانفلات.
ثانياً: تعدد أسباب العنف
تتعدد أسباب العنف وتتشابك، إذ لا يمكن إرجاعها إلى عامل واحد. فهي نتاج تفاعل اجتماعي ونفسي واقتصادي وسياسي معقد. ومن بين أبرز الأسباب:
1. السبب الاجتماعي:
يتمثل في هشاشة الوضع الاقتصادي، وانتشار البطالة والفقر، وغياب الفرص المتكافئة. هذه العوامل تؤدي إلى الإحباط وتآكل الأمل، خاصة لدى الشباب الذين يشعرون بالعجز عن تحقيق ذواتهم داخل وطنهم.
2. السبب النفسي:
يرتبط بمرحلة المراهقة وضغوطها، والحاجة الملحّة إلى الاعتراف والانتماء، وهي حاجات أساسية في البناء النفسي للفرد.
حين يُحرم الشباب من هذا الاعتراف، أو يشعرون بأن لا مكان لهم داخل المجتمع، يتولد لديهم شعور بالدونية والرفض، خصوصاً أمام مستقبل غامض ومسدود الآفاق.
3. السبب السياسي:
يتمثل في ضعف قنوات المشاركة في اتخاذ القرار، وغياب آليات حقيقية للتعبير السلمي عن الرأي. فالشباب اليوم لم يعودوا يقبلون الخطاب الجاهز أو الوعود المكررة، بل يطالبون بخطاب صادق وواضح، يتسم بالشفافية والواقعية، ويترجم القول إلى فعل، والإرادة إلى سياسة عامة ملموسة. إنهم يطالبون بالمصارحة لا بالمجاملة، وبالإنجاز لا بالشعارات، في إطار مقاربة تشاركية تتيح لهم الإحساس بالمسؤولية والانتماء. وباختصار، فإن العنف هو نتيجة طبيعية لتراكم الإحباطات النفسية والاجتماعية، وتفاعل عوامل الفقر والبطالة وانسداد الأفق، وأحياناً كردّ فعل على عنف مضاد.
ثالثاً: من المقاربة التوصيفية إلى المقاربة الإصلاحية
ينبغي أن لا يقتصر الحديث على التشخيص، بل أن ينتقل إلى التفكير في سبل تحويل الطاقة السلبية إلى طاقة بنّاءة. وفي هذا الإطار يمكن اقتراح مجموعة من الإجراءات التكاملية:
1. على المستوى الثقافي:
دعم المبادرات الإبداعية والفنية التي تتيح للشباب التعبير عن ذواتهم من خلال المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية، لأن الإبداع مجال تفريغ إيجابي يحرر الطاقات ويهذب الوجدان وينمي الحس المدني.
2. على المستوى الرياضي:
توسيع شبكة الأندية والبرامج الرياضية المحلية، لما للرياضة من دور في تهذيب السلوك وتعليم الانضباط وتفريغ الطاقة في اتجاه إيجابي، بعيداً عن العنف والانفعال.
3. على المستوى التربوي:
إدماج التربية على الحوار والمهارات الحياتية ضمن المناهج التعليمية، حتى يتعلم النشء ثقافة الإصغاء والتفاهم واحترام الاختلاف، وتترسخ لديهم قيم التواصل السلمي.
4. على المستوى النفسي والاجتماعي:
إحداث مراكز متخصصة للدعم النفسي والاجتماعي داخل الأحياء والمؤسسات التربوية، لتقديم المساندة للأفراد الذين يعانون من ضغوط أو اضطرابات. كما يُستحسن إنشاء مراكز لتأهيل المقبلين على الزواج ومراكز للوساطة الاجتماعية تُعنى بتسوية النزاعات بطرق ودية، على أن تُدار هذه المؤسسات بكفاءات مهنية مؤهلة علمياً وعملياً.
رابعاً: في التوازن بين الحرية والنظام
يقال إن المجتمع الذي لا يفتح باب الحوار يفتح باب العنف على مصراعيه.
فالدولة لا تُبنى على الجدران الأمنية وحدها، بل على جدران القيم وجسور الثقة بين المواطن والمؤسسات. ومفهوم "تقريب الإدارة من المواطن" لا يقتصر على تقريب البناية، بل على تقريب الإنسان من الإنسان، والمسؤول من المواطن، عبر التواصل الفعّال والاحترام المتبادل.
إن مسؤولية الحفاظ على الطمأنينة مسؤولية جماعية: من الدولة في تدبير الشأن العام، ومن المواطن في التزام السلوك الحضاري. ولذلك فإن التعبير السلمي والحوار الهادئ يشكلان السبيل الأنجع لبناء الثقة وترسيخ قيم المواطنة.
خامساً: نحو عقد اجتماعي جديد
ما وقع في هذه الأيام ينبغي أن يُفهم كجرس إنذار وفرصة تاريخية لإعادة بناء "العقد الاجتماعي" بمعناه العميق كما تحدث عنه الفيلسوف جان جاك روسو. فالعقد الاجتماعي هو اتفاق ضمني بين الدولة والمجتمع، يتنازل فيه الأفراد عن جزء من حريتهم الفردية مقابل أن تضمن الدولة الأمن والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. إنه وعد متبادل: المواطن يلتزم باحترام القانون، والدولة تلتزم بحماية مصالحه وخدمته. ومن ثم، فإن ما نعيشه اليوم يمكن أن يكون منطلقاً لبناء عقد اجتماعي جديد، يضمن لكل مواطن الحق في الحلم والانتماء، ويجعل الوطن فضاءً رحباً يحتضن أبناءه بدلاً من أن يضيق بهم.
على سبيل الختم:
إن ما جرى في الأيام الماضية ليس مجرد أحداث عابرة، بل هو مرآة لعمق الأزمة التي يعيشها المجتمع في علاقته بشبابه، وفي منظومة التربية والإعلام والعدالة الاجتماعية. غير أن الوعي بما جرى هو الخطوة الأولى نحو الإصلاح. ولذلك، فإن الحل يكمن في كلمة واحدة: الحوار. الحوار هو القوة، وهو السبيل إلى تجاوز الأزمات، وبناء وطن آمن متماسك، يسوده الاحترام والعدل والانتماء الصادق.
حسن رقيق، استشاري ووسيط أسري

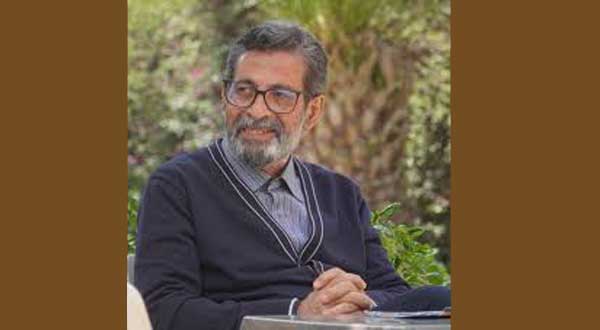 حسن رقيق
حسن رقيق 
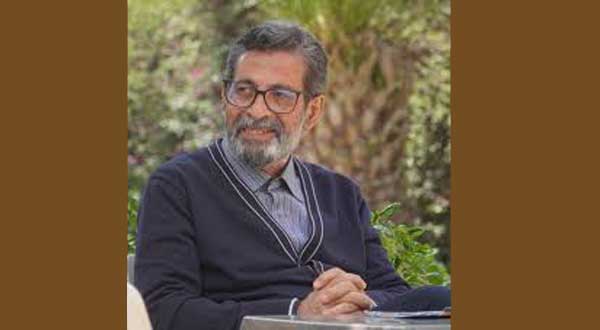 حسن رقيق
حسن رقيق