يعرف المغرب احتقانا اجتماعيا غير مسبوق يفند أكذوبة الدولة الاجتماعية التي تروج لها الحكومة الحالية مستعينة بجيش من أشباه الصحفيين والمدونين المبثوثين في وسائل الاتصال الحديثة. يشهد على حالة الاحتقان تلك ما يعيشه المواطن يوميا عندما يمارس حقه في الولوج إلى المرافق العمومية في الصحة والتعليم وغيرهما من المرافق التي تعد العلامة الأولى على وجود حكومة تنهض بواجبها تجاه المجتمع.
ويبدو أن سياسة تدبير الشأن العام ببلادنا لا تعنى بالإنسان الذي من أجل خدمته وجدت الدولة في الأصل. فقد انصرفت الحكومة الحالية إلى ما يلمع صورة البلاد لدى المؤسسات المانحة، قصد الاستفادة من مزيد من القروض التي ترهن مستقبل الأجيال القادمة لعشرات السنين. وأدت هذه السياسة إلى ترتيب أولويات المواطن المغربي بطريقة أقل ما يقال عنها إنها لا تراعي ظروفه الخاصة. وانكب هم الساهرين على تدبير الشأن العام على إعطاء الأولوية لمشاريع لا يمكن أن ينظر إليها المواطن البسيط إلا بوصفها ضربا من الترف، في الوقت الذي يعاني فيه الفقر والحرمان من أبسط الحقوق المادية، وعلى رأسها الحق في استشفاء يحفظ صحته وفي تعليم يكون أبناءه وفي سكن يستره ويحفظ كرامته.
لقد ترتب عن هذا التردي الذي تعرفه المرافق الاجتماعية إحساس طافح بأن الدولة قد تخلت عن مهامها، وأن الحكومة التي وجدت لتطبق سياسة الدولة تجاه المواطن قد قدمت اسقالتها من هذه المهمة التي وجدت من أجلها، وهو ما حدا بهؤلاء الشباب إلى الخروج إلى الشارع رافعين أصواتهم بالاحتجاج، ولافتين النظر إلى أن السيل قد بلغ الزبى.
ومما زاد الطين بلة أن وزراء الحكومة وبعض المستفيدين من ريعها ماضون من حيث يدرون أو لا يدرون، في إذكاء هذه الحركات الاحتجاجية، إما عن تعنت وإصرار، أو عن غباء سياسي وفقر فكري. وهو ما يبرهن بدون أدنى شك على أن الأمور في هذه الحكومة خاصة، قد أسندت إلى غير أهلها. ولا أدل على ذلك من بعض التصريحات التي يطلقها الوزراء والتي تضمر جهلا مطبقا بملفات المرافق التي يدبرونها.
من المؤكد أن هذا الاحتقان الاجتماعي الذي عبر عنه الشباب بشكل حضاري، لا يمكن أن يجد له حلولا بالمنع والاعتقال اللذين قوبلت بهما هذه الاحتجاجات لحد الآن، وإنما ينبغي أن يقابل بالانكباب على البحث عن حلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تجهز، إن بقيت على حالها، على السلم الاجتماعي.
وفي انتظار ذلك فإن حركة الاحتجاجات الشبابية التي خرجت إلى الشوارع على مدى يومين، تحتاج إلى من يؤطرها سياسيا ويحصنها كي لا تخرج عن أهدافها المطلبية. وقد أبانت التظاهرات التي عرفتها أغلب المدن الكبرى بالبلاد عن غياب يكاد يكون مطلقا للأحزاب السياسية والنقابات التي يوكل إليها دور التأطير السياسي والاجتماعي للمواطن، والتي تخصص لها مبالغ طائلة من ميزانية الدولة مقابل هذا الدور.
وليس في الأمر ما يدعو إلى الاستغراب، فأحزاب الأغلبية ليس لها ما تقوله في الموضوع لأن الواقع لا يرتفع، لذلك لم نر مسؤولا حزبيا في الحكومة يخرج إلى وسائل الإعلام ويبدي برأي حول ما جرى ويجري، كما دأب عليه الأمر في الدول الديمقراطية.
أما أحزاب المعارضة فقد سلمت مفاتيحها منذ زمن غير يسير إلى منطق الريع والمصلحة ولم يعد يربطها بالمجتمع سوى ما يجود عليها من أصوات انتخابية وما تجود عليه من معسول الكلام. وكل هذا يكشف عن خلل ما في المشهد السياسي المغربي، يمكن أن يفسر إلى حد ما هذا النكوص السياسي الذي تعرفه البلاد منذ سنوات خلت.
فبعد مضي أكثر من عقدين ونصف من الزمن على تشكيل حكومة "التناوب التوافقي" التي منحت المغاربة أملا في تداول حقيقي على تدبير الشأن العام، لم ينجح المشهد السياسي المغربي في الوصول إلى فرز يؤدي إلى خارطة سياسية واضحة المعالم. بل يمكن القول إن ذلك المشهد أصبح اليوم أشد غموضا مما كان عليه في السبعينيات والثمانينيات. وقتها كانت لليسار ملامح وكانت لغيره أوجه، وكان الصراع يدور حول رؤيتين مختلفتين إلى حد التعارض.
أما اليوم فقد اتخذ المشهد شكلا متموجا تتغير صورته بين يوم وليلة حسب ما تمليه الحسابات الانتخابية، وليس حسب ما تفرضه القناعات الفكرية والمصالح العليا للبلاد التي هي المقدمة والقاعدة التي تقوم عليها كل ممارسة سياسية. الشيء الذي يزكي الانطباع بأن الحكومات التي تشكلت بعد دستور 2011، في إطار فضاء سياسي، كان المنتظر منه أن يؤثث مشهدا يعيد الاعتبار لمؤسسة مجلس الوزراء رئيسا وأعضاء، لا تختلف في جوهرها عن الحكومات التي سبقت 2011. بل إن وضعية الحكومات المتوالية بعد هذا التاريخ تبدو أسوأ وأنكى، لأنها تحمل في داخلها نفس الأعطاب التي عانت منها الحكومات السابقة لها، أضيفت إليها أعطاب ذاتية خاصة بآليات العمل الحزبي نفسه وبنظرته إلى السياسة التي لا تتعدى نظرة المرء إلى أنفه.
أين يكمن المشكل، في المؤسسات السياسية، أم في القوانين التي تؤطرها، أم في الممارسة؟ من حيث المبدأ لا أحد يمكنه أن ينكر أن دستور 2011 يعد متقدما عن سابقيه، مما يفترض معه أن هذه الوثيقة كان يمكن أن تشكل عاملا لتطوير الفعل السياسي، خاصة مع التراكم الذي حققته التجربة الديمقراطية التي عرفت النور منذ منتصف السبعينيات.
من حيث المبدأ أيضا، فإن المغرب استطاع أن يحافظ على تعددية حزبية منذ الاستقلال، رغم ما اعتراها من نكسات على مر السنين، منها خلق أحزاب تحت الطلب لم يعد المغرب اليوم بحاجة إلى أغلبها. ومع ذلك فإن هذه الأحزاب التي كانت تسمى إلى عهد قريب أحزابا إدارية أريد لها أن تبتلع الأحزاب الوطنية، وأن تقوم مقامها، فغدت مع الأيام "مؤسسات" تحترم مواعيد "مؤتمراتها" وتشارك في الانتخابات بأوراق محبوكة ومسكوكة تسميها برامج عمل، ينتهي الحديث عنها بمجرد إعلان نتائج التصويت.
إن ما كان يطلق عليه أحزابا وطنية أصيبت بعدوى الأحزاب الإدارية، فاختلط حابل السياسة بنابلها، وأصبح المواطن يجد صعوبة كبيرة في التمييز بين البقر الذي تشابه عليه، تحت ثقل المد الإعلامي وسطوة وسائل الاتصال الاجتماعي وهيمنة الهاجس الانتخابي الذي يجعل من الحصول على أكبر عدد من الأصوات غاية في حد ذاتها، وليست وسيلة تمكن من إخراج "الفكرة" التي من الضروري أن تميز هيأة سياسية عن اخرى إلى حيز التطبيق. وهذا ما جعل الأحزاب السياسية تتحول إلى مجرد "إدارات" انتخابية ينصب جهدها على محاولة الفوز بأكبر عدد من المقاعد، حتى وإن لم يكن هذا العدد يشكل أية إضافة نوعية إلى رصيد التجربة الديمقراطية.
إن هذا يعني أن الأحزاب السياسية تعيش أزمة فكر وثقافة جعلت مفهومها للسياسة مفهوما ضيقا ينصرف إلى الكم ولا يعير اهتماما لجوهر العمل السياسي. وقد بدا هذا واضحا في النقاش الذي يشغل بعض قادة الأحزاب هذه الأيام والذي يتمثل في محاولة إقناع أكبر عدد من المواطنين بأن الآخر هو الجحيم. وبذلك يتحول الحزب الذي من الطبيعي أن ينبثق عن فكرة نبيلة تتبلور في موقف وتصور، إلى مجرد آلة انتخابية لجمع الأصوات بالطرق المشروعة وغير المشروعة.
كل عمل سياسي لا تحكمه خلفية فكرية وثقافية بالمعنى الواسع للكلمتين لا يمت إلى السياسة الحقيقية بصلة. خارج هذا الإطار العام الذي كان وراء كل التغيرات التي تحدث في العالم، فإن السياسة تكف عن تكون عملا إبداعيا يناط به تغيير أحوال المجتمع نحو الأفضل.
أن العمل الحزبي عندنا يبتعد شيئا فشيئا عن جوهر هذه المسلمة التي كانت وراء بناء الديمقراطيات العريقة، يشهد على إجبار المثقف المغربي عن التخلي عن دوره السياسي في قيادة الأحزاب والمساهمة في تطويرها، وهو الذي كان يمد عمل الأحزاب بعمق فكري ضروري لأية ممارسة سياسية. لقد اختط المثقف مسافة بينه وبين العمل الحزبي لأنه يرفض الانحدار إلى حضيض يجعل السياسة كما تمارس عند بعضهم مستنقعا تتبادل فيه كل الكلمات الساقطة من أجل حفنة من الأصوات وكمشة من المصالح الضيقة.

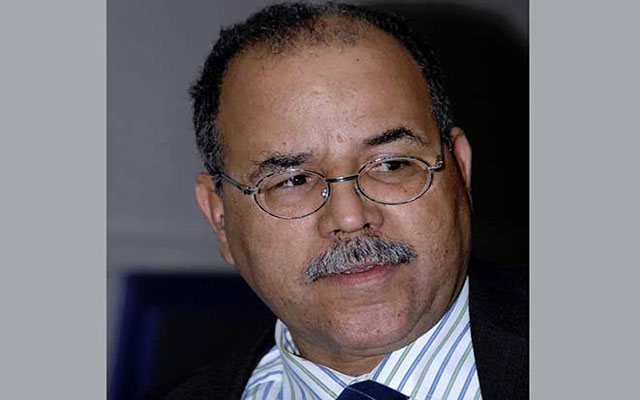 حسن مخافي
حسن مخافي 
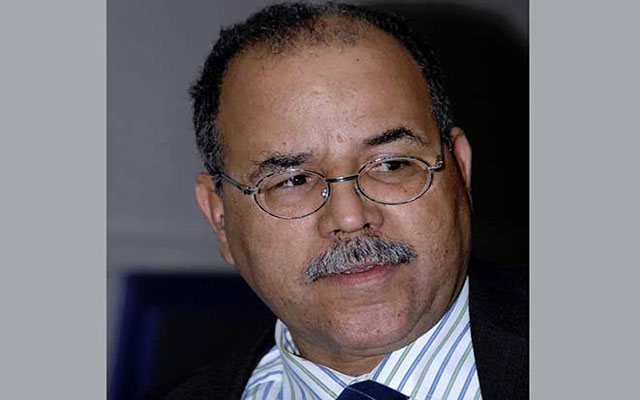 حسن مخافي
حسن مخافي