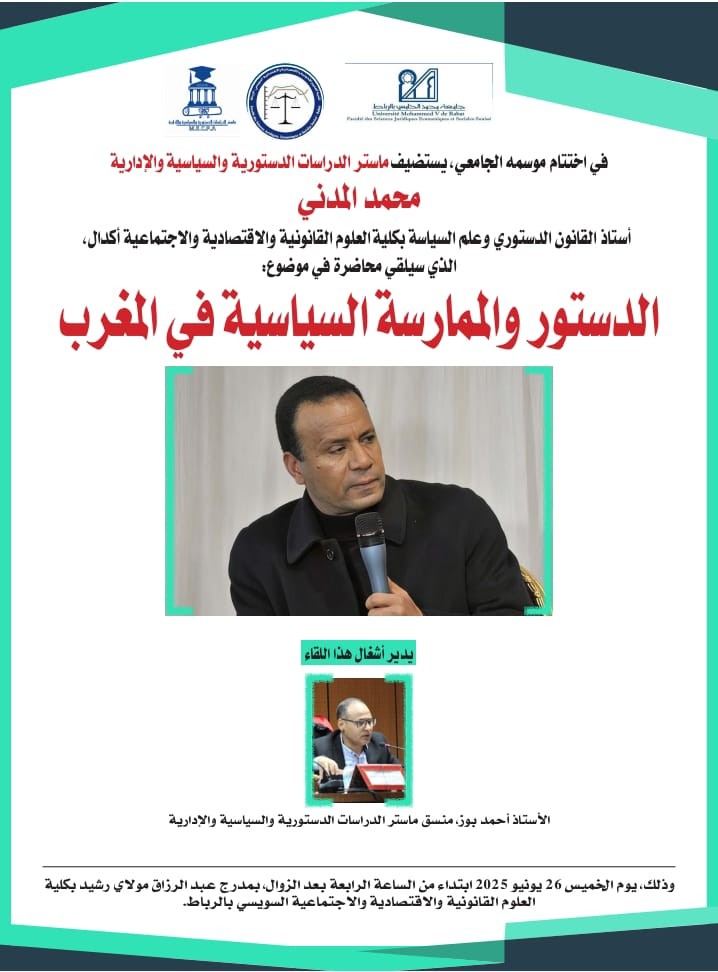محمد المدني في محاضرة حول الدستور.. دستور 2011 نتاج توتر كبير بين إرادة الإصلاح وإكراهات الاستمرارية
 الدكتور محمد المدني وجانب من الحضور
الدكتور محمد المدني وجانب من الحضور 
 الدكتور محمد المدني وجانب من الحضور
الدكتور محمد المدني وجانب من الحضور بمبادرة من ماستر الدراسات الدستورية والسياسية والإدارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - السويسي، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، ألقى الدكتور محمد المدني، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بنفس الجامعة، محاضرة علمية هامة بعنوان: "الدستور والممارسة السياسية في المغرب"، وذلك يوم الخميس 26 يونيو 2025، بحضور نخبة من الأساتذة والباحثين وطلبة سلك الماستر وسلك الدكتوراه.
وتأتي هذه المحاضرة في سياق النقاشات المتواصلة حول التحولات التي عرفها المشهد الدستوري والسياسي المغربي خلال العقدين الأخيرين، خاصة في ضوء دستور 2011، وما أثاره من أسئلة عميقة حول حدود التأويل، وآفاق التفعيل، وإشكالية التوفيق بين النص والممارسة.
كما تأتي في سياق حرص الماستر المذكور على مواكبة النقاش العمومي والأكاديمي حول عدد من القضايا المجتمعية، وضمنها رهانات تفعيل الدستور المغربي، وحدود الممارسة السياسية في ظل التحولات التي يشهدها النظام السياسي والدستوري المغربي، وتفاعل الفاعلين مع منطق النص وروح التعاقد الدستوري، وذلك في إطار تعزيز المقاربة النقدية والتحليلية التي يُشجع عليها التكوين الأكاديمي في هذا المسلك.
ونظرا لما تميزت به محاضرة الأستاذ المدني من عمق تحليلي وغنى معرفي، سواء من حيث المنهج أو المضمون، وحرصا على تعميم الفائدة، وتوثيق النقاشات الأكاديمية الرصينة حول قضايا الشأن الدستوري ببلادنا، يسعدنا أن نقدم للقراء النص الكامل لهذه المحاضرة، كما ألقاها الأستاذ المدني، دون تصرف، حفاظا على سياقها العلمي والدلالي.
نص المحاضرة
المحاضرة التي طُلب مني في بداية السنة أن ألقيها في طلبة الماستر وطلبة الدكتوراه موضوعها "الدستور والممارسة السياسية". وهو موضوع يطرح التساؤل منذ البداية عن هذا الربط بين الدستور والممارسة السياسية.
وفي هذا الإطار، يمكنني أن أقول إنه ربط منهجي يعتبر أن دراسة الدستور لا يمكن أن تنفصل عن دراسة المحيط الاجتماعي والسياسي على وجه الخصوص، كما لا تنفصل عن الوضعية السياسية، بحيث لا يمكن، في تقديري، دراسة الدستور المغربي دون إدراك عميق للسياق الذي أنتجه، ولا دون فهم للفاعلين الذين أسهموا في صياغته وتكييفه وتأويله.
فالدستور ليس مجرد نص فوقي، وإنما هو، في المقام الأول، نتاج لوضعية سياسية محددة، ووليد لتفاعلات بين فاعلين سياسيين واجتماعيين خلال مرحلة تاريخية دقيقة. من هنا، فإن أطروحتي الجوهرية هي أن دستور 2011 يعكس تلك اللحظة، ويترجم رهاناتها، بغض النظر عما إذا كان سيستمر كما هو، أو يتغير حسب تحولات السياق.
من هذا المنطلق، فإن أي محاولة لتقديم نبوءة حول مستقبل هذا الدستور خارج الإطار السياسي والاجتماعي ستكون مفتقدة للأساس التحليلي. فالمآل الدستوري لا تحدده الوثيقة القانونية وحدها، بل تحكمه بالأساس الوضعيات السياسية، وسلوك الفاعلين، وتوازنات القوى.
في هذا السياق، يجدر بنا أن نستحضر ما قاله عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم في درسه الافتتاحي سنة 1888، حيث خاطب طلبة القانون قائلا: "من الضروري لطالب القانون ألا يظل سجينا للدراسات النصية الخالصة. فإذا خصص كل وقته للتعليق على النصوص القانونية، والبحث عن مقاصد المشرع، فسينتهي به المطاف إلى الاعتقاد بأن إرادة المشرع هي مصدر القانون الوحيد، فيغلب النص على المضمون، والمظهر على الواقع. والحقيقة أن القانون يتشكل داخل أحشاء المجتمع. فالمشرع ليس سوى من يكرس ما تم إنجازه مسبقا. لذا ينبغي تعليم الطالب كيف ينشأ القانون تحت ضغط المتطلبات الاجتماعية، وكيف يتطور، وكيف تتغير المؤسسات القانونية الكبرى."
انطلاقا من هذا الاقتباس، أؤكد أن محاضرتي تنتمي لهذا التوجه الذي يربط بين القانون وباقي العلوم الاجتماعية، ويقاوم النزعة النصية الشكلانية التي تتعامل مع النصوص القانونية وكأنها نصوص مقدسة أو طلاسم ينبغي فكها.
وقد أصبح من الواضح اليوم أن القانون الدستوري، سواء في المغرب أم في بقية دول العالم، يتطور بتطور المجتمعات، وخاصة مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية. هذا ما أدى إلى تراجع التدريس الموسوعي والشكلاني للقانون الدستوري، لصالح مناهج تحليلية تدمج علم الاجتماع السياسي، والنظرية السياسية، وسوسيولوجيا الدولة، وغيرها من فروع التحليل السياسي والقانوني المعاصر.
في هذا الإطار، يبدو لي من المهم أن نستحضر أثر المدرسة الواقعية الأمريكية التي لعبت دورا بارزا في تطوير دراسة القانون، من خلال مفاهيم جديدة مثل "الدستور في الكتب" (constitution in books) مقابل "الدستور في الفعل" (constitution in action). وهي تفرقة تفضح التناقض بين النص والممارسة، وتقر بأن التحليل القانوني يجب ألا يكتفي بتفسير المادة القانونية، بل عليه أن يستجلي سياقها، وظروف صدورها، وتوظيفاتها السياسية.
في الواقع المغربي، لا تزال المقاربة الشكلانية تهيمن على تحليل النصوص، سواء في الدرس الجامعي أو في التكوين الأكاديمي، مع بعض الاستثناءات؛ إذ إن الدروس التوجيهية، رغم ادعائها إعطاء أمثلة تطبيقية، تبقى بدورها أسيرة تحليل نصوص المحكمة الدستورية، دون أن تغامر بالخروج نحو واقعها السياسي والاجتماعي. ولهذا، فإننا نحتاج إلى مقاربة أكثر واقعية، لا نكتفي فيها بتحليل النص، بل نسائل القرار القضائي والسياسي من داخله: ما خلفياته؟ ما فلسفته؟ ما توازناته؟ ما علاقته بالتكوين الشخصي أو الاجتماعي أو السياسي للقضاة أو الفاعلين الذين ساهموا فيه؟
هذا المنهج وحده يمكنه أن يفتح "العلبة السوداء" للمحكمة الدستورية، ويمكننا من تجاوز البعد المعياري الجامد. وكمثال على ذلك، يمكنني أن أذكر القرار المتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب، والذي ظلت التعليقات عليه حبيسة التحليل النصي، دون أن تتناول السياق الاجتماعي والسياسي الذي فرض هذا القانون، أو الأسئلة الفلسفية الكامنة وراءه: هل يعكس القرار توجها ليبراليا؟ هل هناك انحياز ضمني لقراءة اقتصادية معينة؟ وهل هذه القراءة مرتبطة بالخلفية الاجتماعية أو التكوينية للقضاة؟ أم بتأثير الأحزاب التي ينتمون إليها؟
هذه الأسئلة لا تُطرح كثيرا، لأنها تعتبر خارج الحقل القانوني "الرسمي"، لكنها ضرورية لفهم عمق القرارات الدستورية.
حين ولجت كلية الحقوق بالسويسي قبل هذه المحاضرة، لفت انتباهي وجود ما يسمى بـ"مصحة قانونية"، وهي مبادرة طموحة تربط النظرية بالممارسة، وتمثل تجسيدا حيا لفكرة جعل القانون في خدمة الواقع الاجتماعي، لا مجرد نص مغلق على ذاته. لكن المشكل هو أن هذه المصحات لا تشمل القانون الدستوري، مع أن هذا الأخير في أمس الحاجة إلى ممارسة منفتحة، تدمج الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين في البحث، وتجعل من الجامعة فضاء لتفاعل الخبرة الأكاديمية مع التجربة الميدانية.
بل أذهب إلى أبعد من ذلك، وأقترح تأسيس ما يمكن تسميته بـ"بيت القانون الدستوري"، يكون منصة للحوار بين الباحثين والفاعلين: أحزاب، نقابات، جمعيات، إعلاميون، وحتى قضاة دستوريون. الهدف هو تجاوز النظرة المغلقة للقانون الدستوري، والانفتاح على أدوات سوسيولوجية وتحليلية جديدة تعيد للباحث حسه النقدي.
هذه الملاحظات ليست عرضية، بل تنبع من اختياري المنهجي في دراسة الدستور المغربي. وهو منهج يركز على الصيرورات السياسية؛ أي على المسارات التي أنتجت النص، وعلى الديناميات التي تحكم تأويله واستعماله. وبهذا المعنى، فإن دستور 2011 لا يفهم إلا باعتباره نتيجة لتفاعلات معقدة بين فاعلين سياسيين واجتماعيين، خلال مرحلة عرفت توترا كبيرا بين إرادة الإصلاح وإكراهات الاستمرارية.
لقد تركزت العديد من الدراسات على "دستور الجريدة الرسمية"، أي النص كما هو منشور، وقارنت بعض مواده بنصوص دستورية أخرى، خصوصا الفرنسية والإسبانية. لكن المقارنة تفقد معناها إذا جردت من سياقها السياسي. فالفصل نفسه يمكن أن يأخذ معنى في بلد ديمقراطي، ومعنى آخر في نظام سلطوي. ومن هنا، جاءت دعوتي إلى أمْبَرقَة الدستور، أي أن نربط النص بسياقه، وندرجه ضمن تاريخه التفاعلي، ونكشف عن القوى التي شكلته، وعن المفاوضات والصراعات التي رسمت معالمه.
في هذا الإطار، من المهم الإشارة إلى أن دستور 2011 لم يكتب على يد مفكر أو فيلسوف سياسي، كما فعل أرسطو في "دستور أثينا"، أو جان جاك روسو في مشروعه لدستور كورسيكا ومشروعه لدستور بولونيا، بل هو نتاج تفاعل غير متكافئ بين فاعلين، كان لبعضهم – وعلى رأسهم المؤسسة الملكية – تأثير حاسم في بلورة معالم النص. فالكتابة الدستورية لم تكن جماعية بالمعنى الحقيقي، لأن ميزان القوة بين من شاركوا فيها لم يكن متكافئا.
هذه التعددية غير المتكافئة في كتابة الدستور، جعلت منه دستورا توفيقياً، أو كما أسميه: "Le syncrétisme constitutionnel"؛ أي دستورا هجينا، تتجاور فيه مفاهيم وأدوات قانونية متناقضة، وأحيانا متصارعة. وهو دستور يعبر عن تعدد الرؤى حول الدولة والسلطة والقانون والديمقراطية، دون حسم نهائي بينها.
ولفهم هذا النموذج التوفيقي، أستحضر مفهوم "القانون المركب" (Le droit composite)، الذي صاغه جاك بيرك في خمسينيات القرن الماضي من خلال دراسته للبينات الاجتماعية للأطلس الكبير (سكتاوة)، حين لاحظ وجود طبقات قانونية رسمية (الدولة) إلى جانب أخرى عرفية (الأعراف المحلية)، تتعايش ضمن منظومة قانونية واحدة، دون اندماج أو صراع مباشر. كما نجد هذا المفهوم عند بول باسكون في وصفه للمجتمع المغربي كمجتمع "مركب" (Une société composite) يتعايش في، جنبا إلى جنب، التقليد والحداثة، المواطن والمؤمن، الفتوى والقاعدة القانونية، الدولة الرعوية (le gouvernement pastoral)، التي دافع عنها ميشال فوكو، والدولة المواطِنة أو دولة القانون، الأمة بمفهومها العصري والأمة بمفهومها الديني، حيث لا تنبع هذه المفاهيم التي استدعاها الدستور من تصور مشترك للسلطة وللقانون ولا تؤدي إلى نفس التأويلات وإلى نفس القراءات.
إن الدستور المغربي الحالي يعكس بدوره هذا التعايش غير المتجانس. ففيه نجد عناصر من الدولة الحديثة، مثل البرلمان، والحكومة، والحريات، ولكن بجانبها نجد عناصر من الدولة التقليدية، مثل إمارة المؤمنين، والطابع الديني للسلطة، وتقديس الوحدة، والمرجعية الشرعية المرتبطة بالتقاليد. فالدستور يتحدث عن "المواطن" بمفهومه القانوني الحديث، لكنه في الآن ذاته يتحدث عن "المؤمن" بمفهومه الديني الروحي. ويتبنى فكرة دولة القانون، من جهة، لكنه، من جهة أخرى، يحتفظ بتأويل رعوي للسلطة، كما تحدث عنه ميشال فوكو، حيث يكون الحاكم راعيا لرعيته، لا مجرد ممثل سياسي خاضع للمحاسبة.
والسؤال الرئيسي الذي يطرحه النظام التوفيقي هو كيف يمكن أن نفهم المنطق الكامل حول كل هذه التناقضات، هل هي فقط تناقضات عشوائية أم يحكمها منطق ما؟
في هذا الإطار، يمكن أن نفهم هذا التناقض بالعودة إلى دور الفاعليين السياسيين في المغرب. لأن هذا التنافر في المفاهيم ليس عشوائيا، بل ناتجا عن تفاعل استراتيجي بين فاعلين سياسيين يتبنون مرجعيات متباينة. فبعض الأحزاب السياسية والنخب الإسلامية تدفع باتجاه تأويل الدستور من زاوية المرجعية الدينية، وتدافع عن إمارة المؤمنين كمرتكز للدولة والمجتمع. في حين تدافع قوى أخرى، من تيارات يسارية أو حقوقية، عن التأويل الكوني لحقوق الإنسان، وعن مساواة النوع، وعن علمانية الدولة بشكل ضمني أو صريح.
وهنا تكمن خصوصية التوفيقية الدستورية المغربية: إنها ليست مجرد جمع للمفاهيم، بل هي ميدان صراع رمزي بين قوى مختلفة، تستعمل النص ذاته لتدعيم مشاريع متناقضة.
هذا النظام التوفيقي في بنية الدستور المغربي، الذي يتسم بجمعه بين عناصر حداثية وأخرى تقليدية، يتميز بعدة خصائص أساسية تظهر تناقضاته الداخلية، وتشرح كيف أن المفاهيم المستعملة فيه قد تتغير معانيها وفق تأويلات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين.
الخاصية الأولى، تتجلى في التعايش داخل نفس النسق الدستوري لعقليات ومقتضيات متناقضة. نجد في الدستور مرجعيات تقليدية تُمجّد الماضي وتسعى إلى إعادة إحيائه، لكنها لا تفعل ذلك بدافع الحنين إلى هذا الماضي أو حبا فيه، وإنما كوسيلة لتأطير الحاضر والسيطرة عليه. هي "عودة استراتيجية إلى الماضي"، حيث تُستحضر بعض مفاهيمه ومقولاته الدينية أو الرمزية من أجل الإجابة عن أسئلة الحاضر، لكن ضمن منطق انتقائي، حيث يتم اختيار عناصر محددة من الماضي لتبرير وضع سياسي راهن.
هذا ما يعرف بـابتكار التقليد (Invention de la tradition)، أي أننا لا نعتمد التقليد كما كان، بل نعيد صناعته وتلميعه كي ينسجم مع الحاضر، دون تغييره فعلا. هكذا، نخلق هوية دستورية هجينة، تستبطن الحداثة لكنها تتحدث بلغة الماضي، فتظهر الازدواجية بوضوح في مفهوم الأمة بين الأمة الدينية والأمة المواطِنة، وفي فهم الحريات بين الحرية بوصفها حقاً فردياً وبين الحرية المقيدة بضوابط الجماعة والدين والهوية.
في هذا السياق، يجدر التذكير بأنه منذ دستور 1962، كان التركيز على مكونين أساسيين في هوية الدولة: العروبة والإسلام، مع الإشارة الجانبية إلى الانتماء الإفريقي. لكن مع دستور 2011، ظهرت روافد جديدة (أندلسية، عبرية، إفريقية...)، غير أنها لم تبدل البنية الأصلية، بل أضيفت كطبقات تزيينية هدفها الاستجابة لانتظارات جديدة دون المساس بجوهر النسق الأصلي.
الخاصية الثانية للتوفيقية الدستورية تتجسد في الترجمة بمعناها اللغوي والاستعاري معا، حيث الأفكار والمبادئ الدستورية التي تنتمي إلى مرجعيات غربية – مثل سيادة الأمة، فصل السلط، الديمقراطية التمثيلية – تمر عبر مصفاة اللغة والتأويل السياسي، مما يجعل معانيها تتغير عند دخولها المجال الدستوري المغربي.
هكذا، تتحول الترجمة من مجرد نقل لغوي إلى فعل سياسي تأويلي. وتصبح المفاهيم "المستوردة" من أنظمة ديمقراطية ليبرالية خاضعة لإعادة تركيب وتأويل يتماشى مع السلطة الملكية، ويُفرغها أحيانا من مضمونها الحداثي. ففصل السلط، مثلا، لا يفهم هنا كأداة لتقييد السلطة التنفيذية، بل كتنظيم وظيفي وتقني يسمح باستمرار هيمنة المؤسسة الملكية باعتبارها محور النظام.
الخاصية الثالثة، وهي مرتبطة بالخاصية الثانية، تتمثل في إعادة تشكيل المعاني الرئيسية للمبادئ الديمقراطية داخل النص الدستوري. وهي ممارسة مشتركة بين القوى المؤثرة في الساحة السياسية، ولا تقتصر على طرف دون الآخر. فمعظم القوى السياسية التي قدمت مذكرات دستورية إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تتبنى خطاباً موحدا حول الديمقراطية ودولة القانون، لكنها تمنح هذه المفاهيم معاني مختلفة حسب مواقعها ومصالحها وتكتيكاتها واستراتيجياته.
ولتوضيح ذلك، سأقتصر على ثلاثة مفاهيم رئيسية وردت في الدستور 2011؛ فصل السلط، السيادة الوطنية والملكية البرلمانية. وسنرى كيف أعطيت لها معاني تسمح بتأويلها بما يناسب ملكية حاكمة ويناسب إمارة المؤمنين؟
-السيادة الوطنية: الدستور يعيد إنتاج نفس التعريف الديمقراطي للأمة لكن يعطيها معنى خاصاً. فهو يُعرّف الأمة كمجموعة من المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات، وهو تصور حداثي علماني. غير أن هذا المفهوم، حين يُربط بإمارة المؤمنين، يتجاوز الحدود الجغرافية للدولة. فإمارة المؤمنين لا تُمارَس فقط داخل المغرب، بل تُحمّل أحياناً بمدلولات رمزية تتخطى الحدود الوطنية، مما يخلق توتراً بين السيادة بمعناها الوطني والمواطنة بمعناها الديني الرمزي.
-الملكية البرلمانية: وردت في الدستور ضمن الفصل الأول الذي يتحدث عن نظام الحكم باعتباره "ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية". لكن عبارة "الملكية البرلمانية" تحديدا لم تُدرج ضمن الثوابت الجامعة للأمة كما حددها نفس الفصل؛ وهي "الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي".
والسبب يعود إلى أن هذا المطلب إذا كان قد ارتبط أساسا بالحراك السياسي في 20 فبراير، وجرى الحديث عنه ضمن وثائقها السبع، إما في شكل دفاع عن "ملكية متنورة" أو "ملكية برلمانية ضمنية" أو "ملكية برلمانية بالمعنى الصحيح"، فإنه لم يحظَ بتمثيلية واسعة داخل النخب السياسية المؤثرة. بل إن القوى التي كان يُنتظر منها الدفاع عن هذا التحول، مثل حزب العدالة والتنمية أو جماعة العدل والإحسان، تجاهلته، إما لأسباب سياسية تكتيكية، أو بسبب تموقعها الإيديولوجي. طبعا، لا نتحدث عن الفاعل الرئيسي الآخر، أي الملكية، لأنه من غير المنطقي أن تأتي المبادرة من المؤسسة الملكية نفسها لتطالب بتقييد سلطتها، لأن هذا يتنافى مع منطق السلطة ذاته. ومن ثم، بقيت الملكية البرلمانية شعاراً غير قابل للتحقق في غياب فاعلين سياسيين يدافعون عنه بوضوح.
لذلك، في هذا السياق المركب، يمكن القول إن الملكية في الدستور المغربي احتفظت بما يمكن تسميته بـ"الوظائف الثلاث الكبرى"، وهي وظائف ليست وليدة السياق المغربي فقط، بل يمكن تتبعها في كتابات جورج دوميزيل (Georges Dumézil) الذي اشتغل على المجتمعات الهندو أوروبية، ووضع تصورا للسلطة يجمع بين ثلاث وظائف: الحربية، الروحية أو الدينية، والاقتصادية. هذه الوظائف كلها حاضرة في الدستور المغربي.
الوظيفة الحربية: تتجلى في كون الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ورئيس المجلس الأعلى للأمن، وله صلاحية إشهار الحرب، بالإضافة إلى صلاحيات استثنائية كإعلان حالة الاستثناء التي يحددها الفصل 59 أو حالة الحصار. هذه الوظائف تمنح للملك موقعا مركزيا في تدبير الأزمات والتحديات الأمنية.
الوظيفة الدينية/الروحية: وهي الوظيفة الأكثر ارتباطا بمفهوم "إمارة المؤمنين"، والتي يمكن مقاربتها بما سماه ميشيل فوكو بـ"الحكم الرعوي" (Le gouvernement pastoral)، الذي سبقت الإشارة إليه. وهو نوع من السلطة التي تجمع بين حماية الجسد وضبط الروح، وتسعى إلى تنظيم الرعية وفق تصور أخلاقي - ديني للسلطة. فالرعاية هنا ليست فقط أمنية أو مادية، بل تمتد إلى المجال الروحي والقيمي.
ثم الوظيفة الاقتصادية، التي كثيرا ما يتم إغفالها في التحليلات الدستورية، لكنها حاضرة بكيفية واضحة في بنية الدستور. ويظهر ذلك من خلال إعطاء الدستور للملك صلاحيات اقتصادية محورية تسمح له بالتحكم في القرار الاقتصادي. فالملك يترأس المجلس الوزاري الذي يحدد التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، كما يحدد التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، ويعطيه صلاحية تعيين المسؤولين في المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، والبنك المركزي، الذي يعد أداة مركزية في السياسات النقدية والاستثمارية. هكذا، تتحقق سيطرة غير مباشرة على القرار الاقتصادي في الدولة.
الخاصية الرابعة للتوفيقية الدستورية؛ تتجسد في إعادة صياغة مبادئ وأدوات التدبير العمومي الجديد (Le nouveau management public)، حيث الدستور المغربي مليء بمبادئ التدبير العمومي الجديد، خاصة تلك الأدوات القابلة لاستعمالات مضادة للأغلبية الحكومية.
فنجد في الدستور المغربي مجموعة من المفاهيم التي تنتمي إلى عالم التدبير وليس إلى عالم القانون، مثل: الحكامة الجيدة، النجاعة، الشفافية، ربط المسؤولية بالمحاسبة، التخليق، التقنين، التقييم... وهي مفاهيم تُستعمل في الظاهر كأدوات لتحديث الإدارة والرفع من جودة الأداء، لكنها في العمق تُستخدم أحياناً لتقويض سلطات المنتخبين، وخاصة الأغلبية البرلمانية، عبر خلق آليات رقابة موازية تُمارَس من طرف هيئات مستقلة، غير خاضعة لمنطق الانتخاب.
هذه الهيئات، التي تتقاطع في طبيعتها مع نماذج الحُرّاس الجدد للدستور (Les nouveaux gardiens de la constitution)، كما تسميهم أدبيات الدستورانية الجديدة، أصبحت تضطلع بوظائف استراتيجية، وقد يتم توظيفها لخلق توازنات ضد سلطة الحكومة المنتخبة، مما يضعف فعلياً مبدأ الديمقراطية التمثيلية.
والهدف من هذا التوفيق هو أن توضع في نفس النص الدستوري عقيدتان متناقضتان، عقيدة حكومة سياسية تستمد سلطتها من صناديق الاقتراع، وهنا أحيل على الفصل 47 من الدستور، وبجانبها عقيدة تدبيرية ترى في قاعدة الأغلبية خطراً يهدد النظام المؤسساتي، وتعطي الأولوية للأخلاق ولمبادئ الحكامة الجيدة. فإذا اطلعتم على الدستور ستجدون أن الحكامة الجيدة منصوص عليها من التصدير إلى الفصل 167، بحيث تعد تيمة مركزية تخترق الدستور من أوله إلى آخره. هذه الحكامة الجيدة تتخذ على المستوى العملي صورة عدة هيئات ومؤسسات، وتلتقي في جوهرها مع مهمة منافسة الحكومة والأغلبية، كما تلتقي مع توجهات الوكالات الدولية التي تروج لمبادئ التقييم والشفافية كيفما كان السياق، ولو في سياق سلطوي. وهي هيئات تندرج في إطار ما يسمى بالنماذج المسافرة، بما أنها موجودة في عدة دول. لكن عندما يتم اعتمادها في المغرب تجري تبيئتها ويعطى لها معنى مختلف.
ومن بين أكثر المفاهيم التي تطرح إشكالاً هو "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، الذي يُستخدم بكثرة في الخطاب الرسمي والدستوري، لكنه يفتقر إلى وضوح مفاهيمي، إذ لا يحدد هل المقصود به هو المسؤولية السياسية التي ترتب آثارا داخل البرلمان والحقل السياسي، أم المحاسبة التدبيرية التي تضطلع بها أجهزة مثل المجلس الأعلى للحسابات؟ في الواقع، يُستخدم هذا المفهوم لتغليب المساءلة الإدارية التقنية على المسؤولية السياسية الحقيقية، مما يؤدي إلى تغييب المساءلة السياسية عن مراكز القرار العليا، أي "الحاكمين من الدرجة الأولى".
وهنا تطرح مفارقة دستورية حقيقية، وهي أن الدستور رغم أنه يقر بوضوح أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، فإن آليات التدبير العمومي الجديد وهيئات الحكامة تشكل شبكة بديلة للمحاسبة قد تؤدي إلى تهميش البرلمان نفسه.
من الأدوات الأخرى التي تبلورت في الدستورانية الجديدة أو الدستورانية المرتبطة بالتدبير العمومي الجديد نجد دور القضاء الدستوري، الذي أصبح يحتل موقعا مركزيا في منظومة "البرلمانية المعقلنة"؛ أي النظام الذي يخضع البرلمان لمجموعة من الآليات الإجرائية والضوابط الصارمة تحد من فعاليته.
فقد أصبح القضاء الدستوري يحتل مكانة متميزة مقارنة بما كان عليه في السابق، خصوصاً مع تطور النشاط الانتخابي الذي أعطى للقضاء الدستوري وظيفة رئيسية هي الوظيفة الانتخابية. وهو أمر ربما لا يعطاه الاهتمام الكافي. طبعا يفسر ذلك بالتحولات التي عرفها الحقل السياسي المغربي، أي تواتر العمليات الانتخابية، وبروز منافسة نخبوية محتدمة، حتى في ظل تراجع الحضور الجماهيري في الانتخابات. وهذا أدى إلى تعزيز حضور القضاء الدستوري، الذي أصبح دوره مهما في مرحلتين: مرحلة ما قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات، خاصة على مستوى مراقبة القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات التشريعية والترابية، ومرحلة ما بعد إعلان النتائج، حيث يبرز شوط جديد تظهر فيه أهمية القضاء الدستوري، من خلال كلمته الفاصلة في الطعون والمنازعات الانتخابية، وخاصة على مستوى البرلمان، بحيث يمكن للنتائج أن تتغير بفعل قرارات هذا القضاء. صحيح أن تعزيز دور القضاء الدستوري يعد ظاهرة عالمية، ولكنه يتميز في الدول الديمقراطية بتقاليد متينة وبمستوى كبير من الاستقلالية. لكن عندما تعطى مكانة متميزة للقضاء الدستوري في الدول السلطوية فإن ذلك يعد مثيرا للتساؤلات.
سأنهي هذه المحاضرة بما بدأتها حول مآل الدستور، لكي أقول إن هذا المنهج الذي اتبعته في قراءة الدستور في واقع الممارسة السياسية يبين أن دستور 2011 هو نتاج لوضعية سياسية معينة، وهو بالأساس نتيجة لتفاعلات ولصراعات الفاعلين في مرحلة معينة، وأيضا هو نتيجة لتوافقاتهم، وخاصة الضمنية منها، التي تتم عن بعد انطلاقا من تصور الفاعلين لانتظارات بعضهم البعض. فدستور 2011 ليس نصا مجردا، بل هو نتاج لصراعات وتوافقات بين فاعلين سياسيين في لحظة تاريخية معينة، اتسمت بتوازنات هشة وتناقضات مرجعية.
وقد صيغ هذا الدستور بناءً على تصوّر كل طرف لانتظارات الطرف الآخر، في ظل منطق سياسي لا ينطلق من فراغ، بل يرتكز على إرث طويل ومعقد.
وبالتالي، فإن مستقبل هذا الدستور، ومآله، لا يتحدد من خلال نصوصه فقط، بل من خلال الوضعيات السياسية القادمة، وتفاعل الفاعلين مع مضامينه، وقدرتهم على تأويله، أو تجاوزه. لأنه، في نهاية المطاف، ليست النصوص هي التي تُنتج السياسة، بل التفاعلات والوقائع، والقدرة على إعادة تشكيل ميزان القوى.