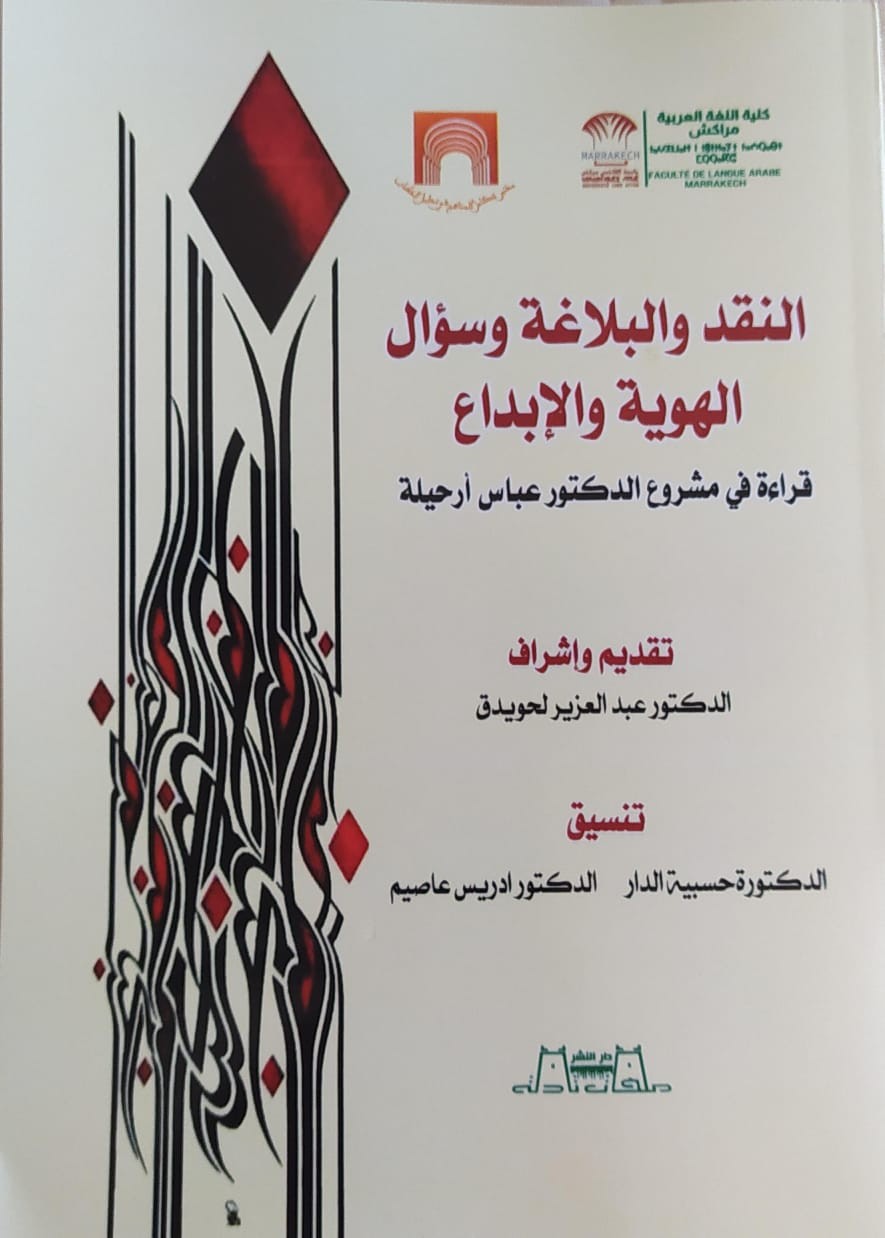نظّم مؤخرا مختبر "تكامل المناهج في تحليل الخطاب" بكلية اللغة العربية بمراكش ندوة وطنية تكريمية لأستاذ الأجيال الدّكتور عباس أرحيلة، بمدرج الشرقاوي إقبال.
واختار القائمون على هذه الندوة عنوان: "النقد والبلاغة وسؤال الهوية والإبداع – قراءة في مشروع الدكتور عباس أرحيلة"، إطارًا إبّستيميًّا مُوجِّهًا لمداخلات المشاركين في هذه الفعاليّة التكريميّة.
والنّدوة من تنسيق الأساتذة الأجلاء د. عبد العزيز لحويدق، ود. حسبية الدار، ود.إدريس عاصم. ولمِا للأستاذ عباس أرحيلة علينا من أيادٍ بيضاء فقد شاركتُ بدوري بورقة علميّة بعنوان: "تأريخ البلاغة العربية عند الأستاذ عباس أرحيلة" إلى جانب أساتذة آخرين احتفلواْ، أيضا، بالمنجز العلمي لفضيلة الأستاذ.
ولا يتطلّع هذا التقرير إلى تقديم ملخّصاتٍ للأوراق العلميّة التي شاركت في هذه النّدوة على أهمّيتها وتنوّعها؛ لأنّها، أوّلًا، نُشرت في مؤلَّف جماعيٍّ أصدرته دار النّشر "ملفات تادلة" قبل انطلاق أعمال النّدوة، وهو سبقٌ إيجابيّ يُحسب للسّاهرين على هذا التّكريم، وثانيا لأنّ ما أردنا التركيز عليه في هذا اليوم الدراسيّ هو كلمة أستاذنا المحتفى به في هذه المناسبة العلمية والإنسانية التي تحتفل فيها أسرة كلية اللغة العربية بمجهودات هذا العلّامة، وذلك بقراءة مشروعه الحضاريّ.
لا شكّ أن موضوع البلاغة ينصرف مباشرة إلى أثر القرآن الكريم في الثقافة العربية وفي تأسيس العلوم العربية والإسلامية، خاصة، علوم الآلة، وذلك بغرض استحداث الأدوات المنهجية التي تُسعف الأمّة في فهم هذا النص الديني المنفتح على التّأويلات، وكلّما ابتعدنا عن عصر النّبوة إلَّا وظهرت الحاجة الملحّة لهذه الآليات البلاغيّة والنّقدية واللّغوية والمناهج والمداخل القرائية التي تساعد المتلقي العربي وغيره على فهم هذا الخطاب الرّبّانيّ.
في ضوء هذه الرؤية المتبصِّرة تنطلق رحلة الأستاذ في كلمته في موضوع "البلاغة والهُوّيُة"، فقد أشار من خلال قوله تعالى : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ اَلْقُرْآنَ خَلَقَ اَلْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ اُلْبَيَانَ﴾ [الرّحمن، 1-2] إلى أنّ تعليم القرآن قد سبق خلقَ الإنسان ترتيبًا، وتعليمُه البيانَ إنطاقُه وجعلُه يُبينُ ويُفْصِح، والبلاغة، من هذا المنطلق، ليست مقصورةً على أمّة دون أمّة، ولا أحد دون أحد، مادام أنّ الوحيَ الإلهيَّ مرتبطٌ بحياة الشّعوب كلِّها، وهو ما نفهمه من قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم، من الآية 5]، ولعلّ معجزةَ الكتاب العزيز المهيمِنة هي "التّحدّي والمعارضة والإعجاز"، وهو ما لم يرد في الكتب السّماوية السّابقة ولا في صحف الأنبياء (صُحُف ّإبراهيم وموسى)؛ فالإعجاز هو الميسَم المهيمن في تحدّي القرآن الكريم للعرب المطالِبين بمعجزة على غرار معجزات الرّسل والأنبياء السّابقين.
وإلى جانب النّص القرآنيّ هناك كلام النّبي ّصلّى الله عليه وسلّم الذي أوتي جوامع الكلِم (وهي عبارات موجزة لم يُعثر لها على مثيل) في مواجهة قومٍ وصفَهم الكتاب العزيز بقوله: ﴿وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا﴾ [مريم، من الآية 98] واللَّدَد شِدّةُ الخصومة والجدل.
وبذلك وجدت البلاغةُ نفسها في "المواجهة" مع قوم تمكّنواْ من فَنَن القول وسحر البيان، ومن ثَمَّ فالمطَّلِع على إعجاز القرآن يلاحظ أنّ البلاغة في جوهرها هي سلاح يجاهد لدخول غمار النص القرآني من أجل القراءة والفهم...
لذلك يرى الأستاذ أنّ كلَّ انفعال بالوجود منطلَقُه النّصّ القرآنيّ؛ إذ به يُستبان ما يحتاج الإنسان إليه، وهذا ما يجعلنا أمام مجموعة من الأسئلة الوجودية المواجِهة من قِبَل الدّيانات الأخرى والتي عبّرت عن موقفها من هذا التّفاعل من خلال ما دعاه الأستاذ "الاحتجاجات الخافتة والظّاهرة"، ومنها ما يجري في غزّة اليوم من الصراع الحضاري لتصدُّر المشهد العالميِّ والرّيادة الحضاريّة لِركْبِ الأمم؛ لأنّ الآخر يُحسُّ إحساسًا فيه نوعٌ من الإفراط، وكأنَّ هذا القرآن قد محَا بقيّة الدّيانات. وهذا التّصوّر الأحاديّ المغلوط للآخر أَسْلَمَ الأستاذَ إلى محاورة سؤال إشكالي ٍّمُهمٍّ هو: ما سبب اختيار اللّغة العربية لتكون حمّالة لمعاني هذا النّصّ دون اللّغات واللّهجات الأخرى؟
وقد حاول تقديمَ معطيات تُزكِّي اختيار اللّغة العربية لغةً حاضنة لهذا النّص، منها خصائصُ متعلقة بالأبنية والصّيغ والترتيب، ومنها التّناغم مع الكون في النّطق والحروف والمعاني، ثم إنّ لغتنا العربيّة لم تعرف مراحل تطوّر (شباب، كُهولة، شيخوخة) كما عرفتْها اللّغاتُ الأخرى التي كانت مهيمنة إبّان نزول الوحي الكريم، وهي اللّغة السّوريانيّة، والعِبريّة، واللّاتينيّة.
وكأنّ القصدَ العامّ، بحسب الأستاذ، هو "جمع شمل الهُويّة الإنسانيّة على قواعدَ موحّدَة"، وقد لفت الأستاذ إلى أنّنا نحن العربَ نظنّ أنّ الآخر سيجد عنتًا في فهم اللّسان العربيّ، ولكنَّ العكس هو الصحيح؛ لأنّ معانيَ العربية عندما تُترجَم إلى لغات إنسانية أخرى تصبح أكثر وضوحًا بالنّسبة لهذه القوميات البرّانيّة عن لغتنا، وآية ذلك هو دخول الكثيرِ من الأعاجم إلى الإسلام بمجرّد قراءتهم للنّصّ القرآنيّ، وهذا مؤشّر على فهمهم له بلغاتهم.
وهنا يعيب الأستاذ على الباحثين العرب أفرادًا ومؤسّساتٍ عدم اهتمامهم بالمناهج لتقريب اللّسان العربي من غير العرب، وأنّنا مُفرِّطون بمسؤوليّتنا الأولى تُجاه الآخرين، وهي مسؤوليّة التّبليغ الذي حثَّ عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُواْ بِهِ﴾ [إبراهيم، من الآية 54]، وعلاقة هذا المعنى، معنى التّبليغ، بحقيقة البلاغة التي هي فهمُ هذا البلاغ، والبلاغ قصدُه العملُ. وقد قسّم علماؤنا العلوم إلى ثلاثةٍ: علمٌ نضج وما احترق (الأصول والنّحو)، علم نضج واحترق (الفقه والحديث)، علم لا نَضَجَ ولا احترقَ (البيان والتفسير).
إنّ القرآن خطابٌ يحتاج منّا إلى التّدبّر، وهذا المعنى موجود في قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ ِليَدَّبَّرُواْ آيَاتِهِ﴾ [ص، من الآية 28 ]؛ فاللّام في (ليدّبّرواْ) لام التّعليل، وهي "اشتراط على القارئ بضرورة التّدبّر"، والتّدبّر في اللّغة: "معرفة أدبار الأشياء ومآلاتها وخواتيمها"، ومن وظائف البلاغة "التّدبّر والتّعمّق في الأسرار والدّلائل" الثاوية في الخطاب القرآنيّ، والتي يجب أن تتحوّل إلى "سلوك عمليّ"؛ لأنّ قارئ القرآن قد تستوقفُه "الغاية الجماليّة"، ولكنّه قد لا ينتبه إلى التّفسير الذي يُعنى بالكشف عن مراد الله، هذا المراد الذي، في الحقيقة، لا يمكن الوصول إليه كلّه. والبلاغ في تقدير الأستاذ هو ما يبلِّغنا إلى أعلى مكانة ممكنة في الوجود الإنسانيّ الذي نتسلّقه من خلال سُلَّمِ القرآن الذي يصنع هُوّيّتَنا، ويُمكِّنُنا بواسطة البلاغة من مواجهة الخطاب المغرِض للآخر.
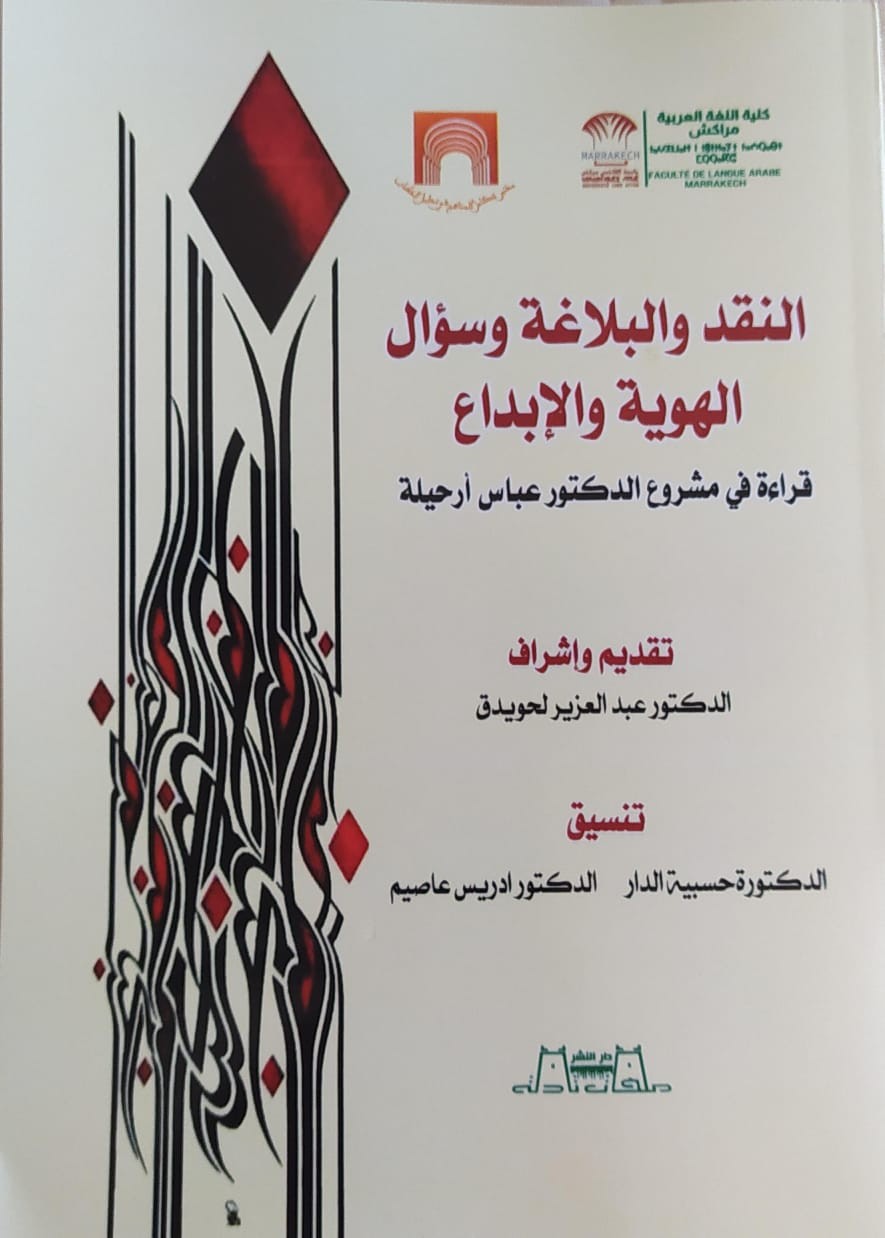

 جانب من المشتركين في ندوة تكريم عباس أرحيلة
جانب من المشتركين في ندوة تكريم عباس أرحيلة 
 جانب من المشتركين في ندوة تكريم عباس أرحيلة
جانب من المشتركين في ندوة تكريم عباس أرحيلة