يكتسي "خطاب" الساسة ببلادنا بين الحين والآخر طابعا حادا يخرجه عن اللياقة التي يقتضيها التسليم بالتعدد والتشبع بثقافة الاختلاف، ويلقي به في أتون ضيقة تسيء للعمل السياسي وتجعل الشباب ينفر منه.
إن هذا يجعل الحديث عن "برامج التنمية" و"النموذج التنموي" و"الانتقال الديمقراطي" وغيرها من التعبيرات التي ظلت تحمل البشائر بأن المستقبل سيكون أحسن من الحاضر تتراجع. كل هذا يشير إلى أن ما شاهدناه ونشاهده من خصومات سياسية، تتخذ طابع الصراع في الكثير من الأحيان، لا تعكس اختلافا في المواقف والأفكار من شأنه أن يرقى بالممارسة السياسية إلى مستوى الخلاف المثمر، الذي يحقق مجتمع التقدم المبني على التسامح، وإنما تنطوي على حقد شخصي، قد يتحول إلى عداء جماعي، يبدأ بعنف لفظي، وقد لا يقف عند هذا الحد.
كل حديث عن البرامج والأفكار التي من شأنها أن تفتح آفاقا للمستقبل تختفي في هذا "الخطاب" لتفسح المجال للغة يجتاحها الإسفاف، قد تحمل أية صفة غير أن تكون لغة سياسية حقيقية: هذا يصف ذاك بأنه ذئب عجوز، وذاك يخون الآخر ويحاول أن يقدمه بوصفه مجرد ميكروب سياسي، وثالث ينبش في ماضي "خصمه" عله يجد فيه ما يسيء إلى شخصه، ورابع يختار لغة الكاريكاتور ليقدم "عدوه" في صورة شيطان يمشي على الأرض.
لو دار هذا العراك الكلامي بين أغلبية حقيقية ومعارضة حقيقية لقلنا إن هذه الملاسنات تعكس تناقضا في الرؤى أسيء تصريفه من قبل هذا الطرف أو ذاك. ولكنه يدور بين مكونات تنتسب بقوة الواقع إلى إجماع على تكريس كل ما يسيئ إلى صورة السياسة وأصحابها.
هكذا بات المواطن يعيش في كل يوم فصول مهزلة فجة تثير من الاشمئزاز أكثر ما تدر من الشفقة، وتشير إلى حالة تضع كل ما له علاقة بالسياسة موضع شبهة. ويبدو المواطن البسيط أمام هذا المشهد حائرا بين "الذئب" وبين "الميكروب". فتتشكل لديه شيئا فشيئا صورة مريبة عن كل ما له علاقة بالسياسة والسياسيين، ويصبح المواطن نفسه ذلك الغائب/الحاضر الذي كان من المفروض أن يشكل محور كل سياسة، يعيش على هامشها.
بمثل هذا الخطاب الذي يتم تسويقه عبر منابر إعلاميا لا تقل انحطاطا وإسفافا "نجح" سياسيونا في احتكار العمل السياسي لأنفسهم، واستطاعوا في زمن قياسي أن يرغموا أفواجا من الشباب على مغادرة "أحزابهم" وتطليق السياسة إلى غير رجعة. فعندما تمارس السياسة دون وازع أخلاقي، فإنها تتحول إلى ساحة للسب والشتم والنبش في الدفاتر القديمة لإسقاط الخصم بالضربة القاضية.
إن هذا المفهوم المغلوط للسياسة كما يمارسها بعض "قادة" الهيئات الحزبية تلحق ضررا كبيرا بالتجربة المغربية التي تظل بحاجة إلى الدعم والرعاية لتجاوز مرحلة الانتقال الديمقراطي الذي طال أمده. ولا يمكن الوصول إلى هذا الهدف في غياب شرطين أساسيين:
الأول يحتم العمل على بناء خطاب سياسي جدير بهذا الاسم. ولا يحق الحديث عن خطاب سياسي إلا إذا كف سياسيونا عن التنابذ بالألقاب وكيل الاتهامات المجانية، وولوا وجوههم نحو التفكير في كل ما يجعل المجتمع متقدما عبر برامج قابلة للتطبيق وأفكار لا تصر على احتكار الحقيقة، بل تبرهن على تعدد أوجهها واختلاف طرق الوصول إليها.
ويفرض الثاني إقناع المواطن بنزاهة ونجاعة العمل السياسي وجعله معنيا بما يدور حوله من أحداث وتدابير، تنعكس على حياته اليومية، في أفق الإيمان بأهمية العمل السياسي ونجاعته والانخراط في فعله.
ومن المستحيل أن يتمكن خطاب "سياسي" يستمر في حفر أخاديد من الحقد المتجدد، ويدأب على إذكاء نار النزاعات الشخصية التي لا تعني سوى أصحابها، من إغراء ذلك المواطن بجدوى السياسة.
إن تتبعا للمشهد السياسي المغربي منذ منتصف السبعينيات إلى الآن، أي منذ بداية الحديث عن التجربة الديمقراطية، يفضي إلى أن هناك اليوم تراجعا كبيرا في نسبة المهتمين بالشأن السياسي، فقد تم تجريد الممارسة السياسية من ضرورتها القصوى باعتبارها وسيلة لتحسين ظروف العيش، وتحولت إلى "عادة سيئة" تنطوي على مخاطر لا علاقة لها بصيرورة المجتمع، وتجرد العمل السياسي من طبيعته كفعل نبيل يساهم في تطور المجتمع. وهذا ما يفسر غياب الفكر الاستراتيجي الذي يستشرف المستقبل، وتغييب المثقف المغربي عن النقاش السياسي العمومي أي تحييد العقل، وهيمنة اليومي والعادي على لقاءات الساسة وندواتهم.
إن هذا قد يصيب العمل السياسي بالعقم، لأنه لا يؤدي إلى إبداع أفكار جديدة تساير تطور المجتمع، ولأنه تخلى عن كل ما هو عقلاني مفكر فيه. لذلك فإنه يؤدي إلى نتيجة واحدة: الكف عن إنتاج نخب جديدة باستطاعتها قيادة المجتمع نحو الأفضل.

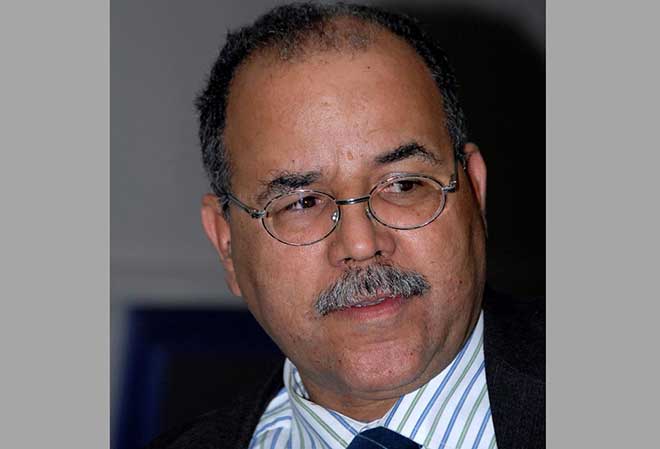 حسن مخافي
حسن مخافي 
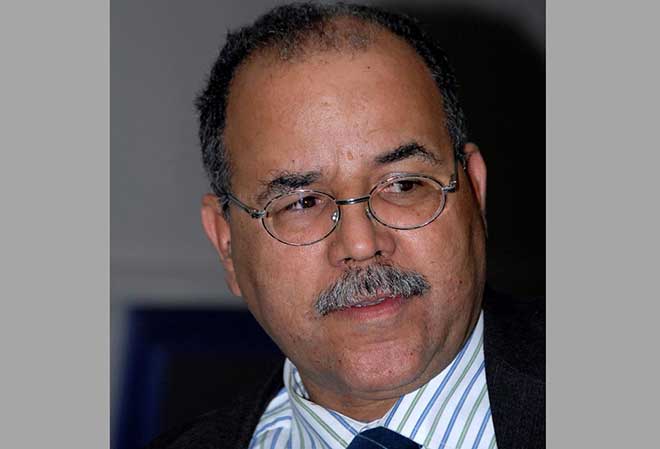 حسن مخافي
حسن مخافي