التجديد l'innovation هو الإتيان بالجديد. وحياة الإنسان نفسُها، إن لم تتجدَّد، تدخل في مرحلة الرتابة la routine. بمعنى إن تكرَّرت، في الحياة اليومية، نفسُ الأفكار ونفس السلوكات ونفس الأفعال ونفس ردود الأفعال… قد تصبح هذه الحياةُ ميكانيكيةً وقد تقود إلى تجميد الفكر وإلى الانغلاق في عالَمٍ سِيمتُه الأساسية هي الجمود والدَّوران في حلقة مفرغة un cercle vicieux. وقد يقِلُّ الاهتمامُ بالأشياء المحيطة بالإنسان، ويزداد التّسويف la procrastination، أي تأجيل الأعمال المفيدة إلى وقتٍ لاحق. أما إذا أصبحت الرتابةُ عادةً، فكل جديدٍ أو تجديدٍ يصبح مُقلِقاً angoissant إن لم نقل مُخيفاً effrayant.
ولهذا، فحياة البشر، بمعناها الواسع، أي الحياة اليومية بجميع تجلِّياتها الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، إن لم يتخلَّلْها التَّجديد، من حينٍ لآخر، فقد تُعيق السَّيرَ إلى الأمام l'avancement، إن لم نقل تُعيق التَّقدُّم le progrès.
ولهذا، من الضروري، أن يُصبحَ التَّجديد شعاراً في حياة الناس، على المستوى الفردي والجماعي وحتى على مستوى الدُّول. وبعبارة أخرى، كلُّ العوالم، فرادى وجماعاتٍ ودولاً، في حاجة ماسة إلى التجديد، وإلا فمحكومٌ عليها بالجمود، إن لم نقل بالاختفاء. فكل جهة تجد ضالَّتَها وتقدُّمَها وتطوُّرها في التَّجديد.
بالنسبة لعالَم المعرفة، مصدر التَّجديد هو البحث العلمي la recherche scientifique. والبحث العلمي، سواءً تمَّ داخلَ المختبرات أو خارجها، إن لم يُفرز معارفَ جديدةً، أي إن لم يأتِ بالجديد la nouveauté، فهو مضيعةٌ للجُهد البشري والوقت والمال. والحقيقة أن جلَّ الأبحاث، إذا كانت مرتبطةً بالواقع الاجتماعي والاقتصادي، على الخصوص، تأتي دائما بالجديد. والدليل على ذلك، الحجم (الرصيد) الهائل من المعارف العلمية التي راكمها البحث العلمي منذ القرن الثامن عشر، وخصوصا، خلالَ القرنين العشرين والواحد والعشرين.
بالنسبة لعالَم المقاولات، التَّجديدُ قيمة مُضافة أساسية وحاسمة لدرجة أن التجديد أصبح شعاراً يرتبط به استمرارُ المقاولات في البقاء أو الحكم عليها بالانقراض. وهذا الشِّعار هو innover ou disparaître، أي أن أيةَ مقاولة، إن لم يكن التَّجديدُ شعارا لها فمحكوم عليها بالإفلاس la faillite أو بالاختفاء la disparition. لماذا؟
لأن أيةَ مقاولةٍ لا تجدِّد أساليبَ تنظيمها organisation وأساليب les procédés إنتاجِها وأساليب تسويق marketing مُنتجاتِها ses produits أو أساليب ترويج خدماتها، لن تستطيعَ مواجهة المنافسة la compétitivité أو la concurrence.
وبصفة عامة، كلُّ المجتمعات والبلدان، إن لم تُساير التَّجديد الذي تُنتِجه العقول البشرية في مختلف مناطق العالم، وتتبنَّاه وتُدمِجه في أساليب تفكيرها وتنظيمها، محكومٌ عليها بالتَّخلُّف sous-développement وبالتبعية la dépendance. وقد يزداد هذا التَّخلُّفُ حجما وتتفاقم التّبعِيةُ إثرَ الطَّفرات التي سيُحدِثها الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات الفكر والعمل.
وما يُثِير الدهشةَ والاستغرابَ هو أن جميعَ العلوم الدنيوية، الإنسانية منها والدقيقة، تغيَّرت وتطوَّرت وتقدَّمت، بل منها ما حقَّق نهضةً لم تعرف البشريةُ مثلَها منذ وجودها على سطح الأرض. إلا ما يُسمِّيه علماءُ وفقهاء الدين، الحاليون، على الخصوص، "العلوم الدينية" لم يطرأ عليها أي تغييرٍ منذ ما يزيد عن 12 قرنا! علما أنها، مثلُها مثل العلوم الدنيوية، إنتاجٌ أفرزته العقول البشرية! بمعنى أن الدينَ الوارِدَ في القرآن الكريم لا يتغيَّر ولن يتغيَّر، مصداقا لقولِه، سبحانه وتعالى، في الآية رقم 3 من سورة المائدة : "...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ ... نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا… ولهذا، ما يُسمِّيه علماءُ وفقهاءُ الدين علوماً دينِيةً، ليس إلا ما استطاع العقلُ البشري فَهمَه للدين الوارد في القرآن الكريم، وهو دينٌ أكملَه، سبحانه وتعالى، قبل وفاة الرسول (ص).
وكأن العقولَ البشريةَ التي أنتجت هذه العلوم الدينية، تعيش خارجَ الزمان والمكان أو تعيش في زمانٍ ومكانٍ مستقلَّين عن الواقع الذي يحيا فيه الناس. وكأن العلوم الدينية علومٌ مطلقةٌ صالِحة لكل زمان ومكان.
قد يقول قائلُ إن الإنتاجَ الفكري الذي جاد به علماءُ وفقهاءُ الدين، مُقيَّد بالقرآن الكريم الذي أنزله الله، سبحانه وتعالى، على آخِرِ الرسل والأنبياء، محمد (ص).
أُجيبُ وأقول : هذا ليس مبرِّر، على الإطلاق. لماذا؟ لأنه، لو كان للقرآن الكريم تفسيرٌ واحدٌ و وحيد، لقام به الرسول (ص). لكنه لم يفعل. وقد فعله كثيرٌ من علماء وفقهاء الدين بعد وفاته، وهم كُثُرٌ. وكل واحد منهم فسَّر القرآن حسب ما كان يتوفَّر عليه من خلفياتٍ فكرية، اجتماعية وثقافية!
ألا يجدر بنا، نحن البشر المعاصرون، أن نفسِّرَ القرآن من جديدٍ، حسب ما تُمليه علينا خلفياتُنا الفكرية، الاجتماعية والثقافية؟ علما أن خلفياتنا هذه أحسن بكثيرٍ من خلفيات علماء وفقهاء الدين القدامى!.

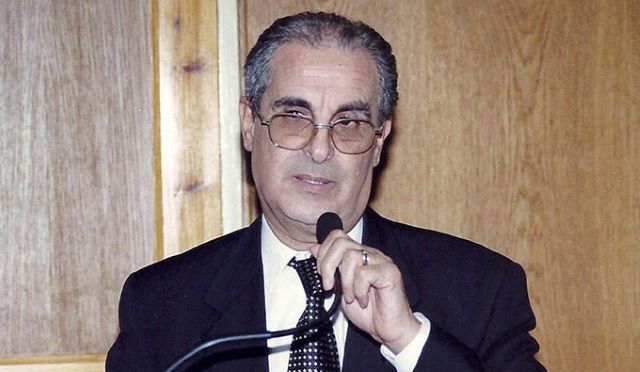 أحمد الحطاب
أحمد الحطاب 
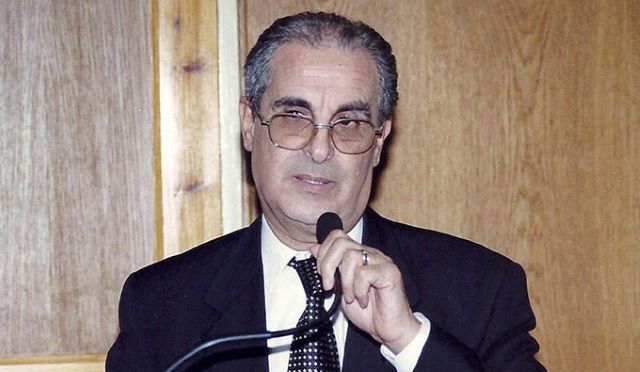 أحمد الحطاب
أحمد الحطاب