لم يعرف عصرٌ من العصور انتشارًا لمصطلح «التنمية الذاتية » كما نعرفه اليوم. فكل من يتصفح مواقع التواصل سيواجه طوفانا من «المدرّبين» الذين يقدّمون أنفسهم بوصفهم مرشدين إلى النجاح، وحمَلة أسرار السعادة، وأصحاب المفاتيح السحرية التي ما إن يتلقّاها الإنسان حتى يعيد تشكيل حياته. هذا الانتشار اللافت لا يعبّر فقط عن موضة فكرية، بل عن خللٍ عميق في علاقتنا بالمعرفة وبالذات، وعن عطش وجودي تم تحويله بمهارة إلى سوق مزدهرة. ما الذي يجعل خطابًا كهذا بكل هشاشته قادرًا على أن يكتسح حياة الناس؟ ولماذا يستسلم كثيرون لسحره، رغم خلوّه من أي سند علمي أو فلسفي متين؟
ولادة الخطاب على أنقاض المعنى.
انبثق خطاب التنمية الذاتية في لحظة تاريخية انحسرت فيها المرجعيات الكبرى وفقدت قوتها. فلم تعد الفلسفة تقدم أجوبة جاهزة، وتراجع دور الدين كموحد مركزي في الحياة العامة، ولم تعد الجماعة تمنح الفرد شعورًا بالانتماء. في ظلّ هذا الفراغ الروحي والمعرفي، يجد الفرد نفسه معلقًا بين رغبة في تحقيق ذاته وشعور طاغٍ بالضياع والقلق الوجودي. هنا بالضبط يظهر «المدرّب» ليلعب دور «المخلّص»، مقدّمًا ما يشبه اليقين السريع؛ يقين يُباع في ورشات ودورات، ويُقدّم على شكل وصفات مُطمئنة تهدف إلى إيهام الفرد بالقدرة على السيطرة التامة في عالم لا يكفّ عن الانهيار. إنه خطاب يزدهر في اللحظة التي يتراجع فيها التفكير العميق؛ فكلما خفت صوت التأمل النقدي، اتسعت مساحة البائعين الجدد للمعنى.
خلطة العلم الزائف
يُفترض أن أي معرفة تُبنى على أساس ومنهج وتجريب ومفاهيم واضحة. غير أن ما يسوّقه أغلب مدربي التنمية الذاتية هو « تلفيق معرفي » يجمع بين فتات الحقائق العلمية والخيال الجامح. هم يستعيرون قشور علم النفس الإيجابي بعد نزع صبغته السريرية، ويخلطونها بتأويلات محرفة لمفاهيم فيزيائية معقدة، لتخرج لنا مصطلحات رنانة مثل: « تنظيف الطاقة» و «برمجة اللاوعي»، و «رفع الذبذبات»، و«قانون الجذب». هذه المفردات تقوم على توهيم لغوي يجعل المتلقي يظنّ أنه أمام معرفة عميقة مدعومة بفيزياء الكم أو علوم الأعصاب، بينما هو في الحقيقة أمام استعارات لا تصلح لأي نوع من التحليل. فكيف تُصلح النفس أو تغيّر الواقع؟ الخطورة هنا ليست في الركاكة العلمية فحسب، بل في تقديم هذه الأوهام كحقائق نهائية تغني عن علم النفس الحقيقي، الذي يتطلب شجاعة مواجهة الذات لا تخديرها بعبارات التحفيز. وهو مشهد يستحضر بصيرة ابن خلدون؛ إذ في أزمنة الانحطاط وشيخوخة العمران، يكثر المنجمون والمدّعون، فيملؤون الفراغ الذي يخلفه العلماء والحكماء.
المسرح الكبير: صناعة نبيّ العصر
ما يجعل خطاب التنمية الذاتية جذّابًا ليس مضمونه بل » المشهدية» (Spectacle) التي يغلف بها. إنها تقوم على أداء مسرحي متقن. مدرب ذو حضور مدروس ولغة جسد موحية ونبرة صوت متحكمة. إن المشهد أقرب إلى طقس ديني حديث منه إلى لقاء معرفي. فالجمهور يدخل القاعة مُحمَّلًا بتوقّع الخلاص، فينفتح على أي خطاب يَعِدُه بالمعنى، مهما كان هشًا. والمدرّب لا يُقنع بالحجة، بل بالإيقاع والكاريزما؛ ولا يقدّم معرفة، وإنما يقدم »نموذجاً » للنجاح والثراء يُسقط عليه الجمهور رغباته المكبوتة. هكذا يتحول المدرب إلى ما يشبه «نبيّ العصر» الذي يبشّر بالخلاص الدنيوي، لكنه خلاص مشروط بشراء دورة جديدة. إنها علاقة قائمة على الإذعان العاطفي، تجعل الجمهور يتماهى مع صورة مثالية للكمال لا وجود لها خارج قاعات التدريب.
اقتصاد القلق: الجرح النفسي كسلعة
وراء كل خطاب وهمي توجد بنية اقتصادية صلبة. فالتنمية الذاتية ليست مجرد أفكار، بل هي صناعة ضخمة (Industrie) تقتات على هشاشة الإنسان. تقوم هذه السوق على معادلة رأسمالية قاسية كلما ازداد خوف الإنسان وقلقه، ازداد استعداده للدفع بحثًا عن وهم الأمان. لا يقدم المدرب هنا حلولًا جذرية، بل يعيد إنتاج الحاجة إلى مزيد من الحلول، في حلقة مفرغة لا تنتهي. إنه اقتصاد يحول الهشاشة إلى سلعة، والقلق إلى فرصة ربح، والرغبة في السعادة إلى مصدر دخل مستدام. هذا هو الوجه الأكثر قسوة في الرأسمالية المعاصرة: تحويل العواطف والمخاوف إلى سلع قابلة للتداول. وهذا لا يعني أن كل من يعمل في هذا المجال متلاعب، بل إن البنية نفسها تُنتج منطقًا تجاريًا يتجاوز نوايا الأفراد.
حينما يصير عبء البنى الاجتماعية والاقتصادية خطيئة شخصية
إن أيّ حديث عن «النجاح» أو «تحقيق الذات» يصبح بلا معنى حين يُنتزع الفرد من شروطه التاريخية ومن محيطه الاجتماعي والاقتصادي. فالفرد لا يولد في فراغ، بل يوجد داخل شبكة من المحددات: كالطبقة التي وُلد فيها، ومستوى التعليم المتاح له، وطبيعة البنية الاقتصادية، وأشكال السلطة التي تَصوغ مسارات الحياة. هنا تحديدًا يتهاوى خطاب التنمية الذاتية، لأنه يفترض وجود فرد مطلق، معزول عن تاريخه وطبقته ومجتمعه، قادر على إعادة تشكيل مصيره بتمارين تحفيزية أو «عادات» جاهزة.
ومن أخطر ما أنتجته هذه الصناعة المعاصرة ما يُعرف بـ « الإيجابية السامة» (positivité toxique)، وهي الفكرة المحورية في الإيديولوجيا النيوليبرالية الجديدة: «أنت وحدك المسؤول عن واقعك، وظروفك هي انعكاس أفكارك». فكرة تبدو تحفيزية في ظاهرها، لكنها في العمق تبسيط عنيف لتجربة الإنسان. فهي تُجبر الفرد على إنكار مشاعر الألم والحزن الطبيعية، وتُوهمه بأن الفقر والظلم الاجتماعي والهشاشة البنيوية ليست سوى «ذبذبات سلبية» استحضرها بنفسه. وبذلك تُصادَر حقيقة البنى الاجتماعية والاقتصادية، ويُحمَّل الفرد عبء العالم كله، ليغدو فشله في النهاية «خطيئة شخصية» لا علاقة لها بالاقتصاد أو الدولة أو التاريخ.
إن الشروط الموضوعية — بما تتضمنه من لا مساواة بنيوية، وثقل للإرث العائلي، وتفاوتات تعليمية واقتصادية — ليست تفاصيل جانبية، بل هي المسرح الكامل الذي يُمارس فيه الإنسان أفعاله ويُبنى فيه مساره. لذلك يبدو عبثيًا إقناع شاب وُلد في هامش حضري بلا مؤسسات قوية، وفي اقتصاد قائم على الهشاشة، بأن مشكلته تكمن في «ضعف الدافع» أو «خلل في الذكاء العاطفي». فإقصاء هذه المحددات البنيوية هو ما يجعل خطاب التنمية الذاتية خطابًا أيديولوجيًا بامتياز، يحوّل ما هو بنيوي إلى فردي، وما هو تاريخي إلى نفسي، وما هو سياسي إلى سلوكي. وهنا تتجلى الخدعة الكبرى لخطاب يعد الفرد بالتحرر والسيادة، لكنه في الجوهر يُغرقه في شعور دائم بالذنب والنقص، ويجعله يلوم نفسه على ما لم يكن له أن يتحكم فيه أصلًا.
المفارقة: مبشرون بما لا يعيشونه.
إن االمفارقة الجوهرية في خطابات التنمية الذاتية ليست فقط أن أغلب مبشّريها لا يعيشون ما يدعون إليه، بل إنهم، في العمق، ضحايا للمنطق نفسه الذي يروّجون له. فالمدرّب الذي يعتلي منصات اللايف ويعد الناس بـ«السيطرة على المصير» ليس سوى قطعة غيار صغيرة داخل آلة ضخمة تُعيد تشكيل العقول في زمن البث المباشر. إنهم أفراد يظنون أنفسهم أحرارًا، بينما هم في الحقيقة مجرّد ناقلين لخطاب عالمي محكم البناء، صُمّم بعناية ليُحوِّل المشاعر الإنسانية إلى رأسمال، ويحوِّل القلق إلى فرصة تسويقية، ويحوِّل هشاشة الأفراد إلى سوق لا تنضب. فالمدرّب، تمامًا مثل المتلقي، يعيش تحت ضغط العصر نفسه. إنه عصر يطالبك بأن تكون دائمًا «في أفضل نسخة منك»، عصر يفرض عليك الحضور المستمر في اللايف، والابتسام المتواصل، والحديث بنبرة المنتصر حتى لو كنتَ غارقًا في الهشاشة. وهكذا يتحول هو أيضًا إلى ذات مُستنزَفة، تُعيد إنتاج أوهام القوة لأنها لا تملك رفاهية الاعتراف بضعفها. إنه لا يبشّر بما يعيش، بل بما يُطلب منه أن يعيشه ظاهرًا؛ وما يقدّمه للآخرين ليس خلاصًا، بل امتدادًا لخطاب لا يترك لأحد خيارًا: كن إيجابيًا وإلا أصبحت عاطلًا عن القيمة. هكذا يتواطأ المدرّب، دون وعي في الغالب، مع منظومة أشمل تنكر الواقع المادي، وتُفرغ التجربة الإنسانية من تعقيدها، وتحوّل الوجود إلى مشروع تسويقي مستمر، لا يحتمل لحظة صمت أو هشاشة أو سؤال.
ما بعد التخدير: الشجاعة المعرفية كبديل وجودي.
ليست خطورة التنمية الذاتية في زيف مضمونها وحده، بل في كونها مُخدراً فعالاً يملأ الفراغ الذي خلفه الفكر النقدي. حين يتراجع العقل، ويخفت صوت الفلسفة، ويتعثر الإنسان في مواجهة ذاته بصدق، يجد هذا الخطاب السهل طريقه إلى الوعي، ويحوّل هشاشة الإنسان إلى سلعة قابلة للاستهلاك. إن الإنسان المعاصر لا يحتاج إلى مزيد من الأوهام المريحة، ولا إلى وسطاء يبيعون له اليقين المعلّب، بل يحتاج إلى شجاعة معرفية تُؤسّس لموقف وجودي بديل. هذه الشجاعة تتطلب أمرين متوازيين:
أولاً، الاستسلام الواعي للغموض. يجب أن نتصالح مع حقيقة أن الحياة ليست مشروعاً هندسياً يمكن التحكم فيه بقانون واحد، بل هي تجربة إنسانية معقدة ومفتوحة، حيث يُعتبر الحزن والشك والقلق إشارات ضرورية لفهم الواقع، لا ذبذبات سلبية يجب محوها. إن إعادة أنسنة المشاعر، وفهمها كجزء من تجربة الوجود، هي خطوة أولى نحو مواجهة العالم بوعي، لا بوهم السيطرة.
ثانياً، إعادة توجيه القلق. إن الشجاعة المعرفية تعني إدراك أن عبء اللامساواة وثقل الظروف الاقتصادية ليسا «خطيئة شخصية»، بل واقع بنيوي وتاريخي يتطلب تحليلًا نقديًا وموقفًا جماعيًا. إنها دعوة لتفكيك الآليات التي تُحوّل هشاشة الأفراد إلى فرص سوقية، وفهم أبعاد الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل مساراتنا.
بهذه الشجاعة، يمكن للفرد أن يتحرر من وهم الوصفة الجاهزة، ويبدأ في بناء معنى حقيقي للحياة: معنى لا يُشترى في دورة تدريبية، بل يُكتشف عبر شجاعة السؤال النقدي، وعمق التجربة الإنسانية، ووعي العيش ضمن حدود الواقع المعقد. إنها خطوة نحو وعي متكامل، حيث لا يصبح الإنسان متلقيًا سلبيًا، وإنما مراقبًا واعيًا، قادرًا على مواجهة هشاشته، وفهم العالم كما هو، لا كما يصوّره خطاب اليقين المعلّب.

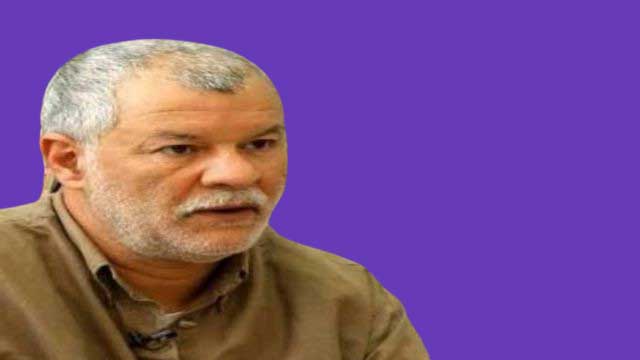 عثمان بن شقرون
عثمان بن شقرون 
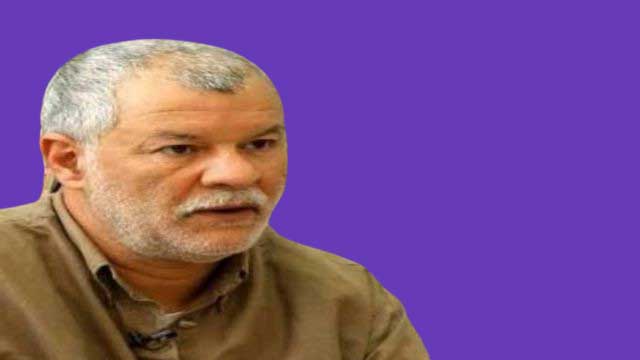 عثمان بن شقرون
عثمان بن شقرون