
غيات: المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالطرق البحرية الجديدة طريق البحر الشمالي
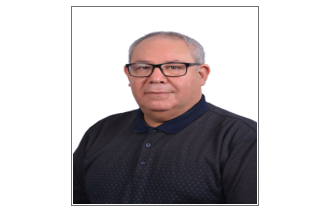 عبد الواحد غيات
عبد الواحد غيات 
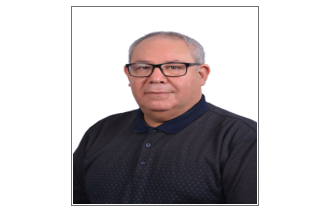 عبد الواحد غيات
عبد الواحد غيات اختصار واعد... لكنه محل نزاع
مع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وذوبان الجليد البحري، ازداد الاهتمام الدولي بالقطب الشمالي، لا سيما في ظل إمكانية بقاء ممرات مائية شبه خالية من الجليد لفترات أطول خلال العام. وتُعزز هذه الظاهرة، إلى جانب التقدم التكنولوجي في مجالات التنقيب والإنتاج ، من الجدوى الاقتصادية لاستغلال موارد الجرف القاري. ونتيجة لذلك، تزايدت المنافسة بين الدول المعنية للسيطرة على الموارد الطبيعية ومسارات النقل، ويُعد طريق البحر الشمالي في هذا السياق من أبرز الطرق الواعدة، نظرًا لموقعه الجغرافي واختصاره للمسافات بين آسيا وأوروبا.الذي
تتمثل أبرز التحديات الجيوسياسية التي تواجه روسيا في مساعي بعض القوى الدولية لفصل هذا الطريق عن السيطرة الوطنية الروسية، والدفع نحو وضعه تحت إشراف دولي أو سيطرة قوى كبرى، بحجة ضمان حرية الملاحة ومنع الاحتكار الوطني. ويُثير ذلك مخاوف جدية بشأن قدرة روسيا على تنفيذ خطة تطوير الطريق حتى عام 2035 ، لا سيما في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وتراجع الطلب العالمي المتوقع على الهيدروكربونات، وصعوبات جذب الاستثمارات وتكوين قاعدة شحن مستقرة.
وفي هذا السياق، يُعد الوضع القانوني للقطب الشمالي مسألة خلافية، إذ تختلف المقاربات القانونية لتحديد حقوق الدول في هذه المنطقة. فقد عمدت الدول المطلة إلى تقسيم المحيط المتجمد الشمالي إلى قطاعات قطبية، تعتبر كل دولة أنها تملك السيادة على المساحات داخل قطاعها، بما يشمل الأراضي والجزر والمياه الجليدية. وكانت كندا أول من أعلن عن هذه السيادة عام 1909، تلتها روسيا (الاتحاد السوفييتي سابقًا) بمبادرة مماثلة عام 1926، هدفت إلى استثناء هذه المناطق من القواعد العامة للقانون البحري الدولي.
روسيا في الصف الأول
وترى روسيا أن هناك عرفًا دوليًا قد تشكل منذ عشرينيات القرن الماضي يدعم مبدأ "التقسيم القطاعي"، وتستند إليه لتأكيد حقوقها، خاصة وأن نحو 60% من موارد القطب الشمالي تقع ضمن مناطق تطالب بها أو تسيطر عليها. ومع ذلك، فإن قسوة البيئة القطبية والتعقيدات الفنية والمالية للاستثمار تجعل التعاون الدولي شبه حتمي، حتى مع تمسك روسيا بمواقفها السيادية.
وفي ظل هذه المعطيات، بات القطب الشمالي يشكّل نقطة ارتكاز جديدة في التفاعلات الدولية، ويزداد دوره في معادلات التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى، خاصة مع بروز تحديات متشابكة تتعلق بالبيئة، والطاقة، والأمن، والسيادة.
يُعد طريق البحر الشمالي أحد المسارات البحرية الواعدة في عالم النقل البحري، نظرًا لموقعه الجغرافي وارتباطه بالتحولات المناخية والتنافس الجيوسياسي المتصاعد في منطقة القطب الشمالي. وقد أصبح هذا الطريق محورًا مهمًا في الاستراتيجيات الوطنية الروسية، مدعومًا بهيئات ومؤسسات أبرزها "صندوق تطوير طريق البحر الشمالي"، الذي يُعد الهيكل المؤسسي الرئيس للمشاريع ذات الصلة، ويشارك في المبادرات الدولية مثل مشروع INSROP، كما نفّذ منذ أوائل الألفية الثانية المرحلة الثانية من برنامج JANSROP، الذي ركز على تطوير الجزء الشرقي من الطريق، وسيبيريا، والشرق الأقصى الروسي.
لعبة تأثيرات عالمية
تزايد اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمنطقة القطبية نتيجة تصاعد المنافسة الدولية حول الموارد الطبيعية. أما الولايات المتحدة، رغم كونها من الدول الخمس المطلة على القطب الشمالي، فهي لا تعترف بمبدأ التقسيم القطاعي، وتعتبر أن لروسيا وكندا فقط حقوقًا في الشريط الساحلي بعرض 12 ميلاً بحريًا، وتتعامل مع الطريقين، الشمالي الغربي والبحري الشمالي، كممرات دولية. كما ترى واشنطن أن محاولات الصين لتوسيع دورها في القطب الشمالي تمثل تهديدًا استراتيجيًا.
بموجب تصديق روسيا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فقدت فعليًا سيادتها على نحو 1.7 مليون كيلومتر مربع من مياه المحيط المتجمد الشمالي. هذه النقطة أثارت مخاوف دولية، حيث عبّرت كندا، في تصريحات رسمية عام 2014، عن استعدادها لاستخدام القوة لحماية مصالحها في القطب الشمالي، مبدية قلقها من تزايد النشاط الروسي في المنطقة. كما أجرت كندا والولايات المتحدة أبحاثًا مشتركة لإثبات امتداد رفهما القاري إلى حافة لومونوسوف، ما يؤكد التنافس الحاد على ترسيم الحدود البحرية.
يُعد عدم حسم الوضع القانوني للقطب الشمالي عاملًا رئيسيًا في تصاعد التوترات، مما يعزز احتمالات نشوب صراعات بين الدول القطبية بشأن حدود الجرف القاري، أو بين الدول غير القطبية الراغبة في الوصول إلى الموارد وضمان حرية الملاحة، مما ينعكس سلبًا على مستقبل مشروع تطوير طريق البحر الشمالي.
يُعتبر هذا الطريق أقصر مسار بحري يربط أوروبا بآسيا، ويمتد من مضيق كارا إلى خليج بروفيدينيا بطول يقارب 5600 كيلومتر. ويعود تاريخه إلى محاولات استكشافية بدأت في القرن السادس عشر، في حين شهد القرن العشرون بداية الاستغلال المنهجي للمسار. يربط الطريق بين موانئ الشمال الروسي ويُعدّ شريانًا مهمًا لنقل البضائع.
ترى دول غير قطبية مثل الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، وفنلندا أن سياسة "الاحتكار القطبي" تُقوّض فرص التعاون الدولي وتُعيق استغلال الموارد. تدعو هذه الدول إلى اعتبار القطب الشمالي إرثًا مشتركًا للبشرية، يجب استغلاله ضمن أطر دولية منصفة. وقد أصدرت الصين عام 2018 "الكتاب الأبيض" بشأن سياستها في القطب الشمالي، وأطلقت خطة لتطوير "طريق الحرير القطبي"، تشمل الاستكشاف، الاستخراج، وبناء كاسحات جليد. أما اليابان، فتُركّز على الطاقة والنقل، وتسعى لترسيخ موقعها كفاعل علمي وتقني رئيسي في المنطقة.
مستقبل غير مؤكد... وطريق محفوف بالمخاطر
في ظل هذا المشهد المعقد، يبقى طريق البحر الشمالي نقطة التقاء للمصالح الجيوسياسية والاقتصادية والعلمية، ويُتوقع أن يزداد دوره أهمية في ظل التغيرات المناخية والتحولات الاستراتيجية العالمية.
بالنظر إلى الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها القطب الشمالي، تسعى الدول الواقعة شمال الدائرة القطبية إلى ترسيخ نفوذها في هذه المنطقة، انطلاقًا من رغبتها في تحقيق الهيمنة الاقتصادية وتعزيز مكانتها الجيوسياسية. وتتصدر روسيا وكندا قائمة الدول التي تطالب بسيطرة حصرية على الممرات البحرية الاستراتيجية؛ فروسيا تؤكد على أحقّيتها في الطريق البحري الشمالي، بينما تصر كندا على سيادتها على ممر الشمال الغربي، استنادًا إلى مفهوم "التقسيم القطاعي" الذي يقضي برسم حدود بحرية تمتد من أقصى نقاط السواحل نحو القطب، بما يمنح هذه الدول سيطرة على مناطق واسعة من المحيط المتجمد الشمالي.
وفي حين تتفق كندا مع روسيا في رؤيتها للتقسيم القطاعي، تعارض الولايات المتحدة هذا المفهوم بشدة، معتبرة أنه يحدّ من فرصها الاقتصادية ويضعف موقعها العسكري في المنطقة. أما النرويج والدنمارك فتقترحان تقسيمًا قائمًا على خط المنتصف، ما قد يمنح الدنمارك موقعًا متميزًا في قلب القطب إذا تم اعتماده. غير أن غياب اتفاق دولي ملزم لتحديد الحدود البحرية في القطب الشمالي يعقّد المشهد ويزيد من احتمالات النزاع.
من جهة أخرى، يكتسب سيناريو تدويل القطب الشمالي زخمًا متزايدًا، إذ تروّج بعض الدول الكبرى والمؤسسات الدولية لفكرة أن موارد القطب الشمالي تمثل "إرثًا مشتركًا للبشرية"، ويجب أن تتاح فرصة استغلالها لجميع الأطراف القادرة على الاستثمار التكنولوجي والمالي. هذا التوجه يلقى دعمًا من أطراف مثل الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، الاتحاد الأوروبي، وحتى حلف الناتو، لكنه يواجه مقاومة شديدة من الدول القطبية التي تضع مصالحها الوطنية في المقام الأول.
ويُثير غياب إطار قانوني واضح لتنظيم المطالبات الإقليمية في القطب الشمالي مخاوف من اندلاع صراعات مسلحة على خلفية إعادة ترسيم الحدود. وتتفاقم هذه المخاوف مع زيادة النشاط الصيني في المنطقة، حيث تشير بعض المنشورات الصينية إلى استعداد محتمل لاستخدام القوة العسكرية لضمان الوصول إلى الموارد القطبية، خاصة في ظل الطلب المتزايد داخل الصين على الطاقة والموارد الطبيعية.
أما روسيا، فرغم أن السيناريو القائم على السيطرة الوطنية يناسب طموحاتها، إلا أن قدرتها على فرض رؤيتها تتقلص بسبب العقوبات الغربية والضغوط الاقتصادية الناتجة عن انخراطها في صراعات إقليمية، مما أدى إلى تراجع أدواتها الدبلوماسية والعسكرية في المنطقة. كما أن توجه الصين لبناء أسطول كاسحات جليد واستثمارها في البنية التحتية البحرية يعكس ميلها نحو تدويل الطرق البحرية، وليس دعم السيطرة الروسية.
في ظل هذه المعطيات، تجد روسيا نفسها أمام تحديات متزايدة تتطلب إعادة تقييم استراتيجيتها في القطب الشمالي، من خلال تطوير مشاريع أكثر مرونة وتأمين مسارات بديلة لنقل الموارد، تكون أقل تعرضًا للقيود الدولية، وأكثر توافقًا مع الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة.