ليس غريبا أن يقف "طوطو" على منصة السويسي، وليس غريبا أن يسبقه جمهور من كل الطبقات، من المحجبات إلى العاريات، من أبناء الهوامش إلى أبناء "الفيلاّت"، من المقهورين إلى المستفيدين، من ضحايا المنظومة إلى بعض من بناها وراكم أرباحها.
ما يُثير الدهشة حقا ليس صعود هذا "الفنان" إلى أعلى مراتب الاحتفاء، بل هو النزول الجماعي إلى قاع الوعي، والانخراط الطوعي في طقوس الفرجة التي تُعيد إنتاج نفس المنظومة التي تدعي الجماهير التمرد عليها. طوطو، هنا، ليس فرداً، بل تجلٍّ حيٌّ للانهيار الثقافي الممنهج، تجلٍّ لهزيمة المشروع التحرري، وتشظي المعنى في مجتمعات استُلب منها كل أمل.
حين يحج عشرات الآلاف، في قيظ الرباط القاسي، للاستماع إلى شاعر التفاهة الجديد، فإننا لا نكون أمام ظاهرة فنية، بل أمام تعبير سوسيولوجي عن إفلاس جماعي، عن حاجة إلى تعويض رمزي عن انسداد الأفق السياسي والاجتماعي. فالجمهور، بتعدده الطبقي وتنوعه الاجتماعي، لم يذهب ليسمع موسيقى أو كلمات، بل ذهب ليعيش لحظة "انعتاق مؤقت"، لحظة وهم كاذب بـ"التمرد"، لحظة يصفق فيها للوقاحة لأنها صارت شكلاً من أشكال "التحرر" في غياب أي مشروع فعلي للتحرر الجماعي.
اليسار المهزوم، الذي ترك الساحة فارغة لمثل هذه الأصوات، هو ذاته الذي فشل في أن يصوغ خطاباً فنياً بديلاً، فترك "القصائد" لكتّاب الشارع، و"الثقافة" لتجار الوعي، و"التمرد" لمن يتقن رفع "الوسطى" كخطاب جماهيري. إن طوطو ليس نتاجاً للشارع كما يحب البعض أن يوهمنا، بل هو منتوج المؤسسة الليبرالية، التي احتوت عنفه وحولته إلى منتج قابل للاستهلاك، مغلف بكلمات بذيئة وصورة مارقة، لكنه في العمق لا يزعج شيئاً، ولا يهدد شيئاً. إن طوطو هو ابن موازين بامتياز، ابن هذا النظام الذي يعرف جيداً كيف يروض حتى أكثر الأصوات "المنفلتة"، فيجعلها سلعة، مهرجاناً، منصة، "gold ticket"، ويبيعها للجميع بنفس التسعيرة.
منهج التحليل النقدي يعلمنا ألا نقف عند الظاهرة، بل نقرأ ما وراءها، نغوص في بنيتها العميقة، ونسأل: من يحتفل بطوطو؟ ولماذا؟ وكيف تم إنتاج هذه "الظاهرة"؟ الجواب ليس في سويسي، بل في المدارس التي لم تعد تنتج وعيا، في البيوت التي هجرتها الحكايات الجماعية، في الشوارع التي تحولت إلى ساحات استهلاك بدل أن تكون ساحات احتجاج، في الشاشات التي تصنع الأذواق، وفي السياسات التي تمعن في تدمير كل أفق جماعي.
حين يكون أول مغربي يغني على منصة السويسي منذ 25 سنة هو من يرفع شعار "ما لاعبش"، فالمفارقة تكتمل: هو لا يلعب فعلا، هو يمارس دورا جادا في اللعبة الكبرى لإعادة تشكيل الذوق العام وفق منطق السوق، هو كائن تم تسويقه ببراعة ليملأ الفراغ الروحي الذي خلفه انسحاب النخبة، وانكفاء اليسار، وصمت المؤسسة. لا غرابة أن تتقاطع عنده المحجبات مع العاريات، لأن الخطاب فقد معناه، وتماهى الكل في مهرجان الفُرجة، حيث لا مكان للأسئلة، بل فقط للرقص.
والجمهور، هذا الجمهور "المتشظي طبقياً"، الذي نحار في فهم دوافعه، ليس جمهوراً واحداً، بل هو طيف من الكائنات الباحثة عن خلاص فردي في ظل انسحاب الجماعة. لا أحد جاء ليغير شيئاً، بل الجميع جاء ليهرب من كل شيء. طوطو هنا ليس مغنياً، بل هو كاهن جديد في طقوس ما بعد الحداثة: يبيع المتعة، السخرية، والجنون في آن، ليضمن بقاء الوضع على ما هو عليه. وهو في ذلك لا يختلف كثيراً عن رجال السلطة أو رؤساء الأحزاب، كلهم يشتغلون على إعادة إنتاج النظام نفسه، كلٌّ بأسلوبه.
وهكذا تتحول لحظة "الفرجة" إلى مرآة لحقيقة صادمة: أن هذا الجيل، الذي كان من المفترض أن يكون وقود التغيير، صار وقود الحفلات. وأن المعنى، الذي ناضلنا من أجله طويلاً، صار بضاعة رخيصة في ساحة السويسي. والمفارقة الأشد قسوة، أن كل هذا يجري برضى الأسر، التي ترافق أبناءها لا لتعلمهم، بل لتصفق معهم. لقد سقط الحاجز بين المرفوض والمقبول، بين الفن والانحطاط، بين التمرد والإذعان، ولم يعد لنا سوى أن نستدعي السوسيولوجيا لا لفهم ما يحدث، بل للبكاء عليه بعلم.
طوطو، إذن، ليس شاعراً، بل نبوءة سيئة لمستقبل ينهار فيه الذوق، وتنهزم فيه المعاني، ونكتشف فيه أن العالم لم يعد بحاجة إلى مفكرين ولا مناضلين، بل فقط إلى "مؤثرين" يملؤون الساحات ويعزفون نشيد النهاية.

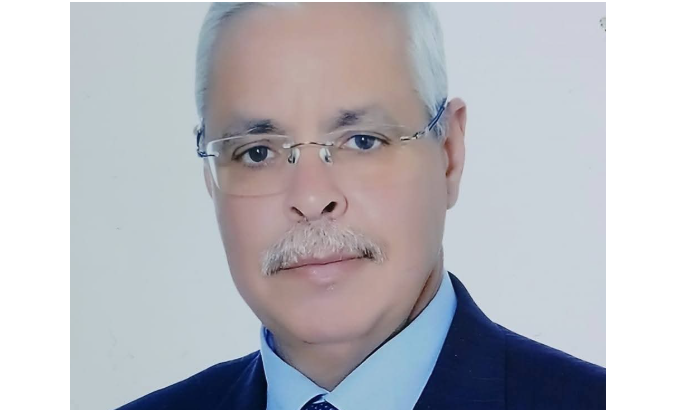 عبد العزيز الخبشي
عبد العزيز الخبشي 
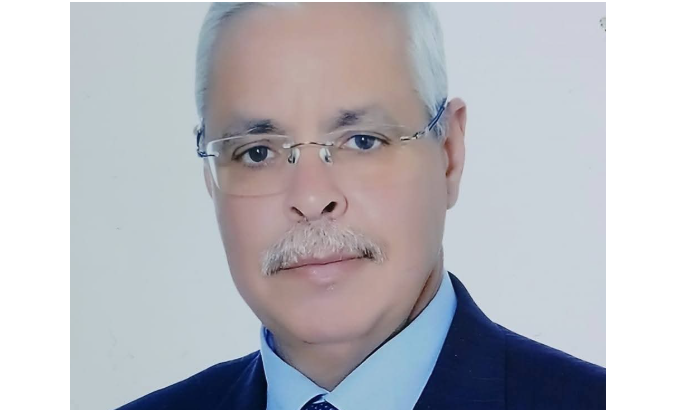 عبد العزيز الخبشي
عبد العزيز الخبشي