لماذا يزهد المبدئيّون من المثقفين في تحمّل المسؤوليات القيادية؟ ولماذا يتصدر المشهدَ العام أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة الفكرية أو الأخلاقية نفسها، بل وربما يمثل بعضهم نقيضًا صريحًا للمعايير التي يُفترض أن تقوم عليها القيادة الرشيدة؟ ولماذا يغيب صوت المثقف العميق والمتزن في زمن يعلو فيه ضجيج الخطاب السطحي والمواقف الانفعالية؟
ليست هذه التساؤلات ترفًا نظريًا، بل هي إشكالية حقيقية تمسّ بنية المجال العمومي وتوازن السلطة الرمزية فيه. فبين من يزهدون في القيادة باسم المبادئ، ومن يتهافتون عليها بلا رصيد أخلاقي أو فكري، يتشكل واقع متناقض تصبح فيه السطحية أكثر تأثيرًا من العمق، ويُحال فيه المثقف إلى موقع المتفرج، أو الناقد المعزول.
يسعى هذا المقال إلى مساءلة هذا الوضع من خلال تفكيك أبعاده البنيوية والنفسية والثقافية، ورصد الديناميات التي تُنتج العزوف من جهة، والضجيج من جهة أخرى. كما يحاول أن يفتح أفقًا للتفكير في إمكانية تصالح المثقف مع الشأن العام دون تفريط في استقلاليته أو رساليته.
1- التهميش البنيوي للمثقف: حين تُقصى الكفاءة باسم الواقعية
غالبًا ما يجد المثقف نفسه مقصيًا من دوائر القرار، لا بسبب ضعف كفاءته، بل نتيجة هيمنة منطق سياسي واقتصادي لا يولي كبير اهتمام لعمق الفكرة أو شرف المقاربة. فالمؤسسات السياسية في العديد من السياقات تُفضِّل «الفاعل القابل للتطويع» على «المفكر النقدي»، و«الخبير التنفيذي» على «صاحب الرؤية».
هذا الإقصاء لا يتم دائمًا عبر آليات صريحة، بل غالبًا ما يُمارَس بصورة رمزية، من خلال تشويه صورة المثقف باعتباره «منعزلًا»، أو «عدميًا»، أو «غير واقعي». كما تُسهم الأنظمة السلطوية أو الزبونية في إعادة إنتاج نخبة هجينة تفتقر إلى العمق الفكري، لكنها تتقن فن البقاء والتسلق.
2- عزوف المثقف الحقيقي: تردد أخلاقي أم انسحاب استراتيجي؟
لا يمكن اختزال غياب المثقف في التهميش فقط، إذ كثيرًا ما يُبادر هو نفسه إلى الانسحاب، إما رفضًا للتنازل عن مبادئه، أو عدمًا للثقة في جدوى الانخراط في مشهد مُشوَّه. وهذا العزوف قد يحمل وجوهًا متعددة: أخلاقي، حين يرى أن مشاركته ستُفقده نقاءه؛ أو معرفي، حين يشك في إمكانية التأثير الحقيقي؛ أو نفسي، حين يشعر بالخذلان أو الإرهاق.
إلا أن هذا التردد لا يخلو من إشكال، إذ يُعيد إنتاج عزلة المثقف، ويترك المجال فارغًا أمام فاعلين أقل مسؤولية، بل وقد يرسخ الانطباع بأن المثقف لا يملك حلولًا، بل يكتفي بالنقد من بعيد.
3 - مفارقة القيادة: من يتصدر؟ ولماذا؟
إذا كان المثقف الحقيقي يعزف عن القيادة، فإن الفراغ لا يبقى طويلاً، بل يُملأ غالباً من طرف فاعلين يختلفون في تكوينهم وخلفياتهم وغاياتهم. فالتقدم المفارق للوصوليين أو غير الأكفاء يعود إلى تمتعهم بمرونة في التكيف مع متطلبات النظام، دون حساسيات فكرية أو ترددات قيمية. إنهم يتحركون ضمن منطق «الوظيفة لا الرسالة»، و«الاستثمار لا الالتزام».
ويُعزز من هذه المفارقة النموذج السائد للقيادة في المخيال الاجتماعي، حيث يُصوَّر القائد كـ«رجل واقعي» أو «شخص عملي»، وهي صفات قد تتناقض جذريًا مع طبيعة المثقف التي تميل إلى النقد والتريث. كما أن النظام الإعلامي والمؤسساتي يُمارس عنفًا رمزيًا يستبعد المثقف من دوائر التأثير، ويدفع به نحو الهامش.
4- المثقف بين الرسالة والمكانة: نحو أفق جديد للمشاركة
إن تجاوز هذه الإشكالية لا يكون بتطبيع غير مشروط بين المثقف والسلطة، ولا بانكفاء دائم باسم الصفاء الأخلاقي، بل بإعادة صياغة دور المثقف ضمن أفق جديد يُمكّنه من الجمع بين الرسالة التي يحملها، والمكانة التي يستحقها.
فالمثقف لا يُطلب منه أن يتحول إلى موظف أو وزير، بل أن يشارك في صياغة التصورات المجتمعية من موقع فاعل. ويمكنه ذلك من خلال التأطير المدني، أو المرافعة الفكرية، أو تقديم الخبرة للسياسات العمومية. كما أن المجتمع بحاجة لإعادة تعريف "النخبة" بشكل لا يفصل بين العمق والإسهام العملي.
إن استعادة المثقف لدوره القيادي لا تعني التخلي عن مهمته النقدية، بل تعني توسيع مسؤوليته لتشمل الفعل إلى جانب القول، والمشاركة إلى جانب التحليل. وحده المثقف الذي يعي هذا الدور ويصالح بين الفكر والواقع، قادر على تحويل العزوف إلى التزام، والانكفاء إلى مشاركة، والهامش إلى مركز جديد للمعنى.
خاتمة
ليست إشكالية عزوف المثقف الحقيقي عن القيادة مجرد ظاهرة طارئة أو خللاً فرديًا، بل هي عرض لخلل أعمق في علاقة المعرفة بالسلطة. وإن مستقبل المجتمعات لن يستقيم إلا بقدر ما يُعاد الاعتبار للجسر المقطوع بين المثقف والمجال العمومي.
يبقى السؤال الكبير مفتوحًا: هل يستطيع المثقف أن يخرج من صمته دون أن يتخلى عن استقلاليته؟ وهل يمكن للسلطة والمجتمع أن يعيدا الاعتبار للكفاءة الأخلاقية والمعرفية؟ إن الإجابة ليست نهائية، لكنها تبدأ من الوعي بهذه المفارقة ومن جرأة التفكير في تجاوزها.

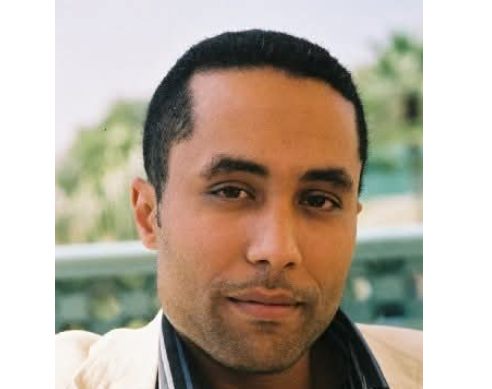 رشيد شخمان
رشيد شخمان 
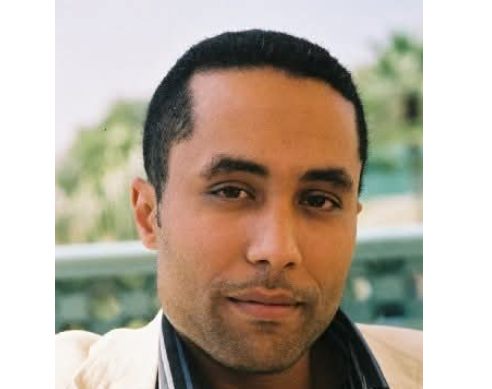 رشيد شخمان
رشيد شخمان