شهدت إحدى الجامعات المغربية حدثا غريبا يتمثل في رفض عميد كلية، بالدار البيضاء، تسليم جائزة التفوق لإحدى الطالبات المتميزات، لأن الطالبة المتوجة تضع الكوفية الفلسطينية على كتفيها. ويبدو من خلال الفيديو الذي "يؤرخ" لهذا الحا دث الشنيع، والذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم، أن العميد حاول أن يقنع الطالبة بخلع الكوفية، وعندما رفضت، اكتفى من الغنيمة بالإياب فانسحب من المنصة دون أن يسلم الجائزة لصاحبتها.
وقبل ذلك بأيام قرأنا في الصحف والمواقع الإخبارية أن إحدى الجامعات المرموقة بالمغرب ألغت الاحتفال الخاص بتسليم الشهادات إلى خريجيها لمجرد أن علم المسؤولون عنها بأن بعض الطلبة ينوون حمل الكوفية الفلسطينية في حفل التخرج تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية.
الذين أنكروا على الطالبة حمل الكوفية الفلسطينية من المعلقين ومن الصحفيين، وهم قلة لا يعتد بها أمام موجة الشجب والاستنكار التي خلفها منظر ذلك العميد وهو يمتنع عن تسليم الجائزة، رأوا فيها رمزا سياسيا لا ينبغي استعماله في الحرم الجامعي الذي من المفروض أن يكرس كفضاء للعلم والتحصيل وليس لغيرهما. وبالتالي فإن الكوفية الفلسطينية تمثل في رأي هؤلاء ضربا من الدعاية السياسية، وأنها تعبر عن موقف سياسي داعم لجهة دون أخرى في الحرب التي تدور رحاها في غزة...
وكأننا أمام طرفين متساويين في الحقوق والمسؤوليات، ولسنا أمام محتل اغتصب أرض غيره بقوة السلاح والنار وهجر أهلها، ويعمل الآن من أجل تهجير من بقي منهم كي يتفرغ لاحتلال أراض عربية أخرى، في أفق تحقيق إسرائيل الكبرى.
هذا الموقف "المحايد" حيث لا ينبغي أن يكون الحياد، هو موقف غريب على المغاربة الذين سالت دماء آبائهم وإخوانهم في ساحة الشرف على أرض فلسطين والجولان. ومن هنا فإن غرابته تتحول إلى نوع من الوقاحة وهي تستخف بمشاعر المواطنين المغاربة، الذين يخرجون يوميا إلى الشوارع محتجين منذ ما يزيد عن تسعة أشهر، وقد بحت أصواتهم ضد المذابح التي يذهب ضحيتها كل يوم عشرات الفلسطينيين العزل من النساء والأطفال.
إنه موقف شاذ يخفي وراءه أمورا أكثر خطورة من حادث عابر جعل من الكوفية الفلسطينية، ولو أنها كانت تحمل العلم المغربي إلى جانب العلم الفلسطيني، رمزا مخيفا يخالف الأعراف والتقاليد الجامعية. مع أن هناك طلبة يروق لهم أن يضعوا ملابس تحمل العلم الأمريكي، يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي، يحضرون الدروس والمحاضرات بكل حرية، دون أن يعترض عليهم أحد، ويتهمهم بأنهم يحملون رموزا سياسية حيث لا يصح حملها.
ولعل الخطورة الكبرى لهذا الموقف الشاذ تكمن في أن بعض المسؤولين من أمثال ذلك العميد، أصبحوا يعتقدون أن المدخل الأساس للحفاظ على الكرسي هو النأي بالنفس عن القضايا الكبرى التي تؤسس للمشاعر الوطنية والتي تعبر في العمق عن هوية وأصالة الشعب المغربي، التي لا يمكن فصلها عن بعدها العربي، وعن تعبيراتها الإنسانية.
ولكن الأخطر من ذلك كله أن هذا لموقف أصبح يعبر عن خوف من إرهاصات نزعة صهيونية بدأت في التشكل، وأصبحت هاجسا يعتري بعض المسؤولين، وما فتئت تلك النزعة تتقوى شيئا فشيئا، وتعلن عن نفسها من طرف بعض الشخصيات العامة وبعض المنابر الإعلامية، دون اعتبار للشعور العام المغربي.
لا شك في أن اتفاقية التطبيع التي وقعها سيء الذكر سعد الدين العثماني عندما كان رئيسا للحكومة عن حزب العدالة والتنمية مع حكومة الكيان الصهيوني، قد شجعت بعض الوجوه المتصهينة على الخروج إلى العلن والجهر بموقفهم الذي يسير عكس الإرادة العامة للمغاربة في الموضوع. ومع ذلك فإن محاولات استقطاب بعض الأشخاص المغاربة من طرف العدو الإسرائيلي الصهيوني، تعود إلى تسعينيات القرن الماضي حين كنا نسمع ونقرأ عن زيارات سرية قام بها بعض الذين يصنفون بأنهم مثقفين وبعض رجال الأعمال إلى الكيان الصهيوني.
كان أصحاب هذه المبادرات المخجلة يحرصون على إخفاء خطيئتهم خشية تعرضهم للعزلة داخل المجتمع المغربي، وفي هذا اعتراف بأن ما كانوا يقومون به عمل مشين...
غير أن اتفاقية التطبيع فتحت الباب أمام بعض الأقلام المأجورة وبعض رجال الأعمال الانتهازيين كي يعلنوا انحيازهم للصهيونية، وبأصوات عالية هذه المرة، فرفع البعض شعار "كلنا إسرائيل" وأسهب البعض الأخر في تبرير العدوان الإسرائيلي على فلسطين بذرائع مختلفة، فمنهم من يرى بأن هذه الحرب التي تدور رحاها بغزة والضفة هي حرب الأخرين، لا ناقة للمغاربة فيها ولا جمل، وبأنها حرب إيديولوجية بين إسرائيل "الديمقراطية" و"حماس الإخوانية". ومنهم من يذهب بعيدا فيجد فيها حربا بين العرب وإسرائيل، وبما أن المغاربة "أمازيغا" وليسوا عربا فإنها لا تعنيهم في شيء.... إلى غير ذلك من التبريرات المغرضة التي تريد للمغاربة أن ينسلخوا عن تاريخهم وهويتهم.
امام هذا المد الصهيوني بدا لبعض المسؤولين عن الجامعات المغربية ممن نزلوا بالمظلات على كراسيهم، أن حركات مثل تلك التي قام بها ذلك العميد، قد تلمع صورتهم أكثر، وربما تجعلهم يحرقون المراحل كي يترقوا سلم الوظيفة إلى مناصب أعلى...
هكذا فإن عميد الكلية ليس وحده من يحمل هذا الوهم، فقد سبقه إلى ذلك رؤساء جامعات وعمداء آخرون، بادروا إلى استضافة باحثين معروفين بميولهم الصهيونية، وقاموا بتوقيع اتفاقيات تعاون مع جامعات صهيونية ندد بها الأساتذة الجامعيون في بيانات أصدرتها النقابة الوطنية للتعليم العالي. وهذا يوضح إلى أي حد يأخذ الصراع مع المتصهينين طابعا حادا على الرغم من انه لم يكشف عن كل ملامح وجهه البشع إلى حد الآن.
لا بد أن يكون النصر في هذا الصراع لأصحاب الحق، المدافعين عن القضية العادلة للشعب الفلسطيني. أما المهرولون نحو الصهيونية فمآلهم الفشل لأنهم يفتقرون إلى قضية يدافعون عنها، وأهدافهم أضيق من خرم الإبرة، لا تتعدى مصالحهم الشخصية الآنية. من أجل ذلك فإن الجهات التي تدعمهم سرعان ما ستتخلى عنهم وتخذلهم عندما يستنفدون أدوارهم القذرة.
الوضع الذي يعرفه المغرب في هذه الأيام إزاء هذه الحالة، شبيه بوضع المصريين آواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات، فعلى الرغم من أن الدولة المصرية كانت سباقة إلى توقيع معاهدة صلح مع إسرائيل، إلى أن تلك الاتفاقية لم تستطع أن تغير من موقف المثقف المصري والمواطن الصري عامة، اتجاه الكيان الصهيوني باعتباره كيانا مغتصبا، وظل المجتمع المصري عصيا عن التطبيع. والمجتمع المغربي ليس أقل إيمانا بالقضايا العادلة من المجتمعات العربية الأخرى، ولذلك سيبقى وفيا لقيمه الأصيلة في الدفاع عن فلسطين حرة مستقلة.

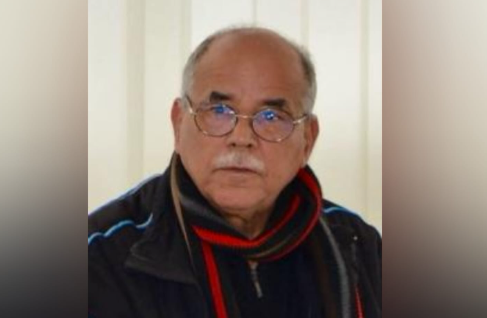 حسن مخافي
حسن مخافي 
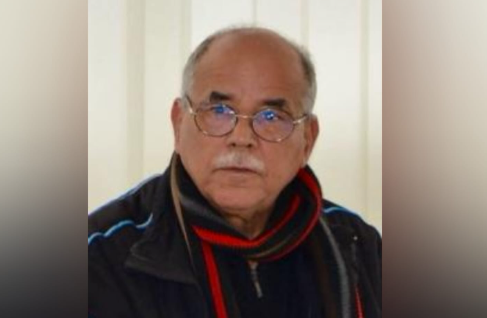 حسن مخافي
حسن مخافي