صدر مؤخرا كتاب: «البرلمان وحقوق الإنسان: مرجعيات وممارسات» للباحث عبدالرزاق الحنوشي، وقد حظي المؤلف باهتمام لافت عكسته اللقاءات المتعددة التي نظمت في عدة مدن (نحو 20 لقاء في ظرف أربعة أشهر)، وكذا القراءات النقدية والتحليلية التي أنجزتها العديد من الفعاليات الأكاديمية والحقوقية. وسبق لنا في «الوطن الآن» و«أنفاس بريس» أن نشرنا بعضها. ومواكبة للدخول الثقافي الجديد، نواصل نشر مساهمات جديدة. في هذا العدد ننشر مساهمة عثمان الزياني، أستاذ بكلية الحقوق بوجدة
يعد كتاب «البرلمان وحقوق الإنسان» للباحث عبد الرزاق الحنوشي من صنو الكتب التأسيسية في مجال الدراسات البرلمانية المتعلقة بوظيفة البرلمان المغربي في مجال حقوق الإنسان، والتي يحكمها دون شك عامل الندرة. والكاتب يلفي من خلاله الى ضرورة الاشتغال المعرفي والفكري والاكاديمي على هذه الموضوعة كمجال لم ينل حظه من الاهتمام الكافي حتى على مستوى الدراسات البرلمانية المقارنة، إذ يعد حقلا معرفيا في طور البناء والتشكل بفعل استعصاءات ابستيمية / معرفية، وفروض قانونية وتقنية وتجاذبات سياسية تصده باستمرار، وتعقد مساراته وسياقاته .وأمام عسر هذه الولادة، يأتي هذا الكتاب كدعوة صارخة للخوض في دور البرلمان في تعزيز حقوق الإنسان عبر استنفار حزمة ميكانيزماته التشريعية والرقابية والدبلوماسية .ولعل في الاشتغال الاصيل على معطى الحصيلة البرلمانية في المجال الحقوقي مؤشر قوي على مدى أهميته وفرادته. ودون شك يمكن اعتبار هذا الكتاب من البدايات الرصينة والمحمودة التي يمكن أن تشكل المرجع الأصيل في هذا المجال المفعم بالتغيرات المساقية الدائمة، حتى وإن كان التمحيص العلمي والبحثي الوافي يستوجب في كثير من الأحيان، استنفار أدوات منهجية غير الوصف والتوثيق، وعليه فالكتاب يشكل دعوة صريحة للباحثين للانخراط في الكشف عن الظاهر والمضمر في مجال الفعل البرلماني الحقوقي، والذي سيفيد كثيرا في توسيع دوائر الفهم، والكشف عن الجانب السلوكي والممارساتي، خصوصا مع ادراك أن هذا الفعل لا ينحصر في الجانب القانوني والتقني، وإنما تكتنفه الكثير من العمليات السياسية المسترسلة، والذي يشتغل تحت ضغط وفروض المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
ولاشك أن قراءة الكتاب أفضت إلى الخروج باستنتاجات محورية قائمة على أساس استحضار ما هو قائم وما يجب أن يكون على مستوى الممارسة البرلمانية في مجال حقوق الإنسان، وذلك وفق العناصر التالية:
- أولا: دراسات وأبحاث البرلمان وحقوق الانسان كحقل معرفي ناشئ: لا تزال دراسة البرلمانات وحقوق الإنسان مجالًا ناشئًا، مما يعني أنه، مع استثناءات ملحوظة، فإن دورها وفعاليتها في التعامل مع حقوق الإنسان لا يخضعان للبحث، مما يعني أن النهج الحذر له ما يبرره، وعليه ينبغي النظر في هذا الأمر .من وجهة التحديات النظرية والمنهجية والمعرفية، مع استحضار البحوث المقارنة، على اعتبار أن عبور الحدود العلمية والاكاديمية تفضي إلى زيادة تيسير عملية تحليل وتفسير نتائج الدراسة. على الرغم من وجود ادراك عام لحجم المشكلات العديدة المتعلقة بإجراء البحوث المقارنة في عالم من الترابطات المعقدة في مجال حقوق الإنسان.
كما تنبع الصعوبة الأخرى من الطبيعة الدقيقة التي يصعب قياسها للتأثير البرلماني .ففي الواقع، تمت مقارنة تأثير العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان بجبل جليدي بحسب تعبير «دونالد أليس donaldalice»، الذي لا يظهر منه إلا قمته، لكن كتلته المغمورة غير مرئية .حيث في قمة الجبل الجليدي توجد التأثيرات الملموسة: التغييرات في التشريعات أو السياسات التي هي نتيجة مباشرة للتوصيات البرلمانية؛ التأثير المباشر على الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية لمتابعة الأحكام أو القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، على سبيل المثال من خلال الشروع في مراجعة خطة العمل أو تغيير التشريعات، تعديل نظام تنفيذ الأحكام من قبل السلطة التنفيذية، لا سيما من خلال وضع الآليات والمواعيد النهائية لتقديم التقارير إلى البرلمان ونقل المعلومات إليه. أما الجزء المغمور من الجبل الجليدي غير قابلة للقياس الكمي بشكل جيد؛ إذ يمكن أن يكون، على سبيل المثال، نتيجة نشاط غير رسمي، والذي لا يظهر في أي وثيقة، ويحدث في الممرات أكثر مما يحدث في غرف اجتماعات اللجان أو غرف البرلمان. يشمل هذا التأثير الذي يصعب قياسه، على سبيل المثال، جمع وتوليف الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على القضايا التي قد يتم التغاضي عنها، وتحسين الجودة.
وعلى الرغم من ذلك فإن أهمية كتاب البرلمان وحقوق الإنسان لكاتبه عبد الرزاق الحنوشي، يؤكد في مختلف محاوره ومحتوياته على أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أمر محوري لسبب وجود المؤسسات البرلمانية وعملها. فالبرلمانات تعد بمثابة المؤسسات «الوصية» الطبيعية على حقوق الإنسان، بسبب ما تملكه من سلطات تشريعية، ودورها المحوري كغرف نقاش وطنية ووظيفتها الرقابية ومسؤولياتها المتعلقة بالميزانية .وهنا يمكن الاشارة إلى أنه تم الاعتراف منذ فترة طويلة بالأهمية المركزية لحقوق الإنسان في عمل البرلمانات، والأهمية المركزية للبرلمانات في التمتع بحقوق الإنسان .فالاتحاد البرلماني الدولي يؤكد دائما على ضرورة تطوير وتعزيز دور البرلمانات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وكان يؤسس لضرورة «الاعتراف بأن البرلمانات لديها مساهمة حاسمة في مجال حماية حقوق الإنسان، على اعتبار أنها ليست عملية تقنية؛ إذ غالبًا ما تتطلب مناقشات وقرارات سياسية صعبة .لذلك فإن المكون السياسي لا مفر منه.
كما يمكن للبرلمانات أن تساعد في تعزيز النقاش العام حول حقوق الإنسان والسعي للحصول على مدخلات من جميع شرائح المجتمع. علاوة على ذلك، يمكنها إضفاء الشرعية الديمقراطية على نتيجة هذا النقاش وحشد الدعم العام للتنفيذ .ومن أجل تعزيز هذا الدور، تحدد أحدث وثيقتين إستراتيجيتين للاتحاد البرلماني الدولي، للفترة 2012-2017 و2017-2021، حماية وتعزيز حقوق الإنسان كأحد التوجهات الاستراتيجية الرئيسية للمنظمة .ومن أجل تشجيع البرلمانات على المشاركة بشكل منهجي في قضايا حقوق الإنسان، تمت صياغة مجموعة من المقترحات على مستوى الأمم المتحدة .في يونيو 2018، اقترح مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) مسودة مبادئ بشأن المشاركة البرلمانية في حقوق الإنسان؛ مشروع المبادئ المتعلقة بالبرلمانات وحقوق الإنسان (يشار إليها فيما يلي بمسودة مبادئ 2018) .وهذا تطور هام يمثل تتويجًا للجهود التي تم بذلها على مستوى الأمم المتحدة، بما في ذلك على مستوى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، في محاولة لزيادة مشاركة البرلمانات في حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
- ثانيا: تواضع أداء البرلمان المغربي في مجال حقوق الإنسان: إن مضامين الكتاب تؤكد على أنه على الرغم من تنامي دور البرلمانات في مجال حقوق الانسان، فإنها لم ترقى إلى المستوى المطلوب، ذلك أنه على الرغم من أن البرلمانات يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في الإشراف على أعمال السلطة التنفيذية وتعزيز المساءلة، فضلاً عن ضمان امتثال القوانين والسياسات والممارسات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، نجد على خلاف ذلك وفي جميع أنحاء العالم لا تشارك العديد من البرلمانات بنشاط كبير ومحفز، ومازال يعتورها الكثير من النقص في شؤون حقوق الإنسان. وهذا يمثل فجوة في الإطار الوطني لحماية حقوق الإنسان. فهناك مؤشرات على أنه، حتى في الديمقراطيات عالية الجودة (المحددة، على سبيل المثال، من خلال مقياس فريدوم هاوس وبوليسي)، لا تعمل البرلمانات فيها بشكل جيد في مجال حقوق الإنسان. حيث إنها لا تشارك بشكل كافٍ في مجال حقوق الإنسان، وبالطريقة التي تستفيد بها استفادة كاملة من صفاتها الديمقراطية، أو بحكم روابطها مع النظام الدولي لحقوق الإنسان. وهذا المعطى ينطبق حتى على مستوى البرلمان المغربي، وهذا ما يؤكده الباحث «عبد الرزاق الحنوشي» بين ثنايا كتابه الذي يستعرض فيه الحصيلة الكمية والنوعية لأداء البرلمان المغربي في مجال حقوق الإنسان.
والأكيد ما يعزز هذا التوجه هو أن هناك حقيقة أساسية يجب إدراكها ووضعها في الحسبان، وهي أن المؤسسة البرلمانية حتى وان تم التفكير فيها على أنها تجسد السيادة الشعبية، والبرلماني يعتبر ممثلا للامة، إلا أنها اصبحت عبارة عن «أغورا مغلقة» عن محيطها الخارجي، ولا تشكل امتدادا للفضاء العمومي الذي غالبا ما يعرف توترات وتفاعلات مختلفة مرتبطة بقضايا حقوق الانسان، والتي لا تجد لها في الغالب صدى في شكل تعبيرات داعمة في الفضاء البرلماني، وذلك بفعل ضوابط وقيود مؤسسية وقانونية وتنظيمية وإجرائية. وأضف إلى ذلك أن المؤسسة البرلمانية هي عبارة عن نسق فرعي من نسق الدولة القائم على أساس هندسة مؤسساتية مضبوطة ومحكمة ذات طابع هرمي/تراتبي، والبرلمان هو مؤسسة غير مستقلة وملحقة ،و الأكيد أن تصوراتها فيما يتعلق بمقاربة حقوق الإنسان لا تخرج عن سياق تصور الدولة في حد ذاته، بما يحمله من محاذير والمسموح به أيضا، وبالتالي لا المؤسسة البرلمانية ولا البرلمانيين يمكن أن يشكلوا الصوت النشاز في ذلك.
وحتى من خلال تمحيص الحصيلة التي يستعرضها الباحث عبد الرزاق الحنوشي يتبين بشكل جلي أن البرلمان المغربي لم يؤسس بعد من خلال عمله ومنطق اشتغاله لنوع من «الأصلانية البرلمانية» في الدفاع والترافع عن حقوق الانسان، أي تكريس عادات وممارسات وسلوكيات فريدة في المرافعة الحقوقية تقتدي بما هو معمول به في البرلمانات المقارنة الرائدة في هذا المجال، حيث أن الامر لا يعدو سوى مجرد مناوشات بدائية حاولت استنفار العقل السياسي/ البرلماني في هذا الاتجاه بشكل مقيد ومسيج. وحتى «اللوغوس الكلامي البرلماني لم يستطع انتاج خطاب حقوقي تأصيلي، وبلاغي، وإقناعي، واستدلالي.
وأضف إلى ذلك أن الفعل التشريعي بخصوص مراجعة مشاريع القوانين للتأكد من توافقها مع معايير حقوق الإنسان يصطدم بطابعها التقني المعقد وعامل الوقت، حيث تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية للبرلمانيين فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الرصد المنتظم لمدى توافق مشاريع القوانين مع حقوق الإنسان. وقد تكون هذه الوظيفة شاقة، خاصة إذا تم نشر المسودات وفقًا لجدول زمني سريع التغير، مما يترك القليل من الوقت للهيئات البرلمانية لدراسة الآثار المترتبة على حقوق الإنسان وإخطار البرلمان بأي تعديلات مطلوبة. كما يمكن أن يمثل الحجم الهائل للنصوص قيد الإعداد تحديًا أيضًا نظرًا لقيود الوقت والموارد التي يواجهها البرلمانيون. وعلى هذا الاساس تم طرح حلان أساسيان للتخفيف من هذه المشاكل. فمن ناحية ، يجب على البرلمانيين أن يطلبوا من السلطة التنفيذية أن ترفق بكل مشروع قانون مذكرة مفصلة عن حقوق الإنسان، تشرح سبب اعتبار الحكومة أن النص متوافق مع حقوق الإنسان أو يسلط الضوء على إمكانية عدم التوافق. من ناحية أخرى، قد يقرر البرلمانيون إعطاء الأولوية للفحص التفصيلي لمشاريع القوانين التي تبدو آثارها على حقوق الإنسان وسيادة القانون بالنسبة لهم الأكثر خطورة. وهذا ما يتم العمل به في الكثير من البرلمانات المقارنة.
وأما على مستوى الفعل الرقابي فهو مسيج بإشكالية غلبة التوظيف السياسي والحزبي للأسئلة البرلمانية، حيث نجد أن الأسئلة الشفوية والمكتوبة غالبًا ما تكون رمزية، بسبب عواقبها المحدودة على السياسة الحقوقية. وبهذه الطريقة، فهي تشبه الأشكال الأخرى للتواصل السياسي، ولا سيما اتصالات الحملة الانتخابية . تستخدم الفرق البرلمانية الأسئلة البرلمانية ليس لأنها عادة ما تهتم بالإجابات التي تقدمها الحكومة، ولكن من أجل تعزيز مصالحها الخاصة. إذ تخضع الأدوات البرلمانية الرقابية في كنهها ووظيفيتها خاصة الأسئلة لمنطق الحملة الانتخابية الدائمة بين الأحزاب، إذ نجدها تشكل استمرار للحملات الانتخابية بوسائل مختلفة. وعليه يمكن فهم استخدام الأدوات البرلمانية (الرقابة) من خلال دراسة إلى أي مدى يمكن تفسير استخدام الأسئلة البرلمانية من قبل الفرق والمجموعات البرلمانية من خلال نظريات المنافسة الحزبية. وبالتالي تماشياً مع نظرية ملكية القضية، دائما ما يتم التوقع أن تطرح الأحزاب أسئلة حول الموضوعات التي ركزوا عليها في برنامجهم، حيث تستخدم الأحزاب الأسئلة البرلمانية للحفاظ على ملكيتها للقضايا والدفاع عنها. ومع ذلك، فإن المنافسة في القضايا ليست سوى جانب واحد من جوانب المنافسة الحزبية. ذلك أنه بالاعتماد على النظريات المتعلقة بالحملات السلبية، غالبا ما تختار الأحزاب استهداف أو «مهاجمة» الوزراء من الأحزاب التي تتنافس معها على الناخبين ، وذلك باستخدام الأسئلة البرلمانية لجذب الانتباه السلبي لمنافسيها. تشير هذه الأدبيات في الوقت نفسه إلى أن الأحزاب قد تختار تركيز اهتمامها على الوزراء من الأحزاب التي تختلف معها أيديولوجيًا. وهنا نفهم كيفية استخدام الأحزاب للأدوات الرقابية البرلمانية لتعزيز أهدافها الانتخابية والسياساتية، مما يؤثر بشكل كبير على سلوكها الرقابي خصوصا الاسئلة البرلمانية بشقيها الكتابي والشفوية في تعاطيها مع المجالات الرقابية التي تعنى بجانب حقوق الانسان. وهذا ما يفسر إلى حد كبير ترسيخ فكرة «البرلماني الخدماتي» وصعوبة تشكل «البرلماني المدافع عن حقوق الانسان»، وعليه فهذه النوازع التي تحكم سلوك البرلمانيين من حيث اتجاهاتهم وتفضيلاتهم وأولوياتهم تفعل فعلها، وترهن تطوير دور المؤسسة البرلمانية في مجال حماية حقوق الإنسان، لأن البرلماني في المغرب لم يستطع بعد الانسلاخ عن تكريس نموذج «البرلماني الخدماتي» الذي يجهد نفسه في الانتقال بين أروقة البرلمان والوزارات لقضاء مصالحه ومصالح هيئته الناخبة .وفي طقوس العبور إلى البرلمان أيضا عبور إلى الوجاهة الاجتماعية والتقرب من السلطة. وعلى هذا الأساس لم يتشكل نموذج البرلماني المدافع عن حقوق الإنسان بعد.
- رابعا: إن أهمية الكتاب تكمن بالأساس في كونه يفتح افاقا واسعة في مجال التفكير في كيفيات تطوير وتفعيل دور البرلمان المغربي في مجال حقوق الإنسان عبر مدخل المأسسة، عبر استحضار منافع وفوائد انشاء لجنة برلمانية متخصصة سواء على مستوى مجلس النواب ومجلس المستشارين أيضا، وذلك انسجاما مع التوجهات العالمية في هذا الصدد عبر تجاوز نموذج تعميم حقوق الإنسان على مختلف اللجان البرلمانية الدائمة، الذي يستند إلى الاعتقاد السائد بأن «كل لجنة هي لجنة لحقوق الإنسان»، والبرلمان المغربي لا يخرج عن هذا الاطار في ظل الجمع بين مجالات العدل والتشريع وحقوق الإنسان في لجنة واحدة والذي أثبت محدوديته على مستوى الواقع والممارسة، مع أنه وجب الذكر، بأن مجال حقوق الإنسان غير وارد على سبيل الحصر بالنسبة لهذه اللجنة، وانما مجال يقع في صميم اختصاصات اللجان البرلمانية الاخرى، وعليه يجب إحداث لجنة برلمانية متخصصة بحقوق الإنسان، وتمكينها بمختلف الموارد المادية والبشرية واللوجيستيكية التي تمكنها من حسن اداء عملها. بالنظر إلى مزايا اعتماد هذا النموذج:
- أولا: إن إنشاء لجان ذات ولاية حصرية تتعلق بحقوق الإنسان يبعث برسالة سياسية قوية إلى الشعب والحكومة وهيئات الدولة الأخرى.
- ثانيًا: تجادل البرلمانات التي تتبع هذا النهج بأن اللجان المخصصة لحقوق الإنسان تساعد في تعزيز تعميم حقوق الإنسان عبر اللجان الأخرى ذات الصلة، من خلال توفير مركز أو نقطة محورية واحدة لتنسيق وقيادة أجندة حقوق الإنسان على مستوى البرلمان.
- ثالثًا: ووفقًا لبعض برلمانيي الكومنولث، يمكن أن يساعد إنشاء لجان مخصصة لحقوق الإنسان أيضًا في بناء قدرات ومعرفة الأعضاء، من خلال السماح لهم للتركيز على جميع قضايا حقوق الإنسان وتغطيتها بشكل مترابط أي بطريقة شمولية. يمكن بعد ذلك نقل هذا الوعي والخبرة إلى لجان أخرى . أخيرًا، يؤدي إنشاء لجنة واحدة لحقوق الإنسان إلى تعزيز الوضوح المؤسسي، وإنشاء نقطة محورية واحدة للبرلمان دور متعدد الأوجه في التنفيذ والرصد، والإبلاغ عن الواجبات والالتزامات الدولية / الإقليمية. وفي هذا الصدد يقترح مشروع المبادئ لعام 2018 إنشاء (أو تعزيز) لجنة برلمانية لحقوق الإنسان تتمتع بصلاحيات واسعة للنظر في جميع حقوق الإنسان. كما يجب أن توفر التفويضات الممنوحة للجان البرلمانية وضوحًا من حيث غرضها وأهدافها. ولضمان فعالية اللجان، تم تحديد طريقة عملها أيضًا في قسم المسؤوليات والوظائف في مسودة المبادئ 2018 التي اقترحها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، حيث ينبغي على اللجنة «...قيادة العمل البرلماني استجابة لتطورات وقضايا حقوق الإنسان الوطنية» من خلال التشريعات والاستفسارات وجلسات الاستماع العامة والمناقشات وإصدار التقارير..
- خامسا- إن الكتاب يبصم على ضرورة إذكاء السياق التعاوني والتوافقي والقطع مع «النزعة الغلبوية» للحكومة وأغلبيتها في مجال تعزيز دور البرلمان المغربي في حماية حقوق الإنسان. ذلك أنه في العديد من النظم البرلمانية المقارنة، تفشل الأحزاب الحكومية والمعارضة تماما في التوصل إلى تفاهم بشأن ما أسماه الأمين العام للكومنولث «السياق التعاوني» لعملهم، حيث لا يوجد اتفاق بشأن الأدوار والحقوق والمسؤوليات على الحدود والتوافق، ذلك أن فكرة وجود معارضة «بناءة ومسؤولة» تعني عمليا، متى وكيف يجب على الحكومة والمعارضة العمل معا لتعزيز التوافق الوطني بشأن مجالات حقوق الانسان؟، وفي كثير من الحالات، لا يوجد حوار حقيقي على الإطلاق. وباختصار، في كثير من الأحيان لا يوجد أي معنى في أن الحكم وأحزاب المعارضة ترى نفسها كشركاء في تطوير العملية الديمقراطية. وكثيرا ما يكون هناك نهج «الفائز يأخذ كل شيء winner takes all» من جانب أحزاب الأغلبية الحاكمة المساندة بشكل آلي للحكومة، والتعبير عن ذلك هو الميل إلى اعتبار النصر في صناديق الاقتراع بمثابة دعوة للهيمنة والسيطرة على جميع الهياكل الديمقراطية ومعاملة مؤسسات الدولة على أنها تشكل امتداد لأحزاب الأغلبية، وقد يكون هناك أيضا تصميم على التخلي تماما عن المعارضة بدلا من العمل معها، ولا زال من الصعب على إقرار الاعتراف الحقيقي للمعارضة بدورها التشريعي والرقابي خصوصا على المستوى الممارساتي، حيث يستوجب تعزيز قدراتها الترافعية عن حقوق الإنسان منحها مكانا رسميا في الترتيبات البرلمانية وغيرها من الترتيبات السياسية.
وفي الختام يمكن القول على أن تعزيز القدرة الترافعية للبرلمان في مجال حقوق الانسان تستلزم العمل أيضا في اتجاه تمكين البرلمان والبرلمانيين من اكتساب عامل الخبرة عبر التدريب والتكوين وتقديم الخدمة والمساعدة والاستشارة في مجال حقوق الإنسان، فمن الأهمية بمكان أن يكون المستشارون البرلمانيون مستقلين سياسياً وعددهم كافٍ، وأن يستفيدوا من الموارد الكافية وأن يكون لديهم أكبر قدر ممكن من الفرص لتطوير قدراتهم الخاصة فيما يتعلق بمعرفتهم وفهمهم لحقوق الإنسان وسيادة قانون .بالإضافة إلى ذلك، يعني هذا الدور الاستشاري الحيوي أن الخبرة القانونية لهؤلاء المستشارين لا ينبغي أن تقتصر على لجنة برلمانية واحدة، بل يجب أن تمتد إلى أقصى حد ممكن لتشمل النطاق الكامل للأنشطة البرلمانية .ويمكن أن ينطبق مبدأ هذا التعميم أيضًا على خدمات البحث والمعلومات المهنية داخل البرلمانات، والتي تكمل بشكل مفيد عمل المستشارين القانونيين .إذ يجب أن تتضمن خدمة البحث البرلماني اعتبارات حقوق الإنسان وسيادة القانون ذات الصلة في موادها الموجزة، ويمكنها أيضًا تزويد البرلمانيين مسبقًا بتحديثات حول التطورات الهامة في مجال حقوق الإنسان، توقعًا لقضايا حقوق الإنسان التي سيتم تناولها في مختلف الأنشطة البرلمانية.
عثمان الزياني، أستاذ بكلية الحقوق بوجدة

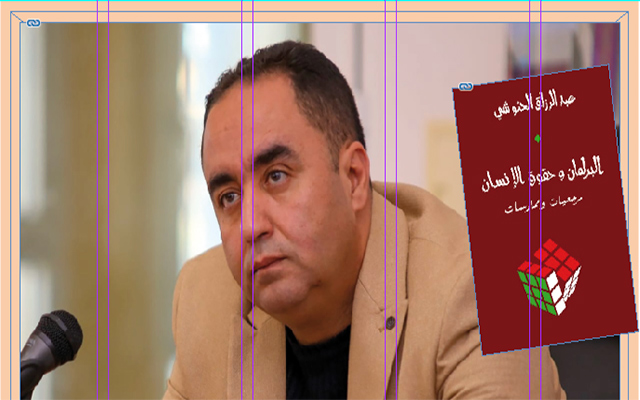 عثمان الزياني، أستاذ بكلية الحقوق بوجدة
عثمان الزياني، أستاذ بكلية الحقوق بوجدة 
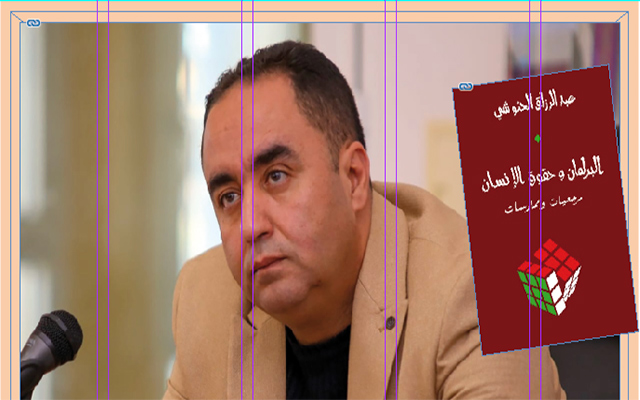 عثمان الزياني، أستاذ بكلية الحقوق بوجدة
عثمان الزياني، أستاذ بكلية الحقوق بوجدة